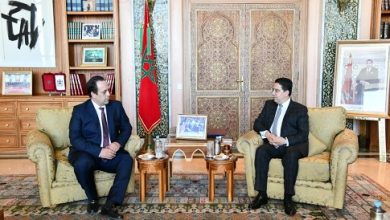الشاعر الفلسطيني محمد القيسي عاش… درويشاً متجولاً

كان ظل الشاعر الكبير محمود درويش كبيراً على خريطة الشعر الفلسطيني، لا بل تعداها ليشمل مساحة واسعة من خريطة الشعر العربي، فكيف بشعراء فلسطينيين ظهروا في زمن محمود درويش، وتمكنوا بفضل قوة موهبتهم وتنوّع ثقافتهم والطاقة المعرفية التي اكتسبوها خلال مسارهم الإبداعي، أن يفرضوا أصواتهم ويبرزوا ليكونوا شعراءَ كباراً أيضاً؟ من بين هؤلاء يحضر بقوة الشاعر محمد القيسي الذي رحل باكراً، وهو لم يكمل الستين من عمره، عمر انقضى في الترحال والسفر والهجرة المبكرة. إنّه ابن المخيّم الفلسطيني بامتياز، شاعر مطبوع، يظهر دائماً بحلة قشيبة، إن كان على صعيد الأداء واللغة، أو على الصعيد الشخصي. لغة أنيقة تلك التي كان يكتب بها القيسي، لغة موسيقية، ملحونة، ومرنانة، النغم هو صاحبها المستديم، ذلكم ما كان يميّزه، ويميّز أناقة مظهره أيضاً. صوته خافت مثل نبرة شعره، والشفافية الشعرية هي من خصوصياته ومحمولاته، وكل ما يندّ عنها من مرهف وليّن وقشيب هو من صناعته الفنية. هذه الخصال الجمالية وغيرها هي التي جعلته شاعراً غنائياً من قماشة نادرة، وقصيدته أقرب الى السونيتة منها الى الملحمة، هي خليط من الكلام الملحون والصدى المنغّم والدربة الإيقاعية، دربة نشأت على ضفاف الشعر الفلسطيني المهجوس بنبرة المقاومة وحس التحريض والمكابدة والقول بمعاني الضد، والضد هنا هو الضد الحقيقي، الواقعي والتاريخي، الضد بقول كلمة لا عريضة وواسعة ضد نهج الاحتلال وتكريس واقع المصادرة لأرض عربية، وتاريخية، أرض النبوءات والقداسات الأولى.
من هنا كان الشاعر الراحل محمد القيسي، صوتاً بارزاً في تكريس قيم الحرية، واسماً لامعاً في عالم الثورة والانتفاض على المسكوت عنه سياسياً، اسم حالم بالعدالة الإنسانية، ومنافح شديد عنها في المحافل الشعرية والمهرجانات وفي كتبه السردية وقصائده الشعرية، التي لا تبتعد بوصلتهاعن آلام المكابدة الفلسطينية ومخيالها الدائب من أجل استرداد المكان الحلمي، الشواطئ والقباب المذهبة، المرافئ والقصبات والمدن الشاعرية التي اغتصبت وانتهكتْ وضُمّتْ وسُبِيَتْ في أكثر من صولة وجولة بربرية للنازية الجديدة، نازية الاحتلال بكل صيغه الحديثة.
شاعر التجوال
تعرفت على محمد القيسي في بيروت، عام 1981 وكان دائم التردّد عليها، لأنها كانت الحضن الجديد للثورة، والحضن الدائم للكتاب، والمكان المناسب والمرموق للحالمين والرومانسيين والشعراء من أمثال محمد القيسي وغيره من الشعراء والأدباء والكتاب والفنانين العرب.
في تلك الأيام الرومانطيقية، كان القيسي قد أصدر ديواناً جديداً، وكدأبه كان يسعى الى عرضه والتعريف بمحتواه الجمالي لكل من يصادفه من الأصدقاء من العاملين في الشأن الثقافي، وهنا كان لا بد في ذلك المكان الصغير، ورشة العمل الثقافي والمقاومة بالقلم، أنْ ترى فيه كلّ زائر جديد يفد اليه.
التقيته في مقهى التوليدو، صحبة أصدقاء مشتركين، كان اللقاء عابراً وسريعاً، فمحمد القيسي لا يعرف الأستقرار بمكان، فهو ابن «عائلة المشاة». كان اسمه بالنسبة اليّ من الأسماء الراسخة واللافتة والمضيئة في مسيرة الشعر الفلسطيني الذي جاء بعد الشعراء محمود درويش وسميح القاسم ومعين بسيسو، أي أنه اسم معروف ومميز الى جانب الشعراء مريد البرغوثي وعز الدين المناصرة وأحمد دحبور، ولنسمهم بشعراء جيل الستينات الفلسطيني.
في تلك الأثناء وخلال هذا اللقاء القصير، أهداني ديوانه الجديد «اشتعالات عبد الله وأيامه»، وكان الديوان يحمل صيغة تعبيرية جديدة بالنسبة لأشعار القيسي، ويقترب من سياق القصيدة اليومية وتفاصيل الحياة التي كانت غريبة عليه الى حد ما، فهو هنا منفتح على عالم فني آخر، وعلى أساليب تعمل على النسق الحسي والملموس والمتعيّن، أكثر من عملها على نسق اللغة الذهنية والتجريدية المحلقة في الميتافيزيق، أو هي غير تلك اللغة الحافلة بنبرة المقاومة المباشرة التي تظهر عليها أحياناً السمة التقريرية والخطاب الواضح والعلني، مثلما كان ملحوظا في «راية في الريح «، وهو ديوانه الأول، أو في ديوانه الثالث «رياح عز الدين القسام»، والتسمية هنا باستطاعتها عكس محتوى الديوان ومضمونه الإنساني والهاجس التعبيري العام الذي كان سائداً في تلك الأيام.
بعد تلك اللحظات القليلة من اللقاء معه، غاب عني القيسي وغبت أنا بدوري كذلك للظروف المعروفة إياها، بعد حصار بيروت واجتياح الأراضي اللبنانية، وبروز الشتات الفلسطيني من جديد، والشتات هي من الكلمات التي تنتمي الى قاموسه الأدبي والشعري، وله فيه كتاب بعنوان «شتات الواحد»، وهو من العناوين الجميلة التي تذكر بعنوان «مفرد بصيغة الجمع» لأدونيس. وقد ألف القيسي في هذا المنحى أكثر من كتاب وديوان. الشتات هي الكلمة التي يمكن وصف حالة القيسي بها، كلمة تخرج منها الردائف والنظائر والأشباه من المعاني: التشرد، التيه، الضياع، الرحيل، الدياسبورا، الهجرة، السّفار، الترحيل، التهجير، التسفير، النزوح وتلحق بها كلمات ذات معان دلالية أخرى، الاستلاب، المصادرة، الانتهاك، التوطين، الغزو، الى آخر المفردات التي تستنبط من قاموس الاحتلال.
مرّت قرابة الربع قرن على لقائنا الأول، حتى التقيته مرة أخرى في لندن. لقد مرّتْ عهود ومواقيت كثيرة، حافلة بالتحوّلات والهجرات والتنقل، وخصوصاً على صعيد العمل الثقافي الفلسطيني، بدءاً من بيروت ودمشق ونيقوسيا وتونس، شتات وهجرات ورحيل، وكان على القيسي أن يمسك بكل هذه المجريات الجديدة، ليوافيها بنصوصه ونتاجه الغزير، قياساً لسِنيّ عيشه، أعماله الشعرية وصلت الى العشرين ديواناً شعرياً، هذا عدا السير والمذكرات واليوميات والمدوّنات التاريخية.
شاعر الأمكنة
كان يمكن أن ترى القيسي، بالنسبة للتجوال الذي عرف به، في كل مكان تقريباً، في لندن وباريس في آن، في عمان وبغداد في آنٍ، حقيبته الجلدية التي توضع على الكتف، كانت لا تفارقه، فهي مليئة بأشعاره ومخطوطاته الجديدة، ونصوصه النثرية، التي كان يكتبها للصحف والمجلات. صدرت كتبه في بغداد وبيروت ودمشق وباريس، كان يفرح مثل أي طفل بكتابه الصادر حديثاً، يتغزّل بالغلاف والورق ويشم الصفحات، وحين يمل منه يذهب ليشتغل على آخر جديد.
كان القيسي شخصاً مُحبّاً، دمثاً، خلوقاً، يتمتع بروح جميلة، تعشق السهر والأنس والحب، أحبّ في بغداد وكتب في حبه اشعاراً، وتوله واكتأب وتعذب. من دواوينه الغزلية ذات المنحى المترع بالتهجّدات والمواجد والتشريق العشقي، يمكن الإشارة الى ديوان «إناء لإزهار سارا – زعتر لأيتامها»، وكذلك ديوان «مجنون عبس» وهو أيضاً من الدواوين التي كان قد كتبها في حب امرأة وقع في أتون غرامها الحارق كما كان يخبرني بذلك، وقد أردف هذا الحب المبني على اللوعة والنقصان والكتمان، بديوانين آخرين هما «مضاء بجمالها – مضاء أنا بحزني» و «كل هذا البهاء وكل شفيف». والأخير كان من الدواوين الرقيقة المليئة بالحب والغزل والمناشدة الروحية.
وإذا كان القيسي سخياً في هدر قصائد الحب والغزل المخفي وغير المعلن في حب امرأة معيّنة، ومقدساً الأنوثة، فهو أيضاً لم ينس دور أمّه التي خلدها في أكثر من قصيدة ونص وعمل نثري، أبرز هذه الكتب هو «كتاب حمدة «، وهو من الشعراء القلائل الذي كتب باسم أمِّه ديواناً كاملاً وذكرها في غير موقع وكتاب ومادة نصية.
لعل الحنان والطبع الأنيس والبوح الأسيان والشكوى ايضاً هي من أبرز سمات محمد القيسي الشخصية، سمات سرعان ما انتقلت من روحه وعمقه الداخلي ورؤاه الجوانية الى قصيدته، لتسمها بأكثر من ميسم شفاف، ميال الى التحنان والعذوبة والكآبة الشاعرية، في طريقة تصرّفه على نحو رومانطيقي، يذكّر بشعراء الحقبة الرومانطيقية التي تجعل حتى الهواء العابر مموسقاً ومنغماً ويحمل فتنته أينما حط في هذا الكون المحفوف بالطبيعة.
لَكَم عرفته هنا في لندن، وغصتُ في أعماقه البديعة التي لا تشي الا بطبع إنساني حالم بالوداعة، كان دائم الشكوى من حظه الذي كان يراه قليلاً، كانت لديه دائماً مشاكل في الحب والمال والعمل.
هو لم يركن الى عمل دائم، مثل أي شاعر صعلوك وجوّال وحالم، لكأنه كان رعوياً، ينتقل وفق إرادة الخيال ووفق طبيعة المزاج ووفق سياق الرؤيا التي ستحرّكه الى هدفه، في الحب أو المدينة والمضطَرب الذي سيجد فيه نوعاً من المحفّزات الشعرية. بغداد كانت إحدى هذه المدن الحالمة، فيها أحبَ وعنها كتب، وهي من عجّلت في أجله، حين احتلتْ من الغازي الأميركي ودليله العراقي الذي خرج من كنف الحالة السياسية الملتبسة، ليتصدّر الراهن العراقي.
كيف لا وبغداد هي مدينة الأحلام والشعراء وألف ليلة وليلة. بسقوط بغداد سقط قلب محمد القيسي منه، وتوقف، هكذا قيل لي، وهكذا قرأت، حينها كنت في لبنان، كان الجو حارّاً من آب (أغسطس) عام 2003، حين طالعتُ صحيفة «الحياة» لأجد خبر نعيه في أسفل الصفحة الأولى، وقد أرفق الخبر بصورة بهية له، هنا كاد قلبي هو الآخر أن يتوقف حين رأيته في الصفحة الأولى، عادة الشعراء هم من سكان الهوامش والزوايا المنسية في الصحف والمجلات، وهذا جميل لهم، لكيلا يختلطوا مع الساسة والمطربين الغارقين بالماكياج ونجوم كرة القدم الذين يظهرون في إعلانات الشامبو والبيتزا ومعجون الأسنان.
في لندن توطدتْ علاقتي بالقيسي الى درجة كبيرة، حتى غدونا صديقين متلازمين، نلتقي في الأسبوع أكثر من ثلاث مرات، نجلس في المقاهي ونتنزه في الهايد بارك ونثرثر طويلاً حول الشعر، كان الشعر مائدتنا البهية والطيبة، التي لا نمل ولا نشبع مما يلمع فيها من طعام للخيال.
صحيفة الحياة اللندنية