أحمد زين يجدد روائياً ثنائية الاستعمار والتحرر
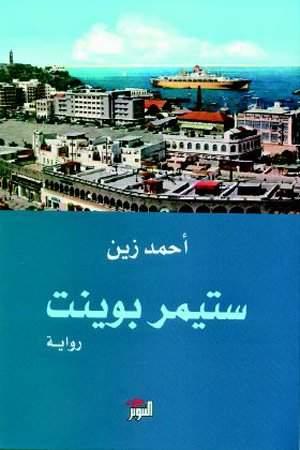
في رواية سابقة عنوانها «قهوة أميركية»، سرد أحمد زين أحوال مدينة يمنية يفترشها التداعي، وينتقل أهلها من حرمان إلى آخر. وفي روايته الجديدة «ستيمر بوينت»، يستدعي مدينة مغايرة، جميلة الترتيب حديثة وتكسوها النعمة هي «عدن»، في زمن الاستعمار الإنكليزي (1839 ـ 1967)، الذي حوّلها إلى مدينة لا تشبه «صنعاء» الشمال التي لا يؤرقها تواتر الأزمنة. صيّر الإنكليز «البلدة» المفتوحة على البحر، في مائة وثمانية وثلاثين عاماً، إلى مدينة ـ معجزة، كما تقول الرواية، قبل أن تعود مجدداً إلى مصائر تنقصها المسرّة. جعل زين من «عدن» شخصية روائية باذخة، لها شوارعها الأنيقة وبشرها المتعددو الجنسيات وانفتاحها على حضارات متنوعة. قالت الرواية في مستوياتها المتعددة: إن وعي الإنسان مما يعيشه، وإن الهوية خارج المعيش اليومي حفنة من تراب، وإن التحرر الوطني ليس أفضل من الاستعمار دائماً.
أدرج الروائي اليمني في روايته الجديدة أكثر من خطاب: فتنة الأوروبي المتحضّر، التي تغوي المواطن المحلي بالمحاكاة والتقليد السعيد، وأسى النهايات الغامض، إذ في رحيل المستعمِر (بكسر الميم) المتحضر ما ينهي مرحلة أقرب إلى الحلم، والعلاقة المتبادلة بين الأنا والآخر، حيث «للأنا المحلية» عريها وللآخر المتفوّق مباهجه التي لا تنتهي… اقترب الروائي، في خطابه المتعدد الأبعاد، من التباس لم يسعَ إليه، فالخير الذي يأتي به الوافد الغريب تلازمه السيطرة (اليمني يخدم الإنكليزي)، مثلما أن «التحضّر»، مهما كان ثمنه، أفضل من ركود مستقل تخترقه الملوحة والأمراض. تعلم «العدني» المحاكاة والمقارنة، فلولا أبهة الآخر لما اكتشف عريه. ترجم الروائي خطابه بشخصيات متنوعة، أخذ فيها «الوافد المتحضر» موقعاً مسيطراً، ذلك أن اليمني ـ يحاكيه وينجذب إليه ويتبعه، حتى لو بدا مستقلاً.
ارتكنت الرواية، من الاستهلال إلى النهاية، إلى فضاء الالتباس، فسردت أحوال يمني دعته «الشاب» يقوم على خدمة فرنسي دعته «العجوز»، كما لو كانت الأسماء لا ضرورة لها، ووضعت بينهما مرآة، تكاد تبدو شخصية روائية، يرى فيها كل منهما وجهه وهو ينظر إلى وجه الآخر. المرآة بديل من الحوار والتعارف، بديل مشوّه، فما خارج المرآة أهم من الصور التي تتجمع على سطحها، وما يجول في الروح لا تعكسه حتى لو كانت صقيلة. والمرآة في صمتها تحرّض على التلصص، ووشاية صريحة مرتبكة، فالوجه في المرآة تقف وراءه عوالم داخلية، وهي سطح بارد بلا ذاكرة، يتكسّر شظايا في نهاية المسار. ولأنها شخصية من شخصيات الرواية، صارت، في نهاية الحكاية «أي لحظة نهاية الاستعمار»، وشاية عالية الصوت، أفصحت عن عيني الفرنسي المليئتين بالخوف، وعن هواجس الشاب اليمني الذي ينظر إلى رحيل المستعمِر الإنكليزي عن عدن بقلق كبير. لذا بدت المرآة موقعاً للقاء أبكم واسع الحركات، قوامه النظرات الخاطفة المسوّرة بالصمت والعزلة، ومناسبة يومية لـ «مونولغ» طويل يتعرّف فيه «الشاب» الى رغباته وينصرف «العجوز» إلى ذكرياته.
إذا كانت المرآة قد جمعت بين فضول شاب يمني وغطرسة عجوز فرنسي، فإن ما جمع بينهما ماثل في جمال مدينة أقرب إلى الجنة. فالأول مبهور بمدينة لا مثيل لها في اليمن، والثاني مبهور بمدينة صنعت ثروته وصنعها مع غيره من الأوروبيين. أوكل السارد إلى ذاته دور مؤرخ مدقق، يقرأ المدينة، سريعاً، في تاريخها البعيد ويقف متمهلاً أمام تاريخها الإنكليزي الذي حوّلها إلى مدينة ـ أعجوبة، فهي كونية يعيش فيها الهندي والإنكليزي والفارسي واليهودي والصومالي ويمني يرى إلى الوجوه والثقافات جميعاً، وهي ثالث مرفأ في العالم بعد ليفربول ونيويورك، وفي مطارها هبطت أول طائرة في الجزيرة العربية عام 1829، وفيها «ستيمر بوينت»، المكان الذي تلتقي فيه سفن العالم، وتصله رسائل من العالم أجمع. مدينة من شعاع، يقول السارد، محورها «الحي الأوروبي»، المحتشد بالمطاعم والبارات والمكتبات والكنائس والمصارف و»المدارس الأجنبية» ودور السينما، وكل ما يجعلها جزءاً من الغرب من دون أن تغادر ترابها اليمني. ولأنها جزء من الغرب، الذي لم يره المواطن اليمني، فهي جزء من الجنة المتخيلة. وعن مدينة ـ جنة، صدر وعي متسامح أقرب إلى الامتثال لا يرى في «الوافد الأوروبي» عدواً، بل يأسف على رحيله، وينظر إلى العجوز الفرنسي بفضول، لا تخالطه الكراهية.
انطوت «فتنة المستعمِر» على وعي منقسم، يُخرج العدني من «عدنيته القديمة»، ويلحقه بالآخر من دون أن يطرح أسئلة كثيرة. فالشاب «يكتشف أنه واقع تحت نير نمط الحياة التي يعيشها» ـ مع الفرنسي، كما يقول، وأنه «شغوف بحياة الأوروبيين». والأمر لا يقتصر عليه، فالشخصيات المتنوعة تردد في سرها ما يقوله الشاب، سواء كانت عادية، أو «مسيّسة ومعادية للاستعمار»، فأمكنة «عدن» الحديثة فرضت عليها عاداتها، بقدر ما علمت الشخصيات ذاتها عادات الأوروبيين التي تحضّ على المحاكاة وتوقظ حسّ المقارنة. ولعل «فتنة الآخر»، التي تبدو كأنها خيانة، هي التي استقدمت إلى الشخصيتين الرئيسيتين (الشاب والعجوز) شخصية «إيريس الإنكليزية» في «جسدها المُشتهى»، التي أرادت أن تكون إنكليزية أخرى، تندمج في المجتمع المحلي وتتعرّف الى عاداته وتعترف بها، بعيداً عن إنكليز مكتفين بغطرستهم. غير أنها في سلوكها المختلف، لن تزيد «فتنة الآخر» إلا فتنة. ما حكايات الشخصيات اليمنية، كما جاءت في الرواية، إلا حكايات انجذابها إلى «الآخر الغريب»، التي لا تستطيع هشاشتها أن تفعل حياله شيئاً.
سعى الروائي إلى توليد «التباس مدروس» ـ ما هو بالالتباس ـ متوسلاً أدوات فنية متعددة: تداخل الضمائر المختلفة، الموزعة على أنا وهو وهي، التي مرجعها «الحي الأوروبي» الذي يسكنه البعض ويشتهيه بعض آخر، الجمل الاعتراضية الطويلة التي توحّد ـ عمداً ـ بين ارتباك السارد وشخصياته، الشخصيات الأوروبية التي هي مرجع الشخصيات اليمنية، النهايات الحزينة التي توحّد، بأقساط مختلفة، بين الشخصيات جميعاً: يرحل الفرنسي حزيناً في الليل، وتغادر «إيريس» بلا فرح كبير، ولا يظفر الشاب الذي يعمل عند الفرنسي بالفتاة التي يحبها، ولا «صاحب المقهى» بفتاة حلم بها. شخصيات من فضول وانتظار، كما لو كان «استقلال عدن» قد أغلق حقبة من السعادة والشرود السعيد، ولم يعد بشيء جميل.
غير أن الروائي، بسبب منظور يتطيّر من الظواهر الخفيفة، يحاصر الالتباس المنتشر ويقارن بين الحاضر والماضي اليمنيين: فصنعاء التي لم تعرف تجربة عدن بقيت ملفوفة برقادها، و«الكفاح المسلح التحرري» الذي جاء من الريف ـ مرّ سريعاً ـ بل إن رجاله يتقاتلون قبل التحرر، واليساري «الثائر المتحزّب» تفوح منه رائحة الدم، والمتبقي هو الخوف من عودة «عدن المتحررة» إلى ما كانت عليه قبل مائة وثمانية وعشرين عاماً. يقول الشاب: «تطلعك الوحيد ورغبتك الأكيدة أن تبقى عدن مفتوحة للجميع، ولا أن تستيقظ يوماً وتجدها تحوّلت إلى مدينة مغلقة على ذاتها. ويزيد قوله وضوحاً: «ما يجري حتى الآن في مدن الشمال، يجعله غير متفائل، لن تخسر شيئاً، لا يوجد ما تخسره، بينما عدن مسألة مختلفة كلياً. ص 142»، فهي مختلفة بما جاءت به إليها «معجزة الإنكليز»، التي وضعت العالم الحديث في مدينة يمنية، كانت شبه مهجورة.
أنتج أحمد زين في روايته خطاباً، لا علاقة له بالتبعية، بلغة كاسدة، ولا بالتخلّي عن الهوية، بلغة بليدة أخرى، أراد أن يقول: «إن ما جاء مع التجربة الاستعمارية ذهب معها، كما لو كان ما تلا التجربة ترك عدن بلا ذاكرة». هناك دائماً ما كان وما سيكون، وذلك «الحضور الاستعماري» الذي يدعو إلى المقارنة. ترجم الروائي خطابه بلغة مقتصدة نافذة التفاصيل، وبشخصيات أقرب إلى المجاز، وبمعرفة تاريخية واسعة الحدود، وبذلك الالتباس الخصيب الذي يقرأ التاريخ بصياغاته الفنية التي تخبر عن شخصيات مختلفة المصائر، برهن في عمله أن الرواية، على المستوى المعرفي، جزء فاعل في قراءة وتأويل «التاريخ الوطني»، وأن كتابة لا تستأنس بالتاريخ، لا تحسن قراءة الحاضر وانهياراته.
«ستيمر بوينت»، العمل الروائي الأفضل للروائي اليمني المجتهد أحمد زين، عمل قصرت عنه الرواية العربية التي عالجت ثنائية الاستعمار والتحرر بمفردات جاهزة، ترضي، بلا قلق، الإيديولوجيات الزهيدة، ولا تعرف من التاريخ الفعلي إلا ظلاله. هل تراءى التقدم مع حضور الاستعمار، ورحل بعيداً مع حضور «الاستقلال الوطني»؟ هذا هو السؤال الكبير الذي عالجته رواية عربية ـ يمنية كبيرة، بوضوح فكري نافذ إلى حدود المجازفة. التقى الخطاب الروائي الخصيب، مع أطروحات نظرية عربية رهيفة، اشتقت هزيمة العالم العربي من ظاهرة مفرحة ـ مؤسية دعيت مرة: ولادة دولة الاستقلال الوطني.
صحيفة الحياة اللندنية




