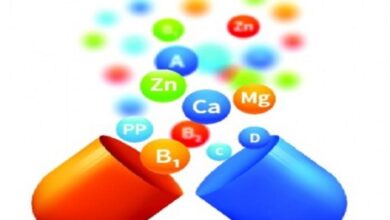البرتغالي أنتونيو أنتونيس يجعل الاحتضار نشيداً سمفونياً

قراءة نثر الكاتب البرتغالي أنتونيو لوبو أنتونيس هي تجربة نادرة، صعبة بقدر ما هي آسِرة، مثل حلم يقظة. نثرٌ لاهث وهاذٍ في ظاهره، يحضر بكل خصائصه في روايته الأخيرة «إلى تلك التي تنتظرني جالسةً في العتمة»، التي صدرت ترجمتها الفرنسية حديثاً عن دار «كريستيان بورجوا» الباريسية، وتغوص بنا داخل الأفكار السديمية لممثّلة مسرح عجوز تقف على عتبة الموت.
وتجدر الإشارة بدايةً إلى أن أنتونيس يمارس منذ فترة طويلة تلك الكتابة الفريدة من نوعها التي تقوم على جُمَلٍ مقطَّعة توقف اندفاعها جُمَلٌ أخرى طارئة، لتعود فتنطلق مجدداً، كما لو أن شيئاً لم يكن. ولكن أكثر من أي نصٍّ سابق له، يبدو هذا الأسلوب في روايته الأخيرة شفّافاً وناجعاً، ربما لاختياره لها بطلةً عجوز تتشبّث بذاكرتها الخائرة كما لو أنها خشبة خلاصها الوحيدة، وتعاني من محيطها الذي يستعجل موتها.
محنة هذه الممثّلة بدأت على خشبة المسرح، أمام الجمهور، حين راحت تؤدّي، من غير أن تدري، دوراً من مسرحية أخرى. وهذا الحادث هو أسوأ من نسيان الممثل نصّه، لأنه يجبر الممثل الآخر الذي يلعب المسرحية معه على الابتكار لإنقاذ الموقف، ما يضع الأول في حالة التباس كاملة. وهذا ما حصل مع هذه الممثّلة. مدير المسرح لم يطردها إثر هذا الحادث، بل نصحها بأخذ إجازة طويلة أجبرتها على ملازمة الشقّة التي تركها لها زوجها الثاني في ليشبونة. وفي عزلتها داخل هذه الشقة، لن يلبث ذهنها أن يتيه في ضباب الماضي، فتسترجع صدمات طفولتها، خيباتها كممثلة مسرح وعلاقاتها العاطفية الفاشلة. سفرٌ سديمي تعي خلاله أن البصيرة لم تغادرها قطّ، والحياة لم تعلّمها شيئاً كانت تجهله من قبل.
وفي البداية، تحضر إلى ذاكرتها فصولُ حياتها كممثّلة، فصولٌ بائسة ومعبّدة بالإذلال، لن يلبث أن يغمرها فيضُ ذكرياتٍ أعمق، تماماً كما كانت تغمر أمواج البحر شوارع قرية «فارو» التي عاشت هذه العجوز طفولتها فيها. هكذا يتّضح لنا أنها ترعرعت في كنف والدين من البورجوازية الصغيرة، في برتغالٍ رجعي وفقير، على هامش العالم. لكن بخلاف رواياته السابقة، لا يغتنم أنتونيس فرصة هذه العودة إلى الوراء لمقاربة دكتاتورية سالازار أو الحروب التي قادها بلده للمحافظة على مستعمراته السابقة، بل يكتفي بتلميحَين أو ثلاثة، مبقياً إيانا في عالم بطلته الحميمي وواقعه اليومي، الكريه والمنفّر غالباً.
وفي هذا السياق، ندخل إلى غرفة والدَيها ونصغي إلى ارتطام الصليب المثبّت على الجدار فوق سريرهما، على وقع لهوهما فيه. ارتطامٌ مقلِق ما زال يصدي في ذكريات طفولتها. وفي السياق نفسه، نكتشف الشفقة والإذعان اللذين كانت ترتكز عليهما الحياة الزوجية في البرتغال، حين لم يكن يتسلّط عليها الاحتقار والمصالح الضيّقة، فنرى مرارة الزوجات وخيباتهنّ، وأحياناً تسلّطهن على أزواجهنّ، ونشاهد خوف الرجال من فقدانهم عملهم، وخضوعهم لقانون سوق العمل الراكدة، ومناوراتهم البائسة لخيانة زوجاتهم، علماً أننا نستشفّ في كل واحد منهم طفلاً يبحث عن الحب وعن «مكانٍ له في العالم»، مهما كان صغيراً.
أصواتٌ كثيرة ترتفع داخل الرواية. صوت الممثّلة طبعاً، وهو صوتٌ داخلي لأنها توقفت عن الكلام. صوت ابن أخيها الذي يزورها من حين إلى آخر ويستعجل وفاتها. صوت زوجته التي تريد وضع يدها على منزل العجوز من أجل بيعه. صوت الطبيب الذي يعالج هذه الأخيرة ويبدو مكترثاً لطمأنة ابن أخيها على رحيلها الوشيك أكثر منه لصحّتها. صوت المرأة المتقدّمة في السن التي تعتني بها باستياء ملموس، من دون أن ننسى الأصوات التي تنبثق من الماضي أو تلك التي تعود إلى شخصيات أخرى أو إلى حيوانات وأشياء تحيط بها. أصواتٌ ترتفع في الوقت ذاته فتختلط وتتصادم بطريقة أكثر منهجية مما اعتدناه في روايات أنتونيس السابقة، لكن يبدو صدى كلٍّ منها وكأنه يردد استنتاجاً مريراً واحداً: «هل هذه هي الحياة، في النهاية؟» الأمر الذي يسيّر على طول الرواية حنيناً معجوناً بالسخرية ورؤيةً سوداء للعلاقات بين البشر.
ومن هذه الأصوات يحبك الكاتب خيوط روايته الغزيرة، عابراً بحرّية وطرافة كبيرتين من شخصية إلى أخرى، ومن حقبة إلى أخرى، ومن راوٍ إلى آخر، ومفصّلاً سرديته على شكل سمفونية من ثلاثة أجزاء موسيقية متكاملة، وهو ما يجعل منها عملاً نصغي إليه أكثر مما نقرأه، عملاً يتطلّب منا أن نترك كلماته تغوص فينا مثل نوتات، وأن نقبل التخلي عن سلطة عقلنا تحت تأثير نثره المنوّم، من أجل الاستسلام لذلك السفر المدهش في جميع الممكنات، حيث تتحوّل الصلبان المثبّتة فوق الأسرّة إلى بندول يمنح ليالي العشق إيقاعها، وتصبح الكلاب المرسومة على فُوَط المطبخ قادرةً فجأةً على الركض في الطبيعة، وتحضر ساعات الحائط بعقربٍ واحد.
عوارض الشيخوخة ومعاناة مَن يبلغها من تواريه التدريجي من عيون المحيطين به، هي أحد المواضيع الرئيسية لروايات أنتونيس. لكن «تلك التي تنتظرني جالسةً في العتمة» التي يستحضرها الكاتب في روايته الأخيرة، ليست فقط الممثلة العجوز، بل أيضاً الموت بالذات. فهو الذي يضرب النصّ بمنجله، قاطعاً الجُمَل في منتصفها، وملغياً أفعالها، أحياناً بشكلٍ كلّي، وموقفاً الكلام بثقةٍ مؤرِقة، وثاقباً الخطابات لفرض نفسه، أو بالأحرى خوائه، ودافعاً نثر الكاتب على التخّلي عن نحوه ليصبح مجرّد أثر صوت.
ولا شك أن عبقرية أنتونيس الأدبية تكمن في هذه النقطة بالذات، أي في تخلّيه داخل رواياته عن الكتابة بلغةٍ أدبية أو محكية، وفي ابتكاره مظهراً خدّاعاً لصوتٍ، لطريقة كلامٍ تجمع داخلها كل معارف الكتابة، وفي الوقت نفسه، تنسينا إياها. وهي الطريقة الوحيدة القادرة، وفقاً للفيلسوف أدورنو، على «تحرير الخطاب الإنساني من كذبة كونه إنساني» أو إنسانوي.
لا بد في النهاية من توجيه تحية لمترجم رواية أنتونيس الأخيرة، دومينيك نيديليك، لتعامله ببراعة لافتة مع صعوبات نصّها الكثيرة وحبكتها المعقّدة والفريدة، كالتبدّل الثابت للرواة داخلها، والتفجير المنهجي لجُمَلها، وانعدام الترقيم فيها، وتداخُل حواراتها الغزيرة، والعبور من التراجيدي إلى المضحك من دون أي تمهيد؛ مثبتاً في ذلك عن مهارات كتابية وتقنية مدهشة سمحت له بابتكار نثرٍ يمنح قارئه الانطباع بأن شيئاً جديداً، آتٍ من البرتغالية، انبثق داخل اللغة الفرنسية.
صحيفة الحياة اللندنية