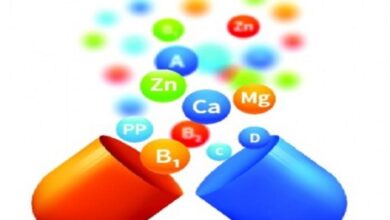التغريبة السورية الدموية في «طريق الآلام»

ليست طريق الآلام هي الرحلة في حقول ألغام الموت الموزع على خريطة الوطن السوري، ولا الخروج كل مرة سالماً من موت أخطأك. إنها طريق دائمة التشكّل، طريق ليست طويلة فحسب، بل تطول وتطول. طريق تمتد بين وطنين، وطن أصيل أعطاك كل شيء، ثم أخذه منك دفعة واحدة بسطوة الموت، وآخر بديل مهما أعطاك فهو عاجز عن أن يمنحك أوائل المعنى.
إنها التغريبة السورية التي ترويها معجونة بمرارة الفواجع في رواية «طريق الآلام» للروائي السوري عبدالله مكسور (دار فضاءات 2015).
ليست «طريق الآلام» الرواية الأولى المنشغلة بالهم السوري للكاتب، بل كان قبلها «أيام في بابا عمرو» و «عائد إلى حلب»، لكنها تتميز عن سابقتيها بالنظرة النقدية للثورة السورية، ورصد التحولات الخطيرة التي طرأت على كل مناحي الحياة، الفردية والمجتمعية. فهي تطرح القضايا الإشكالية بجرأة من دون الانحياز إلى طرف من أطراف النزاع، إنما بالانحياز إلى الإنسان السوري الذي يدفع الأثمان الباهظة منذ أربع سنوات، في أزمة لم تبدأ منذ ذلك التاريخ، بل هي ضاربة جذورها في التاريخ القديم والمعاصر لسورية. إنها رواية تقدم بأسلوب فني تاريخاً معيشاً، تاريخاً محسوساً ومجسّداً، فتتجاوز الجنوح نحو التأريخ والمشهدية اللذين كانا يسمان الروايتين السابقتين.
رواية سيرية
ينتمي النص إلى الرواية السيرية، فهو يحكي تجرية هجرة غير شرعية لشاب سوري هو الراوي الوحيد والمنخرط بالأحداث وأحد أبطالها وليس العالِم بكل شيء، إنما الشاهد على كل شيء والإنسان الذي يتحسّر على وطن منتهك، هو الشاهد على الموت السوري الموزع بين قوات النظام والجماعات المسلحة التكفيرية التي تقتل باسم الله وتحت راية رسوله بكل وحشية وانتقام.
يبدأ السرد من حيث تنتهي المغامرة والنجاة من الموت الأخير أثناء غرق قارب الموت المحمل بالهاربين من الجحيم السوري قبالة شواطئ اليونان، حيث يقدم السارد ثلاثة احتمالات لقصص يمكن أن تروى حول جواز سفر مزور وشخصية منتحلة يستطيع بواسطتها دخول تلك البلاد. ثم يبدأ السرد، وتبدأ التداعيات والذاكرة واستحضار مشاهد الأمس أمام قرائن الواقع لسوري بقي الموت يخطئه ليكون شاهداً على فواجع ومآسي شعبه الواقع بين أحجار رحى القتل والعنف، بينما ما فتئ السؤال يصرخ من قلب الفجيعة: ما هي حكمتك يا الله في ما يحدث لنا؟
والراوي البطل الذي يصحو فجأة على وجوده في غرفة تحت الأرض ويتوه بين أن يكون في العالم الآخر أو في الحياة، تبدأ ذاكرته باستدعاء الماضي وهو يصحو، فيعرّف بنفسه عندما يقول: لقد ولدت هناك، وعملت هناك، ثم انتسبت إلى الحزب، ولي خمسة إخوة. ثم تبدأ السيرة.
يتذكر كيف أصيب في معركة المطار في حماة، وكيف زحف ليهرب من ثقب في الجدار، وكيف فقد رفيقه الذي قضى بقذيفة، ثم يكتشف أنه وقع بين أيدي ملثمين يسحبونه إلى مشارف حفرة ويتلون عليه تهمته بالتعامل مع النظام «المجرم»، ثم الحكم عليه بالقتل ثم التكبير ثلاث مرات، لكنها مزحة من رفيقه محمد الذي هو القائد «أبو الشيماء»، ويقتل أبو الشيماء لاحقاً في مواجهة عسكرية فيبايع المقاتلون غيره «أبو قتادة» الذي يصبح خطيب جامع أيضاً ويدعو في خطبه إلى الانتقام والنهب وسبي النساء، ثم يهاجمون جماعة بايعت «داعش» ويُقتل أربعون شخصاً في الهجوم ومن بينهم صحافي كان مخطوفاً لدى «داعش» هو نيكولاس.
يهرب الراوي من بين أيدي الجماعة، بعد أن يقتلوا رفيقه سمير الذي كان قد خطط معه للهرب، ثم تبدأ مسيرة الوصول إلى الحدود السورية – التركية، حيث يخلّف وراء ظهره لافتة سوداء كتب عليها: سورية الخطوة الأولى لدولة الخلافة، أهلاً بكم في دولة العراق والشام الإسلامية.
تتناسل القصص على طريق الهروب، ويقفز الزمن بين ماض وحاضر، كل من رافقوه ومن التقى بهم في تركيا لاهثين خلف سماسرة التهريب كان لهم حكاياتهم عن الموت السوري والفقدان السوري والتعذيب السوري. بأسلوب مشبوب بالعواطف والانفعالات يمسك بتلابيب القارئ يعزف من خلاله السارد سيمفونية الموت، هروب الوطن، تهتك المجتمع، اغتراب الإنسان، فكل حكاية تحمل فيضاً من الدم والكرامة المنتهكة والفقدان المرير، لكن الأصعب كانت عندما يستمع الراوي إلى حكاية نوال التي اغتصبت في المعتقل ومشاهد ما رأته هناك، ومن بينها حكاية المعتقل الذي قضى تحت التعذيب بعد أن سملوا عينيه، حمزة المفقود منذ أكثر من عام في أقبية التعذيب، والذي هو الأخ الأصغر للراوي.
ربما من يعرف عبدالله مكسور ويعرف أن أخاه حمزة هو المفقود الحقيقي سيفهم تلك العاطفة الحارقة المتفجرة من بركان صدره، ذلك الجرح المفتوح لأملاح الزمن يلهبها فيأكل من شغاف قلبه.
من الصعب الحديث عن تقنية خاصة هي اللافتة في رواية «طريق الآلام» لكنها بمجملها تتخلق كحياة نابضة بالألم بتوليفة خاصة هي ذاكرة تتشكل على طول السرد، وتغتني بأحداثه ثم تنفلت من قمقمها في بلد اللجوء لتطرح الأسئلة الكبرى والخيبات الكبرى وتبكي وطناً كان قد سأله مواطن تركي عنه فأعياه الجواب: لماذا فعلتم هذا بوطنكم؟
المكان والأسئلة
يبرز المكان كحاضن للمشاعر ومحرض على الأسئلة، والذي يبرع عبدالله مكسور في وصفه ومنحه أبعاداً أخرى تميط اللثام عن الحالة السورية، باستثناء مدينة إسطنبول التي يقول فيها: «تلتقي فيها بتاريخك، بنفسك… بعض نسبك، سلطانك الذي مضى إلى اللاعودة، أمجاد الآخرين التي كنت تعتبرها لك» وما يمكن أن يشي هذا البوح بموقف ما على يبدو غريباً بعض الشيء عن روح النص، فإن الشخصيات هنا تبدو مكتملة النضج مترعة العواطف مرة تتكلم عن نفسها ومرات يأخذ الراوي مهمة الحديث عنها فيوظفها بمهارة كي تخدم النص، مثلما هي الأحداث أيضاً، فالهجوم على عرس في الدانة من جانب الجماعات التكفيرية وقتل كل الموجودين في الفرح على مرأى من الراوي الذي أخطأه الموت أيضاً بالمصادفة ليس أكثر، فإن العروس التي تلبس فستاناً من علم الثورة تدفن بثوبها «شعرت بأنهم لا يذرون التراب عليها، بل يدفنون علم الثورة». نعم، إنها كانت المراسم الأخيرة لدفن الثورة، هي الحقيقة التي لا بدّ من قولها… لقد دفنوا الثورة.
لقد وقف عبدالله المكسور في موقع الراصد وفي إطلالة شمولية على الحراك السوري، كان بارعاً في وصف المشهد مسلطاً أضواءه الكاشفة على القتل الممنهج في حرب شرسة تطاول مكونات الشعب السوري وتاريخه وهويته الثقافية، من جانب النظام وحلفائه ومن جانب أولئك المقاتلين المدعومين من قوى تريد الهلاك لهذا الوطن، منتقداً رجال الدين ومحملاً إياهم مسؤولية كبرى عما يجري «رجال الدين أحد أهم وأبرز مشاكل المجتمع، إسقاطهم يعني نهوض المجتمع بالمجمل»، مبتعداً عن الســـياسة والتسييس، متحرراً إلّا من التزامه الأخلاقي بقضية الشعب السوري، حاملاً رسالة إلى العالم من طريق ورقة تركها خلفه في جيب مقعد الطائرة قبل وصوله إلى بلد اللجوء الأخير: «أنا السوري كنت أضع ديوان شعر نزار قباني «أحبك والبقية تأتي» إلى جانب كتاب الديانة في حقيبتي المدرسية… أنا لست إرهابياً».
صحيفة الحياة اللندنية