«مثقف» صبحي موسى تائه في متاهة السلطة
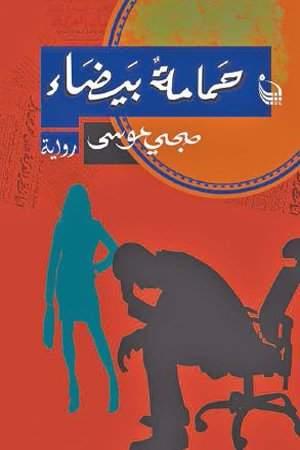
لم يبتعد الكاتب المصري صبحي موسى في روايته «حمامة بيضاء» (دار بتانة – القاهرة) عن المزيج السحري الذي طالعناه في أعمال روائية أخرى له؛ خصوصاً «صمت الكهنة»، و»الموريسكي الأخير»، حيث يختلط الخيال والشعر بالتاريخ والسياسة وحال المجتمع وأوجاع الناس. وإن كان في «حمامة بيضاء» قد صنع حكاية مختلفة، إذ إن التاريخ هو أيام قريبة منا، لا تزال رواسبها تمضي بيننا، والخيال لا يفارق الواقع إلا قليلاً، بل هو الواقع الأغرب من الخيال. أما البناء فيمنح النص وضوحاً وسلاسة، إذ إنه يتهادى سريعاً متدفقاً في مسار خطي، لا يمنع من العودة بين حين وآخر إلى محطات سابقة في حياة بعض الشخصيات، كي يتمَّ رسم ملامحها كاملة. في «صمت الكهنة»؛ كان الكاتب مضطراً إلى العودة إلى التاريخ الفرعوني البعيد، وفي «الموريسكي الأخير»، احتاج لقراءة الكثير من الكتب عن التاريخ الوسيط، لاسيما نهاية زمن العرب في بلاد الأندلس، وفي «أساطير رجل الثلاثاء» كان من الواجب عليه أن يقرأ ملف «تنظيم القاعدة» من ألِفه إلى يائه، وقد اجتهد وفعل. أما في «حمامة بيضاء»، فلم يكن عليه سوى توظيف خبرته في عالم الطباعة والنشر، ومعرفته بتاريخ رموز سياسية وثقافية في مصر، في المرحلة التي تلت ثورة 1952، ليأخذ من بعضها ما تركته من مواقف وحالات وعلاقة مع السلطة، وانحياز لأفكار سياسية، ويصنع الشخصية الرئيسية في روايته التي سماها «عبد القادر الأطرش». تلك الشخصية ليست موجودة، على ما يبدو، تماماً، بالصيغة التي حملتها الرواية، لكنها هنا، تتعدى مسيرة شخص، إلى مسار قطعته العلاقة بين الثقافة والسياسة في المجتمع المصري على مدار نصف قرن تقريباً. فـ «الأطرش» هذا، هو رئيس تحرير سلسلة أدبية، وخلفه تاريخ من التماس مع جمال عبد الناصر والمشاكسة مع السادات، قبل أن تضيق عليه الأرض بما رحبت، وتنحسر عنه الأضواء، ليجد نفسه في حاجة ماسة إلى فعل أي شيء لافت للانتباه، فيبدأ في جمع توقيعات من مثقفين ويذهب بها إلى السفارة الإسرائيلية، عارضاً أن تعترف إسرائيل بالقدس عاصمة لدولة فلسطينية في مقابل أن يتركها العرب تعيش بينهم. لكن خاب مسعاه، لأنه أخفق في قياس موازين القوة، وبالغ في تقدير نفوذه وتأثير من توافقوا على ما رآه، فينتهي به الأمر إلى إضراب عن الطعام، يتضامن معه في البداية بعض الرفاق من اليساريين، ثم يتخلوا عنه تباعاً، تاركينه يواجه نهايته المحتومة وحيداً. وحرص الكاتب على أن يصنع لبطله جذوراً، فربطه بشيخ صوفي، كان جده الأكبر، وكانت له أعمال عجيبة، وأفعال فوق النواميس. لكنه ربطه أكثر بشاب، يجاهد من أجل أن يتحقق، كان يشغل منصب مدير تحرير السلسلة الأدبية، فعرف الكثير عن «الأطرش» حين طلب منه الأخير أن يكتب رواية عن حياته. وبالتالي حصل منه على معلومات حول مسقط رأسه وجذوره، وحياته الخاصة، وخبرته الطويلة، وعلاقاته المتشابكة، ورهاناته الخاسرة، ووعده بأن يكتب عنه «عملاً رائعاً»، يروق له. لكنه حين جلس إلى طاولة الكتابة، غلبته الحقيقة، فكتب شيئاً مختلفاً، ربما بدافع رغبة دفينة في الانتقام من رجلٍ طالما تنَّعم بعطايا السلطة، وربما لأنه لم يجد بطله يستحق أن يخفي ما في حياته من ثقوب وعيوب، فقرر أن يعريه تماماً. بهذا؛ يتوازى خطان، الأول ما يدور حول «كتابة رواية عن حياة البطل»، والثاني عن علاقة الكاتب بالمكتوب عنه، وما حوله من سكرتيرات حسناوات، وبواب العمارة الفخمة التي يقطنها، وبعض رفاقه الذين كابدوا معه مشقة إنشاء حزب شيوعي، بلا جدوى، وحبيبته التي زوَّجها أهلها من شاب ميسور، ثم عادت إليه، وابنه «حازم» الذي اختطفته السلطة ذات مرة، لتجبر أباه على الانحناء. يلخص الكاتب الحكاية كلها في هذا المقطع: «لم يكن أمام الفتى سوى أن ينصت لهذا السيل من صخب الحياة المليئة بالوداعة والخيانة والعنف عن الأصدقاء والسياسة والأدب والمنظمات السرية، وكيف استخدمه السادات. وكيف ماتت الحبيبة على الصدر. ومات الصديق بدلاً منه. عن نجمات السينما اللائي نمن ليلات طويلة في حضنه، والأدباء الذين أكلوا وشربوا وتزوَّجوا في بيته ثم خانوه مع زوجته. عن الطفل الذي رآه في السجن قبل أن يولد. والولي الذي تتوافد عليه الأمم، ويحضر إليه كلَّ مساء».
في الرواية يحضر الشعر بقوة، فمؤلفها له منه دواوين عدة؛ منها «يرفرف بجانبها وحده»، «قصائد الغرفة المغلقة»، «هانيبال»، وهي سمة مستمرة في نصوصه السردية كافة، لكنها تبدو مكثفة هنا، لاسيما أن النص قصير، والأحداث فيه متدفقة، عبر شخصيات تدور في عالمي الثقافة والسياسة، سلباً وإيجاباً. ولعل المقاطع التي التقطها الكاتب من ثنايا نصه، وصدَّر بها الفصول، يصلح بعضها في حد ذاته أن يكون قصائد نثرية، ومنها: «وحدها؛ أناملُها امتدت لتصافحه. أناملها المحتشدة بطاقة تذيب الصخر. ترك نفسه ينساب رقةً عبر نبضات الدم السارية من يديه. فوجئ أنها فاترة ولا طيور لديها. فكل ما هنالك أشلاء معركة مات فيها كل شيء». أما السحر فلا يقتصر على جد البطل، الصوفي صاحب المقام والغرائب، بل كل ما يحيط بالبطل من مكان وحكايات، إذ إن الشقة التي يقطنها تحمل الكثير منه، ليس عبر أثاثها الفخم الذي يخطف الأبصار، إنما من الغموض والعتمة والطرق الطويلة والصمت الذي يخيم عليها، والخيالات التي يصنعها الخمر حين تدور برأسه، وهو مكان يليق بنهاية غريبة للبطل، حين يسابق «مدير التحرير» الزمن ليحصل على نسخة من الرواية يهديها له قبل أن يودع الدنيا، فيجده، حين وصل إليه، لم يعد على حاله، بل تحول إلى «حمامة بيضاء»: «بحث بعينيه عن الرجل. لم يكن في البهو، أو على مكتبه. لم يكن في الحمام ولا المطبخ أو الغرف الداخلية. لم يكن موجوداً على الإطلاق. ولم تكن سوى حمامة صغيرة بيضاء تقف على أعلى رفٍ فارغٍ للكتب، فوضع روايته على الرف المقابل ثم بكى».
قد ترمز الحمامة هنا إلى الروح، التي فارقت الجسد، أو أنها واحدة من تلك اللاتي كن يرفرفن حول جده الولي، أو أنها رمز لبحث شخصيات الرواية عن السلام النفسي الذي يفتقدونه، لكنها كانت كفيلة في حد ذاتها أن تحرر «مدير التحرير» من مخاوفه وتردده ويأسه وأحزانه المعتَّقة، فلم يجد أمامه من سبيل سوى أن يتبعها: «حلَّقت في الفضاء كطائر يُعَلِم صغيره الحياة. شعرَ ساعتَها أنه خفيف، ويمكنه الطيران، فضرب بساعديه في الهواء، وضرب المقعد بساقيه. كانت الحمامة قد عبرت من النافذة، وكانت أنامل قدميه بالكاد تمسك بحافتها. حين اعتدل وجدها ترفرف خفيفاً كسنونوة تقف على ميزان الذهب. شعر أنه أكثر خفة ويمكنه أن يلحق بها، فضرب الهواء بشدة وأطلق جسده للفراغ».
صحيفة الحياة اللندنية




