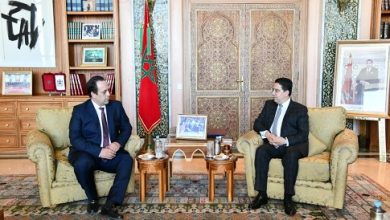هجمات صوتيّة شبحيّة تجدّد النقاش حول «الأسلحة غير القاتلة»

لم يتوان الرئيس دونالد ترامب عن التعامل مع «هجمات صوتيّة» يفترض أنها طاولت ديبلوماسيّين في السفارة الأميركيّة في هافانا، على أنها حقائق محسوم أمرها. ولم يحل الغموض الذي حاق بالتقارير المعلنة عن تلك الهجمات، دون الحديث عن الأسلحة الصوتيّة باعتبارها أدوات متحقّقة. وجرى الحديث أيضاً عن تأثيراتها في من تصيبهم بمنطق التشخيص الطبي المتيقّن من وجودها. وكذلك نصح مسؤول في السفارة الأميركيّين بعدم السفر إلى كوبا تجنّباً لتعرضهم لهجمات صوتيّة تؤثّر في الصحة، مذكراً بأن موظفي السفارة ممن طاولتهم هجمات مشابهة، عانوا من مشاكل شملت فقدان السمع واختلالاً في التوازن واضطراباً في النوم وأوجاعاً في الرأس. («الحياة» 30 أيلول-سبتمبر- 2017).
الأرجح أن أميركا تعرف جيّداً عما تتحدث. إذ تندرج الأسلحة الصوتيّة ضمن قائمة كبيرة من أسلحة غير تقليديّة، يشار إليها غالباً بمسمّى «الأسلحة غير القاتلة» Non Lethal Weapons.
ونفتح قوسين للقول إنّ الأغاني والأفلام ليست من تلك الأسلحة، مع الاعتذار من أغنية «يقتلني بنعومة بأغنيته» التي أدّتها الأفريقيّة- الأميركيّة روبرتا فلاك في العام 1973، وفيلم بعنوان مشابِه صنعته هوليوود في 2002!
ولأن الحديث عن هجمات غائمة في كوبا جاء قريباً من مقتلة مأسوية في «لاس فيغاس» ارتكبت بأسلحة فعليّة شحذها التطرف، يجدر لفت النظر إلى أن هناك مخازن أميركيّة تتباهى بعرض مجموعات ضخمة منها على الانترنت، على غرار موقع «ذي هوم سيكيوريتي سوبر ستور» thehomesecuritysuperstore.com. إذ يعرض مجموعة منها قابلة لأن يستخدمها الأفراد العاديّون، فلا تكون حكراً على العسكر والقوات الأمنيّة وقوى إنفاذ القانون. إذا وصلت في أميركا إلى حدّ العرض والتجارة عبر الانترنت، لماذا لا يسأل ترامب عن مدى وجود قوانين تضبط تلك الأسلحة التي تبدو مُباحة ومشاعة أكثر من تلك التي استخدمها المجرم الأميركي ستيفن بادوك في اعتدائه المشين على مدنيّين كانوا يرتادون حفلاً موسيقيّاً في لاس فيغاس؟
تبرير السلاح بالنعومة!
في سياق دفاعها عن إنتاج أسلحة غير قاتلة، يورد الموقع الإلكتروني لـ «المعهد الوطني (الأميركي) للعدالة» aijinc.org النص التالي: «إنّ الولايات المتحدة تصمّم الأسلحة والذخائر غير القاتلة لأنها لا تحدث سوى الإرباك والتشتيت والإذهال الموقّت، كي تستعمل لمواجهة أشخاص يحتمل أن يكونوا مصدر تهديد جدي لها… (والأصل في الموضوع) هو أنّ الأسلحة غير القاتلة طُوّرت من أجل تأمين دعم لوجيستي منطقي وتخفيف استعمال القوّة القصوى والعنصر البشري، وكذلك باعتبارها بدائل عن القوّة القاتلة».
وهناك أيضاً نص لافت في «لائحة التكنولوجيّات المتطوّرة» في وزارة الدفاع الأميركيّة، في شأن سلميّة تلك الأسلحة. إذ يرد فيه «أنّ الرغبة في تقليل الوفيّات في النزاعات المستقبليّة المسلّحة، وفي دعم السيناريوات المتصلّة بالعمليات غير الحربيّة، أدّت إلى زيادة الاهتمام بتطوير تقنيات لصنع أسلحة غير قاتلة…. إذ تتيح للقادة خيارات لمواجهة مواقف لا يكون فيها استعمال القوة القاتلة هو الخيار الأفضل. وتملي متطلّبات سياسيّة وديبلوماسيّة واقتصاديّة مستقبليّة، ألا تتضمّن العمليات الأمنيّة والعسكريّة إيقاع أعداد كبيرة من القتلى في صفوف قوات الولايات المتحدة.
وفي المقابل، تقلّل الأسلحة غير القاتلة من الأضرار في صفوف المدنيّين وممتلكاتهم. كما يعتبر ضبط الجماهير عند إجراء مهمات حفظ السلام، وإيصال مساعدات إنسانيّة، من الأعمال التي توازي في أهميّتها عمليات تدمير سلاح العدو وقواته. لذا، يساهم تزايد الطلب على الخدمات العسكرية لأداء عمليات أخرى غير الحرب، في تنامي الحاجة إلى الأسلحة غير القاتلة». والحق أن تلك الكلمات تدفع الى التفاؤل بتلك الأنواع من الأسلحة، فهل يتطابق ذلك مع معطياتها فعلياً؟
وفي أواخر العام 2014، طوّرت الولايات المتحدة تكنولوجيا تتعلّق بسلاح كهرومغناطيسي لمكافحة الشغب، يستطيع إحداث حروق في الجلد من مسافة كبيرة. وأطلق على السلاح الجديد اسم «شعاع الألم».
واعتماداً على فلسفة النظر إلى الألم بوصفه بديلاً رحيماً من الإماتة أو الإعاقة الدائمة، يعتقد مطوّرو الجهاز أنه أكثر رحمة وإنسانية (وتأثيراً أيضاً) من الأسلحة التقليديّة القاتلة. وعند الشعور بالألم، تكون الاستجابة الأولى التلقائيّة هي الهروب من المواجهة والابتعاد من مصدر الألم. ويبيّن تقرير نشرته مختبرات البحوث التابعة لإدارة القوة الجوية الأميركية، أن «شعاع الألم» يخترق الجلد لمسافة تقل عن نصف ملليمتر، ما يتكفل بإحداث ألم شديد نظراً لتركّز أعصاب الحسّ في الطبقة العليا من الجلد.
وجاء السلاح تتويجاً لسنوات من البحوث في مختبرات إدارة السلاح الجوي الأميركي، بكلفة بلغت قرابة 40 مليون دولار. ولأن الشيء بالشيء يذكر، يؤثر عن وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد، أنّه كان من المغرمين بتلك الأسلحة بدعوى إنسانيّتها. والأرجح أنّ رامسفيلد الذي كان من صقور «المحافظين الجدد» الذي اكتظّت بهم صفوف إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، نسي وجودها في ترسانة جيشه الذي وجّهه لغزو العراق في 2003.
وفي المقابل، لم ينس رامسفيلد تزويد ذلك العسكر بذخائر اليورانيوم المستنفد التي ما زالت هماً مقيماً يؤرق العراقيّين ويفتك بصحتهم سنين تلو سنين. وتشتد حدّة المفارقة عند تذكّر أنّ الغزو جرى بذريعة أسلحة الدمار الشامل لدى نظام الديكتاتور العراقي السابق صدام حسين، ولم يعثر عليها في ترسانة جيش العراق ومخازنه التي زوّدها رامسفيلد ذاته بأسلحة كيماويّة عانت منها مدينة «حلبجة» الكرديّة في 1988.
صحيفة الحياة اللندنية