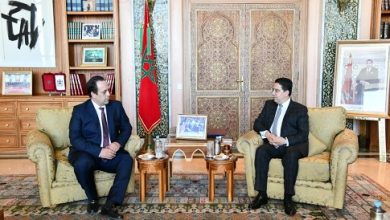كيف لم أعد يهوديّاً (شلومو ساند)
شلومو ساند
ترجمة آسيل الحاج
«إنّني، إذ أُواجه صعوبة في تحمّل فرض القوانين الإسرائيلية، عليّ الانتماء إلى إثنية وهمية، وإذ أواجه صعوبة أكبر في تحمّل الظهور أمام العالم بأسره على أنّني عضو في جماعة مختارة، أرغب في الاستقالة وفي الكفّ عن اعتبار نفسي يهوديّاً.»
صدر مؤخّراً عن دار «فلاماريون» الفرنسية كتابٌ للمؤرّخ والكاتب الإسرائيلي شلومو ساند يحمل عنوان: «كيف لم أعد يهودياً»، ترجمه عن العبرية ميشيل بيليس.
يستهلّ شلومو ساند كتابه متخطّياً حدود الديانة اليهوديّة ومتحدّثاً في المطلق عن الدور البارز الذي أدّته الهويّات الدينية المختلفة في تصنيف البشر، وفي تفسير ظواهر طبيعية واجتماعية، وفي وعدِ المؤمنين بالحياة الأبدية أو بالتقمّص، وفي إخضاعهم إلى حقائقها الحصرية. وينتقل إلى مفهوم الهويّات القوميّة الذي برز في القرن التاسع عشر، مشدّداً على قوّة النزعة القومية في إسرائيل، لا سيّما أنّها تنكر مبدأ الجنسية المدنية وتستعيض عنها بجنسية «يهودية» تحدّد انتماء قوميّاً لا انتماء دينيّاً. ويشير الكاتب إلى أنّ عرب إسرائيل محرومون من هذا الانتماء، لأنّهم لم يولدوا من أمٍّ يهودية، ناهيك عن أنّ الحركة الصهيونية تستخدم التوراة كصك ملكيّة لاحتلال فلسطين.
ولأنّ شلومو ساند يرمي في هذا الكتاب إلى دحض مفهوم اليهودية العلمانية الذي كرّسته الصهيونية، وإلى دحض مفهوم الانتماء العرقي الواحد لليهود، يتساءلك «هل من ثقافة يهودية علمانية؟»، ويجيب بـ«لا» نظراً إلى غياب أي لغة مشتركة أو نمط حياة مشترك بين اليهود العلمانيين، وغياب أي أعمال فنية أو أدبية يهودية علمانية، على الرغم من إمكانية التعرّف إلى ملامح ثقافة علمانية يهودية في فكر كارل ماركس وألبرت أينشتاين وسيغموند فرويد مثلاً. بيد أنّ هؤلاء عبّروا انطلاقاً من ثقافاتهم الخاصّة، ولم يرسوا أسس فكر يهودي علماني. ويرى الكاتب أنّ التوفيق ما بين العلمانية والانتماء إلى اليهودية أمرٌ مستحيل، وقد ينطبق هذا الأمر على سائر الأديان أيضاً. ثمّ يستعرض ساند أصول الديانة اليهودية والجذور التاريخية لـ«رهاب اليهود» في أوروبا، قبل أن يتطرّق إلى الممارسات الطائفية والعنصرية في إسرائيل ضدّ العرب على وجه الخصوص، وموجات التهويد التي لا تنبع من إيمان ديني راسخ، بل تهدف إلى الوقوف بوجه الفلسطينيين لأنّ «المرء لكي يكون يهوديّاً في إسرائيل، عليه قبل كلّ شيء ألّا يكون عربيّاً».
يتحدّث الكاتب في ما بعد عن الصور النمطية التي أحاط اليهود أنفسهم بها، وهي أنّ لهم صفات خاصّة متوارثة لا يتمتّع بها أي شعب آخر. ويقارن اليهودي في إسرائيل بنماذج عنصرية سابقة مثل المستوطن الأوروبي الأبيض في جنوب أفريقيا، مشيراً إلى مفارقة تكمن في أنّ إسرائيل أصبحت مرجعاً لغالبية التيارات اليمينية المتطرّفة التي كانت تحمل راية معاداة الساميّة سابقاً. ثمّ يندّد ساند بعنصرية إسرائيل قائلاً إنّها «أحد أكثر المجتمعات عنصريّةً في العالم الغربي»، وتتبدّى هذه العنصريّة في قوانينها ومدارسها ووسائل إعلامها.
في ما يلي ترجمة لفصل من الكتاب:
ألاّ يكون المرء عربيّاً
في العام 2011، كنت في مطار تل أبيب أنتظر رحلةً إلى لندن. طال التفتيش الأمني ونفد صبر المسافرين. انتابني الملل، شأني شأن الجميع، إلى أن شدّت نظري بغتةً امرأةٌ تجلس على مقعد قربَ الحاجز الأمني؛ كان يغطّي رأسها، وليس وجهها، منديلٌ تقليدي (تخطئ وسائل الإعلام الغربية قصداً بتسميته «حجاباً»). وكان يحيط بها عنصران من الشرطة الإسرائيلية بعد أن أخرجاها من الصفّ. حزرت فوراً انّها امرأة إسرائيلية «غير يهودية». بدا اليهود الإسرائيليون حولي وكأنهم لم يروها، فهذا مشهد معتاد في مطار إسرائيل حيث يُفصل الفلسطينيّون ـ الإسرائيليون دائماً عن سائر الركّاب ويخضعون لاستجواب وتفتيش خاصَّين. أمّا التبرير «البديهيّ» الذي يُعطى فهو خطر القيام بهجوم إرهابي. لم يخفّف عدم تورّط عرب إسرائيل في الهجمات وتدنّي الأعمال الإرهابية في السنوات الأخيرة من الحالة العصبية في أمن المطار: ففي دولة المهاجرين اليهود، يبقى الفلسطينيون الأصليون مشبوهين ويخضعون للمراقبة المستمرّة.
تضايقتُ وهززت كتفيّ عجزاً. تأمّلتني لحظةً بصمتٍ استفهامي. لم تتطابق نظرتها إليّ مع وصف أبي، ولكنّها كانت تشي أيضاً بالخوف والحزن الناجم عن الإساءة. ابتسمَت. وقرأتُ في ملامحها رضوخاً لهذه الحتميّة. بعد دقائق قليلة، عبرتُ الحاجز الأمني بمنتهى السهولة. خجلتُ إلى حدٍّ ما من أن أدير رأسي باتّجاه المرأة. وأنا أعوّض عن ذلك في هذه الأسطر. أكّد لي هذا اللقاء الخاطف أنّ في إسرائيل، كي يكون المرء «يهوديّاً»، عليه قبل كلّ شيء ألّا يكون عربيّاً.
منذ تأسيس دولة إسرائيل، واجهت الصهيونية العلمانية سؤالاً أساسيّاً لمّا تجب عنه حتى اليوم، ولم يجب عنه كذلك مؤيّدوها في الخارج، وهو: من هو اليهوديّ؟
القوانين الدينية والقوانين المدنية
لم تطرح اليهودية التلمودية هذا النوع من الأسئلة. فعلى خلاف التوراة التي تصف اليهودي على أنّه المؤمن بالله، لطالما كان اليهوديّ هو الذي ولد من أمّ يهودية أو الذي اعتنق الديانة اليهودية وفقاً للقانون الديني وأتمّ التعاليم الأساسية. في الزمن الذي لم يكن فيه الإلحاد خياراً، كان الذي يتخلّى عن الديانة اليهودية لاعتناق ديانة أخرى (كحال كثيرين آنذاك)، يكفّ عن كونه يهوديّاً في نظر أتباع الديانة. ومع ظهور العلمانية، أصبح اليهودي الذي يكفّ عن تأدية الفرائض الدينية من دون أن يعتنق ديانة أخرى، يثير أسى المقرّبين منه، ولكنّه يبقى يهوديّاً بالنسبة إليهم، ذلك أنّ الأمل يبقى موجوداً بأن يعود مجدّداً إلى ربوع الإيمان، بما أنّه لم يعتنق لا المسيحيّة ولا الإسلام.
في السنوات الأولى بعد تأسيس دولة إسرائيل، حين أرسلتْ موجاتُ الهجرات حصّتَها من «الأزواج المختلطين»، حاولت الصهيونية تخفيف حدّة المشكلة، بيد أنّها سرعان ما فهمت أنّ تعريف اليهوديّ لا يمكن أن يرتكز على مبدأ التطوّع. بموجب «قانون العودة»، منحت الدولة الجديدة تلقائيّاً إمكانية الهجرة والحصول على الجنسية إلى جميع الذين يُعرَّف عنهم على أنّهم يهود. كان يحتمل أن يزعزع فتحُ أبواب الهجرة على هذا الشكل شرعيةَ الاستيطان الإثنية ـ الدينية التي ترتكز عليها الصهيونية العلمانية. بالإضافة إلى ذلك، عرّفت الصهيونية اليهود على أنّهم «شعب» من أصل واحد، الأمر الذي جعلها تخشى، على غرار اليهودية قبلها، «تشبيه» اليهود بالشعوب المجاورة.
وهكذا، مُنع الزواج المدني في الدولة العلمانية طور التأسيس، ولم يُسمح إلّا بالزواج الديني. ولا يحقّ ليهودي الزواج إلّا من يهودية، ولمسلم الزواج إلّا من مسلمة. وينطبق هذا القانون التمييزي جدّاً على المسيحيين والدروز أيضاً. ولا يجوز على الزوج اليهودي الذي لم ينجب أطفالاً أن يتبنّى طفلاً «غير يهودي» (مسلماً أم مسيحيّاً) إلّا بعد جعله يهوديّاً بحسب القانون الحاخامي اليهودي؛ أمّا فرضيّة تبنّي زوج مسلم طفلاً يهوديّ الأصل فغير واردة. فعلى خلاف التفكير السائد، لا يُعزى استمرار هذا التشريع الديني الكاذب والمضاد للّيبرالية إلى القوة الانتخابية التي يتمتّع بها المتديّنون، بل إلى الشكوك التي تحوم حول الهوية الوطنية العلمانية وإرادة الحفاظ على العرقية اليهودية. لم تظهر إسرائيل يوماً على أنّها ثيوقراطية حاخامية، إذ ما زالت منذ تأسيسها عبارة عن إثنوقراطية صهيونية. لطالما واجهت هذه الإثنوقراطية مسألة في غاية الأهمية: فهي تعرّف عن نفسها على أنّها «دولة يهودية»، أو حتى «دولة الشعب اليهودي» من كافة أنحاء العالم، بيد أنّها عاجزة عن تحديد من هو اليهودي. وتجدر الإشارة إلى أنّ المحاولات التي أُجريت في خمسينيات القرن المنصرم لتحديد العرق اليهودي من خلال البصمة، أو الاختبارات الحديثة العهد الرامية إلى تمييز حمض نووي يهودي، باءت كلّها بالفشل. وعبثاً حاول بعض العلماء الصهيونيين في إسرائيل وخارجها الإعلان عن «نقاوة وراثية» حافظ عليها اليهود على مرّ الأجيال، بيد أنّهم لم ينجحوا حتى اليوم في تمييز اليهودي استناداً إلى نموذج من الحمض النووي.
لم يكن ممكناً الاحتفاظ بالمعايير الثقافية أو اللسانية: فلم تتشارك ذرّيتهم قطّ لغة واحدة أو ثقافة واحدة. ولم يبقَ متاحاً للمشرّعين العلمانيين سوى المعايير الدينية: الذي وُلد من أمٍّ يهودية أو اعتنق اليهودية بموجب القانون والفريضة الدينية تعترف به دولة إسرائيل على أنّه يهوديّ له حقّ حصريّ وأبديّ في امتلاك الدولة والأرض التي تحكمها هذه الدولة. من هنا الحاجة المتزايدة إلى الحفاظ على اللباس الديني اليهودي في سياسة الهويات الرسمية.
دولة يهودية أو دولة طائفية
منذ أواخر السبعينيات، وأكثر حتى في الثمانينيات، ثمة تشديد على أنّ إسرائيل دولة يهودية لا إسرائيلية. بينما تشمل الصفة الأولى يهود العالم بأسره، لا تشمل الثانية «سوى» مجموع مواطني إسرائيل: من مسلمين ومسيحيين ودروز ويهود من دون التمييز في ما بينهم. وعلى الرغم من أنّ الأسرَلة الثقافية تزداد إيناعاً في الحياة اليومية (يشهد الفلسطينيون ـ الإسرائيليون تثاقفاً مع اليهود)، أصبحت الدولة يهدويّة أكثر فأكثر، بدلاً من أن تعترف بهويّتها وتجعل منها بوتقة وعي جمهوري وديموقراطي.
إنّ الواقع الثقافي الإسرائيلي والهوية اليهودية الكبرى أحدثا فصاماً غريباً في سياسة الهويات في إسرائيل: فمن جهة، تعلن إسرائيل أكثر فأكثر أنها دولة يهودية وتلتزم بتقديم الدعم المتزايد لمؤسسات ثقافية ومنشآت دينية ووطنية تقليدية، على حساب تعليم الإنسانيات العامّة والمعارف العلمية. ومن جهة أخرى، لا تزال النخب الفكرية القديمة وشريحة من الطبقة الوسطى العلمانية تشكو القيود الدينية. وهي تودّ التحليق خارج السرب الديني، شرط ألّا تنفصل عنه كلّيّاً: فهي تودّ أن تبقى يهودية ببساطة خارج إطار الديانة اليهودية، من دون أن تدرك أنّ هذا الأمر مستحيل.
تعلّل أسبابٌ كثيرة التشديد على التهويد في هوية الدولة. وينجم هذا التوجّه عن واقع أنّ دولة إسرائيل سيطرت في ليلة وضحاها على شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني. إذ يشكّل الفلسطينيون المقيمون في مناطق «الأبارتهايد» في الأراضي المحتلّة، فضلاً عن عرب إسرائيل، كتلةً ديموغرافية يُعتبر أنّها تشكّل خطراً وتهديداً على الطابع اليهودي الكاذب لدولة إسرائيل.
تنبثق الحاجة المتزايدة إلى الصفة اليهودية من أجل تعريف الدولة بانتصار اليمين الصهيوني الذي استفاد أساساً وليس حصراً، من دعم الإسرائيليين من أصل يهودي ـ عربي. حافظ هؤلاء على هويّتهم اليهودية بشكل أشدّ وضوحاً بكثير من مجموعات المهاجرين الآخرين. فقد نجحوا منذ العام 1977 في ترجمتها سياسيّاً وبشكل فاعل على الصعيد الانتخابي، الأمر الذي وجّه باستمرار البوصلة الإسرائيلية.
إنّ وصول «الرّوس» إلى إسرائيل ابتداءً من أواخر الثمانينيات، بما يحملون من صفاتٍ مختلفة جدّاً، قد فاقم التوجّه العامّ في البلاد أيضاً: فغياب التقاليد اليهودية عن هؤلاء المهاجرين الجدد وعدم معرفتهم بالثقافة الإسرائيلية دفعا المؤسسات الإسرائيلية إلى التشديد على اليهودية المشبعة لا بالإرث الثقافي، بل بجوهر اليهود، أي بحمضهم النووي. وتبيّن أنّ حملة الهويّة هذه معقّدة، لأنّ شريحةً لا يُستهان بها من الشعب لم تكن يهوديّة: وهكذا، أعاد عدد من المهاجرين الروس اكتشاف «يهوديّتهم» عبر إبداء عنصرية شديدة تجاه العرب.
ظهرت في إسرائيل مؤشّرات تنبئ بانحدار القومية التقليدية في العالم الغربي مقابل تصاعد الطائفية أو القبلية العابرة للحدود. فأيّ قيمة لهوية ثقافية إسرائيلية صغرى في عصر العولمة؟ ألا يُفضّل إذا تطوير هويّة «إثنية» تتخطى القومية، وتمنح يهود العالم الشعور بأنّ إسرائيل ملكٌ لهم، وتصون شعور اليهود الإسرائيليين بأنّهم جزءٌ من شعب يهودي عظيم يتسلّم بعضه سلطات بارزة في سائر عواصم الغرب؟ ألا يُفضَّل الانتماء إلى «شعب عالميّ» تحدّر منه كثيرٌ من الحائزين «جائزة نوبل»، وكثيرٌ من العلماء، وكثيرٌ من المخرجين السينمائيين؟ فقدت الهوية المحلية الإسرائيلية أو العبرية هيبتها السابقة، وتركت المنبر لهوية يهودية تلقائية ومتضخّمة. لذلك، ارتَدَت اليهوديةُ التقليدية حلّةً معاصرة لدى عدد من «اليهود الجدد».
لماذا يقتلك؟ لم تفعل شيئاً!
تنتقد طرفةٌ يديشية شعبية، على سبيل التندّر والسخرية من الذات، الطابعَ الطائفي المتجذّر في الأخلاق اليهودية. وتروي أنّ أمّاً يهودية كانت ترافق ابنها الذي جُنِّد في جيش القيصر الروسي للقتال في حرب القرم (بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية). وما إن همّت الأمّ بالرحيل، أوصَت ابنها قائلةً: «يا بنيّ، لا تنسَ أن تتناول الطعام بعد أن تقتل تركيّاً.» فأجابها الشاب: «حسناً يا أمّي». فأضافت الأم: «واحرص على أن تأخذ قسطاً من الراحة بعد كلّ هجوم تقتل فيه أتراكاً!» فوافق الجنديّ الشاب مجدّداً: «بالتأكيد». وبعد هنيهة من التردّد، تساءل قائلاً: «ولكنْ، ماذا لو قتلني التركيّ؟» فجحظت عينا الأم استهجاناً: «يقتلك؟! لماذا؟ هل فعلت له شيئاً؟!!».