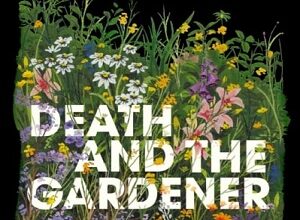ترامب والعالم.. والعقدة الإيرانية

“أيها الملك! عليك أن تدفع”. هذه هي اللغة التي استخدمها ترامب لمُخاطبة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز. الحليف التاريخي للولايات المتحدة، ومن يأخذ عنها مهمة الوقوف بوجه كل إرادات المقاومة في المنطقة العربية، وفي محيطها.
لم تشفع له حرب بلاده الشعواء لضرب مشروع المقاومة وإضعاف كل أعداء “إسرائيل” ومصالح أميركا في المنطقة. نداءُ تصغيرٍ هو كل ما أغدقه ترامب عليه، ليقوم بدفع كل ما لديه لأميركا، ويضيف إليهم كل ما ستجنيه بلاده مستقبلاً، في سلّة واحدة فاقت 450 مليار دولار من الاتفاقيات والمشروعات التي لا هدف لها إلا نقل المال من المنطقة إلى واشنطن.
الأوروبيون أيضاً لم يسلموا. لكن طريقة مُخاطبتهم كانت أكثر احتراماً من تلك التي تلقّاها الملك سلمان. “حلفاؤنا الأوروبيون يجب أن يدفعوا أيضاً لقاء حمايتنا لهم”. لا شيء لدينا بالمجّان، هكذا خاطبهم ترامب، وهي لغةٌ أميركية جديدة عليهم، أميركا ترامب التي دفعت باتجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا تتمسّك كثيراً بوحدة الاتحاد الأوروبي بل ترى فيه مُنافِساً مُحتَملاً فيما لو استمرت موجة الخطاب اليميني بالتصاعُد. الخطاب هذا دفع بالأوروبيين أيضاً إلى إعادة التفكير في صيغٍ قديمة مثل “الجيش الأوروبي” الذي فكّر فيه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قبل أن يجد السترات الصفر تجتاح شوارع باريس وتحطّم واجهات المحال التجارية وتنفجر غضباً لأسابيع طوال.
مع روسيا والصين خطاب مختلف
مع روسيا الأمر كان مختلفاً. التعاطي كان من الندّ إلى الندّ، الأمر الذي عزَّز شكوك مُعارضي ترامب في الداخل حول علاقته بروسيا، ودعم هذه الأخيرة له في الانتخابات. خصوصاً عندما لم يجد مانعاً من سيرتها على سوريا، كما صرّح قبيل إعلانه قرار الانسحاب من مناطق الكرد في شرق الفرات بسوريا.
ومع الصين، أعلن ترامب حرباً تجارية شرسة أراد من خلالها استعادة التفوّق الاقتصادي الأميركي الآخذ بالتراجُع أمام صعود الصين والقوى الصاعِدة الأخرى. وشكّلت حرب ترامب هذه عَصَب خطابه الاقتصادي الداخلي الذي بناه على أسُس استعادة رؤوس الأموال وفروع الشركات إلى الداخل الأميركي وخلق فُرَص العمل التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، وهو ما حقّق جزءاً منه فعلياً على أرض الواقع، الأمر الذي أعطاه دفعاً أكبر للاستمرار في سياسته التي يفرض من خلالها رسوماً جمركية على أصناف جديدة من البضائع الصينية كل مرة، ويتلقّى بالمقابل زيادة الرسوم التي تفرضها الصين على البضائع الأميركية، في لعبة كرٍ وفرٍ لا تزال في مطلع أحداثها. فتارةً تحرّك من بوابة بحر الصين الجنوبي ومشكلاته، وطوراً تُحرّك من باب الملف النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، وفي طيّات الملفين وغيرهما من الملفات محاولةٌ أميركية لتطويق الصعود الصيني بالنار والأزمات، حين تختمر الطبخة على النار الهادئة.
إيران العقدة
أما النار الهادئة التي سعَّرتها واشنطن تحت قضية إيران، فقد أوصلها ترامب إلى ذروة تحميتها للصراع الدائر بين القوّتين، من خلال الخروج من الاتفاق النووي، وفرضه عقوباتٍ متوالية على طهران، وصلت إلى حد محاولته تصفير العائدات الإيرانية من قطاعات النفط والمعادن والتجارة الخارجية.
الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران تمّت عَنْوَنتها “استراتيجية الضغوط القصوى”. ومنها تريد إدارة ترامب إنهاك إيران اقتصادياً ومحاصرة نفوذها في المنطقة، وصولاً إلى إلزامها بالتراجُع عن دعم حركات المقاومة، والتخلّي عن حقها باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، والتقوقع على نفسها، وترك المنطقة مجالاً لأميركا وحلفائها الذين يتكتّلون في تحالفٍ بين الإمارات والممالك الخليجية و”إسرائيل”، ليقضوا معاً على آخر آمال الشعب الفلسطيني بالعودة وتحقيق دولته على أرضه السليبة.
تكتيكات هذه الاستراتيجية يتمّ تطبيقها اليوم في اليمن والعراق ولبنان، ضمن رؤية مُتناغِمة لتطويق القوى التي تدعمها إيران، كمُقدّمةٍ لفرض الشروط الأميركية فيما لو عادت طهران إلى المفاوضات التي ترفضها بسبب عودة ترامب عن نتائج سابقتها.
في هذا السياق، يشير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى أنشطة إيران فيصفها دائماً بـ”الخبيثة”، ضمن رؤية تفترض أنها “الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم”. لكن تعريف الإرهاب الذي تعتمده الأمم المتحدة على أنه استخدام العنف أو التهديد به لترويع المدنيين الأبرياء وإرهابهم لا ينطبق على أيٍ من سياسات إيران في المنطقة. بل إن هذا التعريف قد يكون أقرب إلى أداء الولايات المتحدة نفسها، وحلفائها في المنطقة.
أعدَّت صحيفة “الغد” تقريراً تحت عنوان “شيطان أميركا الأكبر.. 40 عاماً من الهَوَس بإيران”، وفيه تسرد تاريخاً مستمراً من المحاولات الأميركية لتطويق النفوذ الإيراني ومحاصرة النشاط الهادِف إلى دعم قضايا الشعوب العربية في مواجهة “إسرائيل”.
وتنقل الصحيفة عن مجلة “فورين أفيرز” الأميركية الرصينة في عدد تشرين الثاني (نوفمبر الحالي)/ كانون الأول (ديسمبر) ملفاً يضمّ مجموعة من المقالات التي تقيّم أداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سياسة الشرق الأوسط. ويحمل الملف عنوان “شرق أوسط ترامب: دليل للمحتارين”.
يقول مُحرِّر المجلة الأميركية إن سياسات إدارة ترامب في الشرق الأوسط قفزت إلى عناوين الأخبار في الصيف الماضي، بينما انتقلت المنطقة إلى شفا الحرب. ولأن الموقف مشوّش ومُربِك، قمنا بتجميع “دليل للمحتارين”.
دليل المحتارين هذا يقول إن “للشرق الأوسط تاريخ وثقافة ومنطق جيوسياسي متميّز؛ حيث القوى المحلية عالِقة في لعبة كبيرة مُتغيّرة بلا توقّف. ومع أنه أضعف كثيراً من إمكانية تجنّب الهيمنة المؤقتة للغرباء، فإنه قوي بما يكفي لمقاومة الإحتواء الكامل. ونتيجة لذلك، تذهب الخطط الكبرى لخلق نظام إقليمي بشكلٍ حتميٍ أدراج الرياح، ويغادر الأجانب مصحوبين بالسخط والغضب في نهاية المطاف، واللعبة تستمر”.
ويعود الدليل إلى منتصف القرن العشرين، ليورِد أن الولايات المتحدة استلمت الزِمام من المملكة المتحدة لتكون القوّة الخارجية القياسية في المنطقة. وبحلول سبعينات القرن العشرين، كان عليها أن تتعامل مع بقايا حرب الأيام الستة، التي استولت فيها “إسرائيل” على أراضٍ من مصر والأردن وسوريا. وقد استخدم وزير الخارجية الأميركي في ذلك الحين، هنري كيسينغر، الدبلوماسية الأميركية لتسهيل تسليم الأرض مقابل السلام، مؤذناً بانطلاق عقود مما تعرف الآن باسم “عملية السلام في الشرق الأوسط”. لكن هذه العملية توقّفت بحلول العام 2016. وكانت معظم الإدارات الجديدة تحاول المضي قُدُماً بهذه العملية. لكن الرئيس دونالد ترامب أوقف عنها الهواء.
الآن، عملية السلام هذه مرفوضة من قِبَل الطرفين الأكثر فاعلية بشأنها، “إسرائيل” بكاملها جيشاً ومستوطنين من جهة، والشعوب العربية بكاملها من جهة ثانية. وبين هذا وذاك، تقف معظم الأنظمة العربية الخليجية أقرب إلى الموقف الإسرائيلي، وهذا التغيّر الكبير في المشهد اتضّح وخرج إلى العَلَن في السنوات الأخيرة فقط. بينما تقف بعض الدول العربية إلى جانب إيران في دعمها لموقف الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في استعادة حقوقهم المسلوبة.
لكن مُنتهى استراتيجية الضغوط القصوى كما تريدها إدارة ترامب يتكشّف في ملامحه المُتراكِمة اليوم في أحداث لبنان والعراق واليمن وإيران نفسها التي تعاني من الحصار والعقوبات والتطويق المستمر؛ يتكشّف عن محاولاتٍ أميركية لكسر مقاومة المشروع الأميركي لتوطين الفلسطينيين في الدول العربية، وإبقاء اللاجئين السوريين في مناطق وجودهم في الدول المجاورة، لتغيير التركيبة الديموغرافية لهذه الدول من جهة، ومنع الدولة السورية من استعادة قدراتها وشعبها الذي هجَّرته الحرب وقوى الإرهاب، للاستفادة منهم في بناء مستقبل البلاد.
وفي المنظور الأميركي القابِع خلف المشهد اليوم، فإن كسر القوّة الأساس الداعِمة لقدرة الصمود عند الفلسطينيين وبقية قوى المقاومة، سيفضي بالضرورة إلى استسلام هذه الأطراف، وموافقتها على أية صيغةٍ تعرضها إدارة ترامب، ومنها ما تمّ عرضه فعلاً بعد الزيارات المُتكرِّرة لصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إلى المنطقة، والتي كانت نتيجتها عرض “صفقة القرن” المرفوض فلسطينياً بالإجماع، والذي يُراد للفلسطينيين أن يُساقوا إليه مرغمين بعد انكسار القوى الداعِمة لهم ولقضيتهم.
ووفق هذه الرؤية، ستستمر الولايات المتحدة بالضغط حتى تمكين “إسرائيل” من سرقة نفط لبنان المُتنازَع حدودياً على مناطقه وخرائطه، وتوطين اللاجئين، وضمّ الجولان السوري المحتل إلى كيان الاحتلال بصورةٍ نهائية، واقتطاع أراضٍ من الأردن لمصلحتها، وإجبار الجميع على الاعتراف بها بـ”إسرائيل الكبرى” دولةٍ إقليمية كبرى مُسيطِرة، تدور القوى الأخرى في فلكها، وحينها سيقول الرئيس الأميركي لحليفه السعودي: أيها الملك! ما تقوله إسرائيل وحده يمشي.
لكن ليتحقّق ذلك، يجب أولاً تكذيب “دليل المحتارين” حين يقول: “تذهب الخطط الكبرى.. ويغادر الأجانب مصحوبين بالسخط والغضب في نهاية المطاف، واللعبة تستمر”.
الميادين نت