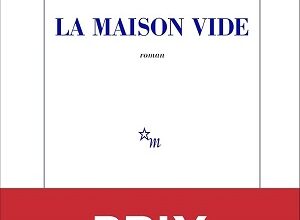محمد جازم يقرأ وجوه قريته ويرسمها

يكتب القاص اليمني محمد عبدالوكيل جازم هذا الكتاب “تأملات للذكرى.. وجوه غادرت القرية إلى الأبد” انطلاقا من وجع إنساني شفيف ليشكل حالة إنسانية فريدة في توهجها، فهو يكتب عن شخصيات عاصرها وعاشها متفاعلا مع تجليات حضورها الثقافي والإبداعي والإنساني لكنها للأسف غادرت تاركة فراغا كبيرا ليس لديه وحده ولكن لدى الأجيال الجديدة، لذا فإنه هنا يضعها قبل أن تندثر من ذاكرته وذاكرة الأجيال القادمة كونها تحمل ملامح وأبعاد إنسانية واجتماعية يمنية أصيلة.
ويقول في مقدمة كتابه الصادر عن مؤسسة أروقة “الحق أنه في كل كتاباتي المتواضعة كنت أحلم بوطن يمضي إلى الأمام وفي كل مرة أقول بعد عشر سنوات سنرى ملمحًا جديدًا في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اليمنية، بعد عقد سينعم أطفالنا بالرخاء والتقدم، ولكن يا للأسف في كل عشر سنوات كانت اليمن تعود عشرين سنة إلى الخلف. وفي كل يوم نزداد بؤسا وفقرًا ووجعًا. ومع توالي الانقلابات التي حدثت بعد 62 وانتشار شبح الحروب وارتفاع منسوب تمزق النسيج المجتمعي، كان الأمل يرافق مسيرتي بقوة حتى الآن، ومازالت بلادنا تشهد حروبا غير معهودة والأمل موجود يخبرنا بأن القادم أجمل مهما كانت التحديات والتضحيات “أعلل النفس بالآمال أرقبها.. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل”. نعم مع ذلك كله كانت اليمن هي الأكثر بهاء والأشد إيغالًا في النفس. والأقدر على لفت الانتباه وإثارة البهجة.. وفي كل مرة كنت أنظر للوطن الكبير بفرح طفولي متوقعا أننا الآن سنخرج من ربقة التاريخ وعنق الزجاجة”.
ويوضح جازم “المكان قرية “حارات” التي يرجع تأسيسها إلى عهد الدولة الرسولية؛ حيث إن الدولة الرسولية التي حكمت اليمن بين عامي 1229 – 1454 اتخذت من مدينة تعز مركزًا وعاصمة للحكم، وكان من الطبيعي أن تتدفق السيول البشرية للسكن في هذه المدينة التي كانت القبائل المحيطة بها: “الحجرية صبر وخدير وشرعب” تسيَّجها من جميع الجهات شأن كل المدن التي تحيطها النجوع والضواحي والقرى القبلية التي تمثل عادة سوار الذهب الذي يحيط المدينة. والحق أن هذه القبائل إذا كنت متنورة ساهمت في بناء المدينة وإذا كانت قبائل جاهلة ومتخلفة اكتسحت المدينة ودمرت كل مافيها من حياة ومؤسسات مدنية وثروات ونهبت كل ما فيها من مال وتراكم مدني وأخلاقي؛ حسب نظرية ابن خلدون في العمران، ومن دون شك فإن مدينة تعز الرسولية في تلك الفترة مدت جذورها وتشعبت؛ فبنت الحصون والقلاع على مشارف التباب التي تقع على حواف الطرق والحدود بما يحقق لها الأمان”.
ويلفت إلى أن تلك الحقبة شهدت بناء حصون وقلاع اندثرت فيما بعد؛ بفعل عوامل التعرية، وغياب الوعي بأهمية الآثار وبدون شك فقد مثّلت “حارات” الإطلالة المهيبة للدولة في ذلك المكان المطل على باب المندب؛ فسكنها أولًا القائد العسكري ريحان العبسي الموالي للدولة الرسولية الضاربة أطنابها في التاريخ والجغرافيا، ومن الإشراقات التي حفلت بها الآفاق زواجه من امرأة تسمى حميدة بنت الأغبر التي كان والدها يمتلك أراضي وقرى واسعة غير آهلة بالسكان وكانت هي الوريث الشرعي له وهو ما شجع الأمير ريحان على بناء التحصينات في الجبال والتلال المحيطة تلك الأمكنة التي كانت تطل منها حميدة؛ فتلمع أساورها وحليها الذهبية مشكّلة ألواناً شاعرية في المكان كما يُحكى وهو الأمر الذي أخذ منحى الأسطورة فيما يخص أملاك حميدة وإضافات ريحان الذي كانت له رؤى استراتيجية في تلك المناطق التي حماها بتأسيس الفرق الاستكشافية وسرايا الاستطلاع والحرس الليلي بقصد صد الهجمات المحتملة”.
ويشير جازم إلى أن عمله هذا عبارة عن “بروتريهات” قراءة في وجوه وذاكرة وأود من خلاله المساهمة في تشكيل الوعي الوطني والجمالي. عمل لا يذهب إلى التوثيق التاريخي؛ لأن هذا له باحثوه الذين يمتلكون وثائق تشير إلى نشأة القرية وأقدم بصيرة وصلت إليهم، وهي بين يدي عبدالفتاح عبدالولي ودرهم عبدالفتاح والقاضي محمد راشد.
ولا مناص من الإشارة هنا إلى ما أورده الكاتب والمؤرخ عبدالرحمن سيف إسماعيل حول “التاريخ الحديث لهذه القرية: “في هذا الموقع عقد عام 1963 مؤتمر لحركة القوميين العرب.. فرع الجنوب تم الإعلان فيه عن تأسيس الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل وفيه اتخذ أخطر قرار في تاريخ اليمن المعاصر وهو قرار الكفاح المسلح كخيار وحيد لطرد الإستعمار البريطاني البغيض الذي احتل جزءاً من وطننا بالقوة في عام ٦٨ عقد فيه مؤتمر حركة القوميين العرب – فرع الشمال – والمؤتمر التأسيسي للحزب الديمقراطي الثوري اليمني أبرز الأحزاب المدافعة عن الثورة اليمنية ونظامها الجمهوري وأبرز الأحزاب المؤسسة للحزب الاشتراكي اليمني، وفي القرية ذاتها عقد العديد من الاجتماعات التمهيدية لقيام الخطوة التصحيحية في الجنوب وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بقيادة المناضل سالم رُبيّع علي. ولجأ إليها الكثير من قادة الثورة أثناء هروبه القسري أثناء الصراعات الدموية في كل من الشمال والجنوب”.
ويوضح أن مادة كتابه تكونت لديه بمحض المصادفة؛ خلال اشتغاله في الكتابة؛ و”لم أخطط أبدًا لموضوعات هذا الكتاب لأنه ليس بحثا ولا سيرة ذاتية ولا رواية. وإنما نسيجاً خاصاً بنفسه أزعم أنه كتاب تذكاري وكفى؛ مثلاً التربويون: كيف كتبتُ عنهم؟ مرة طلب مني الصحفي الكبير محمد رواح الذي كان يرأس تحرير صحيفة “السياسية” الكتابة عن التربويين الذين أعرفهم من أجل التوثيق لجهودهم المشهودة، وحتى لا تندثر جهودهم. التقطت الفكرة التي رأيت أنها رؤية صائبة.
وبالفعل مضيت في الكتابة، ومرة أخرى طلب مني راوح مادة عن رائد الفن الفوتوغرافي في اليمن أحمد عمر العبسي، وهكذا توّلدت عندي بعد فترة فكرة الكتابة عن بعض المصورين، وتوسعت الفكرة لتصبح؛ جمع كل ما كتبته بهذا الخصوص، وخاصة فيما يخص أبناء القرية الذين لهم بصمات وطنية، وهكذا كتبت عن المبدعين الذين جاء على رأسهم محمد عبدالولي وعبدالفتاح عبدالولي وعبدالرحمن سيف إسماعيل وغيرهم وربما سقط بعضهم ليس سهوا، ولكن لعدم قدرتي الصحية على السهر والكتابة والجمع بسبب آلام فقرات الظهر والرقبة التي تزداد ألمًا كلما أردت المتابعة والمثابرة، وهكذا كما أسلفت تكونت لديّ مادة أحببت أن أشارك الجميع في مناقشتها وإغنائها بالقراءة والإضافة ثم معارضتها بمايثري لمن أراد”.
ويقول جازم “في هذه الإضمامة أوردت الأساتذة أولًا؛ لأنهم بالفعل كانوا الشرارة الأولى التي أشعلت النور، وجميعنا يعلم ما للتعليم من أهمية في استنهاض الأمم وتأتي أهمية المربين في الدرجة الأولى مع الأنبياء والرهبان. بعد المربين جاء الجزء الخاص بـ”الفوتوغرافيين”المصورين؛ ثم المناضلين الذين تركوا بصمة عميقة في جدار الوطن ثم المبدعين في الجزء الرابع، واحتوى الجزء الخامس على مساهمة المرأة ومشاركتها الفاعلة. وكذلك جزء الشبان، وهو توثيق وجمع لما تيسر لي كتابته سلفاً، وبالتأكيد هناك شخصيات سقطت وهي تستحق التوثيق آمل أن يمتد بي العمر لأسجل جزءاً آخر من الكتاب؛ أو تطوير هذا الكتاب عبر طبعة أخرى منقحة”.
ويضيف محمد جازم “كنت أنظر إلى هذه القرية على الدوام بأنها جزء صميمي من التكوين العام للمجتمع اليمني العربي العالمي وكنت انظر للمساهمة بنوع من الحماسة فقد كان معظم أبناء القرية عناصر فاعلة في الوطن.
أتذكر في طفولتي المبكّره جيدًا كنت أطل من نافذة ديوان دار جدي وهي نافذة كبيرة في الدور الثالث. في قاع النافذة يوجد عدد كبير من الكتب أخذت أتصفح بعضها، وفجأة وقعت نسخة لأحد كتب الروائي محمد عبدالولي الإبداعية في يدي لعلها “الأرض يا سلمى”. تلك الطبعة التي استقر على وجه غلافها الخلفي اسم محمد أحمد عبدالولي – قاص وروائي- ولد في إثيوبيا – استشهد في حادثة طائرة ـ له من الأبناء أيوب وبلقيس..”.
وتوقفت هنا: أيوب وبلقيس- اللذان أعرفهما- كانت الأحرف مكتوبة بخط الكتاب المدرسي وهذا الربط شدني جدا وتخيلت أيوب وبلقيس وكأنهما إحدى شخصيات كتاب القراءة “أحمد وأروى”. بدا الأمر وكأنني وجدت ينبوعاً من الحلوى. وشرعت أقلب أوراقه وأتملى بغلافه المصقول ولا تزال الذكريات تتوارد بهذا الشأن. أين ذهبت تلك الطبعة؟ فقد حدث أن النسخة لم أرها بعد ذلك سوى مرة أو مرتين على الأرجح. ثم من الذي جاء بها إلى الدار؟ لعل النسخة تم اهداؤها لجدي – من والد القاص – الشهير فقد كان قارئًا نهما، وربما أن أحد أعمامي هو من جاء بها لعله عمي عبدالحفيظ هو أكثر أبناء العائلة ذكاءً وقراءة، وكان قد رُشّح في تلك الأثناء ليكون عضو مكتب سياسي في الحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى أنه متزوج من شقيقة زوجة محمد عبدالولي؛ الذي أرجح أنه أهداه النسخة.
بعد ذلك دار حوار لا أتذكر تفاصيله تمامًا حول هذا الكتاب – من أنه مهم جدًا – دار الحوار بيني وبين عمي عبدالنور الذي ولدنا أنا وهو في نفس الوقت ونشأنا مثل أخوين ننام في بعض الأحيان في غرفة واحدة ونصحو معاً ونذهب إلى المدرسة معا ونلعب معا. تربينا أنا وهو هكذا مثل أخوين يمتلكان أمّين وأبوين ودارين متقابلتين.
بعد سنوات من مغادرة القرية للدراسة في مدينة الحديدة عدت ثانية إلى القرية، وفي كل مرة كنت أعود فيها أتمنى لو أعيش بين دفتيها إلى الأبد؛ ولكن ظروف العيش الكريم كانت تستدعي أن أترحل ودائما أعيد قول الشاعر الشريف الرضي:
“وَلَقَدْ مَرَرْتُ عَلى دِيَارِهِمُ
وطلولها بيد البلى نهب
فوقفت حتى ضج من لغب
نضوي ولج بعذلي الركب
وَتَلَفّتَتْ عَيني، فَمُذْ خَفِيَتْ
عنها الطلول تلفت القلب”.