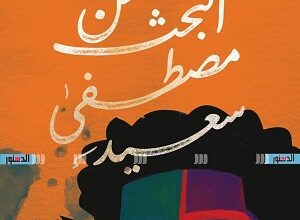أزمة المثقف المصري.. البحث عن أب بديل (محمد شعير)
محمد شعير
لم يكن صنع الله إبراهيم قد تجاوز التاسعة عشرة عندما قبض عليه، ووضعه نظام عبد الناصر في سجونه، ليكون شاهدا على اغتيال استاذه الروحي شهدي عطية الشافعي من التعذيب… وصف صنع الله بعد خروجه من السجن مشاهد السجن في أكثر من عمل. «تلك الرائحة» كان عمله الأول الصادم الذي منعت السلطة الناصرية نشره كاملا لسنوات. وفى روايته « ذات» قدم تصورا كاملا لما جرى في مصر من انحدار.. وصل ذروته عندما وقف صنع الله في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ليعلن رفضه الحصول على جائزة الرواية لأن النظام «فاقد المصداقية».. مضيفاً: «ولا يراودني شك في أن كل مصري هنا يدرك حجم الكارثة المحيقة بوطننا، وهي لا تقتصر على التهديد العسكري الإسرائيلي الفعلي لحدودنا الشرقية ولا على الإملاءات الأميركية وعلى العجز الذي يتبدى في سياسة حكومتنا الخارجية إنما تمتد إلى كل مناحي حياتنا. لم يعد لدينا مسرح أو سينما أو بحث علمي أو تعليم… لدينا فقط مهرجانات ومؤتمرات… وصندوق أكاذيب… لم تعد لدينا صناعة أو زراعة أو صحة أو عدل… تفشى الفساد والنهب ومن يعترض يتعرض للامتهان والضرب والتعذيب… انتزعت القِلة المستغِلة منا الروح… «الواقع مرعب»… هذا الواقع المرعب هو ما دفع صاحب «أمريكانلى» لأن يكون في طليعة المثقفين في ميدان التحرير، ثم في اقتحام وزارة الثقافة لطرد الوزير الإخواني منها.. ومن ثم الاحتجاج على رئاسة محمد مرسي… فيما بعد أعلن صنع الله تأييده المطلق للمؤسسة العسكرية المصرية، وتأييده ترشح جنرال وزارة الدفاع عبدالفتاح السيسي لمنصب رئاسة الجمهورية. لم يكن صنع وحيدا، أو مغردا خارج السرب في موقفه هذا، وإنما كان موقف العديد من المثقفين الذين يرون أن «جماعة الإخوان هم المشكلة أو العقبة الوحيدة أمام تحديث المجتمع وحداثته».. وهذه ليست حقيقة… ربما تكون جماعة الإخوان أحد اعراض الاستبداد السياسي، ربما تكون جزءا من المشكلة، ولكنها ليست كل المشكلة بالتأكيد!
في حوار له مع اللوموند منذ أسابيع قال الباحث والمترجم الفرنسي ريشار جاكمون ومترجم صنع الله إلى الفرنسية: «صنع الله إبراهيم، مثله مثل كثير من المثقفين اليساريين من الأجيال الكبيرة، يبقى ناصر التجسيد الأكثر اكتمالاً لمشروع الاستقلال الوطني، والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. بالنسبة لهم فإن الحريات السياسية كانت تعد ثانوية مقارنة بهذه الأهداف، والمفارقة أن صنع الله إبراهيم وكثيراً من زملائه دفعوا الثمن عبر مكوثهم لسنوات طويلة في السجن، أو تعرضهم لمضايقات أخرى في وقت عبد الناصر أو من تلوه. بالنسبة لهم فاليوم أيضاً ليست الأولوية هي بناء ديموقراطية ليبرالية وإنما التنمية والعدالة الاجتماعية وسياسة خارجية مستقلة. ولكن هذه الرؤية عفا عليها الزمن. أما هنا فرؤيتنا أيضاً ناقصة، لأننا نعطي الكلمة بشكل أكبر للشخصيات المعروفة والكبيرة. المناداة بالحرية أقوى لدى الأجيال الصغيرة.»ريشار يرى أن «الشعور القومي السائد في مصر يمكن تفسيره بالإحساس القوي لدى الإنتلجنسيا بأن البلد التي تم إنهاكها بعد ثلاث سنوات من عدم الاستقرار السياسي أصبحت معرضة لتدخلات أجنبية وأن الخلاص لا يمكن أن يأتي إلا على يد سلطة قوية. هذا هو خطاب «الوطن المهدد».
ـ 2 ـ
طرح عدد كبير من المثقفين اسم عادل السيوي وزيرا للثقافة في المرحلة الانتقالية، ولكن يبدو أن المؤسسة الرسمية لم تكن راغبة في شخص «مثير للقلق».. يمكن أن يصنع تغييرا حقيقيا.. السيوي قضى فترة طويلة من حياته في إيطاليا.. وزار العديد من دول العالم بثقافاتها المختلفة يمتلك رؤية ثقافية يمكن أن تصنع فرقا..انشغل في أعقاب ثورة يناير بتقديم مبادرة لهيكلة المجلس الأعلى للثقافة في مصر..وهى رؤية لم يتم التعامل معها جدياً… فشلت مبادرة السيوي لأسباب كثيرة، ولكن كان من أهم أسباب الفشل المثقفون أنفسهم.. يقول: «المثقفون، هم حتى الآن قابعون في موقع رد فعل، حتى في احتلالهم لوزارة الثقافة كانوا رد فعل، لأنهم عاشوا لسنوات طويلة على ابتزاز الجهاز البيروقراطي للدولة، وفي انتظار ثمرات بائسة منه، بل وأحياناً على نقد هذا الجهاز لتبرير فشلهم..ثمة حالة مرضية من التساكن بين حركة المثقفين والمؤسسات الرسمية. وبالتالي ليس هناك حركة واسعة وسط المثقفين تستطيع أن تتفق على هدف محدد يمكن انجازه. يضحك السيوي: «كنت أقرأ محضر اجتماع حكماء المجلس الأعلى للثقافة أثناء مناقشتهم استقلال المجلس، كانوا جميعهم ضد فكرة الاستقلال، او متشككين في أهميتها لأنهم يتصورون أن من هو خارج الدولة هو في الصحراء، تائه.. وهذه جملة قالها الدكتور جابر عصفور للراحلة الدكتورة فاطمة اسماعيل عندما اخبرته أنها ربما تفكر في ترك عملها بالدولة».
سألته: هل ترى أن أزمة المثقفين هي أنهم دائما جزء من السلطة.. ولا يستطيعون التحرر منها؟
يجيب: لدينا عمر طويل من الصراع، هناك من المثقفين من يرى أن الدولة قوة يمكن ترشيدها وإطلاعها على الامكانيات المتاحة في الواقع، مثلما فعل رفاعة الطهطاوي مع محمد علي، وهى رؤية ترى أن الحاكم موجود كإرادة ناجزة وأنت ما عليك إلا أن تقترح، وهناك صوت آخر يرى أن الدولة عليها التكامل مع ارادات الجماعات المختلفة، كي تنجز المهام الثقيلة في التعليم والصحة والثقافة. وبعيدا عن هذين المسارين لدينا. نماذج قليلة لمثقفين وجماعات ومبادرات مستقلة، في فترة الأربعينيات تكونت جماعات غلب عليها صحيح الطابع الإيديوجي ولكن ثقل الدولة لم يكن موجودا، كان همها المجتمع والفكر والفن هو هاجسها الأساسي.. الأمر ذاته حدث بعد هزيمة 67 مع «جاليري 68».. أي أننا لم نعدم محاولات الاستقلال، ولكن ما زال لدينا ميراث طويل من العلاقة المريضة بالدولة..وأظن أن الأجيال الجديدة متحررة إلى حد كبير من هذا الميراث، ومتخلصة من التبعية للسلطة، ولديهم قدرة أكبر على التواصل والحراك. الباحث السياسي الشاب محمد مصلح يرى الأمر من وجهه نظر أخرى يقول: «بالتأكيد يمكن لنا بسهولة تفهم المزاج الدولتي الطاغي في مصر بمجرد ربط هذا الشعور الجارف بحرج اللحظة الراهنة، وما خلفته احداث الاشهر الماضية لدى الجميع من انزعاج واضطراب، وهو الظرف الذي يقدم للجميع لحظة مثالية للالتصاق بالدولة باعتبارها الضمانة الاهم ضد هذا التهديد المرعب.. التهديد بالفوضى.كان مفهوماً كذلك أن يخرج البعض من تجربة الاسلام السياسي العسيرة، لا فقط بتصميم على حماية الدولة، وانما ايضاً بقدر من الشراسة في الدفاع عن علمانية هذه الدولة واستقلالية مؤسساتها وضمان الجوهر الليبرالي لأي عملية ديموقراطية تتضمن تداول للسلطة».
ما يدهش حقاً اليوم في موقف عدد من المثقفين، حسب مصلح ـ لا يبدو منشغلا باي شيء آخر الا بالتبرير والتهليل لكل انحراف او سلوك انتهاكي او اجرامي حالي.
لماذا؟ ظناً بأنهم بهذا يؤدون واجبهم المقدس في «اسناد الدولة «.. اسناد الدولة أمر هام.. إذا ما تعرضت هذه الدولة لتهديد جاد، حيث سيعني الامر حينها ارتباط سلامة افراد المجتمع بسلامة هذا الكيان.. فهل الأمر كذلك الآن في مصر؟ يجيب مصلح: «لا… لا يوجد تهديد وجودي للدولة في مصر يستدعي اسنادها بلا قيد او شرط على النحو الجاري طليه وتنفيذه من البعض.. نعم ثمة مخاطر جادة.. الا ان جزءاً منها يتمثل في تهديد متصاعد ينذر بمحاولة بعض اجنحة هذه الدولة التغول مرة أخرى ومصادرة المسار الحالي بأكمله لمصلحته، في سلوك متهور قصير النظر مخدر بالتهليل والتشجيع الحاليين، ومن دون توافر مقومات هذه الجرأة. اي باختصار السير بشدة كاملة وخطوات ثقيلة في بحر من الرمال المتحركة داخليا ودولياً. يضيف: «اسناد الدولة كذلك أمر هام كوسيلة.. وليس كغاية.. وكان على من يجد في نفسه شجاعة القيام به ان يضمن من نفسه ممارسته بصلابة لا انبطاح.. وكما هي شجاعته في تحمل تقريظ بعض مجانين الثورجية ومزايدات بعض الصبية.. كان عليه في نفس الوقت ان يجد في نفسه القدرة على نقد الدولة وسلوكياتها إذا ما تخطت دورها الى مرحلة الافتراس والجنون والهذيان والاجرام».
ـ 3 ـ
ربما تلخص مقولة الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين عن «الأسلاك الشائكة» التي ينبغي أن تتوقف عندها الكتابة ولا تتخطاها «أزمة النخبة» المصرية. هذه الأسلاك أو الخطوط منعت دائما التقدم نحو «علمنة» حقيقية للمجتمع وعقلنة الفكر. عندما كتب طه حسين كتابه الشهير»في الشعر الجاهلي» خرج سعد زغلول صارخا أمام البرلمان «وماذا علينا إن لم يفهم البقر؟».. وتلقى قاسم أمين أعنف هجوم على أفكاره حول «تحرير المرأة» من مصطفى كامل صاحب المقولة الشهيرة «لو لم أكن مصرياً…»، كما تخلى النحاس باشا زعيم حزب الوفد عن العقاد بعد هجومه الشهير على»الملك».. وعندما أثيرت قضية الخلافة الإسلامية على يد علي عبد الرازق صمت سعد زغلول.. وقال لمقربين منه: «الموضوع حساس عند العامة.. وأخشى أن يستغل خصومنا ما سأقوله ضدنا..»، وعندما أثيرت قضية ترقية نصر أبوزيد أصدر بياناً للإعلام ليشرح فيه أفكاره، أضاف البعض إلى البيان عبارة «لا إله إلا الله» بدون الرجوع إليه!
هذه المواقف تلخص باختصار لماذا فشلت النخبة المصرية السياسية والثقافية في أن تنقل المجتمع نحو تحرر حقيقي بعيداً عن التلفيق «الحداثي» الذي جعل رفاعة الطهطاوي يكتب كتابه عن رحله «باريز» سارداً ما شاهد هناك من قوانين وقواعد.. ولكنه يختم كل واقعة بنقدها لأنها لا تناسب المجتمع. قد يكون ما فعله الطهطاوي حيلة، ولكن لم تكن مقولة سعد زغلول: «قد يستغل خصومنا ما أقوله…»حيلة» أيضاً.. بل «نهج» سار عليه الجميع فيما بعد حتى وصلنا إلى لحظة اكتشف فيها الجميع وهم «التلفيق».. أصبح المثقف عاريا أمام ذاته، لم تصمد تنظيراته المتوهمة عن «التغيير من الداخل» طويلاً بينما ترتقي تيارات الإسلام السياسي إلى الحكم. باختصار خرج المثقف من «كهف أفلاطون» الذي ظل سجينا فيه طويلاً ليكتشف أنه «لا يعرف من الحقيقة إلا الأشياء المصنوعة».
أربكت الثورة الجميع، أدرك المثقف، أو لم يدرك بعد، أنه كان يعيش في كهف السلطة، نشأ وتربى في حضانتها.. مساحات الحركة والحرية التي حصل عليها كانت بإذن منها. لم تقمعه يوماً لأنها لم تجد حاجة لقمعه.. لماذا إذن تقمعه؟
جاءت الثورة لتفض الاشتباك بين المثقفين والسلطة، أصبح المثقف عارياً، وحيداً عليه أن يواجه قدره، لا كما كان يحدث من قبل حيث يجد نفسه أمام سلطة فاسدة لكنها تدّعي علمانيتها ومدنيتها ودفاعها عن المثقف.. هذا الصراع الذي نشأ بين العمامة والطربوش، لم تتخذ فيه السلطة موقفاً حيادياً، وإنما انحازت إلى ما يخدم مصالحها سواء أكانت هذه المصالح لدى «العمامة» أو «الطربوش»..وهكذا أيضا اعتبر المثقف نفسه ابناً باراً للسلطة، تستدعيه وقتما تشاء ليخوض معاركها نيابة عنها وتتخلى عنه أيضا عندما تتعارض مصالحها معه. هكذا كان يسير المثقف باتجاه «الأسلاك الشائكة» ولكنه غير مسموح له أن يتجاوزها، ولكنه أيضاً لم يحاول المغامرة من أجل تجاوزها. وفي مقابل إحساس المثقف باليتم، ومحاولته البحث عن أب بديل، لا يتناسى الكثيرون أن الثورة لم تكن ضد سلطة فاسدة وإنما ضد سلطة أبوية بالأساس، ضد طرق من التفكير القديمة، الأمر الذي دفع «أسئلة الغرف المغلقة» إلى الفضاء العام. الأسئلة الخجولة التي كان مكانها الوحيد بين أغلفة الكتب، وأحياناً قاعات الدرس المغلقة، وندوات المثقفين ونقاشاتهم. كان الاقتراب منها عملاً محفوفاً بالمخاطر. كان المثقف يطرح سؤاله في خجل، أسئلة حول الدين والسياسة، والشريعة ومفهومها، الحدود، وأساطير التدين، والقداسة التي يضفيها البعض حول الشخصيات الدينية البشرية، وغيرها احتلت مساحة واسعة في النقاش العام، تخطت حدود «الكتب» لتصبح مجالاً للحديث في برامج التلفزيون، وعربات المترو، بل في المناقشات العائلية أحياناً. كان الهدف الرئيسي من الثورات العربية هو تخليص المجتمع من هيراركيته، أو تفكير القبيلة، للبدء في البحث عن طرق تفكير أخرى جديدة بعيداً من سلطة الوصاية الأبوية، ولكن الدخول في معارك الماضي لتمجيده منع هذه الثورات من التطور.. وهذه هي المعركة الأكبر.. والتي تحتاج زمناً أكبر ايضاً.