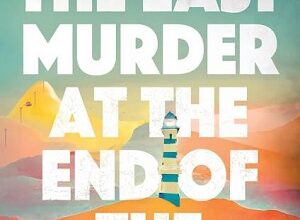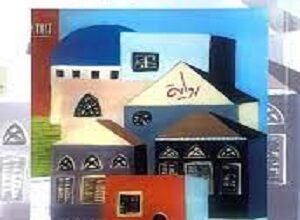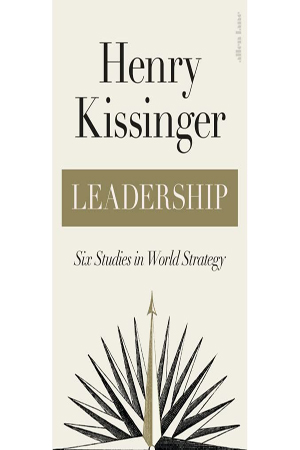
يتميّز كيسنجر بأنه يحظى بالإعجاب والذم على نطاق واسع بسبب إدارته للشؤون العالمية في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون.
يروي وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق هنري كيسنجر في كتابه الأخير “القيادة: ست دراسات في الاستراتيجية العالمية” كيف سأل أحد طلاب التبادل الأميركيين ونستون تشرشل في عام 1953 عن كيفية الاستعداد “لمواجهة تحديات القيادة”. فأجاب تشرشل: “أدرس التاريخ”. “في التاريخ تكمن كلّ أسرار فنّ الحكم”.
استمرار سياسة كيسنجر
وتكمن أهمية مؤلفات كيسنجر في مجال العلاقات الدولية في 3 أشياء: فحسب مجلة “التايم” كان هنري كيسنجر لأكثر من نصف قرن من الزمان، موجوداً في كلّ مكان بالفعل، وصوتاً في السياسة الخارجية مسموعاً دائماً فوق الضجيج. لقد تمّ تعزيز هذا التأثير إلى ما هو أبعد من أدواره الرسمية من خلال النشر الدوري للكتب الأكثر مبيعاً حول موضوعات في الوقت المناسب، بدءاً من الدبلوماسية إلى الصين وحتى الآثار المجتمعية لسياسة الذكاء الاصطناعي. ويوضح مترجم الكتاب “محمد عثمان خليفة”: رغم غياب هنري كيسنجر، تستمر السياسة “الكيسنجرية” مرجعاً للدبلوماسيين عبر العالم، لم يترك هنري كيسنجر حجراً لم يقلّبه في الدبلوماسية الناجحة عالمياً.
الشيء الثاني: عمل كأستاذ في جامعة هارفارد ثم أستاذاً ومديراً لبرنامج الدراسات الدفاعية. وعمل مستشاراً أمنياً لوكالات المخابرات الأميركية في إدارات الرؤساء أيزنهاور وكينيدي وجونسون، ومستشاراً للأمن القومي لريتشارد نيكسون، ثمّ وزيراً للخارجية لكلّ من نيكسون وللرئيس جيرالد فورد. وواصل كيسنجر تقديم المشورة للرؤساء جورج بوش وكلينتون، ولفترة وجيزة، وجورج دبليو بوش بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر في مناصب مختلفة.
وبحسب قول مترجم الكتاب “محمد عثمان خليفة”: صنع كيسنجر “أيقونة” نفسه أيضاً في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت “الدبلوماسية المكوكية” التي اعتمدها كوزير للخارجية الأميركية خلال عام 1973 بمثابة الحجر الأساس ليس فقط لمعاهدة السلام بين مصر و”إسرائيل”، بل أيضاً لاحتكار الولايات المتحدة رعاية ما صار الآن عملية السلام المترنحة بين الفلسطينيين والعرب من جهة والإسرائيليين من الجهة الأخرى. فمن الصعب أن تفتحَ صفحات الأحداث الكبرى من النصف الثاني للقرن العشرين من غير أن يكون لهنري كيسنجر مكانٌ بارزٌ في صناعتها أو التأثير فيها.
– الشيء الثالث: واجه كيسنجر بحسب مترجم الكتاب “محمد عثمان خليفة”، طيلة عمره تهمة “هندسة الخراب” في العديد من بلدان العالم، بما في ذلك لبنان عربياً، وتشيلي والأرجنتين في أميركا الجنوبية، وفيتنام وكمبوديا في آسيا، وصولاً إلى عدة بلدان في أفريقيا. وكما تقول مجلة “التايم”: يتميّز كيسنجر بأنه يحظى بالإعجاب والذم على نطاق واسع بسبب إدارته للشؤون العالمية في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون.
ولهذا أجاب كيسنجر مجلة التايم الأميركية عندما سألته “هل تعتبر نفسك قائداً”؟ بقوله: “نعم، ولكن في المجال الفكري والمفاهيمي أكثر منه في مجال القيادة السياسية الفعلية. حاولت أن يكون لي بعض التأثير على التفكير السياسي أيضاً، ولكن ليس من خلال المشاركة بنشاط في السياسة”.
ويكمل مترجم الكتاب “محمد عثمان خليفة” في مقدّمته القيّمة لكتاب “القيادة: ست دراسات في الاستراتيجية العالمية” بقوله: ولولا هذه وتلك، ما كان نجم هنري كيسنجر ليلمع منذ أكثر من نصف قرن، ثم يطبع اسمه على السياسة الخارجية الأميركية، وربما الغربية عموماً.
ويؤكد خليفة أن هذا الكتاب من “أكثر المؤلفات أهمية في دراسة القيادة أو الزعامة”. حيث يتميّز بمقدّمة تشكّل مدخلاً مهماً في علم القيادة بعكس “الواقعية” التي طغت على أعماله السابقة.
يعتبر هنري كيسنجر الحائز على جائزة نوبل للسلام في كتابه “القيادة: ست دراسات في الاستراتيجية العالمية” الصادر عن “شركة المطبوعات للتوزيع والنشر” في بيروت، أن اختياره لست شخصيات استقى منهم موضوعات كتابه، يعود سببها بأنهم كانوا “مهندسي النظام العالمي في فترة ما بعد الحرب “العالمية الثانية”.
وبالتأكيد اختار كيسنجر القادة الستة من موقع إعجابه بهم. لكنّ هناك قادة تاريخين أنجزوا أعمالاً وانتصارات كبيرة إلا أنهم لم يحظوا بإعجابه. وإلا أين تقييمه لتشرشل وموتسي تونغ وكيم إيل سونغ وهوشي منه والإمام الخميني وغيرهم.
ويقول كيسنجر في كتابه: “لقد كان من حسن حظي أن ألتقي بالستة وهم في أوج تأثيرهم… كلّ واحد من الزعماء الستة تمكّن من الجمع بين الاتجاهين “رجل الدولة والملهم (صاحب البصيرة) أو صاحب الرؤية”. “لقد أصبح جميع القادة الستة مهندسي تطوّر مجتمعاتهم والنظام الدولي في فترة ما بعد الحرب”.
القادة نوعان
يحدّد كيسنجر نوعين من القادة: الأول أن أغلب القادة هم إداريون، وأن كلّ مجتمع بحاجة إلى من يديرون شؤونه اليومية المعتادة. لكن في أوقات الأزمات، في الحروب والتغيّرات التكنولوجية السريعة إلى الخلل الاقتصادي أو الاضطراب الأيديولوجي، يقتضي الأمر وجود قادة قادرين على إحداث التغيير.
أما القائد الثاني الملهم (صاحب البصيرة) فيقدّم أمثلة على ذلك: يوليوس قيصر، والمهاتما غاندي، وأوتو فون بسمارك، وجواهر لال نهرو، وفرانكلين روزفلت، ووينستون تشرشل. فالملهمون ـــــ وفقاً لما يراه كيسنجر ـــــ لا يقبلون هذه التفرقة أصلاً، وإنما يعتقدون أنه لا بدّ من إعمال رؤاهم بأسرع ما يمكن، وأن هذه الرؤى هي التي تحدّد أهمية دورهم السياسي، ويقول كيسنجر بأن “الرؤية الملهمة هي في الغالب الرؤية الأكثر رفعة والأقدر على تحقيق التحوّلات التاريخية”.
ويضيف كيسنجر أن رئيس وزراء بريطانيا تشرشل بين 1929-1939، وهي السنوات المعروفة بـ “السنوات البرية”، والرئيس الفرنسي ديغول في مرحلة قيادته لفرنسا الحرة، كانا ينتميان إلى فئة الملهمين، وعملياً، كلّ قائد من القادة الستة الذين يتحدّث عنهم هذا الكتاب هو مركّب من النزعتين، مع ميل ما إلى طبيعة رجل الدولة.
ويوضح هنري كيسنجر في كتابه الأخير هذا: “يتمركز فكر القادة وسلوكهم عند تقاطع محورين: المحور الأول ما بين الماضي والمستقبل، والمحور الثاني ما بين القيم الراسخة وتطلّعات من يقودهم. والتحدّي الأوّل هو التحليل، والذي يبدأ بتقييم واقعي للمجتمع بناءً على تاريخه وأعرافه وقدراته. ومن ثمّ يجب أن يوازن القائد بين ما يعرف، والمستمدّ بالضرورة من الماضي، وما يتخيّله عن المستقبل، وهو تخمينيّ وغير مؤكّد بطبيعته. إن هذا الإدراك الحدسي للاتجاه هو الذي يمكّن القادة من تحديد أهداف ووضع استراتيجية، وكلاهما مَهمّتان جوهريتان”.
يبدأ كيسنجر تأريخه للقادة الستة في كتابه “القيادة: ست دراسات في الاستراتيجية العالمية” باستعراض صفات واستراتيجيات القيادة معتمداً فيه على لقاءاته بستة قادة سابقين عرفهم، غير عاديين من خلال الاستراتيجيات المميّزة لفنّ الحكم، والتي يعتقد أنهم يجسّدونها بعد الحرب العالمية الثانية.
الفصل الأول: كونراد أديناور
يبدأ كيسنجر بكونراد أديناور أول مستشار لألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية الذي التقى به في مناسبات قليلة فقط، والذي أعاد ألمانيا إلى مجتمع الأمم من خلال ما يسميه كيسنجر “استراتيجية التواضع” (الاعتراف بالتجاوزات، والعمل على محاولة التعويض)، والذي ساعد الألمان على تقييم أفعالهم بعد الحرب العالمية الثانية.
وبحسب كيسنجر فإن الإنجاز الذي حقّقه أديناور يتلخّص في تحويل ألمانيا الغربية الديمقراطية إلى ركيزة لأوروبا القوية وشريك مهم في حلف شمال الأطلسي.
كان أديناور مهتماً بتوازن القوى في القرن التاسع عشر، لكن إنشاء نموذج اتحادي لألمانيا ما بعد الحرب أكثر أهمية. وفي السياسة الخارجية، يلاحظ المؤلف ثلاثة مبادئ رئيسية لإعادة إحياء ألمانيا ودور أديناور في تحقيقها. أولاً، كان هناك هدف تعزيز العلاقات مع الغرب، وخاصة مع الولايات المتحدة. ويوضح كيسنجر: وافق أديناور على اتفاقية الرور لعام 1949، والتي مكّنت الحلفاء من الاحتفاظ بالسيطرة على الصناعة الألمانية. الهدف الثاني كان من أجل المصالحة مع فرنسا. ويشير كيسنجر هنا إلى أن النجاح في ذلك كان بسبب براعة أديناور في التعامل مع الأجانب الفرنسيين وخلق في نهاية المطاف طريقاً إلى مجلس أوروبا، وفي وقت لاحق إلى الجماعة الأوروبية للفحم والصلب. وكان الهدف الثالث تحدّي الاتحاد السوفياتي من خلال إعادة بناء اقتصاد ألمانيا الغربية وإنشاء مؤسسات تقدّمية، ويركّز كيسنجر بأن الجهود المبذولة في هذا الصدد نجحت بمسعى أديناور.
الفصل الثاني: شارل ديغول
يتحدّث كيسنجر بإعجاب شديد عن ديغول الذي أسس الجمهورية الفرنسية الخامسة، ويقول: “وضعَ فرنسا إلى جانب الحلفاء المنتصرين وجدّد عظمتها التاريخية من خلال (“استراتيجية الإرادة”) وأعاد الثقة إلى فرنسا خلال الفترة نفسها، “الجانب الحيوي للقيادة هو الثقة بالنفس، فإن القليل من القادة أظهروا المزيد من هذه الثقة في ظروف أقلّ نجاحاً”. ويقول: “كان شارل ديغول “قاسياً ودقيقاً” ــــ وفعّالاً ـــــ في استعادة فرنسا كقوة بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية”.
ويكشف أنه “في حزيران/يونيو 1940، أضحى ديغول أصغر جنرالات فرنسا، فعندما عّين نفسه زعيماً للفرنسيّين الأحرار لم يكن لدى ديغول سوى خبرة سياسية لمدة أسبوعين فقط كنائب لوزير الدفاع”.
ولأنّ ديغول ـــــ وفقاً لما ينقله كيسنجر ـــــ لم تكن السياسة [بالنسبة إليه] فنّ الممكن بل فنّ الإرادة. فعندما اقتربت القوات الألمانية من باريس توجّه عن طريق الجو إلى لندن، “ولم يكن عملياً يملك سوى بزته العسكرية وصوته”، كي يكرّس نفسه كزعيم للمقاومة الفرنسية. يتضمّن ذلك الأمر ما يتعدّى مجرّد الثقة المفرطة بالنفس.
نشأ الخلاف بين ديغول وحلفائه في زمن الحرب من تباين الأهداف. ففي حين سعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى هزيمة ألمانيا، ركّز ديغول على إنهاء حكومة فيشي و”استعاد ثقة فرنسا بنفسها” بشكل سريع. وفي أواخر عام 1944، وفيما لم يكن النصر في الحرب قد تحقّق، قدّر ديغول أن فرنسا تحتاج إلى الدخول من جديد في ميدان الدبلوماسية الدولية بوصفها طرفاً فاعلاً مستقلاً، وتعهّد مقابلة “الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين. وإذ لم يستطع الوصول بأمان إلى موسكو على متن طائرة فرنسية، سلك ديغول وفق ما يروي كيسنجر، طريقاً ملتوياً يمرّ “عبر القاهرة وطهران إلى باكو على بحر قزوين، وأعقب ذلك برحلة استغرقت خمسة أيام في قطار خاص”. وتمكّن ديغول من أن يصبح أول زعيم من الحلفاء يستطيع أن يناقش تسوية مرحلة ما بعد الحرب مع ذلك الزعيم السوفياتي.
وقد أقنع ديغول رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل بالاعتراف به “كزعيم للفرنسيين الأحرار”، مع منح قوات ديغول التي لم تكن موجودة بعد، الحقّ في العمل كوحدات مستقلة تحت إشراف ضباطها. لقد شكّل ذلك أداءً مذهلاً من قبل شخص “الجنرال ديغول”.
ويعتبر كيسنجر أن ديغول خلق واقعاً سياسياً، “بقوة الإرادة المطلقة” فبوصفه بطل حرب في الحرب العالمية الأولى، مكّن ديغول الفرنسيين من رؤية أنفسهم باعتبارهم مقاومين أشداء للنازيّين، الأمر الذي أزال وصمة عار حكومة فيشي عن المخيّلة الفرنسية.
ويكتب كيسنجر أن ديغول دفع فرنسا إلى فلك الدول الناجحة. مثل حالة كونراد أديناور، فأثبت إرث شارل ديغول نجاحه ليكون ملهماً طوال القرن العشرين، وحتى اليوم، كما ويشير كيسنجر إلى أنه بعد مرور أكثر من نصف قرن على وفاته، لا يزال من الممكن تسمية السياسة الخارجية الفرنسية بالديغولية. ويخلص كيسنجر إلى وصف ديغول بأنه “يسير عبر التاريخ كشخصية متقوقعة وانعزالية، عميقة وشجاعة ومنضبطة وملهمة ومثيرة للغضب، وملتزمة تماماً بقيمها ورؤيتها”.
الميادين نت