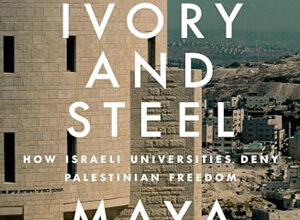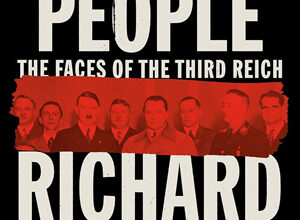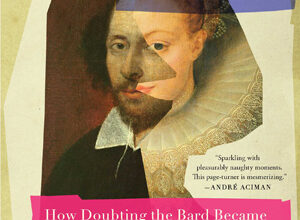عالم الاجتماع الفرنسي يرى في كتابه ان الديموقراطية فقدت قدرتها على فهم ذاتها وعلى الدفاع عنها وعليها أن تستعيدها للحيلولة دون سقوط العالم في دوامة حرب تدور رحاها بين هويات مهووسة وأسواق تقضي على تنوع الثقافات وعلى مجالات الاختيار السياسي.
إذا لم تكن الديمقراطية إلا نظاماً من الضمانات المؤسساتية، فمن يدافع عندما تتهددها الأخطار؟ وإذا كان المجتمع لا يتصور نفسه إلا مجموعة من الأسواق والتدابير الاجرائية، فمن ذا الذي يجازف بحياته دفاعا عن الحريات السياسية؟ وكيف السبيل إلى التوفيق بين هاتين القناعتين: لا ديمقراطية من دون حد للسلطة، ولا ديمقراطية أيضا بدون السعي إلى حياة كريمة؟.
الجواب على هذه التساؤلات وغيرها حول الديمقراطية تشكل محور كتاب “ما هي الديمقراطية.. حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية” لعالم الاجتماع الفرنسي ألان تورين، الذي أشار إلى أن كتابه اجتاز مسافة طويلة انطلاقا من فكرة الليبرالية ومن تبن يكاد يكون عفويا لتصور بسيط للديمقراطية، للحرية “السلبية” بوصفها مجموعة من الضمانات ضد التعسف السياسي. وكيف لا يتساءل المرء بعد قرن أو زهاء القرن من الأنظمة التوتاليتارية، عن الحرية السياسية، وعن الحد من سلطة الدولة، وبالتالي عن احترام المعايير والضوابط المختصة بتنظيم وتقييم كل حقل من حقول الحياة الاجتماعية، كالاقتصاد والدين والعائلة والفن، إلخ؟ وكيف له أن لا يوسع نطاق هذا الحذر ليشتمل على التصور اليعقوبي للديمقراطية الذي كان قد فرض ملكوت المجتمع أو الأمة بصورة لا تقل شراسة عن تلك التي فرض بموجبها نظام ديني أو ملكي، بل تفوقها في بعض الأحيان؟ لقد ظلت الدعوة إلى الإنسان الجامع تبرر زمانا طويلا قمع العاملين، واضطهاد الشعوب المستعمرة، واحتجاز النساء ضمن الحياة الخاصة، وإخضاع الأولاد لتربية سلطوية تجعل منهم كائنات عقلية ومواطنين وتمنعهم جميعا، رجالا ونساء من الاستناد إلى انتماءات مجتمعية وثقافية مخصوصة.
وأكد تورين في كتابه الصادر عن دار الساقي أنه لا قبل للمرء بالاستغناء عن تصور إيجابي للحرية. وأوضح أن “الديمقراطية هي النظام الذي يعترف بالأفراد والجماعات بوصفهم ذواتا، أي النظام الذي يحميعم ويعزز لديهم رغبتهم بأن يعيشوا حياتهم، ويضفي وحدة ومعنى على تجاربهم المعيوشة، بحيث أن ما يحد من السلطة لا يقتصر على مجموعة من القواعد الإجرائية بل هو العزيمة الإيجابية على توسيع نطاق الحرية لدى كل منا. فالديمقراطية هي استلحاق التنظيم المجتمعي، وخاصة السلطة السياسية، بهدف لا يتصف بصفة مجتمعية، بل بصفة معنوية: هو تحرر كل واحد منا. وهذه مهمة من شأنها أن تكون متناقضة إذا كان من الممكن تحقيقها تحقيقا كاملا، لأنها تؤدي عندئذ إلى انحلال المجتمع، ولكنها تطرح على المجتمعات الديمقراطية، على سبيل معارضة قوى السيطرة والرقابة المجتمعية، من أجل رفع نصيب الفرد من المبادرة ومن سعيه إلى تحقيق سعادته، وذلك إذ تعترف كل قوة من القوى المجتمعية الفاعلة بحقوق القوى الأخرى بصياغة مشاريعها والاحتفاظ بذاكرتها.
ورأى أن هذه النتيجة لا تعود بنا إلى التصورات القديمة حول المواطنية والروح الوطنية وبالتالي حرية القدماء التي انفصلنا عنها، نحن والليبراليون، دون أن يكون في نيتنا العودة إليها. فالمسألة لم تعد مسألة إلغاء الفروقات المجتمعية والثقافية بموجب إرادة عامة، بل بالعكس، مسألة رفع التنوع الداخلي في مجتمع ما إلى أقصى الدرجات الممكنة، والتقدم باتجاه إعادة تركيب ترمي إلى إيجاد عالم جديد وإلى استعادة ما هو منسي ومهمل. لم تعد المسألة أيضا مسألة إلغاء الماضي من أجل بناء غد مشرق، بل مسألة تمكين أنفسنا من العيش في أكبر عدد ممكن من الأزمنة والأمكنة، واستبدال مونولوغ العقل أو التاريخ أو الأمة بحوار الأفراد والثقافات. حتى أننا عن حلم التسيير الذاتي، وهو آخر ما تبقى من حرية القدماء، إذ إننا بتنا نعلم بالتجربة أن الجماعة الواحدة، مهما بلغ صغرها، قد تطغى عليها الروح الحرفية المحافظة، أو تخضع لطُوَيغية، أو لجهاز من أجهزة السلطة، وأنها قد تنوء على أفرادها بضغوطات تزداد شدتها بقدر ممارستها عليهم عن كثف، فحرية المرء بحاجة ماسة ومطلقة لمجال عمومي ولتدابير ديمقراطية متزنة ومدروسة.
ولفت تورين إلى أن الانتقادات التي كانت توجه للتصور السياسي وحسب للديمقراطية غالبا ما كانت تتم باسم ضرورة تغيير المجتمع، لكن قرننا أجبرنا على الاعتراف بأن صيغة السلطة السياسية أهم من التنظيم المجتمعي للانتاج، وإن العمل الذي يهدف إلى تحرير العاملين قد يؤدي إلى احتجاز السكان بأسرهم بمن فيهم العاملون أنفسهم ضمن عبودية جديدة إذا لم تكن مبنيّا على الحرية السياسية. فإذا كان علينا أن ننتزع أنفسنا اليوم من تصور سياسي خالص للديمقراطية، فإن ذلك ينبغي أن يتم انطلاقا من تحت لا من فوق. فقبل أن يكون هدف الديمقراطية إيجاد مجتمع سياسي عادل أو إلغاء كل أشكال السيطرة والاستغلال، ينبغي أن يكون هدفها الرئيسي أن تتيح للأفراد وللجماعات وللتجمعات أن تصبح ذواتا حرة، صانعة لتاريخها، قادرة على أن تجمع في عملها بين جامعية العقل وخصوصية الهوية الشخصية والجماعية. وفي وجه جميع الأشكال التي يسميها السندرو بيزورنو السياسة المطلقة، ينبغي إعطاء الأولوية لحق كل كائن بشري بتأكيد حريته عبر تجربة مخصوصة وضد علاقة سيطرة مخصوصة.
وشدد على أن تاريخ الحرية في العالم هو تاريخ الجمع الأوثق بين جامعية حقوق الكائنات البشرية وخصوصية الأوضاع والعلاقات المجتمعية التي ينبغي الدفاع عن الحقوق المذكورة في ظلها، وهوجمع لا يسعه أن يتحقق إلا على يد القوى الفاعلة نفسها لا عبر الحلم بمجتمع مثالي، إن الطوباويات تُخضع الواقع المجتمعي لمبدأ أوحد العقل. أما الديمقراطية فهي بطبيعتها مضادة للطوباوية لأنها تقتضي إعطاء الكلمة الأخيرة للأكثرية، المتغيرة بحكم تعريفها، لتختار تركيبة ـ قابلة للتعديل دائما ـ من المقتضيات أو من المبادئ المتعارضة، على نحو ما تتعارض الحرية والمساواة، أو يتعارض الجامع والمخصوص. والفكر الديمقراطي يسعى مهما كان شكله إلى إعطاء الأولوية لمن هم تحت على من هم الاعتراف بأن الدور الرئيسي في بناء الديمقراطية ينبغي أن تقوم به القوى المجتمعية الفاعلة بالذات، لا أن تقوم به الطلائع ولا الفئة المميزة. وهذا ما يحمل على تحديد الديمقراطية باعتبارها ثقافة أكثر مما هي مجموعة من المؤسسات والتدابير الاجرائية.
وقال إن التفكير والعمل في سبيل الديمقراطية ظلا يتماهيان زمانا طويلا مع العمل الحر على بناء مجال سياسي يمكن أن تنتظم ضمنه الحملات على مجتمع متراتب ومتجزيء تحل فيه التقاليد والامتيازات والإجحافات. لقد استمدت الفكرة الديمقراطية قوتها الرئيسية في البداية من تلك العزيمة المصممة على القضاء على المجتمع التقليدي، النظام القديم (بالحرف المكبر) وعلى ابتداع مجتمع جديد. وهذا ما أدى إلى تزويد العمل السياسي بأساس متعارض مع أساس المجتمعي المدني؛ فقد كان هذا مجال المصالح المخصوصة، بينما كان ينبغي على ذاك أن يكون مجال الجامع، وإذن مجال العقل، ومجال مستقبل يتحدد بوصفه انتصارا للعقل. لذا ارتبطت فكرة الديمقراطية ارتباطا وثيقا بفكرة بناء سلطة مطلقة على ما نشهد أولا فكرة الإدارة العامة كما تصورها جان جاك روسو، ثم كما تصورتها الأنظمة الثورية والقوموية المتنورة التي استهواها هذا الارث. وأدت هذه الجامعية بأشكالها الملطفة إلى كلام علموي تمسك به “جمهوريو” أواخر القرن 19، وكثيرا ما يتمسك به اليوم أولئك الذين نسجوا على منوال أفكارهم. هكذا كان ينبغي أن يكون هدف الديمقراطية أقرب بكثير إلأى انفتاح السستام السياسي، منه إلى تحرره من التقاليد ومن ضغوطات المصالح المجتمعية، إلى نزع الطابع المجتمعي عنه، إذا جاز القول لجعل الحياة المجتمعية طبيعية أكثر وعقلية أكثر. استثارت هذه الفكرة جهدا كبيرا في مجالي التعليم والإعلام حتى تتيح للحلول المتنورة أن تفرض نفسها.
وأشار تورين إلى أن نموذج العقلنية السياسية هذا هو الذي نشهد إفلاسه اليوم. أولا لأننا أصبحنا بعيدين جدا عن ذلك المجتمع المتراتب المتجزئ الذي قضى عليه قرنان من التحديث المتسارع. بل إننا شهدنا بالعكس خلال القرن العشرين، كيف انتصرت في أنحاء كثيرة من العالم استبدادية كانت تظن نفسها متنورة وتقول عن نفسها أنها ديمقراطية، لكنها فرضت حلولا كانت تراها حلولا عقلية على مجتمع لم يكن بوسعه أن يكون صانع تغيّره الخاص لأنه كان، برأيها، لا يزال غارق في الاستغلال والاستلاب. وقد أدت هذه الاستبداديات إلى التوتاليتارية قبل أن تنهار وتختنق وتصاب بالشلل بفعل أعمالها، فانهارت معها هذه المماهاة بين الديموقراطية والثورة التحديثية، في غضون سنوات قليلة.
ورأى أن ديمقراطية الحديثين ليست ديموقراطية مشاركة، ولا ديمقراطية تمثيل ولا حتى ديمقراطية اتصال وتواصل. إنها تستند قبل كل شيئ إلى حرية الذات الخلاقة‘ على قدرتها على أن تكون قوة مجتمعية فاعلة وأن تبدل محيطها لتستصلح فيه أرضا تستطيع أن تختبر نفسها فيها كذات خلاقة حرة. لكن هذا التصور لا يخولنا الحق بتقليص الديمقراطية إلى سوق سياسية منفتحة حيث يستطيع المستهلكون أن يختاروا مرشحا، سواء بحريتهم أو بناء على تحريضات تسويق سياسي يتصاعد اجتياحه للمجتمع. فهذه الليبرالية القصوى، الإباحية، لا تشترك مع الاستبداد المتنور إلا بنقطة واحدة، لكنها مهمة، وهي أن كلاهما يؤمن بحلول عقلية ويخشى السجال والايديولوجيات السياسية. إن تقليص الليبرالية إلى الفكرة القائلة بان من الواجب تصور المجتمع كمجموعة من الأسواق، يسوقنا، في هذا المجال كما في غيره، إلى مشاركة العدد الأكبر في كل أشكال الأستهلاك، وإلى اتساع نطاقة الهامشية والاستبعاد، في آن معا. وهذا ما أدى بالمقابل إلى صعود أشكال الدفاع الطائفية، وإلى الهوس بالهوية، وإلى عودة التقاليد. فالعالم اليوم ينقسم إلى دنيا السوق الاشتمالية، ودنيا أخرى مجزأة هي دنيا الهويات القومية والدينية والثقافية. وهكذا نجد، من جهة، تداولا محموما للمال والمعلومات، ومن جهة أخرى، تعددية ثقافية راديكالية. وهذان الاتجاهان يتوافقان بقدر ما يتعارضان، إذ إنه إذا لم يعد هناك معايير وضوابط جامعة لتقويم أشكال المعيشة المجتمعية والثقافية، فإن السوق وحدها تستطيع تأمين الاتصالات بين وحدات منفصلة بعضها عن بعض تمام الانفصال، ومترددة دائما، حيال الآخرين ، وبين اللامبالاة والفضول، أو بين التسامح والعدوانية.
وأوضح تورين أنه ينبغي على المرء أن يقلق لضعف فكرة الديمقراطية ولافتقادها للمعنى، إذ خارت قواها ولم تعد قادرة على القيام بشيئ في وجه خصومها بالذات، على نحو ما يتبين لنا من هذا الاستنكاف الجبان الذي اتخذته البلدان الغربية حيال العنف المستشري في الكثير من مناطق النزاعات المسلحة على يد الذين يطبقون التطهير العرقي. صحيح أن عجز الأنظمة السلطوية أصبح واضحا في عدد كبير من البلدان، ولكن ألا تملك الديمقراطية علة لوجودها غير فشل خصومها؟ لقد آمنا بالسياسة إيمانا مفرطا، فصرنا الآن نفرّط بالإيمان بها. ليست الديمقراطية هي التي تنتصر اليوم بل الاقتصاد السوقي هو الذي ينتصر، علما بأنه إلى حد ما نقيضها، إذ أنه يسعى إلى تقليص تدخل المؤسسات السياسية، بينما تسعى السياسة الديموقراطية إلى توسيع نطاقها لحماية الضعفاء من سيطرة الأقوياء.
وأضاف “كيف يستطيع المرء أن يتكلم عن حقوق أساسية عندما يطغى الخلط يوما بعد يوم بين ما هو هوية ثقافية وما هو سلطة سياسية، وينشر التخوف والحذر حيال جامعية باتت توهم بأنها إيديولوجية الأمم المسيطرة؟ هكذا صارت الفكرة الديموقراطية تستبدل ـ في حال عدم نبذها واستبعادها ـ يترك الأمور تجري على غاربها في ظل تسامح يوفر على النفس عناء أي حكم أخلاقي أو سياسي. وبين دفاع كل بلد من البلدان وكل منشأة من المنشآت عن حصصها من السوق وبين الهوس بالهوية الذي يتخذ شكل الفردوية الاستهلاكية أو شكل الطائفية، يتحول المجال السياسي إلى ساحة مهجورة ويفقد سكان البلدان الغنية مبالاتهم بالقكرة الديموقراطية، بينما ينبذها في البلدان الفقيرة الذي صاروا يعولون آمال المستقبل الرغيد على التعاظم الاقتصادي أكثر مما يعولونه على تحرر سياسي خيب هذه الآمال.
وخلص قائلا “بين مطرقة الثقة العمياء وسندان التعصب الطائفي، علينا أن ندافع عن الحرية السياسية وعن الديموقراطية، وأن نجعلهما في خدمة تعددية ثقافية وسياسية ينبغي أن تتوافق مع وحدة المواطنية والقانون والعمل العقلي. لقد فقدت الديموقراطية قدرتها على فهم ذاتها وعلى الدفاع عنها، وعليها أن تستعيد هذه القدرة للحيلولة دون سقوط العالم في دوامة حرب أهلية عالمية تدور رحاها بين هويات مهووسة وأسواق تقضي على تنوع الثقافات وعلى مجالات الاختيار السياسي. ينبغي أن تكون الديموقراطية فكرة جديدة، فهي لا توجد من احترام الحرية السلبية، ومن دون القدرة على مقاومة سلطة سلطوية. ولكنها لا تستطيع الاقتصار على هذا العمل الدفاعي. وعلى بعد متساو من الاختلافية الطائفية العدائية والليبرالية السياسية التي لا تبالي بأنواع التفاوت والاستبعاد، تقوم الثقافة الديموقراطية بوصفها واسطة سياسية لإعادة تركيب العالم وإعادة تكوين شخصية كل امريء، وذلك بتشجيعها لالتقاء الثقافات المختلفة وتدامجها، في سبيل مساعدة كل منا على أن يحيا أكبر قسط ممكن من الخبرة البشرية.
ميدل إيست أونلاين