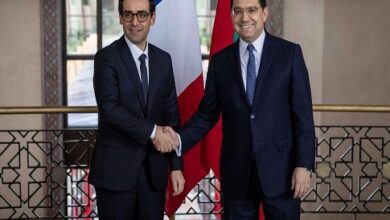الإخوان المسلمون والسلطة (غالب ابو مصلح)
غالب ابو مصلح
وصل «الإخوان المسلمون» إلى السلطة في مصر بعد مسيرة سياسية طويلة، وبعد أن مضى على تأسيس تنظيمهم قرابة ثمانية عقود. ويعود تنظيم «الإخوان»، فكراً ونهجاً، إلى التيار السلفي في الإسلام. نجد جذور هذا التيار في مدرسة «أهل الحديث»، ويُعتبر «ابن حنبل» مؤسسها في القرن الهجري الثالث (855 م). وقاد ابن حنبل عملية التصدي لـ«المعتزلة»، وهي المدرسة العقلانية في الإسلام (من ضمن فرق علم الكلام) التي سعت إلى التوفيق بين العقل والإيمان، ما أدى إلى سحق المعتزلة وسحلهم في شوارع بغداد. وبرز ابن تيميّة كأحد مجددي السلفية (سنة 1260 م) إبّان احتلال المغول لبغداد، ثم ظهر محمد بن عبد الوهاب كداعية لإحياء السلفية (1791م) الناشطة حتى اليوم في المملكة السعودية في الجزيرة العربية.. كما عمل العديد من المفكرين الإسلاميين على تحديث السلفية ومواكبتها العصر، مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده.
أسّس حسن البنّا حركة «الإخوان المسلمين» كحركة سياسية سلفية «غير أنه اختلف عن السلفيين في أنه وظّف الدين في السياسة، وقال إن الإسلام مصحف وسيف، فدشّن بذلك عهد الإسلام السياسي وفتح الطريق أمام انبعاث ما يسمى السلفية الجهادية والتي اتخذت أبعادها على يد السيد قطب»، كما يقول شمس الدين كيلاني. وتشعّبت الحركات السلفية مدارس مختلفة وحصلت انقسامات عديدة فيها «في أتون الصراع مع أميركا بعد حرب الخليج، فنمت السلفية الجهادية. رغم ذلك بقيت الغلبة للسلفية الانسحابية من السياسة».
واصطدم «الإخوان» في مصر بثورة الضباط الأحرار عندما حاولوا السيطرة على الثورة وفرض رؤيتهم على قادتها، فتم قمعهم إلى أن توفي الرئيس جمال عبد الناصر. ولم يعد «الإخوان» بعيدين عن السلطة منذ بداية عهد «الرئيس المؤمن»، أنور السادات، وانقلابه على الناصرية. وتقول نادية فرنسيس فرج في كتابها «الاقتصاد السياسي لمصر»: «إن السنوات الـ35 الماضية في مصر قد تميّزت بسيطرة أيديولوجيا دينية متشددة، كانت تستهدف تبرير القضاء على النظام الناصري». وقد يسّر ذلك إحياء تنظيم «الإخوان المسلمين» وتوسيعه وتداخله في البنيتين السياسية والاقتصادية لمصر. وكان الإخوان مؤيدين لجميع التوجهات السياسية والاقتصادية للنظام المعادي للناصرية. فقد أيّدوا وبرّروا علاقات مصر بالمعسكر الرأسمالي بقيادته الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبنوا علاقات وثيقة مع هذا المعسكر، وقد ساعدتهم هذه العلاقات التاريخية في الوثوب إلى السلطة في ظروف الانتفاضة الشعبية المصرية ضد مبارك وحمتهم من بطش القيادات العسكرية الواقعة تحت الهيمنة الأميركية.
الرؤية الاقتصادية لـ«الإخوان»
أيّد «الإخوان» إعادة الأرض إلى الإقطاع ونزعها من الفلاحين إبّان حكم مبارك، كما أيّدوا سياسة الخصخصة لتقزيم دور القطاع العام ونهبه، وخنق قطاعي الصناعة والزراعة لمصلحة قطاع الخدمات، والقطاع التجاري منه بشكل خاص. فقد وقف «الإخوان» دائماً مع السياسات الليبيرالية التي دعا إليها «إجماع واشنطن». وهذا الانحياز الأيديولوجي لليبيرالية الجديدة ليس حكراً على «إخوان» مصر، بل يتشارك فيه العديد من الأحزاب الإسلامية الفاعلة مثل «جبهة العمل الإسلامي» الأردنية، و«حزب النهضة» التونسي وحزب «العدالة والتنمية» المغربي.. كما تتشارك فيه معظم الحركات الإسلامية في الموقف المهادن للكيان الصهيوني ولإقامة العلاقات الشاملة معه، كما ظهر في ندوة قطر في الدوحة تحت عنوان: «الإسلاميون والثورات العربية» المنعقد في النصف الأول من شهر أيلول 2012.
وتحاول هذه الحركات السلفية النأي بنفسها عن تهمة الالتزام بالأيديولجيا الرأسمالية الغربية المُدانة من قبل أوسع الجماهير العربية والإسلامية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فيقولون بـ«الاقتصاد الإسلامي» كنهج بديل. ولكن ما الفرق بين اقتصادهم «الإسلامي» والليبرالية المتوحّشة التي يدعونها «إجماع واشنطن»؟ لا فرق إلا في التسمية. الفرق في المظهر لا في الجوهر. ولتبرير النهج والسلوك المتعارض مع مبادئ الإسلام وقيمه الأخلاقية، تسعى السلفية عبر الإيغال في التأويل والتحريف إلى شرعنة مواقفها وسلوكها على الصعد كافة. فالمرابحة مثلاً لا تختلف في جوهرها ونتائجها عن الربا. تحريم الفائدة ناتج عن مفهوم يقول إن المال لا ينتج المال، الجهد البشري هو المنتج. و«المرابحة» لا تعني المشاركة في نتيجة العمل الاقتصادي الذي تمّ تمويله من المقترض حتى تكون على الأقل نتيجة المشاركة في تحمّل المخاطر، ربحاً كان أم خسارة، هي فائدة على القرض بتسمية أخرى.
كتب السيد قطب كتاباً عن «معركة الإسلام والرأسمالية»، بغية التمييز بين «الاقتصاد الإسلامي» والرأسمالية. ويعلّق عمّار علي حسين على هذا الكتاب لسيد قطب قائلاً: «إلا أن قضيته لم تكن مواجهة الرأسمالية الاستعمارية المتوحشة برؤية تنزع إلى الانتصار للطبقات الشعبية، بقدر ما كانت تواجه رأسمالية الغرب برأسمالية تتكئ على النصوص الإسلامية، إمّا بتأويل للقرآن الكريم يوائم أفكاره، أو بانتقاء الأحاديث النبوية، أو التقاط المواقف من سِيَر الآخرين».
وفي دراسة حول سمات رأسمالية «الإخوان» قام بها مركز «النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية» بإشراف عبد الخالق فاروق، توصّل الباحثون إلى خلاصات منها أن بعض الإخوان يملكون «إمبراطوريات مالية صغيرة (داخل مصر)… إلى جانب إمبراطوريات أكبر في الخارج يبلغ رأسمالها مليارات الدولارات». وأغلب هذه القدرات الرأسمالية الإخوانية غير تنموية، لأنها تقوم في الأساس على التجارة التي يكرر بشأنها كبار الرأسماليين الإخوان دوماً الحديث المنسوب إلى الرسول الكريم: «تسعة أعشار الرزق في التجارة».
والاستشهاد بحديث منسوب للرسول فيه كثير من الخبث التاريخي. كان يصحّ هذا القول بالنسبة للعديد من الحواضر العربية والإسلامية الواقفة على خطوط التجارة البعيدة المدى (من الصين إلى أوروبا) في ذلك الزمن الغابر. فقد قام العديد من الدول والأمبراطوريات ونما العديد من الحضارات على محطات طرق التجارة تلك. ولم تكن الزراعة مصدراً أساسياً للرزق إلا في حوضي النيل والفرات. وعندما تمّ قطع الطريق على هذه التجارة، أو الالتفاف حول خطوطها التقليدية، انهارت هذه الحضارات أو تخلّفت وضعفت إلى حدّ بعيد. أمّا في عصرنا الراهن، وفي وطننا العربي كله لم تعد التجارة تمثّل تسعة أعشار الرزق، بل إن الإنتاج السِلَعي أصبح أساس خلق الثروة الدائمة والمتجددة، أي قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة. وقد سقطت مقولة الأميركيين بأنهم تجاوزوا عصر الصناعة إلى عصر «ما بعد الصناعة»، عصر الخدمات، إبّان الأزمة البنيوية الدورية التي ضربت الولايات المتحدة منذ نهاية سنة 2007، وما زالت تتخبّط فيها وإلى سنوات عديدة آتية. فانتشال مصر من مأزقها الاقتصادي ـ الاجتماعي يحتاج إلى «تثوير» قطاعي الصناعة والزراعة.
ويقول الدكتور خليل العناني (أكاديمي مصري ـ جامعة درهام البريطانية) إن تعبير «الاقتصاد الإسلامي» عبارة عن محاولة «ثقافية» وأيديولوجية للهروب من «كمّاشة الرأسمالية والاشتراكية» أكثر من كونه تأصيلاً رصيناً لنظرية اقتصادية متماسكة تستلهم القيم الإسلامية… يوجد انفصام بين البرامج الاقتصادية للإسلاميين وسياساتهم الفعلية. السياسة الاقتصادية والممارسات الواقعية للحزب لا تختلف كثيراً عن الممارسات الرأسمالية التي كان يتبنّاها النظام السابق. ويصف بعض الباحثين هذه السياسة بأنها «نيوليبرالية» يمينية لا تختلف عن رؤية نظام حسني مبارك ورجاله» .
ويتعارض هذا «الاقتصاد الإسلامي» مع أخلاقية الإسلام ومبادئه الداعية إلى العدالة والمساواة والتكاتف والتضامن الاجتماعي، كما إلى احترام الإنسان، إلى الإنسان كقيمة مطلقة يتمحور حوله ومن أجله الجهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. فالإنسان ذو قيمة لذاته، وليس أداة لهدف اقتصادي خارج عنه، كما تدّعي الليبرالية الجديدة. وتتعارض «العدالة الاجتماعية» مع تراكم الثروة وتركّز أدوات الإنتاج في يد قلّة من البشر تعيش على جهد الآخرين. «النار والماء والكلأ ملك للجميع»، هذا ما يقوله الإسلام عندما كانت الزراعة مصدراً أساسياً للرزق وإنتاج الثروة. ولم يشهد التاريخ العربي ـ الإسلامي إقطاعاً شبيهاً بالإقطاع الأوروبي، يملك الأرض والإنسان، ويتم توارثهما. كانت الملكية الزراعية مشروطة بالعمل الزراعي. وحتى أواخر العصر العثماني لم تكن هناك ملكية متوارثة للأرض، إلا في جبل لبنان، ولأسباب تاريخية خاصة. فالملكيات الإقطاعية في مصر ـ والتي يتحمّس لها «الإخوان» ـ تتعارض مع تاريخ الحكم الإسلامي وقيم الإسلام. ونزع الأرض من الفلاحين وإعادتها للإقطاع عمل يتناقض مع المبادئ والقيم الإسلامية.
والعدالة الاجتماعية في الإسلام لا تتحقق عبر الصدقات للفقراء. فللإنسان حقوق أساسية تحدث عنها الجيل الثاني من شرعة حقوق الإنسان وأقرّتها شعوب العالم ودوله، أهمها حق الإنسان في العمل والسكن والغذاء والطبابة والعلم. يقول أبو ذر الغفاري: «عجبتُ لمَن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج إلى الناس شاهراً سيفه»، ولم يقل مادّاً يده للاستعطاء، وعلى المجتمع والنظام تأمين هذه الحقوق للإنسان، لكل إنسان. صدقات الأغنياء لا تحقق العدالة، بل تحقق المهانة للفقراء والمعوزين. وإعادة توزيع الثروة الوطنية أو الناتج الوطني عبر الضرائب التي يقع عبؤها على الأغنياء، وعبر الإنفاق الاجتماعي الذي يستفيد منه الضعفاء وعبر التوظيف العام المنتج الذي يخلق فرص العمل المجزية، هو الذي يحقق العدالة الاجتماعية.
وتتمسّك جماعة الإخوان بـ«شروط صارمة لمَن ينضمّ إليها، ومنها ضرورة أن يكون له عمل يكسَب منه» (عمار علي حسين، المرجع السابق). وهذا الشرط للعضوية يتناقض مع أخلاقيات الإسلام وقيمه. هذا الشرط لا يطبّق على الإقطاعيين والأثرياء الذين يعيشون على كدح الآخرين، على الريوع من رؤوس أموالهم وممتلكاتهم. بل يطبّق شرط العضوية هذا على الفقراء والعاطلين عن العمل. وتتطابق هذه الرؤية مع فلسفة «الليبيرالية الجديدة» للإنسان. تقول هذه الفلسفة إن «السوق الحرة» تحدد قيمة الإنسان، وقيمة الإنسان تُقاس بأجره أو بدخله. فالعاطل عن العمل يتحمّل شخصياً مسؤولية بطالته، وهو مشبوه بشكل ما، ومدان، وعلى الدولة تركه لمصيره كمشرّد، كلّ ما يمكنه الحصول عليه هو صدقات الآخرين. هنا يتناقض مع مبدأ التكاتف والتضامن الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية للنظام السياسي، ويتم تشييء الإنسان وتحويله إلى سلعة، إلى أحد مدخلات الإنتاج الهادفة إلى تعظيم أرباح رؤوس الأموال وتراكم الثروات في أيدي الأثرياء. إنها دعوة إلى نزع إنسانية الإنسان المناقضة لروح الإسلام وأخلاقياته ومُثُله.
فـ«الاقتصاد الإسلامي» الذي يدعو له «الإخوان» هو أحد تسميات النظام الرأسمالي الأكثر رجعية وتخلّفاً، ويشكل استمراراً لنظام اقتصاد حسني مبارك بإشراف «إجماع واشنطن».
قامت مؤسسة «كارنيغي» الأميركية المعروفة بدراسة لأدبيات الأحزاب الإسلامية العربية الأساسية في كلّ من مصر والأردن وتونس والمغرب (ثلاثة منها في السلطة)، وحول خمس قضايا اقتصادية رئيسية في سياساتها: (1) دور الدولة والنظرة إلى القطاع الخاص، (2) مكافحة الفقر والبطالة، (3) سيادة القانون ومكافحة الفساد (4) العجز والموازنة العامة، (5) العلاقات الخارجية والنظرة إلى المؤسسات الدولية. ويتّضح من تلك الدراسة أن «الأحزاب الأربعة تملك برامج اقتصادية مفصّلة في المحاور الخمسة. ولا تشكل الفلسفة التي تقوم عليها تلك البرامج قطيعة مع الحاضر، بل تتبنى سياسة اقتصادية تؤمن بحرية الأسواق والملكية الخاصة، وهي بذلك لا تقدم بدائل «ثورية» من شأنها تغيير النظام الاقتصادي السائد والهيكلية القائمة، إذ يقوم الرهان الإسلامي على إدارة الاقتصاد في شكل أفضل من السابق…».
وصل «الإخوان المسلمون» إلى السلطة في مصر، في ظروف حراك شعبي عارم وأوضاع اقتصادية واجتماعية متردّية. لأول مرة في تاريخ مصر تحتل الجماهير الغاضبة الساحات العامة، تواجه بطش السلطة، تدفع ضريبة الدم وتتحدى الحاكم، رافعة قبضاتها وصوتها الشعب يريد…»بدلاً من «بالروح بالدم نفديك يا…». لأول مرة تمسك الجماهير بزمام أمورها، أو على الأصح تقاتل للإمساك بزمام أمورها، معبّرة عن مطالبها الاقتصادية والاجتماعية من دون قيادة تخطط لها وترسم مستقبلها، وبرامج إنقاذية شاملة. ولحقت الأحزاب بالجماهير، ومنها «جماعة الإخوان»، مترددة، متذبذبة ومساومة، متأرجحة بين الجماهير والعسكر، تضجّ بتناقضاتها الداخلية. ولكن «الإخوان» تميّزوا بتنظيمهم المجرّب المتداخل مع السلطة وأجهزتها، وبعلاقاتهم الخارجية الأميركية ـ الأوروبية، وامتداداتهم العربية وارتباطاتهم مع أنظمة النفط في الجزيرة العربية، وبتصميم على الوصول إلى السلطة والإمساك بها مهما كان الثمن. فهل يستطيع «إخوان» مصر حكمها وانتشالها من مأزقها الشامل والاحتفاظ بالسلطة؟ إلى متى؟ وبأية وسائل؟ بصناديق اقتراع أم بالقمع باسم الله وشريعته؟
لا ريب في أن اقتصاد مصر ينزلق على طريق التردّي الشامل. ويعلّق أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة محمود عبد الفضيل على أوضاع مصر قبل استلام مرسي سدّة الرئاسة فيقول: «إن الوضع الاقتصادي سيكون في غاية الصعوبة بالنسبة إلى الرئيس، في مرحلة تباطؤ اقتصادي». ويرى عبد الفضيل أن الخروج من هذا المأزق الاقتصادي يكون بابتكار حلول غير تقليدية، لتعديل المسار. ويرى الخبير الاقتصادي أحمد جمال أن على الرئيس «أن يمزج بين الانفتاح الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية، عبر سياسات تراعي الفقراء». ويعتقد أن التحدي الأساسي للرئيس سيكون في «كبح جماح الأسعار وتوفير فرص العمل إضافة إلى مساواة أكبر بين المصريين في بلد يعيش 40 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
من السهل توصيف الواقع وتحديد التمنيات والحاجات. لكن وضع سياسات قادرة على إنقاذ مصر وتحقيق الأهداف المرجوّة شيء آخر. قبل وصول مرسي إلى الرئاسـة، ارتفـع عـجز المـيزان التجاري خـلال عـام واحد بنسبة 95,3%، وبلغ 3,55 بلايين دولار في شهر آذار 2012. فقد انخفضت الصادرات بنسبة 9,5% وارتفعت الواردات بنـسبة 31,4%. وصرح وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن عجز الموازنة للسنة المالية 2011 ـ 2012 بلغ 170 مليار جنيه متجاوزاً العجز المقدّر أصـلاً بـ134 مليار جنيه. وقال الوزير إن أحد أسباب هذا الارتفاع الكبير في العجز هو «زيادة الأجور التي تمّت تحت ضغط مختلف الفئات»، فأوصلت بند الأجور إلى 122 مليار جنيه، بزيادة 12 مليار جنيه عن المقدّر سابقاً لهذه الزيادة. وقال أيضاً إن موارد الدولة تغطي 74% فقط من إنفاقها، أي أن عجز الموازنة يصل إلى 26% من مجمل الإنفاق ويساوي 11% من الناتج المحلي القائم لمصر. ويقترح الوزير اتخاذ إجراءات عدة لإنقاذ الموازنة، منها: «خفض وترشيد الإنفاق الحكومي والحد من صور الإسراف والنظر في أمر الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية»، في الوقت الذي يركز فيه المسؤولون السياسيون في خطاباتهم على فكرة الاعتماد على الخارج، من حيث الاستدانة وجذب الاستثمارات.
ولا تقتصر مشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية على تنامي العجوزات في موازين التجارة الخارجية والحساب الجاري الحقيقي والموازنة العامة وتدني التدفقات المالية الخارجية، وخاصة التوظيفية الإنتاجية منها، كما ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتوسّع الفروقات الطبقية. فبالإضافة إلى كل ذلك هناك تنامي الفساد في الإدارات العامة واهتراء البنى التحتية وتدني مستوى التعليم في جميع مراحله وتلوث المياه المنزلية أو عدم توافرها، ما أنتج كوارث صحية ضاعفت كلفة قطاع الصحة وأدت إلى تدني إنتاجية العمالة. كما هناك نقص في استهلاك الغذاء بعد أن استنفد الفقراء التحوّل إلى بدائل أرخص، ما أدى إلى توسّع سوء التغذية وخاصة عند الأطفال. كل ذلك أدى إلى تدهور القدرة التنافسية في معظم قطاعات الاقتصاد. وتتداخل هذه الأزمات مع السياسة الخارجية لمصر حيث تثير هذه السياسة الكثير من النقمة الشعبية والمطالب، وأهمها العلاقات مع العدو الصهيوني والإدارة الأميركية. وتُقيِّد هذه العلاقات الخارجية المتداخلة مع تدهور الوضع الاقتصادي خيارات العمل على إخراج مصر من مأزقها الشامل. وتطرح سلطة «الإخوان» نتيجة ذلك حلولاً وهمية تنسجم مع بنية الإخوان الطبقية ودور العديد من كواردهم على الصعيد الاقتصادي وعلاقاتهم السياسية الخارجية المبنية على التزاماتهم الفكرية، وخاصة مع دول النفط وقيادات المعسكر الرأسمالي.
خيار الاعتماد على الخارج
يبدو أن الإخوان اختاروا السير، اقتصادياً ومالياً وسياسياً، على نهج حكم مبارك، وعلى الاعتماد على الخارج في العمل على تجاوز مأزق الاقتصاد المصري. وأبدى الرئيس مرسي نشاطاً كبيراً في التجوال الخارجي طلباً للمساعدات والقروض. فتغطية عجز في الموازنة العامة يصل إلى أكثر من 12 مليار دولار، مع ضعـف شـديد في الـسوق الماليـة الداخلية، يحتاج إلى تدفقات مالية خارجية كـبيرة جداً ومكلفة على الصعيدين المالي والسياسي. وطريق التمويل الخارجي يمر حكماً بموافقة أميركية مشروطة. فالولايات المتحدة تملك مفاتيح الإقراض من المؤسسات الدولية ومن السوق الرأسمالية العالمية، كما من خزائن دول النفط العربية وصناديقها السيادية. وللإقراض شروط اقتصادية ومالية وسياسية.
وكثيراً ما تتعارض هذه الشروط مع حاجات مصر الملحّة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتوجهات الجماهير السياسية. فنتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وما تنتجه من نقمة شعبية ونشاطات اعتراضية وإضرابات، قررت حكومة «الإخوان» رفع معدلات دعم السلع ذات الاستهلاك الشعبي. وأكد وزير المالية ممتاز سعيد حرص الحكومة على «تخفيف الأعباء على محدودي الدخل والشرائح العريضة في المجتمع بالعمل على تأمين السلع والحاجات الأساسية وتعزيز مخصصات الإنفاق الاجتماعي». وبالتالي تم تخصيص 47,5 مليار دولار في السنة المالية الجديدة للإنفاق على البرامج الاجتماعية المتنوعة، وبزيادة قدرها 15,8 بليون جنيه عن مخصصات السنة السابقة. ولكن بعد حوالى ثلاثة أشهر، اتّجهت الحكومة إلى رفع الدعم عن بعض السلع، بغية خفض عجز الموازنة. فقد برزت قضية إلغاء الدعم عن المنتجات النفطية مع بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض منه، قدره 4,8 مليارات دولار. فالصندوق يعتبر الدعم إهداراً لمالية الدولة. كما يطالب الصندوق بـ«رفع أسعار الطاقة وزيادة رسوم الخدمات العامة وأسعار منتجات القطاع العام، ولا سيما خفض حجم الإنفاق الحكومي وتقليص الإنفاق العام الاستثماري». فدعم المحروقات يساوي خمس الإنفاق الحكومي، ونحو 6,31% من الناتج المحلي القائم، و19,27% من الإنفاق العام، وبالتالي، ونتيجة ضغوطات الصندوق، توجهت الحكومة لتبني سياسة رفع أسعار الوقود بفئاته المختلفة تدريجياً، بدءاً من الأسابيع المقبلة وحتى نهاية سنة 2013، مؤكدة أن ذلك يقتضي رفع سعر الوقود بنسبة 50%.
وفي مقابلة للرئيس مرسي مع وكالة «رويترز»، سألته الوكالة عمّا إذا كانت الحكومة تفكر في خفض قيمة الجنيه المصري، فأجاب: «لا على الإطلاق… هذا غير وارد على الإطلاق». فخفض سعر صرف الجنيه يخفض الدخل الحقيقي لأصحاب الرواتب والأجور، ويرفع معدل كلفة سلّة الاستهلاك الشعبية ويشكل تهديداً للسلم الأهلي. ولكن ضغوطات الخارج كما ضغوطات السوق المالية أدت إلى خفض سعر صرف الجنيه بنسبة عالية بعد أقل من شهر على جواب مرسي لوكالة «رويترز». ويقول الخبير الاقتصادي مختار الشريف إن انخفاض سعر صرف الجنيه بنسبة عالية قياساً بالدولار الأميركي كان بسبب «عدم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف، وتوقفه عن دعم الجنيه، كأحد شروط قرض الصندوق» (صندوق النقد الدولي).
وتأتي ضغوطات صندوق النقد الدولي هذه، والتي سترفع من معاناة أصحاب الدخل المحدود، في الوقت الذي يرتفع فيه الغليان الشعبي وتتّسع فيه رقعة الاحتجاجات والإضرابات. فقد تم رصد 300 حالة احتجاج في النصف الأول من شهر أيلول 2012، وهو رقم قياسي لعدد الإضرابات في مصر. ويضيع حكم «الإخوان» بين ضغوطات الجماهير والقوى العاملة صاحبة الحاجات الملحة التي فجّرت الثورة في وجه حكم مبارك، وبين الضغوطات الأميركية المباشرة، أو غير المباشرة، عبر مؤسسات «إجماع واشنطن» ومشروطيات الإقراض.
ويبدو أن صعود الإخوان إلى السلطة قد تم بمشروطيات أميركية. فبعد سقوط مبارك مارست الولايات المتحدة ضغوطاً كبيرة على المجلس العسكري كما على الإخوان لمنع الصدام بينهما. وتعددت زيارات الموفدين الأميركيين إلى القاهرة لاستطلاع الأوضاع وتوجيه الصراع والإمساك بسير الأحداث. والتقى العديد من المبعوثين الأميركيين مع قيادات الإخوان (أمثال ماكين، وكيري، وكارتر، وكلينتون) وخرجوا جميعاً باستنتاجات شبه متطابقة: «تلقّينا ضمانات قاطعة بالحفاظ على الاتفاقات الموقّعة مع إسرائيل، وتدعيم النظام الاقتصادي القائم». فاستمرار النهج الاقتصادي ـ الاجتماعي السابق، وغير البعيد عن رؤية «الإخوان» الفكرية، تم الالتزام به مسبقاً، مع تغيير اللافتة المرفوعة، من «ليبرالية جديدة» إلى «اقتصاد إسلامي».
عارض «الإخوان» مبدأ الاستدانة من الخارج قبل وصولهم إلى السلطة. وقال الناطق باسمهم محمد غزلان إنهم يعارضون توجّه رئيس الوزراء في حينه، كمال الجنزوري، للاستدانة من الخارج، ويخشون من عملية «توريطهم في تركة ثقيلة… لذلك نرفض طلب الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولي (كان القرض المطلوب 3,2 مليارات دولار)، لأن أعباء القرض ستتحملها الأجيال المقبلة. فالاقتراض كأكل الميتة. وهناك بدائل أخرى لحل الضائقة المالية، لأن أعباء القروض تكلف 30 إلى 40% من حجم الموازنة. ونرى الأفضل في الحد من النفقات وعدم الإسراف، وسد الثقوب التي تتسرّب منها الأموال».
ولكن رؤية الإخوان للاقتراض تغيّرت بعد وصولهم إلى السلطة، فلم يعد الاقتراض من الخارج محرّماً كأكل الميتة، فقد طلب «الإخوان» قرضاً من صندوق النقد الدولي لا بمبلغ 3,2 مليارات دولار بل بمبلغ 4,8 مليارات دولار، وذلك إلى جانب قروض أخرى أميركية وسعودية وقطرية وإماراتية وكويتية بمليارات الدولارات، وذلك بعد أن تراجع الاحتياط النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار إلى 14,4 مليار دولار خلال 18 شهراً. والتبرير الدائم لهذه التحولات هو الفتوى التي تقول بأن «الضرورات تبيح المحظورات»، ولو كان المحظور الذي تبيحه محرّماً في الإسلام.
فـ«الضرورات» تبيح إعادة القواعد العسكرية إلى الأرض التي حرّرتها الثورة بقيادة عبد الناصر من القواعد العسكرية الغربية، وبثمن كبير من المال والدماء والتضحيات.
كما تبيح «الضرورات» أو «الحاجات» تشديد الحصار الظالم على قطاع غزة، حيث يحكم «الإخوان» الفلسطينيون، حتى «أكل لحم» إخوتهم في غزة أصبح حلالاً مباحاً.
تقول صحيفة «وورلد تريبيون» الأميركية إن الرئيس مرسي، قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة العامة للأمم المتحدة في أيلول 2012، والتي اجتمع خلالها بالرئيس الأميركي باراك أوباما، قد وافق على السير بالمشروع الأمني الأميركي ـ الصهيوني «لضبط الحدود» مع قطاع غزة، بعد أن أبلغته واشنطن نيتها إسقاط مليار دولار من الديون المستحقة على مصر. وكان كبار الضباط في الجيش المصري في عهد مبارك قد رفضوا ذلك المشروع الذي «سيمنح الولايات المتحدة وجوداً عسكرياً دائماً في شرق سيناء». ويدعو هذا المشروع الأمني الأميركي ـ الصهيوني، الذي جرى تعليق العمل به سنة 2010، إلى أن يقوم سلاح المهندسين في الجيش الأميركي ببناء جدار بطول 10 كلم على حدود غزة مع مصر، مع تركيب مجسّات حرارية وأجهزة استشعار داخل الجدار لسد الأنفاق وتعزيز حالة الحصار على غزة.
صحيفة السفير اللبنانية