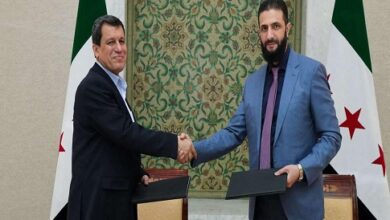الديموقراطية العربية بالعسكر و«البيعة» للرؤساء كما للملوك (طلال سلمان)
طلال سلمان
بمصادفة قدرية، توالت «الانتخابات الرئاسية» في خمس «جمهوريات» عربية، بينها ما حسمت النتائج فيها آليا، والباقي قيد الانجاز كحالة مصر ولبنان.
ففي الجزائر تم التجديد، لمرة رابعة، للرئيس المُقعد عبد العزيز بوتفليقة، الذي ذهب إلى الاقتراع على كرسي متحرك يدفعه بعض الحرس، ثم ساعده بعض آخر في ملء استمارة انتخابه نفسه، وتولى بعض ثالث «ترجمة» تمتمات شكره الناخبين إلى كلمات مفهومة.
أما في سوريا التي تعاظم عدد المرشحين فيها فكاد يبلغ العشرين ثم تناقص إلى ثلاثة فقط فليس من يجادل في أن «الرئيس» سينتخب لولاية ثالثة، وهذه المرة بلا اللجوء إلى الاستفتاء المعلنة نتيجته مسبقا.
وأما في العراق حيث رئيس الدولة «مام جلال» الطالباني مصاب بمرض سيمنعه من ممارسة صلاحياته المحدودة أصلاً، فان رئيس الوزراء الذي يكاد يختصر حكم ما تبقى من العراق بشخصه، نوري المالكي، بشر العراقيين بان لوائحه ستفوز بأكثرية ساحقة حتى من قبل إعلان النتائج الرسمية التي ستتأخر نحواً من شهر، بينما مسعود بارزاني يجدد لنفسه رئاسة إقليم كردستان، مرة بعد أخرى، من دون الرجوع إلى بغداد.
أما في لبنان، فقد تعذر على المجلس النيابي انتخاب رئيس جديد، في ثلاث دورات متتالية ما دام تعذر تحقيق توافق (حتى نتجنب القول بالتزكية)، ما يوحي بأن الرئيس العتيد لن يهل على اللبنانيين إلا بعد شهور، تاركا «لفخامة الفراغ» أن يملأ مقعد الرئاسة إلى أمد غير معلوم. وللمعلومات: فليست هذه أول مرة يفرغ فيها منصب رئيس الدولة في لبنان… فقد حدث ذلك مرتين من قبل، الأولى في أواخر أيلول/سبتمبر 1988، وقد امتدت لأكثر من سنة، والثانية امتدت من أواخر أيلول/سبتمبر 2007 وحتى 25 أيار/مايو من العام 2008، وها إن لبنان مهدد بفراغ في رأس السلطة لمرة ثالثة لا يعرف إلا الله مداها.
وأما في مصر، فان الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد بضعة أسابيع سترفع إلى السدة رئيساً ثالثاً للدولة (ويمكن اعتباره رابعاً إذا احتسبنا المكلف الآن بشؤون الرئاسة القاضي عدلي منصور) خلال ثلاث سنوات: مبارك، ثم المجلس العسكري، ثم الرئيس «الاخواني» الدكتور محمد مرسي).
يمكن للأعداء والخصوم أن يلخصوا هذا الوضع الغريب بالقول: في الجزائر يحكم من يمنعه مرضه من التحرك، وفي سوريا يكاد الدم أن يكون قاعدة الحكم، وفي العراق الانقسام، وفي لبنان الفراغ، وفي مصر الجيش، ولو أن المشير عبد الفتاح السيسي قد استقال من موقعه العسكري ليتقدم للانتخابات. فالرتبة تبقى من حق صاحبها حتى لو صار مدنيا، فكيف وهو قد استقال قبل فترة وجيزة، مقدما التبرير البديهي: أريد أن آتي نتيجة صندوقة الاقتراع وليس تعبيرا عن الحب الشعبي الجارف للجيش.
في كل حال، فكل دولة تذهب في اتجاه، وكل «عهد جديد» عليه أن يبدأ من الصفر. لا قطيعة ولا تصادم ولا تلاق ولا تقارب بين الأنظمة «الجديدة»، وحتى «القديمة» منها… مباشرة على الأقل.
المفارقة أن الملوك والسلاطين والأمراء في الجزيرة والخليج، فضلا عن المغرب، يعرفون بعضهم البعض، يتبادلون الكراهية وان اظهروا الود، لكنهم يحتمون بالاتحاد خوفاً من الضياع.
أما الرؤساء فهم الأكثر قلقا، كأنما «الربيع العربي» لا يطارد الملوك والأمراء والشيوخ وإنما يقصر اهتمامه على رؤساء الجمهورية المنتخبين ـ غالبا – بتزكية الاستفتاء الذي لا يحتاج إلى ناخبين، ويكاد يماثل «البيعة» التي كانت تعطى ـ طوعا!! – للخلفاء والسلاطين!
لكأنما الجمهوريات هي وحدها المهددة بالديموقراطية، خصوصاً إذا كانت «الجمهورية» نفطية كحال الجزائر والعراق.
حتى «الرئيس المدني» في هذه الجمهوريات يعطي لنفسه رتبة عسكرية عليا، أو ينظر إليه كعسكري بسبب من صلاحياته المطلقة التي تتخطى صلاحيات السلاطين.
منذ ستين سنة تقريبا، تحكم الجيوش معظم «الجمهوريات» العربية، بدءا بسوريا 1949، مروراً بمصر 1952، وبعدها العراق 1956، وصولاً إلى ليبيا 1969، فالسودان 1969، ثم تونس (قبل انتفاضة البوعزيزي في خريف 2010)، فالجزائر (بعد ثلاث سنوات من انتصار الثورة العظيمة، وقيام الجمهورية سنة 1962 بعد إخراج الاستعمار الفرنسي)، واليمن (1962) وحتى اليوم مع فترات قصيرة من الحكم المدني.
لكأن الجيش هو صانع الأقدار في الجمهوريات العربية. وحتى لبنان الذي يعتبر نظامه استثنائيا وفريدا في بابه وفي تركيبته الطائفية، فان الرئيسين الأخيرين للجمهورية انتقلا من موقع قيادة الجيش إلى الرئاسة الأولى، بأصوات الخارج الذي يصير في مثل هذه الحالات داخلاً.
ليس أسهل من تبديل الملابس العسكرية بالبدلات المدنية، لكن الحكم يبقى لصاحب الأمر.
النموذج الدائم للحكم في الأقطار العربية هو «الملكية» حتى لو تمت تسميتها «جمهورية»، والانتخابات في الغالب الأعم أشبه بالبيعة، وما أكثر المرات التي تمت فيها مبايعة الخليفة بالسيف مشهراً على الطامع في القفز إلى المنصب الفخم (كما في حكاية يزيد بن معاوية مع عمرو بن العاص بعد وفاة معاوية وغيرها كثير).
ومعروف أن الملك لا يخرج من القصر إلا إذا مات أو خلعه إخوانه (كما جرى مع الملك سعود، أو حاكم قطر الأسبق الشيخ حمد مع أبيه الشيخ خليفة).
ثم إن الملوك والأمراء والسلاطين يعرفون بعضهم البعض وتجمع بينهم غالباً روابط النسب أو المصاهرة، وهذا لا يعني أن علاقاتهم الشخصية تخلو من التحاسد بل التباغض والكراهية أحيانا، لكنهم يحتمون بالاتحاد خوفاً من الضياع إذا ما تفرقوا. وقد يتآمر بعضهم، مع الأبناء الطامحين، على الآباء الذين يطيلون مكوثهم أكثر مما يطيق ولي العهد أو بعض إخوانه.
في أي حال، فالتغييرات التي توالت في قمة السلطة في بعض البلاد العربية (مصر، ليبيا، تونس) لم تحدث حتى الساعة تغييراً جديا في العلاقات العربية ـ العربية. فكل من القادة الجدد يذهب في اتجاه: بينما مصر تخلع الرئيس «الاخواني»، فإن «الإخوان» في تونس مُكَوِّن أساسي في السلطة الجديدة التي جاءت بها انتفاضة البوعزيزي (وكذلك يحاول «الإخوان» التسلل إلى السلطة في ليبيا، وسط الفوضى العارمة، ولو كشريك مع سائر الثوار الذين لا هوية محددة لهم).
وحتى إشعار آخر، فان من يحكم في الجزائر هو الجيش من خلف الرئيس الذي أعجزه المرض، ومع ذلك فقد بقي أو ابقي منعا من وصول غيره. ومن يحكم في سوريا هو العسكر، ولو بالدم، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولاً. وفي لبنان، سيحكم الفراغ حتى تتفاهم دول الكون، وبالذات الأقوى نفوذاً، وبالتحديد الولايات المتحدة الأميركية وضمنها السعودية من جهة، وإيران وضمنها سوريا من جهة أخرى، حتى تحصل معجزة التوافق.
وهي قد تحصل في يوم، في شهر، في سنة، والله اعلم.
تعيش الديموقراطية العربية.