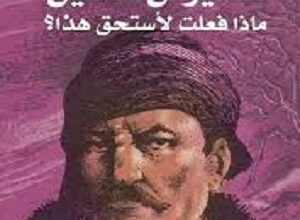ليس سهلاً أن تكتب عن عالم فواز حداد الروائي، عالم ممسوس بإشكاليات إنسانية عن الحياة والمتغيرات والبشر. قد يربكنا أسلوبه الحكائي الساخر، سهل وممتنع، صارم ومتلون. في روايته الجديدة التي اختار لها عنوانا لافتاً “جمهورية الظلام” كأننا نراه يقف في مكان قصي، هادئا حياديا وصادما. يروي كراوٍ عليم سردية الحدث السوري، وهي سردية صعبة ومتشعبة موضوعها الأول، مسيرة الإنسان السوري المطحون بدواليب القهر والظلم – تناولها بروايات المرحلة الأخيرة من عالمه الروائي على مدى السنوات العشر الماضية – تتعالى في روايته هذه، بنبض مختلف، يضعنا أمام إشكاليات نفسية معقدة، أفرزتها بلا شك المحنة السورية.
يستعير فواز حداد أحياناً دور الحكواتي، مشحوناً بسخرية يتقنها، ويعرف كيف يستخدمها. فهو يدرك جيدا أنه لا بد من إضفاء بعض الطراوة المخادعة، تخفف من إيقاع قسوة عالمه الهادر بالألم – أشبه بتعبير عامي؛ يرش على الموت سكرا – وهي تقنية محيّرة، فأنت لا تدري إن كان عليك أن تبكي، أو تضحك، أو حتى تقهقه أحياناً. ما يذكرنا بحكاية الفارابي الشهيرة، حين دخل على مجلس الخليفة، فأبكى الجميع، ثم أضحكهم، ثم أرسلهم إلى النوم. بينما في رواية حداد، لا تستطع أن تنام، فالألم الذي تختزنه الرواية يتحدى العمق الإنساني لديك، يورطك، لا يدعك تهدأ ولا تسترخي.
أقتبس هذا الحوار بين العميد والمحقق الشاب، دلالة النهج الساخر الذي يسير عليه خط الرواية:
“الضمير هو صوت الله في الإنسان “
من قاله؟ حاول أن يتذكر لكنه طار من ذهنه، ربما كان…
“حسبما أتذكر، قاله رجل روسي اسمه تولستوي”.
قال العميد بامتعاض:
“آه، خبير روسي”.
“لا، كاتب روايات”.
“ليس خبيراً ؟”.
“إنه خبير بالنفس البشرية”.
“نحن لا نأخذ بالاعتبار البضائع المستوردة”.
كتب
“إياك وأن تعيد ما قلته، هذا شيء شبيه بما يهددنا به الإرهابيون الإسلاميون، تعلم لديهم تفسيراتهم، ينسبون كل شيء إلى الله”.
أليس جميلاً أن يخرج من عمق المأساة فن راق، اسمه الكوميديا السوداء؟
لن ألخص الرواية، ولن أفكك تقنياتها. أنا روائية وقارئة، أكتب انطباعي، رؤيتي، ما أثارته في نفسي من مشاعر مختلطة. إن فعلت، فأنا أمتهن عذابات ورؤى وشجون وأحلام ليالي الروائي الطويلة. هذا النوع من الروايات لا يُلخص، وإنما يُقرأ، يُعاش، يُشعر به. وإلا كيف يمكن تلخيص هذا العري الإنساني الفاضح، إلى اجتزاء يفتقد إلى حرارة السرد، والتفاصيل والدهشة والدموع! كيف أفعل ذلك، وأنا أتجول في عالم مقروح، تسحق فيه إنسانية الإنسان في الأقبية المعتمة، وخلف صليل الأبواب الحديدية الموصدة، وحيث تنظر العيون على اتساع حدقاتها، إلى الخلاص بالموت، على أنه الحلم المشتهى. أما كيف يصبح الموت هو الحلم المشتهى؟ عليك أن تطرح قبل ذلك السؤال المرعب:
إلى أيّ حد يمكن أن يكون الإنسان وحشاً؟
عندما يطرح فواز حداد أسئلة مباشرة، إنما يستفز الأسئلة في داخلك، ويترك لك حرية الإجابة، ولا يدعك تتريث لتتأكد إن كان ما يرويه حقيقياً أم محض خيال. أنت حر، في مساحتك الحرة المطلقة كقارئ، لا شأن له فيما إذا ارتفع مستوى الأدرينالين في دمك، أو تسارعت نبضات قلبك رعبا أو ألما أو غضباً. فهو على يقين من أنك وأنت تتوغل في هذا الإيقاع السردي الساخر ستشعر أنك غدوت جزءاً من الرواية، وسيصبح إيقاعها جزءاً منك، فهذه الحكاية، أو تلك، ربما تكون حكايتك، أو حكاية شخص تعرفه أو سمعت به.
ماذا عن الضمير؟ ماذا يعني، أو ماذا يكون؟ تلك المسألة، سيتمحور منها سؤال إشكالي يتطلب منك قدراً من الشجاعة النفسية للتجرؤ على الإيغال في عالم يعج بأنين المحتضرين، وصراخ المركولين، وخراء المسهولين.
الضمير هنا، ليس كما نعرفه، ليس كما أكده جيمس هنري في كتابه فجر الضمير “اللحظة التي سمع بها الصياد أول مرة همسا داخله يؤنبه:. أما في روايتنا “إذا كان الضمير قد ورد في كتب الفلسفة والروايات ، كأمر مفروغ منه، لكنه خطير في عالم ينبذه، وأقولها لك لم أكن معدوم الضمير ولا ينقصني في عالم يخلو منه، لقد استعدته ممّا يشبه العدم، إنه بالتحديد ضمير مرن. يأخذ بالحسبان ظروف الزمان والمكان. إنه يريحني لكنه لا يطمئنني”.
إنه ضمير مرن!.. هكذا يصفه المحقق سامر، أقل المحققين بطشاً، وأقلهم سوءاً. لقد وجد نفسه في مستنقع عالم غامض، بالصدفة، أو نتيجة خيبات الأيديولوجيات المثالية التي رافقت شبابه المبكر، أو بسبب ماضيه الفقير البائس. ليس مهماً، المهم أنه في هذا الأتون، ضابط تحقيق في فرع أمني كبير. يواجه اختباراً خطيراً. يفاوض معتقلاً على حياته مقابل عمالته. قال له «أقبل بما أعرضه عليك واختم اعترافك بالندم» ومع أن جواب المعتقل كان حاسماً «لا تحاول معي». أراد إنقاذه، فأرسله للقبو لاقتلاع أظافره، عسى يلين موقفه. افترض ضميره المرن، أن يكون هذا العقاب هو الأقل فظاعة، الذي قد يؤجل مصيره المحتوم. لكن المعتقل المنهك من سادية التعذيب، سخر من فرضيات المحقق، وانتحر (رآه في الزنزانة رقم 15، مكوماً على الأرض، قميصه ممّزق، محطماً، بلا أظفار، الدماء تخثرت على أصابعه، أثار الهراوات على جسده).
لا جدوى من اجترار حياة انتهت، لا داعي لإطالتها.
إلى أي حد يمكنه المضي في هذا العالم، أو النكوص عنه؟ بقي هذا السؤال يحاصره، يؤرق ضميره المرن. وما بين هذه المسافة الواسعة الفاصلة بين النأي والجذب، ستعبر مياه كثيرة تحت الجسر، وتجري أحداث الرواية.
أعتقدْ أن التحدي الأصعب الذي واجه الروائي، هو التوغل في رسم البعد النفسي لشخصيات جمهوريته المظلمة. جمهورية تعني أن هناك بشرا، أن هناك حياة كاملة تُعاش، بكل ما فيها من خيبات وأفراح وشهوات وحب، وأحلام وسلطة ومصائر.
إلى أي حد تمادى في الولوج إلى عمق هذه الشخصيات؟ وإلى أيّ حد استطاع أن يقترب من التباساتها وتناقضاتها؟ أن يلمس ألمها ووحدتها، وحشيتها واستبدادها، حنانها ووداعتها، ضعفها وشهواتها. هل استطاع أن يمس ذاك الخيط الرفيع الذي يفصل بين الخير والشر؟ من الصعب الإجابة عن هذا السؤال الوجودي المحير. لكن كاميرا فواز حداد المشاكسة لا تنفك تدور وتدور، تلتقط مشاهد مرعبة ومسارات مؤلمة، ومصائر تنتهي بالجنون أو الموت. ربما تعطي أجوبة، أجوبة عرجاء. مثلها مثل الضمير المرن، فما بين مشاهد الجوع والاحتضار والأنين، وحقن الموت في مشفى الظلام، والمعتقل المسهول الذي تغوط في ثيابه، فضُرب حتى الموت. هناك ثمة عشب، وهناك ثمة غيم ونشيج مطر. فالمقدم الحزين القادم من بيئة السلطة ذاتها، المغرم بالعمليات الاستشهادية، الذي يحمل رؤى ساذجة لواقع شديد القسوة، والذي أصبح فجأة رئيساً للفرع 650 الجديد، المختلف في تخصصه، وفي طبيعة زواره من الأدباء والمثقفين. هاله أن يرى معتقليه يوشكون أن يموتوا جوعاً، فهو يملك ضميراً، ضميراً أعرج أو مرناً لا فرق، ما كان منه إلا أن سطا على ما تبقى من بغال وكلاب وقطط وحمير تركها أصحابها هربا إلى أمكنة آمنة، وأقام لهم حفلة شواء فاخرة. حيث استدعت رائحة الكباب المشوي والخبز المسقسق بالدهن مع زبادي السلطة المتبلة بالرمان إلى ذاكرة المعتقلين المذهولين من هذا الرخاء المفاجئ الذي هبط عليهم، ذكريات، سيارين يوم الجمعة، في بساتين الغوطة، وعلى ضفة بردى، رائحة الأراكيل، البطيخ في النهر البارد، التراشق بماء النهر، ما أعاد إلى ذاكراتهم أنهم كانوا في يوم ما بشراً .
واقع أم تخيل ..
لم يكتب فواز حداد هذه الرواية، ليؤرخ أو يوثق هذا العالم المظلم، هو ليس مؤرخاً، هو ببساطة روائي ساخر ممسوس بفضح الدولة الشمولية الرثة. فأن تكون روائيا، عليك أن تملك خيالا يفيض حيوية وخلقاً وابتكاراً. الخيال الذي يُبنى على معطيات الواقع، هو المعادل للإبداع. مع أن هذا لا يلغي أن يكون الواقع أحياناً أكثر خيالا من الخيال نفسه.
منذ البداية، وما بين المسافة من تآزر المكان والزمان الذي تجري فيه أحداث الرواية، مع الكثير الكثير من الدلائل والإشارات والإيماءات، كانت الشخصية الهامشية آحيانا والمركزية أحيانا أخرى، لكن الغامضة التي اكتفى التعريف بها بحرفي “ف خ” اسما لها، تسير في الظل، تظهر فجأة من حيث لا ندري، ثم تختفي من حيث لا ندري أيضاً، «لم تكن خيالا شريراً كان فاعل خير لا وجود له، وإن كان يظهر في الوقت المناسب، بموعد ودون موعد» شخصية تعرف الكثير، عليمة وحكيمة، تحلل وتستنبط مصائر، تشير وتدل.
كان فواز حداد، يلعب لعبته الذكية، ويورطنا بين الواقع والمتخيل حتى فاجأنا بحضوره الواقعي في الرواية. فكان هو “ف ح” ذاته. لكن هل فاجأنا حقا؟
يجيب السائل بسـؤال مماثل:
“هل تظن أن الروايات على تضاد مع الواقع، لو كانت هكذا، لما كانت الحياة”.
ما يوقعنا في الحيرة: ماذا إذا كان هذا كله من افتراض فواز حداد الغائب عن المكان، بينما هو الحاضر الوحيد؟
هل سخر منا فواز حداد، أم كان يسخر من نفسه، أم من الواقع المرير؟ هل كان كل هذا الرعب والألم متخيلاً؟
أعترف أنا القارئة، أنني قد تنفست الصعداء.
لكن فواز حداد لا ينفك يناور، لا ينفك يدور بنا في دوامة التناقض المضني بين الواقع والخيال، لا يريد أن يهبنا لحظة من نعمة الراحة، يورطنا بالشك، ويختم روايته بهذه الجملة المحيرّة:
“إذا اعتقدت أنك تتوهمها، فهل كان كل هذا الدمار والموت متخيلا”.
مجلة الجديد اللندنية