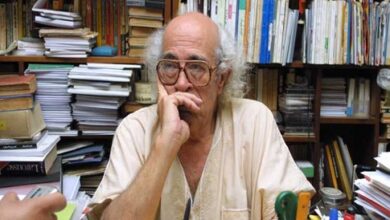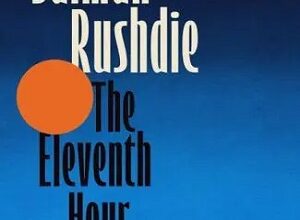«العسكريتاريا» ونظام الحكم في مصر: رؤية مقارنة

يعبر البعض عن خشيته، ولو من طرف خفي، من تعرض مصر في المرحلة المقبلة، في أعقاب حدث الثلاثين من حزيران والرابع من تموز2013، لبروز نمط من نظام الحكم القائم على سيطرة نخبة بيروقراطية مدنية ـ عسكرية متكلّسة، ذات عصب عسكري بصفة جوهرية، وفق الأنموذج الجزائري مثلاً.
ومصدر الخشية لدى ذلك البعض، أن النخبة الجزائرية السائدة، ذات العصب العسكري، تمثل «حكومة خفية» تحكم الدولة الجزائرية منذ إعلان الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، وهي متغلغلة في جميع قنوات إدرات الدخل النقدي عبر جهاز الدولة. ولم يحصل ذلك التغلغل من خلال رجال الجيش فقط، بل على أيدي «العسكريين المتقاعدين» أيضاً، خصوصاً بعد رحيل بومدين (1978)، حيث أخذوا يقيمون المشروعات الخاصة ذات الربحية المرتفعة نسبياً، في المجالات التي شرعتها سياسة «التفتح الاقتصادي» و»آليات السوق» في الثمانينيات والتسعينيات وما بعدها، أو يسهمون في الاستيلاء على منشآت القطاع العام المفككة بواسطة سياسات «الخوصصة»، أو ينشطون في مفاصل الاقتصاد القائم على دورة الاستهلاك الموسع والاستيراد المرتفع، بالاعتماد الأساسي على العائدات المتولدة من صادرات المحروقات.
ويمكن القول، في ضوء ما سبق، بوجود اختلاف جوهري بيّن، بيْن الحالتين الجزائرية والمصرية:
فالبيروقراطية العسكرية للجيش في مصر، تم تهميشها سياسياً إلى حد بعيد طوال حقبة السادات ـ مبارك، وجرى تقليم أظافرها من زاوية وضعيتها المميزة داخل المجتمع، تلك الوضعية التي شهدت فترتين ذهبيتين في التاريخ المصري القريب: أولاهما فترة قيادة عبد الحكيم عامر للقوات المسلحة، خصوصاً خلال المدة الواقعة بين انفصال العام 1962 والعدوان الإسرائيلي في الخامس من حزيران 1967، في ظل ما عرف بعد هذا العدوان بفترة تحكم «مراكز القوى» والتي مارست دورها الظاهر والخفي داخل المنظومة العسكرية – السياسية، حتى بإزاء موقع الرئيس نفسه. أما ثانيتهما ففترة قيادة عبد الحليم أبو غزالة للقوات المسلحة ـ لعشر سنوات تقريباً – في ظل نظام مبارك، بعد اغتيال السادات.
في هاتين الفترتين تمتع الجيش وأفراده بميزتين:
أولاً، التغلغل والتمدد في الاقتصاد المدني انطلاقاً من بنية اقتصادية ـ عسكرية قوية، ممثلة في الصناعات الحربية في عهد عبد الحكيم عامر، وفي أنشطة جهاز الخدمة المدنية في عهد أبو غزالة.
وثانياً، ضمان وظائف مجزية في شركات القطاع العام المؤممة أو المنشأة حديثاً في عهد عبد الحكيم عامر، أو الحصول، في عهد أبو غزالة، على»تعويض تقاعدي» مجزٍ يكفل الاستفادة من أجواء الفساد في ظل «الانفتاح الاقتصادي»، من خلال إقامة مشروعات خاصة عالية الربحيةً المقارنة في جميع المجالات تقريباً.
ولكن بعد تفجر الصراع الخفي بين أبو غزالة ومبارك، ثم خروج الأول من هرم السلطة بعد «فضيحة» مدبّرة، جرى تهميش نسبي ملحوظ لوضعية الجيش اعتباراً من مطلع التسعينيات، سواء بسبب قرب نفاد رصيد الشركات المخوصصة، أو بسبب اضمحلال الصناعة العسكرية والحربية في كل من «الهيئة العربية للتصنيع» ذات الاستقلالية الإدارية، و»قطاع الإنتاج الحربي» المرتبط مباشرة بوزارة الدفاع. في تلك الفترة التى امتدت لعشرين عاماً تقريباً، منذ مطلع التسعينيات حتى «ثورة يناير» 2011، والتي هيمن على أغلبها ظل المشير طنطاوي، تبلورت سياسة «تقليم الأظافر» التى مارسها نظام مبارك إزاء المؤسسة العسكرية. وقد اتخذ الجيش في المقابل موقفاً أقرب إلى التمنع والاستنكاف إزاء مشروع التوريث لنجل مبارك، خلال العشرية السابقة لتفجر أحداث «ثورة يناير».
لكن في المقابل، استطاع الجيش في عهد طنطاوي أن يؤسس بنية إنتاجية وخدمية داخل إطار القوات المسلحة، سمحت له بتوفير وسائل تلبية الحاجات الاستهلاكية للأفراد، وضمان موارد مالية للمؤسسة العسكرية تعزز مخصصاتها في الموازنة العامة للدولة، التى ظلت مقننة في حدود رقم عام داخل الموازنة ـ من دون ذكر بنود تفصيلية ـ تحت مظلة رقابة مفترضة، عامة أو فضفاضة، من قبل «الجهاز المركزي للمحاسبات». بالتوازي مع ذلك، ظلت وضعية الجيش المصري داخل المجتمع وبإزاء المنظومة السياسية قلقة وغير مستقرة إلى حد بعيد.
إن هذه الحالة قد تخالف تماماً واقع الحال في الجزائر، حيث تمكنت النخبة العسكرية من تكريس مواقعها الصلبة والصلدة داخل النظامين السياسي والاقتصادي، انطلاقاً من دور قيادي مستبطن وربما غير ملموس، بإزاء منظومة الحكم والإدارة الاقتصادية العمومية. وقد استفادت النخبة القيادية للجيش الجزائري في هذا المقام من الإرث السياسي الذي خلّفه موقع الجيش في حركة الثورة الجزائرية (1954-1962)، باعتباره سليل قوات جيش التحرير ـ الجناح العسكرى لـ «جبهة التحرير الوطني الجزائرية» – عبر المقاومة المسلحة للاحتلال الفرنسي.
وقد برزت الوضعية المميزة للجيش بصورة عامة خلال الأمد القصير لحكم أحمد بن بيلا (1963-1965) وتبلورت في ظل هواري بومدين (1965-1978)، وإن كانت زعامة بومدين ذات الطابع الكارزمي قد تكفلت بتحجيم أدوار العسكريين في المجالين الاقتصادي والسياسي.
وقد تكون وفاة بومدين حدثاً مفصلياً في التاريخ السياسي للجيش، إذ تصدّى الجيش بنفسه لملء المنصب الشاغر، ودفع بقائده العام الشاذلي بن جديد إلى سدّة الرئاسة، وهو من هو بطبْعه التوافقي وغير المبادر ـ علي المستوى الفردي أو الشخصي ـ وبضعف ملكاته القيادية.
في ظل هذا الوضع الجديد، صعد الجيش ونخبته القيادية العليا، ليمارسا دوراً لم يكن لهما إلى حد كبير، فتمدّدا داخل الاقتصاد والمجتمع، وامتد دورهما إلى حيّز خطير، هو «الحيز السياسي»، بل وصلا إلى وضعية «صانع الرؤساء» في رأي البعض. وسنحت للجيش الفرصة لأداء هذا الدور الأخير بالذات إثر تمكنه من إقصاء الإسلاميين وتعقبهم، بعد إلغاء نتائج الانتخابات البلدية التى فازوا فيها العام 1991. ولعل المسلسل الدموى الذي استمر نحو عشر سنوات بعد ذلك، كان المنفذ لتعاظم دور الجيش في الحياة السياسية.
وفي حدث افتتاحي فريد، اختبر الجيش قدرته وعَجَم عوده، إثر تولي أول رئيس للجمهورية بعد تفجر أحداث العنف المسلح – في أعقاب فترة حكم «مجلس الدولة» المسيطَر عليه عسكرياً ـ ونقصد محمد بوضياف. فقد تناثرت شواهد دالة على أن اغتيال بوضياف مبكراً جداً، كان يمثل إشارة لا تخطئ على أن من أتى من خارج دائرة الاختيار المحكمة للجيش، لن يقدَّر له أن يستمر في السلطة. بعد بوضياف، وقع اختيار الجيش على وزير الدفاع «اليمين زروال» في العام 1995. واستطاع هذا الرجل قويّ الشكيمة أن يفرض قبضته نسبياً إزاء أترابه، وبدأت مسيرة المصالحة بصورة متواضعة مع «الإسلام المسلح»، ثم ما لبث أن «تخارج» تماماً من لعبة الحكم، بعد انتهاء عهدته الرئاسية، واعتكف حتى الآن في منزله الخاص بمدينة باتنه بالشرق الجزائري.
وللمرة الثالثة، قام «صانع الرؤساء» ـ أو «صانع الألعاب» بامتياز- بالتدبير المحكم خلف ستار كثيف لـ «إعادة التنقيب» عن عبد العزيز بوتفليقة، والمجيء به من حيث مقامه المستقر منذ مطلع التسعينيات في دولة الإمارات إلى الجزائر مرة أخرى، اعتباراً من العام 1999، ليتولى منصب رئيس الجمهورية. وقد تولى المنصب المختار لعهدة أولى من دون منافس تقريباً (خمس سنوات) ثم لعهدة ثانية سحق فيها منافسه القوي، مساعده السابق، وتمكن خلال العهدتين من إجراء «تقليم» هيّن للأظافر، استطاع بمقتضاه إقصاء أبرز القادة العسكريين المؤهلين نظرياً للحكم (وأهمهم خالد نزار).
وحين شارفت العهدة الرئاسية الثانية على الانتهاء، كان الجيش جاهزاً لعملية التعبئة من أجل إعادة انتخاب الرئيس ذاته – برغم المرض الذي أقعده وأعجزه عن الحركة ـ ليستكمل فترة مقدرة بخمسة عشر عاماً، إن قدّر له استكمال المدة. ويحاجج بعضٌ من المعارضة الجزائرية بأنه سيترشح لعهدة رابعة في العام 2019 إن لم يقهره قاهر، وأنه غير جاد في إجراء التعديل الدستورى الذي سيضع سقفاً زمنياً لولاية رئيس الجمهورية.
فأين هذا كله من وضعية القوات المسلحة المصرية؟ تلك التي «عانت الأمرّيْن» سياسياً خلال عشرين عاماً على الأقل من عهد مبارك، وسرعان ما لحقت بركب الثورة الشبابية – الشعبية في كانون الثاني 2011، وتولت أمر السيادة العليا من خلال «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» لعام أو بعض عام، حتى تم ترتيب الانتخابات الرئاسية والإتيان برئيس «مدني» منتخب، هو مرشح جماعة «الإخوان المسلمين»، والذي لم يعمّر لأكثر من عام، كما هو معروف.
لهذا إذن، نجادل بأن الحالة المصرية تختلف إلى حد كبير عن الحالة الجزائرية في هذا الباب، وبأن منظومة الحكم المصرية غير مرشحة على الأرجح لظهور دور «صانع الألعاب» الذي مارسته القوات المسلحة الجزائرية ونخبتها القيادية العليا.
هذا كله مع العلم بأن القوات المسلحة المصرية دعمت قائدها العام «السابق» – رئيس الجمهورية الحالي. ونضيف أيضا أنها لم تزل تتمتع بوضعيتها ذات الاستقلالية النسبية في المجال الاقتصادي، وقد أخذت تستعيد عافية منظومة الصناعات العسكرية، سواء من خلال «الهيئة العربية للتصنيع» أو «وزارة الدولة للإنتاج الحربي». ثم إنها تمكنت من خلال أداء مندوبها داخل «لجنة الخمسين» لإعداد الدستور المعدل (2014)، من المحافظة على ميزة الحصانة المالية النسبية بالموافقة على إدارج مخصص الجيش في الموازنة العامة للدولة في صورة «رقم عام» فقط، من دون إيراد التفاصيل، وكذا الموافقة على توسيع جزئي لاختصاصات القضاء العسكري. ولكن هذا وذاك، لا يمثلان، بأي حال، ما يمكن أن يعتبر قرينة على تهيؤ القوات المسلحة لأداء دور مماثل لدور الجيش الجزائري في العملية السياسية ككل.
فهل بعد ذلك يمكن القول إن نظام الحكم في مصر مرشح للوقوع في قبضة العسكريتاريا على النمط الجزائري مثلاً؟ أم أن الأمر خلاف ذلك، حيث الأفق السياسي في مصر متفتح أكثر، بحكم الظروف الخاصة للمؤسسة العسكرية وإمكانية تحقيقها تحولاً سلساً في مسار العملية السياسية، بعيداً عن القبضة القوية للمؤسسة العسكرية؟ هذا ما نميل إليه، وإن كنا لا ندّعيه صواباً مطلقاً على كل حال!
صحيفة السفير اللبنانية