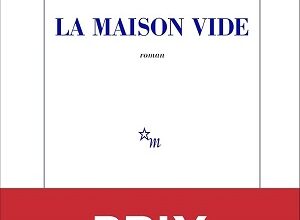الماحي بينبين يسرد سيرة والده في بلاط الملك

تـمُـتُّ رواية «مجنون الملك» Le fou du roi: Mahi Benbine ، Stock ،2017 للكاتب المغربي الفرنكوفوني الماحي بينبين بـصلةٍ قـوية إلى السـيرة الذاتية وإلى الـبـيـوغرافيا في آنٍ، لأن كاتبها يـستـمِـدّ مـادّتـه الخـامّ من والـده الذي عـمل مؤنساً ومُــسلـياً للملك.
ولا يمكن منْ يــقــرأ الرواية أن يتناسى علاقة الكاتب /الابن بـوالده، ولا بالسياق الذي رافـَــق كتابتها. ذلك أن مُلوك الدولة الـعلوية التي تأسست في المغرب منذ منتصف الـقرن السابع عشـر، عـززوا نـظام «الـمـخزن» الـهَــرمـيّ، وأحيـوا طقوس الملكية الـعتـيقة التي يحــظى فيها المـهرجون والمـؤنسون وحاشية صاحب الجلالة، بـالاعـتـبار. وفي عـهد الحسن الثاني (1961- 1998)، لـوحظ اهتمام بالحاشية المقربة التي تجالس الملك وتسلـيه، والتي كان يتـمّ اختيارها من خلال مقايـيـس تـوفـّر أعضاؤها على مواهب الـفكاهة والـظـُّـرْف، ومـعـرفة بالأدب والـثقافة الشـعبية… وكانت أسماء معظم هؤلاء المـؤنـسيـن مـعروفة لـدى الـمـهتـمين بالسياسة وبـِـمـزاج الجالس على رأس المخزن، وقد يتوسلون بهم لقضاء حاجاتهم لدى الملك… وعلى رأس هؤلاء الجـُــلساء المؤنسين للحسن الثاني، اسـمُ الـفـقيـه بـِـيـنْـبــيـنْ، والـد كاتبِ «مجنون الملك» الذي سـبق أن نشـر تـسع روايات باللغة الفرنسية، إلى جانب ممارسته للرسـم.
في روايته، يجمع الماحي بـيـنـبـين بين السيـرة الذاتية، بحكم أنه ابن مؤنس الملك، وبيـن الـبـيـوغرافيا على اعـتـبار أنه «أرّخ» روائياً لـتجربة والـده، مُـعــتمداً على ما حـكاهُ لــه عن مـعاشـرته للمـلك طوالَ ما يـزيد على ثلاثيـن سنة. لكن الكاتب اختــار شـكلاً يـتدثـر بالتخييل على رغم وجود وقـائع وأحداث تـحـيل على «رواية العائلة» وانعكاسات وظيفة الأب على أسـرته، بخاصة ما يـتـصل بمـحنـة الابن الضابـط الذي شـاركَ في انـقلاب «الصـخيـرات» الفاشل عام 1971، وأمضى 18 سنة في سِـجـن تازمامرت الرهيب…
يـشتـمل النص على ثلاثة عـشـر فصلاً تـأتـينا على لسـان الأب، مـؤنس الملك الذي كانت لـه، وفق ما يـؤكدهُ، مـكانة خاصة عـند مولاه، بسبب ثــقافته الأدبية الواسعة، وذاكــرته الـمُــذهلة القادرة على حـفظ كـل ما يـقــرؤه أو يسمعه. ولـم يكن وحـده مَـنْ يـتولى استجلابَ النوم إلى عـيني الملك، بـل كان يـرافـقه في تلك المهمة الموسيقي الملقب بالساحر، عـازف العود وراوي القصائد، إلى جانب الحاشية الصغيرة المكونة من الطبيب الخاص، والـمـنجّــم والـقـزَم والحاجب، الذين يســتأنس بهم الملك في ساعات الملـل والــترويح عن النفس… إلا أن مكانة الفقيه محمد بن مـحمد كما يسميه السلطان، كانت تـعـلو على الآخــرين، لأنه يتـمتع بحضور البـديهة واخـتـلاق الحكايات لإضحاك الملك. ومن ثـمّ، كانت الحاشية الـحمـيمة تـلجأ إليه كـلما تـعـكّــر مـزاج الملك أو عـزف عن الأكل وتـدبيـر شـؤون المـملكة. وهذه العلاقة التي نشأت بين الـفـقـيه المؤنس-حتى لا نـسميه مـهـرج السلطان-، هي التي نـسجتْ خـيــوط صداقة خاصة سـتـتـجلى مـعالمها عند ما حـانَ رحـيـل أمــيــر الـمؤمـنيـن عـن الحياة الدنـيا.
حكايات ومشاهد
تنطلق الرواية من مشـهـد قصير يستعيد فيه المؤنس السارد مرافقته للملك داخل القـصر، ذات ليلة وقد تـمـكـّنَ منه الداء واستـعصى عليه النوم. وخلال الجولة، تـنـبّه الملك إلى ضوء يـنـبعث من غرفة الـهدايا، فـقرر أن يزورها، وهناك وجدا أحد عـبيد القصر منـهمكاً في الاختلاس. وعلى غير ما تـوقع السارد، كان ردّ فعل الملك تشـجيع الـعبْد على السرقة والانصراف قبل أن يمسك به الـحرّاس. ذلك أن شعور الملك بــدُنـوّ الأجل، جعله يـغـيّـر من طبيعته القاسية. وحين يـرتــدّ السـارد إلى بداية التحاقه بالقصـر، يـورد مشاهد تجسد شراسة ســيّـده وحـرصه على الـهـيْـبة «الـمخزنـية»، مثلما فـعل مع أحد وزرائه الذي جاء يسـتـعجله في إمضاء أحد الملفات، فقد أمـر بإدخاله إلى الإسطــبْـل طوال ليلة بكاملها… لكن السارد يحرص على أن يـرسم خطوطاً عامّة لمساره قبل أن يصبح مـسلياً ومُسامراً لـلملك. لقد درس في جامعة ابن يوسف، واستـوعب العلوم الدينية، وارتـوى من الآداب، وأسعفته ذاكرته على حفظ الأشعار وما ورد مِـنْ حكايات في كتب التراث، وأسـعفه الحظ بالتعـرّف إلى الشاعر المراكشي الشهيـر مـحمد بن إبـراهيم، وعاشـره في سـهـراته المجونية، وكان يحفظ الأشعار التي يـرتجلها بـتـأثير من نشوة الخمر ويـنساها، فـيفاجئه الفقيه بـيـنْـبـينْ بـحفظها في ذاكـرته… هذه المزايا هي التي جعلت الملك يُـلحـقه بالحاشية المقربة. لكن المؤنس كان يـدرك أن التحاقه بالقصـر يضع حداً لما كان يتمتـع به من حرية في مدينة مراكش: «نـدخـل إلى القصر الملكي مـثـلمـا نـعـتـنق مِــلـّـة، لأن الانخراط في سِــلْـكِـه يكون كاملاً، كــليـاً، باتــجـاهٍ واحـد. عندمـا نـنـخـرط في القصر الملكي، لا يعود هناك تـراجع مـمكن» ص 69. وقد وعى الـفقيـه المُـسلي وظيفته وأدرك أن عليه أن يعطي كل الأسبقية لرغبات الملك ونزواته: «الواقع أن الـهدف الأسمى لـوجودي العجيب، باتَ يـقـتصـر على أن أجعل الملك سعيداً. لـم أعـد أعيش إلا لــهذا الغرض. مـا من شيء كان يجلب لي الـمـسـرّة والارتـيـاح الـكـبـيـريْـن سـوى أن أرى وجـه سـيّـدي مُـضيئـاً» ص 22. وتـتـوالى الحكايات عن تصرفات الملك وعن تنافس أفراد شـلة الأنـس في إرضائه واستـجلاب الكـرى إلى جـفـنيْـه، وفي كل مـرة يكون الفقيه محمد بن مـحمد مـتـفـوقاً على بقية المؤنسـين، ويـزداد قـربُـه من ولـيّ نـعمــته؛ إلا أن محاولة الانقلاب العسكري عام 1971 في الصخيرات، أزالت حـُـظـوته عند الملك وأصبح من المغضوب عليهم، على رغم تـبـرؤه من ابـنـه الضابط المشارك في الانقلاب وإلغاء انـتـسابه إليه. كان لا مناص من أن يغادر القصر ويعود إلى بيـته وزوجته وولـديْـه الآخـريْن، حيث كان سُخط الأسرة يـنـتـظرهُ جـرّاء إنـكاره أبـوّتـه لـلابن الضابـط المـعتقل. وكان جرحاً عميقاً جعل الفقيه المؤنس يعيش معزولاً، شـقـياً، في انتظار أن يـعفـو الملك عليه، رغم أنْ لا يـد لـه في ما حدث. سيقول عن هذه الحادثة التي قضت مضجعه، بعد أن استأنف عمله في القصر ودخل الملك إلى مرحلة المرض الخطير الذي سـيودي بحياته: «اليوم يمكنني أن أتكلم بـحـرية من دون تحفــظ. غـداً أو بـعد غـد، سـيلـفظ «سـِـيـدي» أنفاسه وسأعود لأعيش مع أهلي. بالقرب منك يا أميـنة (زوجته) (…) أريد أن أخفـف مــن أثــقالِ قلبي (…) كيف أشــرح لكِ يـا حُـبي، أن تصريحاتي الرسمية لــم يكن هــدفها ســوى أنْ أنـقــذ بـقية أفــراد الـقبيــلة. هـل كان لـديّ من خـيار آخـــر غيـر أن أنـكر فـلذة كـبـدي، أنــكــرهُ علانـيـة وبـصوتٍ مـرتـفـع؟ ص 108.
صداقة الملوك
عـبْـرَ بـنـيـةٍ مـفتـوحة، تُـطـلّ رواية «مــجنون الملك» على مشـاهد من حياة مؤنس السلـطان طوال ثلاثيـن سـنة من تاريخ المغرب الحديث. وعلى رغم أن هذه الرواية السيرية لا تـتوخى التأريخ، فـإنها تلتـقط سـماتٍ وتــضاريــس تـحيل على سـلوك اوطبيـعة مَـنْ كان على رأس «المـخــزن» يـمـارس حكماً مـطلقاً رغـم الواجهة الديموقراطية المصطنعة من بـرلمان وانتخابات وأحـزاب… وإذا كان صاحب الســـيــرة وكـاتـبها لا يـقـصدان إلى الانتـقاد السياسي المباشـر، فـإنـنـا نـعـثـر على عـبارات تـنـطوي على دلالاتٍ عـميقة وكاشفة، بخاصـة ما يـتـصل بطـبـيعة الملك الـعميقة التي تحـتـقـر المواطن وتـعـتـبـر مجموع الشعب «رعــيـة» في خدمة الملك وتـقديســه ومـباركة قـراراته.
وفي معرض حديثه عن أحد الملوك العرب القدامى، يـقارن بـينه وبيـن الحسن الثاني مســـتـخلصاً: «… حـياة إنــسانٍ أو حياة حـشـرةٍ، لـم يـكن بـينهما فـرق عـنـد كــلٍّ مـنـهما» ص 146. ومثل هذه الملاحظة تـتـأكد من خلال بعض خُـطب الحسـن الثاني، بحيث أعـلن من شاشة الـتـلـفزيون، بعد انتفاضة الدار البيضاء، أن الشــرع يُـبيـح له أن يـقـتل ثـلـثـي المواطنين من أجل الثلث الصــالح، المـطيـع…
لـكن المحور الأبـرز في الدلالة هـو إضـفاء الطـابع الإنســاني على الـنص، من خلال علاقة الابـن الضابط مع والـده الذي أســاء إليه، بل ومع الملك، إذ ســألــتْــه أمه هل يكرهه فـأجاب بالنفي. ويـمــتد هذا الــبُـعد الإنساني لـيحوّل العلاقة بيـن المـؤنــس وســيّـده إلى صداقة تـقف على أرض الـنـدّيـّة، دون اضـطرار إلى الكــذب أو إخـفاء العواطف. هكذا يأتي الفصل الأخير من الرواية ليحكي عـن آخـر لقاء بيـنهما، بـعد أن استـفحــل مرض الملك وأشــرف على الأفــول. عـن ذلك اللقـاء يـقول الــسارد: «لا هـو ولا أنــا، كـنا نـريد أن نــغـشّ. ســيدي كان يـنـتظـر مني أن أنـظـر إليه كــما نـنـظـر إلى صديــق مُـحـتـضـر، لا يحتاج إلى الكذب. كان قلبي يـخـفـق بـشـدّة وأنا أقـدِمُ على حـركــة غير معقـولة، كنت أستـحق عليها مـائة جـلدة. حـركة ما كان لأحــدٍ أن يسـمح بها: أمـسـكتُ يــد مـولايَ بيـن يدي وضـغـطتُ عليها بـقوة (…) رفع الملك عينيه نحو أزهار الجوكاندا وقال: لــن أراها قـط، أليــس كذلك؟ – لا، لن تـراها بعد اليوم، يا مولاي.» ص168.
صحيفة الحياة اللندنية