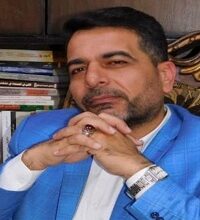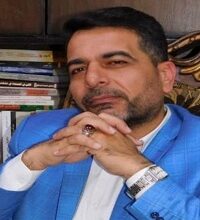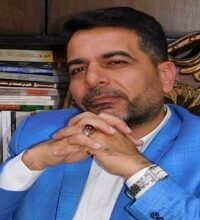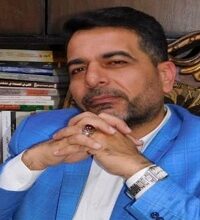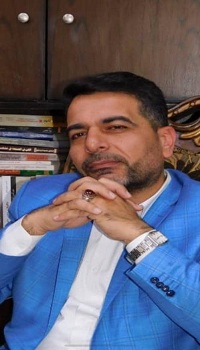
ربما كان على حق أصحاب الرأي القائل بأن أحد أهم أسباب الأزمة الثقافية، أو المأزق الثقافي الذي يعيشه المجتمع العربي، هو تلك النرجسية المتحكمة بغالبية النخب الثقافية وبعدها عن مجتمعاتها، الأمر الذي أدى لخلق هوّة كبيرة بين الشعوب ونخبها الثقافية والمعرفية، التي آثرت الابتعاد عن هموم الشعب ومعاناته، والاكتفاء بتحصين أبراجها ونرجسيتها، وهي إذ تفعل هذا فإنما لقناعتها المطلقة بفرادتها، واستماتتها للحصول على المنافع لتحقيق أهدافها الشخصية وتطرفها في أفكارها لمصلحتها الشخصية، بعيداً عن مصالح الأمة أو الشعب الذي خرج منه، وهو إذ يفعل هذا فإنما يمارس سلوكاً استعلائياً لا يمكن أن ينهض بالمفهوم الحقيقي للثقافة الحية، كما أنَّهُ وهو يفعلُ هذا فإنما يجرد الثقافة من أبسط حقوقها ومن شموليتها ودورها في نهضة المجتمعات والوقوف على مشكلاتها ومعاناتها، وهو ما يعني أن هؤلاء يعيشون أزمة وعي حقيقية، وبالتالي فإنهم يبتعدون كل البعد عن المثقف التنويري النهضوي، أو المثقف النقدي حسب رؤية محمد أركون.
حالة التورم هذه والنرجسية، لم تقتصر على أصحاب الثقافة والفكر والباحثين، وإنما تتعدّاها إلى غيرهم من الكتاب والروائيين والشعراء الذين تضخمت ذواتهم إلى درجة منعتهم عن رؤية الآخر والتفكير به، وهم إذ يفعلون هذا فإنما يؤكدون على حقيقة الذهنية الهشة التي يعانون منها والتي تؤدي بهم إلى السقوط في عيون الأغلبية. وإلى فقدان الثقة بين الجماهير ونخبها الثقافية، وهو ما أكدته الأحداث الأخيرة التي عصفت بالكثير من الدول العربية، والتي أكدت حاجة النخب الثقافية المراجعة مع الذات وإعادة النظر في دورها، حتى تتمكن من إعادة بناء الثقة مع مجتمعاتها والعودة للتموضع في الخارطة الاجتماعية، وأخذ زمام المبادرة في قيادة الجماهير والإسهام في بناء ثقافة التعددية والتنوع وتكريس مفهوم المواطنة والانتماء.
لقد آن الأوان لكي تبتعد النخب عن الاستعلائية والقومية وثقافة الوصاية التي مارستها لفترة طويلة من الزمن فخلقت حالة من الفصام والنكد بينها وبين الجماهير التي تريدها متماهية مع حقوقها ومطالبها المحقة، ومرتبطة بشكل عضوي معها إذا ما أرادت قيادة الجماهير بر الأمان.
ومن الضرورة بمكان عودة النخب الثقافية إلى خطها التاريخي وإعادة ضبط علاقتها بالمشروع الوطني، إذا ما أرادت وضع حد لتراجعها وإنكفائها عن نفسها في الإطار الضيق الذي وضَعَتْ نفسها فيه، وعندما تقوم النخب بهذا فإنها تفرض على الدولة التي تعيش فيها، والنظام الذي تستظلُّ بظله، أن تكون شريكة له في اتخاذ القرار وبناء مستقبل الأمة، من خلال مبادراتها الإنسانية وتماهيها مع الشعب في معاناته ومكابداته، وبالتالي يمكننا الحديث عن دور النخب في حركة صناعة التاريخ، وهي حركة من شأنها أن تهب له شكله ومضمونه اللائق.
إن أهم ما يجب على المثقف فعله هو التخلي عن نخبويته، حسب رؤية عبد الإله بلقزيز وأن يتخلى عن اللغة التي لا يفهمها الشعب ولا يتداولها في قاموسه اليومي، وأن يبقى ثابتاً على مواقفه الوطنية الأصيلة، لاسيما بعد تحول بعض المثقفين إلى دعاة للمشروع الديني المغلق حيناً، وإلى تجار بالقضية الوطنية، ووكلاء للأجندات المعادية، وتخليهم عن قضايا شعبهم وإدارة ظهورهم عن هموم وطنهم، صحيح أن المثقف العربي كان دائم الاشتغال على التغيير، إلا أنَّ البعضَ اشتغل عليه من منطق الوصاية بعيداً عن مبدأ المحاورة، وذلك من خلال محاولته فرض حقائقه الثابتة، وزعمه الرغبة في التأثير على العامة بينما كانت عينه على الخاصة، وعندما كان يتعامل مع العامة فإنما يتعامل معهم بفوقيته ونرجسيته المعهودة.
من جهة أخرى فإن نخبوية المثقف، تظهر في أحيان كثيرة، في الموضوعات الفكرية المجردة التي يشتغل عليها. إذ الموضوعات التي يولع بها غالباً ما تكون بعيدة عن مشاغل الناس، ولا تقع على سلّم أولوياتهم فهو يهتم مثلاً بقضية حرية الرأي والنشر والتعبير، فيما ينشغل الشعب بمشاكل الرغيف وتأمين العيش والمسكن حتى ليبدو في حالة التباعد هذه كل من الفريقين مشدوداً إلى موجة مختلفة، وكأنهما من عالمين على درجة شديدة من التباين.
لقد آن الأوان لكي يعود المثقف إلى رشده المجتمعي وأن يكون معبراً عن هموم الشعب ومعاناته، وفاعلاً في تأصيل ثقافة الانتماء والوطنية، لأنه من خلال هذا يمكن أن يكون قائداً حقيقياً وفاعلاً.
بوابة الشرق الأوسط الجديدة