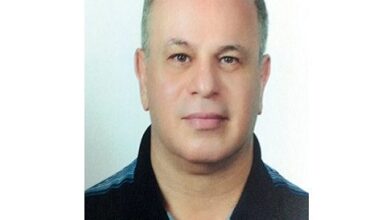فشل الأحزاب السياسية والعقائدية في بناء الديمقراطية في الشرق الأوسط | من التواطؤ مع الأنظمة إلى صعود السلفية…
ماهر عصام المملوك

يمثل سؤال غياب الديمقراطية في الشرق الأوسط واحدًا من أعقد الأسئلة السياسية والاجتماعية التي تناولتها الدراسات الحديثة. على امتداد القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، لم تكن المجتمعات العربية تفتقر إلى أحزاب سياسية تحمل شعارات التحرر والعدالة، ولا إلى تيارات عقائدية تعِدُ ببناء مجتمع الفضيلة والقيم، ومع ذلك، ظلت الممارسة الديمقراطية شبه غائبة أو سطحية.
ويعزى جانب كبير من هذا الغياب إلى فشل الأحزاب السياسية والعقائدية في التحوّل إلى بنى تنظيمية ديمقراطية حقيقية، وفي ترسيخ ثقافة المشاركة والتعددية داخل مجتمعاتها.
وبدلًا من أن تشكّل هذه الأحزاب رافعة لبناء حياة سياسية ناضجة، فقد انخرط كثير منها في صفقات تواطؤ مع الأنظمة الشمولية، أو أخفقت في ترجمة شعاراتها على أرض الواقع، الأمر الذي ترك فراغًا واسعًا ملأته التيارات السلفية والراديكالية لاحقًا.
ولا يمكن فهم إخفاق الأحزاب السياسية في الشرق الأوسط دون الإشارة إلى السياقات التاريخية التي نشأت فيها. فقد ورثت المنطقة، عقب انهيار الإمبراطورية العثمانية، بنية دولية قوامها النفوذ الاستعماري البريطاني والفرنسي، الذي أولى عناية محدودة لبناء مؤسسات سياسية وطنية مستقلة.
فقد تأسست معظم الأحزاب السياسية الأولى في هذا المناخ المشحون بالاستعمار، حيث غلبت عليها صفات النخبويّة، وافتقرت إلى قواعد شعبية واسعة.
علاوة على ذلك، كان معظم هذه الأحزاب يُدار بأسلوب مركزي شديد الانغلاق، وظل حبيس نخبة ضيقة من القادة المتعاقبين الذين احتكروا القرار التنظيمي. هذا النموذج البطريركي، الذي يكرس الزعامة المطلقة داخل الحزب، كان على تناقض بنيوي مع قيم الديمقراطية الداخلية والمساءلة.
في مصر مثلًا، ورث حزب الوفد بعد ثورة 1919 حضورًا جماهيريًا عريضًا، لكنه لم يفلح في تأسيس تقاليد مؤسسية تضمن استمرار التداول القيادي داخله، فتراجع نفوذه تدريجيًا. وفي سوريا، لم يختلف المشهد كثيرًا، إذ شهدت فترة الاستقلال (1946–1958) تعددية حزبية على الورق، لكنها افتقرت إلى معايير التنظيم الديمقراطي والحوكمة الرشيدة.
ومع تصاعد الانقلابات العسكرية في منتصف القرن العشرين، تحوّلت الأحزاب السياسية إلى شريك مباشر أو غير مباشر للأنظمة الشمولية. ففي العراق وسوريا، على سبيل المثال، أفضى صعود حزب البعث إلى بناء نظام الحزب الواحد الذي صادر الحريات السياسية، وجرّد الأحزاب الأخرى من أي قدرة مستقلة. استعملت الأنظمة هذه الأحزاب أداة دعاية وشكلًا من أشكال الشرعية الزائفة.
في مصر، بعد ثورة 1952، لم يُسمح للأحزاب السياسية بالعمل بحرية، بل أُنشئت “هيئة التحرير” ثم “الاتحاد الاشتراكي العربي” كتنظيمات احتكارية للسلطة. هذا التواطؤ التاريخي عمّق هشاشة الثقافة السياسية، وأفقد المواطن العربي الثقة بوجود حياة حزبية حقيقية.
حتى الأحزاب اليسارية والقومية التي رفعت شعارات التقدّم والتحرّر، وقعت في تناقض صارخ بين خطابها المعلن وممارساتها الفعلية،إذ لم تعارض في كثير من الحالات انتهاكات الحريات العامة، بحجة “الحفاظ على مكاسب الثورة” أو “مواجهة الاستعمار”.
ولم يقتصر الفشل على الأحزاب المدنية، بل شمل الأحزاب ذات الطابع العقائدي والديني. فقد مثّل صعود الإسلام السياسي رد فعل على إخفاق الأنظمة القومية واليسارية في تحقيق التنمية والعدالة. ومع ذلك، أظهرت هذه التيارات قصورًا بنيويًا مشابهًا، وإن اتخذ طابعًا مختلفًا.
تجربة الإخوان المسلمين في مصر تقدم مثالًا بالغ الدلالة، فعندما وصلوا إلى السلطة عقب ثورة 2011، لم يتمكّنوا من بناء توافق وطني أو ترسيخ مؤسسات ديمقراطية جامعة، بل بدت أولويتهم إقصاء المنافسين السياسيين وترسيخ السيطرة التنظيمية. سرعان ما تراجع خطاب التعددية لصالح خطاب تعبوي يشرعن احتكار السلطة باسم الشرعية الانتخابية، فانتهت التجربة إلى مواجهة صفرية مع الدولة العميقة والقوى المدنية، وإلى انقلاب عسكري أعاد البلاد إلى مربع الاستبداد.
في تونس، نجحت حركة النهضة إلى حد ما في تقديم نموذج أكثر براغماتية وتوافقية، لكنها وجدت نفسها في مأزق موازنة خطابها العقائدي مع ضرورات الدولة المدنية الحديثة، ما أدى إلى تراجع شعبيتها تدريجيًا أمام وعود الأحزاب العلمانية.
ولقد أسهم الفراغ الذي خلّفه فشل الأحزاب السياسية والعقائدية في إتاحة المجال أمام التيارات السلفية والراديكالية لتوسيع نفوذها الاجتماعي. استفادت هذه التيارات من تراجع الثقة في السياسة التقليدية، ومن انسداد أفق الإصلاح داخل الأنظمة، لتقدّم نفسها بديلاً أخلاقيًا وروحيًا.
خلال العقدين الأخيرين، تحوّل الخطاب السلفي في صورته الدعوية أو الجهادية إلى مرجعية لكثير من الفئات المهمشة أو الغاضبة من التهميش والفساد، لا سيما في البيئات الفقيرة أو المناطق الطرفية. هذا الصعود لم يكن فقط نتيجة عوامل خارجية، بل جاء أيضًا كارتداد طبيعي لعجز الأحزاب عن بناء نموذج حكم يوازن بين الهوية والانفتاح السياسي.
أنتج هذا الفشل المركب عدة نتائج خطيرة على بنية المجتمعات العربية، من أبرزها:
- تآكل الثقة العامة: إذ لم يعد المواطن يثق بالأحزاب كأدوات تمثيل أو كوسائل لإحداث التغيير.
- الانكفاء على الهويات الضيقة: الطائفية والمناطقية أصبحت بدائل عن الانتماء الوطني.
- عزوف الشباب: مع غياب القدوة السياسية وانسداد الأفق، انسحب جزء واسع من الأجيال الجديدة من العمل السياسي.
- شرعنة القبضة الأمنية: إذ باتت الأنظمة تستخدم فشل الأحزاب حجة لتكريس مزيد من القمع.
مع ذلك، لا يمكن إغفال بعض التجارب التي حاولت المضي نحو بناء حياة حزبية ديمقراطية، ولو بقدر محدود. تجربة تونس بعد الثورة قدمت درسًا بأن التوافق السياسي والإصلاح التدريجي يمكن أن يكون ممكنًا في ظل بيئة سياسية مرنة. لكن هشاشة المؤسسات والضغوط الاقتصادية والسياسية ظلت تهدد التجربة باستمرار.
وفي السودا الذي حصل بعد الثورة على نظام البشير، ظهرت محاولات لتأسيس حياة حزبية مدنية، لكنها اصطدمت هي الأخرى ببنية الدولة العميقة والانقسامات الأيديولوجية.
تشير هذه التجارب إلى أن بناء الديمقراطية يتطلب أكثر من مجرد انتخابات أو تداول رمزي للسلطة. إنه يحتاج إلى إعادة هيكلة الثقافة الحزبية، وتطوير المؤسسات التنظيمية، وتأسيس قواعد صارمة للحوكمة والشفافية.
وفي خلاصة المقام ، لا ينحصر الفشل الديمقراطي في الشرق الأوسط في هيمنة الأنظمة الشمولية وحدها، بل يتجذر كذلك في إخفاق الأحزاب السياسية والعقائدية في أن تكون تجسيدًا عمليًا لقيم الديمقراطية التي تدّعي الدفاع عنها. لقد تحولت هذه الأحزاب عبر التواطؤ مع الأنظمة أو الانغلاق الداخلي أو النزعات الإقصائية إلى عقبة أمام بناء المجال العام التعددي. وسمح هذا الفشل للتيارات السلفية والراديكالية بملء الفراغ واستقطاب قطاعات واسعة من الجمهور.
إن استعادة الثقة بالديمقراطية تتطلب مراجعة جذرية لثقافة العمل الحزبي، تبدأ بتأسيس ديمقراطية داخلية شفافة، وتلتزم ببرامج حقيقية قابلة للتطبيق، وتنبذ النزعات السلطوية والتبريرية. وبدون هذه المراجعة العميقة، سيبقى المجال مفتوحًا أمام مزيد من الاستبداد والانقسام والتطرف وبمسميات واهنة وهو ما يعيد إنتاج الحلقة المفرغة ذاتها التي شهدتها المنطقة على امتداد قرن كامل.
ولكم في التاريخ عبرة ،فاعتبروا ياأولي الألباب .
بوابة الشرق الأوسط الجديدة