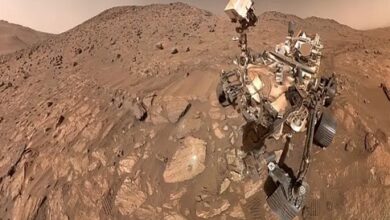تشارلز سيميك يكتب سيرته بلغة اللاجئين

في سيرته الذاتية «ذبابة في الحساء» (الكتب خان، ترجمة إيمان مرسال)، يرسم تشارلز سيميك قصة شاعر فَقَد وطناً فكتب القصيدة محاولاً استعادة رائحة البيوت التي قصفتها الطائرات، عازفاً على وتر شعري جاد. ومن دون أن يستبعد القضايا الكبرى من محيط اهتمامه، يروي خيبات الصبي الصغير قبل أن يصير شاعراً كبيراً. تلك الخيبات المبكرة سَلَبت صاحب السيرة وطناً اسمه بلغراد، عاصمة صربيا وأكبر مدنها، بينما كان لا يزال في ريعان الصبا.
تستعرض السيرة التي صدرت بنسختها الإنكليزية عن جامعة ميتشغن (العام 2000) هذا الولع بـ «الخيبات»، بإتقانٍ مُثيرٍ للإعجاب، عبر رحلةٍ تجوَّل خلالها الشاعر الأميركي الحاصل على جائزتي «بوليتزر» و «ملك شعراء الولايات المتحدة»، بين صدمات فكرية وجمالية عدة، ليصل إلى نقاء نصِّه. يُكمل تجواله بين مدن خرَّبتها الحرب، وشوارع مظلمة وغرف نوم بائسة، زارها بين أوروبا وأميركا، حيث عانى مآسي اللاجئين وصعوبات حياتهم، حين كان طفلاً. يُدرك من ثمّ أن قادةَ الأمم الأوروبية المتصارعين، كانوا هم الذين يحددون له ولأسرته الفقيرة ولآلاف اللاجئين غيرهم، ولمدينة بلغراد كلها، اتجاه الرحلة المقبلة، إلى المجهول.
يُعدّ كتاب سيميك، شاعر قصيدة النثر الأميركي من أصل صربي، كأنه بيانٌ صاخبٌ من شاعر مكلوم، وجد نفسَه في حاجة ماسة للبوح، خصوصاً بعدما أصبح ابن ثقافة مُرحَّلة. يحكي كيف حاول عبثاً أن يُلملم جراحه كمهاجر لا يجد من يتحدث معه لغته الأم، فيُضطر إلى تحمل «مصمصة شفاه الآخرين كلما تكلم»، إلى أن أصبح أحد أهم شعراء الولايات المتحدة الأميركية، فغدا صوتاً لكل الذين فقدوا أوطانهم، في اللغات والعصور كافة.
يبدأ الكاتب سيرته بسطور بليغة: «قصتي قديمةٌ وأصبحت الآن مألوفة. لقد تشرَّد كثيرٌ من الناس في هذا القرن، أعدادهم مهولة ومصائرهم الفردية والجماعية متنوِّعة، وسيكون مستحيلاً أن أدَّعي تميّز وضعي كضحية، أنا أو أي شخص آخر، إذا أردتُ الصدق. خصوصاً أن ما حدث لي قبل خمسين سنة يحدث لآخرين اليوم. رواندا، البوسنة، أفغانستان، كوسوفو، والأكراد المهانون، بصورة لا تنتهي».
يروي الكتاب قصة شابٍ سيئ الحظ، يواجه دائماً خيباتٍ يحوّلها بإرادة قوية إلى نجاح هائل. من حياة في أسرة «سيئة الحَظ»، اختارت لها الأقدار أن تنطلق في بلغراد العام 1938، إلى الفشل الدراسي وضعف القدرة على التحصيل بعد اضطرار الأسرة إلى عيش حياة اللاجئين، تحت قسوة الحرب، مروراً بالهروب من الفصل الدراسي، والتعرف إلى أكثر رجال العالم تسولاً في السجن، الذي دخله سيميك، وهو في العاشرة فقط.
ففي الخامسة من صباح يوم 6 نيسان (أبريل) العام 1941، وبينما كان عمره ثلاث سنوات فقط، ضربت قنبلةٌ المبنى المقابل لبيته، في بلغراد، ما أدى إلى اشتعال النار فيه، ومن ثم تكرر قصف هذه المدينة المنكوبة: «بلغراد التي ولدتُ فيها، لديها تميّز مُريب. لقد قصفَها النازيون في عام 1941 والحلفاء في 1944، والناتو في عام 1999».
السيرة كلها محاولة لتوصيل رسالة صغيرة، هي أن صاحب كل هذه الخيبات المتوالية، يعبر العام المقبل إلى عقده التاسع، وقد صدر له أكثر من سبعين كتاباً، بين شعر ونثر وترجمة، وحقق من جوائز الشعر أرفعَها، بعدما مزَّق آلاف القصائد. يروي سيميك كثيراً عن القصائد التي أغرقها أو أطلقها في الريح، لأنها لم تحقق توقه إلى التعبير عن آلام القرن العشرين، ويذكر أن أحد بسطاء العالم نصحه، ذات مرة، بينما كان لا يزال شاعراً شاباً، ألا يكتب مثل هؤلاء الشعراء، الذين يبدعون ما يُمتع الأغنياء، الذين يدفعون لهم فواتير المطاعم والفنادق الفاخرة. وبعد كل نصيحة جديدة، كان الشاعر الشاب يُمزق مزيداً من القصائد.
أما المشهد الذي يلخِّص قيمة هذه السيرة وقيمة شاعرها فيتمثّل في مشهد اللقاء الفادح، بين سيميك وشاعر أميركي آخر، يُدعى ريتشارد هيوغو، الذي شارك في قصف بلغراد، عام 1944، وهو لم يكن يعلم أن صديقه الذي التقاه مصادفة في المطعم، خلال أحد المهرجانات الأدبية، كان أحد المقصوفين. ريتشارد الذي قصف المدينة، أخذ يحكي الحكاية بمنتهى البساطة، بينما تشارلز يتألم. سأله: «لماذا قصفتم أحياء سكنية ولم تقصفوا مقر «الجستابو»؟»، فكان ردّ ريتشارد هو الأقسى بأنّ «الطائرات كان عليها أن تتخلص من حمولتها من الذخيرة، فوق بلغراد، وهي في طريق العودة، إلى إيطاليا، حيث يقضون بقية اليوم على الشاطئ مع بائعات الهوى».
لم يكن لهذه السيرة أن تحقق جزءاً أصيلاً من تميزها، في النسخة العربية، إلا بسبب رهافة لغة المترجمة إيمان مرسال (شاعرة قصيدة النثر المصرية، تقيم في كندا، تعمل في تدريس الأدب العربي في إحدى جامعاتها) وقدرتها على اصطياد التعبير الملائم، بين محكية بسيطة في بعض المواضع، ولغة عميقة في مواضع شاعرية جداً.
صحيفة الحياة اللندنية