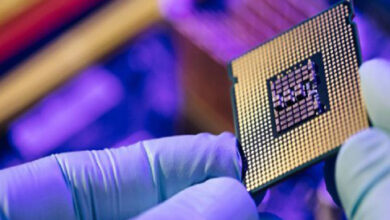حسابات الربح والخسارة في المواجهة بين أميركا وإيران

ترتسم ملاحم حرب مؤجّلة. المواجهة بين إيران وبين أميركا هي مُعدَّة أميركيّاً منذ عقود. لكن هي تصعب مع تنامي القوة العسكرية الإيرانية. أميركا، التي تتهم دول العالم الثالث وخصوصاً دول العالم العربي، بالوقوع تحت تأثيرات ثقافات تقليدية متخلّفة وبالالتزام بمبادئ الثأر والقبلية، هي دولة ثأرية، وتعتبر أن الانتقام هو جزء من عقيدتها السياسية والعسكرية والاجتماعية. كذلك، فإن الاعتذار عن جرائمها الداخلية والخارجية هو من المحظورات السياسية. أميركا لم تفقد دور إيران الشاه في منطقة الشرق الأوسط فقط، بل هي تعرّضت للإذلال الشديد من قبل نظام الثورة الإسلامية. مع العلم أن العرب يتناسون أن دور الشاه لم يكن محصوراً في منطقة الخليج، بل كان يقوم بأدوار وظيفية بالنيابة والتوافق مع الإدارات الأميركية في أكثر من منطقة من العالم: من عُمان إلى لبنان إلى العراق. الشاه كان حاضراً في الحياة العربية أكثر ممّا كان قاسم سليماني حاضراً، بحسب الدعاية الأميركية ــ الإسرائيلية ــ السعودية عنه.
صدفَ أنه أُفرجَ عن وثائق جديدة، أخيراً، تتعلّق بالسياسة الأميركية نحو إيران، هي وثائق سكرتير ديفيد روكفلر (رئيس مصرف «تشيز منهاتن» والمندوب الرئاسي الخاص إلى إيران في آخر أيام الشاه). روكفلر كان حليفاً وثيقاً للشاه، وحقّقَ مصرفه أرباحاً كبيرة هناك، كما كان مبعوث الشاه إلى إدارة جيمي كارتر أكثر ممّا كان مبعوث كارتر إلى الشاه (وكان روكفلر جمهورياً). تكشف هذه الوثائق الجديدة أن كارتر، الذي يتغنّى ليلَ نهارَ بمناصرته لحقوق الإنسان، كان يحثّ الشاه على استعمال العنف ضد المحتجّين في إيران، وأنه كان يحضّر مع مساعديه لانقلاب عسكري للحفاظ على النظام بأي ثمن. وهذه الرواية لكارتر تتناقض مع رواياته عن موقفه من استعمال العنف في إيران يوم الثورة. الولايات المتحدة خسرت في الشاه حليفاً لا يقلّ عن إسرائيل، مع فارق واحد: إن إيران كانت تدرّ المال على أميركا، فيما تستنزف إسرائيل المال الأميركي على مدى عقود طويلة (فاقَ تمويل أميركا لإسرائيل مبلغ المئة وعشرة مليارات دولار، كما أن أوباما وقّع مع دولة العدو عقداً تتكفّل فيه أميركا بتمويلها بمبلغ ٣٨ مليار دولار على مدى عشر سنوات: والكونغرس لا يكتفي بالاتفاقيات التي تعقدها الإدارة فيزيد من عنده مساعدات سخية إضافية يلحقها بمشاريع نفقات لا تتعلّق حتى بإسرائيل).
أميركا تريد أن تثأر من إيران بسبب تغيير نظام الحكم فيها، وبسبب سلسلة من الإهانات التي ألحقتها إيران بالإمبراطورية. لم تنسَ أميركا بعد، هزيمتها في لبنان (١٩٨٢ ــ ١٩٨٤)، ولهذا كانت شريكة كاملة في قرار اغتيال عماد مغنيّة. ثم هي لم تغفر لإيران دعمها للحرب ضد الاحتلال الأميركي للعراق. لم يكن اسم قاسم سليماني معروفاً في أميركا، ولم يتم التداول باسمه قبل عهد جورج بوش، الذي أصبح بعد حرب العراق وعجز الجيش الأميركي عن تحقيق النصر، مهجوساً بـ«فيلق القدس» وباسم قائده قاسم سليماني (وكان بوش يسيء لفظ اسم القدس واسم سليماني، تماماً مثل ترامب قبل أيام). سردية مقاومة الاحتلال الأميركي غائبة كليّاً عن الرأي العام العربي، الذي يقع تحت تأثير الضخّ الإعلامي الهائل لدول الخليج (المُنسِّقة مع دولة العدو وأميركا) التي، لأسباب التحريض الطائفي، روّجت لأطروحة أن إيران عقدت صفقة مع أميركا في العراق وأن مقاومة الاحتلال الأميركي لم تكن إلا من صنع الجماعات التكفيرية المسلّحة. هذه السردية غيّبت دور سليماني في دعم فصائل مقاومة عراقية، لأن هذه الحقيقة تتناقض مع شيطنة المحور الذي تقوده إيران ــ وتتناقض أيضاً مع شيطنة الشيعة (لم يمرّ في أي من أخبار العرب والغرب أن الملحق الديني في سفارة السعودية في كوالالمبور، الشيخ عبد الرحمن إبراهيم الربيعان، وصف الشيعة قبل أيام فقط بـ«المنحرفين»، ورفض إدراجهم في صف المسلمين لأن «الاختلاف بين السُّنة والشيعة لا يتعلّق فقط بالفقه بل يتعلّق بالحق والباطل». يبدو أن الحوار بين الأديان والتفاهم بينهم لا يشمل إلا يهود إسرائيل).
وتضع أميركا حماية إسرائيل في طليعة أولوياتها، كما أن حكومات العرب أجمعين تخلّت في قمّة بيروت عن القضية الفلسطينية، و«العامود الفقري» لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، هي أيضاً تخلّت عن القضية الفلسطينية. ولم يعد هناك من نظام عربي واحد يمدّ الفصائل الفلسطينية بالسلاح، تحت طائلة العقوبات الأميركية والأوروبية. مشروع السلام مع إسرائيل هو اليوم مشروع العرب لتحرير ما تتخلّى عنه إسرائيل طوعاً متى أرادت. ولا تزال إيران هي الوحيدة بين الدول التي تمدّ فصائل المقاومة بالسلاح. طبعاً، مطبخ الإعلام الصهيوني العربي يضع علامات استفهام كبيرة حول الدوافع الإيرانية من هذا الدعم ويربطها (حسبما تفتّقت عنه قريحة السفارة الأميركية في عمّان يومها، فيما كتبته للملك الأردني من عبارة طائفية) بمشروع للتوسّع الإيراني. لكن إذا كان التوسّع الإيراني يأتي على حساب احتلال إسرائيل لفلسطين فلماذا لا يقدّم العرب بديلاً عن ذلك، غير التطبيع واستجداء الرضى مع اللوبي الصهيوني؟ أميركا تريد أن تتخلّص من العدوّ الذي تعتبره إسرائيل الخطر الداهم والأساس لها، والتهويل بخطر حزب الله على إسرائيل هو فعل يومي في الدعاية الصهيونية العالمية، ما يدلّل على ما يتمتّع به لبنان من منعة وقوّة. لكن الدعاية الأميركية في بلادنا فعلت فعلها وبات في بلادنا من قوى يسارية تساوي بين إيران (الذي تمدّ فصائل المقاومة على اختلاف عقائدها وطوائفها) بالسلاح وبين الأمبريالية الأميركية. تتمثّل الدعاية الأميركية في رفع شعار «لا إيران، ولا أميركا»، كأنّ القوتين تتساويان في حجم الجرائم والصهيونية وتفتيت العرب. ويريد البعض في لبنان التخلّص من المقاومة كليّاً (بحجّة أن دعمها إيراني، كأن هناك مقاومة في التاريخ لم تتمتّع بتدعم خارجي) وتوكيل قائد الجيش (الذي يجد صعوبة في فتح طريق في جل الديب يصرّ زعران القوات على إغلاقه) مهمّة الدفاع عن لبنان بوجه إسرائيل. ويرى اللوبي الإسرائيلي أنه لو تخلّص من إيران فإن المنطقة العربية برمّتها سترحّب بدخول إسرائيل إلى المجموعة العربية، حسب المشروع التقليدي لشمعون بيريز والتي انبرت جريدة «الحياة» في التسعينيّات للترويج له.
لم يكن من المتوقَّع ان يفجّر دونالد ترامب حرباً. كان حتى الساعة أقلَّ نزوعاً للحرب والعدوان عن أسلافه. ترامب خاض الانتخابات في الحزب الجمهوري على أساس برنامج الانكفاء والانسحاب العسكري الأميركي من الشرق الأوسط. وهو تحدّى خصومه في الانحراف عن مسار «بناء الأمم»، وهو المصطلح الأميركي السياسي عن غزو وتدمير الدول حول العالم (تحتاج الامبراطوريّات إلى أوصاف تجميلية لحروبها وغزواتها، لأن ديمومتها على مدى عقود تتطلّب مقداراً كبيراً من المشروعية الأخلاقية الداخلية. هذه مثل المعارضة الأميركية التي تقول في معرض رفضها للحروب الأميركية إنه لا يجب أن يترتّب على أميركا لعب دور «الشرطي حول العالم». وهذا الوصف لأميركا يمنحها ما لا تستحقّه، إذ أن دورها العالمي هو أقرب إلى دور المجرم منه إلى دول الشرطي). ترامب حاول، للأمانة، سحب القوّات الأميركية من سوريا والعراق وأفغانستان. لكنه اكتشف ما هو معلوم: هذه إمبراطورية حربية وليس بمستطاع رجل واحد، مهما كانت توجّهاته ونزعاته، أن يغيّر مسار الإمبراطورية نحو السلم. لو أن برني ساندرز، الاشتراكي النزعة، وصل إلى سدة الرئاسة لكان هو أيضاً سيشنّ حروباً. يكفي أن تُراجع مسار الاشتراكيّين في الحكم في فرنسا أو مسار «العمّال» في بريطانيا. لكن معايير الإمبراطورية الأميركية أكثر رسوخاً، وأقلّ عرضة للتأثّر بتغيّر دفّة القيادة.
القرار الأميركي بقصف مطار بغداد واغتيال سليماني والمهندس، كان قراراً مفاجئاً لأنه فتح احتمالات الحرب على رئيس كان يُظنّ بأنه سيكون أقلّ ترحيباً بالحرب من أسلافه. لكن لكل رئيس أميركي حربه، أو حروبه، يطبعها بطابعه وتطبعه بطابعها. تمهر ختمها على عهده، لترفعه حيناً، أو لتلوّث سمعته حيناً آخر. هبط الرئيس الأميركي ليندون جونسون في حرب فيتنام، وأعلن عزوفه عن الترشّح في عام ١٩٦٨، كما أن مرثاة جورج دبيليو بوش ستذكر في عنوانها كارثة العراق المدمّرة (له ولشعوب المنطقة ودولها). باراك أوباما كان مسؤولاً عن حرب مدمّرة في ليبيا، لكنّ سمعته لم تتأثّر بها بعد، لأن الوعي الأميركي بالكارثة الليبية شبه معدوم. حتى العالم العربي صرف أنظاره عن ليبيا، تاركاً مصيرها لصراع بين دولة الإمارات والسعودية وروسيا من جهة، وبين قطر وتركيا من جهة أخرى (الدور الأميركي في ليبيا تنقّل بين الأطراف، قبل أن يترك لوكلائه تقرير مصيرها مع حفظ حقوقه في القصف والاحتلال والتدمير).
كيف قرّرَ ترمب أن يأمرَ بعمليّة يمكن أن تؤدّي إلى حرب مدمّرة؟ هناك تفسيرات عدّة لما حدث. في السياسة الخارجية، تفترض النظرية السائدة فيها (أي الواقعية الكلاسيكية) أن الحاكم لا يأخذ قرارته إلا بناءً على صنع قرار عقلاني. والعقلانية ليست إلا وصفاً لحساب الربح والخسارة، لتقرير المصلحة القومية، أي أن الحاكم يطلب من مساعديه تقديم جردة باحتمالات الربح والخسارة من جرّاء انتهاج هذا الخيار أو ذاك. ويكون الحاكم بناءً على ذلك مستعداً لشتى الاحتمالات. والعقلانية، كي تكتمل، يجب أن تفترض أن عدوّكَ لا يقلّ عقلانية عنك. إن افتراضَ جنون عدوّك (كما تسارع وسائل الإعلام هنا وأعضاء الكونغرس إلى وصف كل حاكم عربي عدو للولايات المتحدة بأنه مجنون: لأن العقلانية تفترض عندهم الطاعة والولاء للإمبراطورية الأميركية) تضعف من حسابك للربح والخسارة لأنها تقلّل من خطر حسابات عدوّك. لكن، حساب الربح والخسارة يجب أن يأخذ في الحسبان جنون كما عقلانية العدو لتزيد من التحضّر. أضفْ إلى ذلك نظرية «الرجل المجنون» التي يحبّذها ترامب، والتي تدفع الحاكم لتصنّع الجنون ليخيف أعداءه. وقد انتهج ترامب ذلك في سلوكه نحو الحاكم الكوري الشمالي، وانتهجها نحو إيران أيضاً في تهديدات تويترية. لكن تصنّع الجنون من دون ترجمة الجنون، يخفّف من وطأته. وانتقل ترامب من تصنّع دور «الحاكم المجنون» مع كوريا الشمالية إلى التودّد الفائق مع الحاكم هناك. لكن ذلك لم يأتِ بنتيجة لترامب، وإن كان لم يُشعل حرباً. إلا أن الحاكم الكوري الشمالي ضاق ذرعاً بترامب، وبات يهدّد بالعودة إلى تجربة الصواريخ الباليستية. لعبة «الحاكم المجنون» تحتاج إلى تعديل. يريد ترامب أن يظهر بمظهر الحازم والعنيف ويريد ألّا يكون أوباما.
وحسابات الربح والخسارة في تقرير السياسة الخارجية تحتاج إلى:
1) رئيس يتحمّل المعارضة والاختلاف مع مساعديه، لأن الموافقة العمياء على أهوائه تعزّز ما يُسمّى بـ«تفكير المجموعة السائد»، والذي يتناقض مع عملية القرار العقلاني.
2) فريق مكتمل من المساعدين الأكفّاء الذين يستطيعون مدّ الرئيس بما يحتاج إليه من معلومات ونصح للقيام بعملية صنع القرار العقلاني. لكن إدارة ترمب تفتقر إلى هذيْن العنصريْن: لا يتحمّل ترامب المساعدين الذين يختلفون معه في الرأي، والطاعة والولاء الأعمى يتفوّقان عنده على الكفاءة. والفريق الاستشاري لترامب ضعيف جداً، لأنّ عناصره تتغيّر باستمرار ولأن الكثير من الوظائف العليا تفتقر إلى مَن يتولّاها. عند كتابة هذه السطور كانت وظائف مدير الاستخبارات الوطني ونائب مدير الاستخبارات الوطني ووزير الأمن الداخلي ونائبه، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الحد من التسلّح ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا ووزير البحرية ومفوّض حماية الحدود وإدارة فرض الجمارك والهجرة، شاغرة. ليس هناك، مثلاً، في شؤون الشرق الأوسط أي خبير معتدّ به في شؤونه في وزارة الخارجية أو الدفاع. عادة، يكون مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى رجلاً تمرّس في العمل الدبلوماسي، وتنقّل بين العواصم العربية. المساعد الحالي، ديفيد شنكر، لم يأتِ من السلك الدبلوماسي بل من الذراع الفكرية للوبي الصهيوني، وهو محدود الاختصاص والدراسة: له إلمام فقط في شؤون لبنان والجيش اللبناني (وهو شديد الرضى عن قيادته هذه الأيام). هذا النقص في الوظائف الكبرى في الإدارة، لا يسمح بإجراء جردة حساب عقلانية في صنع القرار، هذا لو شاء الرئيس ذلك. البنية التحتية لإجراء عملية قرار العقلانية في السياسة الخارجية، حتى من منظور المنفعة الأميركية، غائبة عن هذه الإدارة. وسيادة الأيديولوجية على المصلحة السيادية هي من مخاطر صنع القرار في الحكم، وهي طبعت فريق جورج بوش. وترامب، وإن كان بعيداً عن الأيديولوجيا، فإنه مُحاط بفريق من عتاة اليمينيّين (من أمثال مايك بومبيو الوثيق الصلة برئيس الموساد) الذين يريدون تأديب إيران.
3) ترامب يتأثّر كثيراً بحسابات تفرضها عليه الإمبراطورية الحربية التي رفضت الانسحابات العسكرية، لا بل فرضت عليه زيادة عدد القوات العسكرية في كل من سوريا والعراق وأفغانستان ودول الخليج. (دول الخليج ليست دولاً بالمعنى المألوف، هي عادت منذ عام ١٩٩٠ إلى زمن المحميّات العسكرية التي تستضيف قواعد عسكرية واستخبارية تتصرّف فيها كما تريد من دون العودة إلى الحكومة المُضيفة. وهذا بالمعنى القانوني يعني: أن كل دول مجلس التعاون الخليجي مسؤولة ــ في القانون الدولي ــ عن كل جرائم الحرب التي ارتكبتها أميركا في الشرق الأوسط منذ عام ١٩٩٠، لأنها سمحت باستخدام أراضيها لارتكاب أعمال عدوان أميركي ضد دول ذات سيادة، عربية كانت أم غير عربية).
خيارات الحرب
بالرغم من حماس جمهور المقاومة لها في كل العالم، فإن الحرب خيار صعب على أميركا وصعب على إيران أيضاً:
ــ أميركا لا تريد حرباً لا تنتصر فيها، حتى ولو تحقّق لها إسقاط النظام بقوّات برية، وهذا الخيار من سابع المستحيلات. لا يزال تحذير وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، بأن أي رئيس أميركيّ يفكّر مرّة أخرى في غزو دولة في الشرق الأوسط، يحتاج إلى فحص في قواه العقلية، قائماً.
ــ إيران منهكة اقتصادياً وسياسياً، لكنّها في وضع أفضل بكثير من العراق، الذي كان أيضاً منهكاً (أكثر) اقتصادياً وسياسياً في عام ٢٠٠٣. والعراق حارب وحيداً، فيما يمتلك المحور الذي تقوده إيران طاقة إقليمية هائلة. وهذه الطاقة هي التي تخيف إسرائيل وتشكّل عنصراً رادعاً أمام أي قرار أميركي بالتصعيد. والحرب تعني خسارة ترامب لرصيده السياسي الوحيد، وهو الوعد بالمزيد من الرخاء الاقتصادي (بتعريفه هو، طبعاً). وإيران تعاني من عقوبات صارمة لا سابق لها في تاريخ العقوبات التي تفرضها أميركا حول العالم. والحرب المفتوحة تدمّر الكثير من المكتسبات العلمية والدفاعية للنظام. والحرب، لو فُتحت على أبوابها، ستكون طويلة جداً، وهذا رادع آخر أمام القرار الأميركي بالحرب. وتخويف دول الخليج (التي تسابقت لنفي انطلاق الطائرات الأميركية من أراضيها للعدوان على العراق) فعل فعله، وباتت هي أيضاً تحذّر من عواقب الحرب على إيران (هي، كما يقول مدير «مؤسّسة الدفاع عن الديمقراطيات»، وهي من أكثر المنظمات تطرّفاً في الصهيونية واليمين في العاصمة الأميركية، تريد صرامة في الحرب الاقتصادية وليس في الحرب العسكرية).
إن قرار ترامب باستفزاز إيران كان خارج سياق تعريفنا لشخصيته الرئاسية. هل كان ذلك لأن قدرته التخويفية التويتريّة اضحملّت لأن الصوت المرتفع لم يترافق مع أفعال، أم لأنه يحتاج إلى أن يحرف الأنظار عن محاكمته في مجلس الشيوخ الأميركي؟ والنظام الإيراني، خلافاً لنظام القذّافي أو صدّام حسين، لا يسهّل مهمة أعدائه، بل يصعّبها. والقرار قبل أيام بالرد القوي والمحدود على قواعد عسكرية أميركية، كان لبعث رسالة بعدم الرغبة في التصعيد. إيران تعلم أن خيار الحرب المفتوحة يقلب النظام الإقليمي القائم رأساً على عقب، وهذا سيناريو مخيف لأعداء إيران لكنه سيناريو غير مفيد بالضرورة لإيران، لأنه ينزع عنها الحظوة الإقليمية السياسية والعسكرية التي تتمتّع بها.
إنّ قصف القواعد الأميركية في العراق، كان رسالة إيرانية واضحة: إيران أعلنت مسؤوليتها المباشرة عن ذلك، لأنها تريد أن تقول لأميركا إن المواجهة الكبرى (لو أتت) لن تكون بالواسطة، بل ستكون باحتكاك الحديد بالحديد والنار بالنار واللحم باللحم. وصاحب إعلان إيران عن القصف مشاهد فيديو وخطاب تصعيدي يضاهي البروباغندا العسكرية الأميركية. وتسديد رمي الصواريخ بهذه الدقّة (لو أن صاروخاً واحداً أخطأ هدفه، لكانت أميركا قد نشرت صور الأقمار الاصطناعية لتسخر من الصواريخ الإيرانية، والإعلام الأميركي اعترف ــ مرّة أخرى بعد قصف منشآت أرامكو ــ بدقّة التسديد). وكما يقول عامر محسن، فإن الإعلان عن إطلاق الصواريخ وتسديدها بهذه الدقّة هو رسالة إلى إسرائيل عن طبيعة المعركة المقبلة، والتي تخاف إسرائيل منها أكثر فأكثر، يوماً بعد يوم. إيران ردّت بصورة محدودة: تكفي لإعلان الانتقام ولا تكفي لاندلاع الحرب.
خسر المحور الذي تقوده إيران عدداً كبيراً من قياديّيه العسكريين والأمنيين والعلميين على مرّ السنوات. لكن تراكم عملية الاغتيال لم يضعف ــ ليس بعد ــ من بنية هذا المحور، ما يشير إلى قدرة في مأسسة القيادة، وفي الاستعانة بنموذج اللامركزية في العمل الأمني والعسكري، وكان هذا ما ميّز العمل العسكري الإيراني في الحرب مع العراق، كما ميّزَ عمل المقاومة (قارن ذلك بنمط قيادة الأنظمة العربية، أو حتى ياسر عرفات، الذي كان يصرّ على ضرورة توقيعه على أصغر عملية نقل ضابط من موقع إلى موقع آخر). لكن الحرب الأميركية ــ الإسرائيلية مستمرّة: وهي لا تنطلق من معاداة لعقيدة دينية أو بدافع الرغبة في نشر النسوية والعلمانية. هي تريد ألا تكون هناك معارضة أو مقاومة لاحتلال وعدوان إسرائيل وأميركا في المنطقة العربية. والذي يرفع شعار «لا إيران ولا أميركا»، إنما يساوي بين المُحتلّ والمعتدي وبين الذي يقاوم المحتل والمعتدي. وهذا حقّه وحقّها. نحن في زمن يريد فيه البعض أن تقتصر أعمال المقاومة على قرع الطناجر والأواني.
صحيفة الأخبار اللبنانية