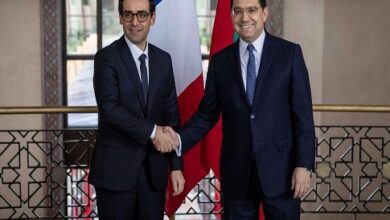حلف الفضول هو الحل (فهمي هويدي)
فهمي هويدي
لا تستطيع مصر أن تحتمل طويلا استمرار الحرب الأهلية الباردة الدائرة على أراضيها بين قبائلها السياسية التي باتت أخطر معوقات إقامة نظامها الجديد. وأرى لذلك حلا يتمثل في استدعاء صيغة «حلف الفضول» علّها تخرجنا من المأزق.
ــ1ــ
أكاد أرى تشابها بين الحاصل في مصر بعد الثورة وبين حروب ملوك الطوائف في الأندلس قبل أكثر من ألف عام. ذلك أنه حينذاك (عام 422 هجرية) أعلن الوزير أبو الحزم بن جهور سقوط الدولة الأموية، فتسابق أمراء الولايات على إقامة ممالك مستقلة لهم مستفيدين من ثراء الخلافة وانفراط عقدها. وكانت النتيجة أن قامت على أرض الأندلس 23 دويلة تحول التنافس بينها إلى تنازع واحتراب. وقد استمر ذلك الصراع بين الأشقاء، وطال أجله في الوقت الذي كانت فيه جيوش الفرنجة في الشمال تتربص بهم، تحت قيادة الملك ألفونسو السادس وزوجته إيزابيلا، الصراع أضعف ملوك الطوائف، الذين حاول بعضهم الاستقواء بالفرنجة ضد أشقائه. وانتهى الأمر بهزيمة الجميع وسقوط الأندلس في أيدي الفرنجة.
من المصادفات أن عدد الدويلات التي قامت في الأندلس بعد سقوط الدولة الأموية (22 دويلة) قريب من عدد الأحزاب والجماعات السياسية التي تبلورت بعد سقوط النظام السابق في أكثر من 20 حزبا. وإذا كان ملوك الطوائف تقاتلوا فيما بينهم بالسلاح، ومنهم من حاول الاستقواء بالفرنجة، فإن الصراع في مصر بات يدور في ساحة الإعلام، التي هي أقوى تأثيرا، ومن بين زعماء طوائفنا من لجأ إلى الاستعانة بفلول النظام السابق لكي يرجح كفته في مواجهة المنافسين، وكان ذلك واضحا في انتخابات رئاسة الجمهورية، وشهدناه في سعي بعض الأحزاب الجديدة إلى جذب عناصر الحزب الوطني سيئ الذكر.
من الفروق المهمة بين التجربتين أننا عرفنا ما الذي انتهى إليه الأمر في الأندلس، لكن اقتتال الطوائف عندنا لا يزال مستمرا ولا نعرف له نهاية، وإن كانت خبرة التاريخ تدلنا وتحذرنا من النهاية التي تؤدي إلى هزيمة الجميع وضياع الوطن.
ــ2ــ
إذا اقتربنا أكثر من تفاصيل الواقع المصري فسنجد أن علاقات القوى السياسية تعاني مشكلتين أساسيتين، الأولى تتمثل في أزمة الثقة سواء بين الأحزاب بعضها البعض، أو بين التيار العلماني والتيار الإسلامي. وهي الأزمة التي ولدت سوء ظن كل طرف بالآخر، أما المشكلة الثانية فتتمثل في غياب الإجماع الوطني حول القضايا الأساسية، حتى بدا وكأن ثمة خلافا في أصول المشروع الوطني وليس في فروعه. وهو ما تبدى في الخلاف حول هوية الدولة ذاتها، وهل تكون دينية أو مدنية.
في تتبع جذور الأزمة سنكرر ما سبق أن قلناه من أن النظام السابق حين دمر القوى السياسية وأصابها بالإخصاء والإعاقة، فإنه حرم تلك القوى من أن تعمل مع بعضها البعض، الأمر الذي أثر بالسلب على الثقة والمعرفة المتبادلة. وفي غيبة ثقافة الممارسة الديمقراطية لم يكن غريبا ولا مفاجئا أن يتوجس كل طرف من الآخر، وأن تصبح شيطنة كل منهم إزاء الآخر هي الأصل والأساس. وما عرضته في الأسبوع الماضي نموذج لذلك، حين بينت أن نصيب الأوهام من مخاوف الأقباط في الوقت الراهن أكبر بكثير من حصة الحقائق. والحاصل بين الأقباط والمسلمين ليس مختلفا كثيرا عن الحاصل بين القوى السياسية المختلفة، إذ إن الفجوة واحدة وغربة كل طرف عن الآخر أيضا واحدة.
ليس ذلك كل ما في الأمر، لأن حروب الطوائف السياسية المصرية تأثرت بعاملين مهمين، هما: فتنة القسمة بين الديني والمدني ــ وخطاب التيارات الإسلامية الذي أصبح يشكل عقبة دون تحقيق التوافق المنشود والثقة المرجوة.
لا أعرف من الذي أطلق شرارة الفتنة، لكني أجد القسمة بين الديني والمدني من الخطورة بمكان. من ناحية لأنها أقحمت الهوية الدينية في الصراع، في حين يفترض أن محور الخلاف هو الرؤية السياسية. ومن ناحية ثانية فإن القسمة اختزلت أزمة الثقة وعبرت عن سوء الظن، فعبرت مقدما عن تقدير القوى المدنية وتصويرها بحسبانها طليعة التقدم، وأوحت بتصنيف القوى الدينية باعتبارها نقيضا ذلك وهي إلى التخلف أقرب. وذلك تقسيم مشكوك في براءته ومطعون في صوابه من الناحيتين النظرية والعلمية.
سوء النية واضح في صياغة المصطلح، الذي يمثل دعوة مبطنة إلى إضفاء الجاذبية والإشراق على طرف، وحث على النفور والانفضاض من حول الطرف الآخر. في الوقت ذاته فالمصطلح مغلوط من الناحية النظرية لأن ما هو مدني بمعنى أنه مؤسسي وموكول إلى إرادة البشر يمكن أن تكون له مرجعيته الدينية كما يمكن أن يكون له جذوره العلمانية، والحضارة الإسلامية بكل جلالها وثرائها كانت لها مرجعيتها الدينية. كما أن نظام الوقف، الذي هو ابتكار إسلامي صرف، ليس سوى عمل مدني يحقق المصالح الدنيوية التي تنفع الخلق، لكنه ينطلق من ابتغاء وجه الله تعالى واستجلاب رضاه. وقبل أن يستخدم المصطلح في تلغيم الساحة السياسية في مصر. كنت قد كتبت مقالا نشره الأهرام قبل عشرين عاما في الدفاع عن المجتمع المدني. وفي وقت لاحق أعلن عن تأسيس حزب الوسط باعتباره حزبا مدنيا بمرجعية إسلامية. لكن الذين روجوا للمصطلح أخيرا خلطوا الأوراق، وأرادوا استخدامه في إقصاء التيارات الإسلامية والكيد لها والتخويف من تأثيرها الذي افترضوه سلبيا على هوية الدولة والمجتمع.
ــ3ــ
ما قلته بخصوص الخطاب الإسلامي وكونه أصبح يشكل عقبة تحول دون تحقيق التوافق المنشود يحتاج إلى ضبط وتحرير. إذ أرجو ألا أكون بحاجة إلى القول بأنني لا أتهم الخطاب الإسلامي ولا أنتقص من قدره. ولكنني أسجل ملاحظاتي على أولويات وملاءمات ذلك الخطاب. إذ ليس المطلوب من الإسلاميين أن يتنازلوا عن مشروعهم، وإنما عليهم أن يدركوا أنهم ليسوا وحدهم في الساحة، وأن البلد تسع آخرين إلى جوارهم. وبالتالي يتعين عليهم أن يضعوا هؤلاء في حسبانهم، وأن يبحثوا عن نقاط الالتقاء معهم فيقدمونها على نقاط التقاطع والاختلاف.
أستأذن في توضيح فكرتي باستعادة كلام قلته أخيرا في لقاءات مع بعض الناشطين من الإخوان والسلفيين وهو يتركز في النقاط التالية:
ــ إن وحدة الجماعة الوطنية ينبغي أن تحظى بالأولوية بشكل عام، وفي الظروف الراهنة بوجه أخص. وفي القرآن نموذج يؤيد هذه الفكرة. فيما ورد بسورة طه، التي تحدثت عن النبيين موسى وهارون، وكيف أن موسى غاب عن قومه لبعض الوقت وتركهم في عهدة أخيه هارون. ولكن القوم فتنوا وعبدوا العجل من دون الله في غيابه، وحين عنفه النبي موسى بعد عودته، فكان رده حسب النص الوارد في الآية: 9 من السورة «يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي». وهي واقعة قدمت فيها وحدة القوم على ما أصابهم من خلل في اعتقادهم. ومن ثم الخوف من انفراط عقد الجماعة وأن ينشق صفها.
ــ إنني من حيث المبدأ ضد فكرة تطبيق الشريعة بقرار فوقي من السلطة أيا كانت، وأفضل ألا تتم إلا من خلال إجماع وطني وشعبي. بحيث يقام البنيان فيها من القاعدة إلى القمة وليس العكس. علما بأن التوفيق لم يحالف التطبيقات التي فرضتها من خلال مؤسسات السلطة، الأمر الذي أدى إلى تشويه الشريعة والإساءة إليها.
ــ إن المجتمع المصري ليس مهيأ لتطبيق أحكام الشريعة لأسباب يطول شرحها، في مقدمتها أن التطبيقات المعاصرة لها ليست جاذبة في حدها الأدنى، فضلا على أن المجتمع الذي لا يستطيع أحد أن يشكك في إسلامه، لم يختبر دعاة تحكيم الشريعة في الوقت الراهن، خصوصا أن أغلبهم لجأ إلى وعظ الناس بأكثر من لجوئه إلى خدمتهم ورعاية مصالح ضعفائهم. ولا يكفي في هذا الصدد أن تكون الأغلبية الشعبية في صف تطبيق الشريعة، لأن الأمر ليس كذلك بالنسبة للنخب المهيمنة على الواجهات السياسية والإعلامية. وهذه لا ينبغي تجاهلها أو التقليل من شأنها.
ــ إن الكلام عن إحياء الخلافة الإسلامية يبسط الأمور أكثر مما ينبغي، ومن المنادين بذلك من يعمد إلى رفع السقف والمزايدة على الجميع. إذ رغم أن الخلافة الراشدة تمثل صفحة ناصعة في التاريخ الإسلامي فإننا نعلم أن الإسلام لم يقرر شكلا معينا للحكم، ولكنه دعا إلى قيم ومبادئ معينة يتعين أن يلتزم بها كل نظام يريد أن ينسب نفسه إلى الإسلام. أيا كان الشكل الذي اختاره.
ــ إذا كان تطبيق الشريعة يعد الهدف الأسمى والحد الأقصى، وإذا كان المجتمع ونخبه ليسوا على استعداد للقبول بذلك في الوقت الراهن، وإذا كان ذلك التطبيق لا ينبغي أن يتم بقرار فوقي أو بإصرار فريق بذاته، فلا مفر من بحث عن حل يخرج المجتمع من الأزمة، وهو ما أجده في فكرة حلف الفضول الذي له شهرة خاصة في التاريخ العربي.
ــ4ــ
تتحدث كتب التراث عن أنه قبل عشرين سنة من ظهور الإسلام عقد وجهاء قريش حلفا فيما بينهم تعهدوا فيه ــ كما يذكر ابن هشام ــ بألا يجدوا بمكة مظلوما دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، وقد وصفه ابن كثير بأنه أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب. وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام «لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت».
نحن لا نريد الآن نصوصا على تطبيق الشريعة تثير شقاقا أو مخاوفا في المجتمع، ولا مشروعا «للنهضة» يدغدغ مشاعرنا ويجعلنا نسبح في الفضاء البعيد، ولا كلاما عن الخلافة يمثل استحضارا للماضي أو بكاء على طلاله، ورغم أنني لست ضد شيء من كل ذلك، وأحترم ما تعبر عنه، فإنني أتحدث عن أهداف أكثر تواضعا، توثق عرى المجتمع ولا تمزقها أو تشتتها، وفي الوقت نفسه تحقق مصالح الخلق وتأخذ بيد الضعفاء وتستدعي القادرين إلى ساحة الخير والنماء.
ليحتفظ كل فصيل بمشروعه وأحلامه ــ إسلاميين كانوا أم علمانيين ــ وليدعى أهل الغيرة إلى حلف يتوافقون فيه على ما لا يختلف عليه من أهداف مرحلية تتعلق بكرامة وعافية الوطن والمواطن، على أن تؤجل بقية الأهداف إلى طور آخر تتعزز فيه الثقة بين الجميع، بحيث يصبح بمقدورهم أن يقطعوا أشواطا أبعد في رحلة تأسيس النظام الجديد الذي يقيم حلم الثورة على الأرض. وإذا فشلوا في ذلك فإن مصير ملوك الطوائف ينتظر الجميع.
صحيفة الشرق القطرية