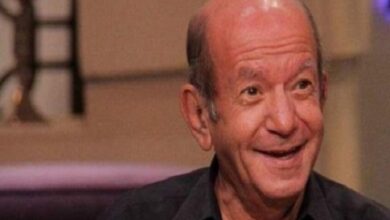حيوات السفرجل الفلسطيني … كل قضمة بغصة

«السفرجلة» للفلسطيني حيدر عوض الله، («السفرجلة»، حيدر عوض الله، دار الأهلية، عمان، 2016، 205 صفحة) اليساري النقدي، ليست وحسب رواية جردة الحساب، بل رواية الجردة الكاشفة، العابثة، الجريئة، وغير الآبهة بشيء. بطلها وراويها تقلّب بين مرارات الحياة وخيباتها وسخرياتها بما طهّر النص من أي تعالٍ يحاول تجميل ما قبُح من الزمن، أو تصنيع بطولة لم تكن، أو نفي حضور وضاعة كانت. لا تتصدر الرواية ولا تختمها أية مقولة رتيبة تدّعي أن أحداث القصة وشخوصها محض خيال وأن انطباق ما فيها على أحداث وشخوص من الواقع لا يتعدّى الصدفة.
عوضًا عن ذلك، تتلقانا في الصفحة الأولى مقولةٌ قصيرة ما تلبث أن تتكشف طيّاتها الكثيفة فور الشروع بقراءة فصول الرواية: «الحياة أشدّ فجوراً من خيالاتها، السفرجلة حياة كل قضمة منها بغصة».
نتابع قضمات حياة الراوي مرحلة تلو أخرى، وهي في ما يبدو مراحل حياة المؤلف. هكذا ومن دون اي ليّ للنص او اعتذارية لا محل لها، تنطبق سفرجلة الرواي على سفرجلة المؤلف. تولد السفرجلة في مخيم المغازي للاجئين في قطاع غزة في عائلة يتشتت فيها الزوج اغتراباً يطول عن بقية الأسرة وينتهي بالطلاق.
إثر ذلك، يُرسل الأولاد «وجيه»، بطل السفرجلة، واختاه، وعبر توسط قريب لهم في مخيم «البقعة» قريباً من عمان إلى والدهم المقيم في مخيم اليرموك في سورية. والدهم كان قد صار منذ سنوات كادراً مُعتبراً في تنظيم شيوعي فلسطيني. يحب «وجيه» حياة المخيمات في «المغازي» و «اليرموك»، ربما لأنها الحياة الوحيدة التي عرفها، ثم مع حرب إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية والبنان سنة 1982 يتطوّع للقتال مع المقاومة، وهو لا زال على مقاعد الثانوية. يعيش تجربة الفدائيين، ويركض على غير هدى محاذاة حواف الموت في الجنوب اللبناني والبقاع وبيروت، ويشهد عيناًَ عبثية الدم المسفوح.
يعود إلى المخيم وينهي بصعوبة بالغة شهادة الثانوية التي تؤهله، بإسناد من علاقات والده الحزبية واليسارية، للالتحاق بـ «الأكاديمية الحزبية» في صوفيا، العاصمة البلغارية، لدراسة الفلسفة. تنقضي سنوات الدراسة بتجربتها الثرية، وتعثراتها، وخيباتها، وعبثها وخمرياتها ونسائها، وتنظيراتها الفلسفية والماركسية، ولا يعود «وجيه» إلى مخيم اليرموك لأنه ووالده ما عاد مرغوباً فيهما في دمشق «الصمود والتصدي»، بسبب عدم خضوع تنظيمهما لرغبة «نظام الصمود» في السيطرة على قيادة المقاومة وتوجيهها.
يتجاوز وجيه رغبة قوية اجتاحته للذهاب إلى اليمن الجنوبي لتدريس الفلسفة، موقناً أنها المكان شبه الوحيد الذي في إمكانه العيش فيه حيث يتوافر الشرطان الأساسيان للحياة كما يراها: الانفتاح الاجتماعي والشراب! بدلاً من ذلك يقنعه والده بالذهاب إلى تونس حيث يصبح قريبًا من سليمان النجاب، الأمين العام للحزب الشيوعي الفلسطيني. في تونس تكون المقاومة، وبعد أن رُحّلت من بيروت، دخلت أطواراً من الحيرة والتعفن والفساد بعيدة من الحدود مع فلسطين، وقيادتها مثقلة بالمسؤوليات الـــبيروقراطــية، وبالشـــلل السياسي.
«وجيه» صريع شهواته مع النساء، وصارع منظّري الماركسية السوفياتية التي قولبت الفكرة الأم وقضت على روحها النقدية، كما يخبر المنصتين له في محاضراته الحزبية والتأهيلية، وقع اخيراً في مسؤوليات الزواج وما اثمر عنه من طفل وليد قائمة احتياجاته لا تني تطول. لم يكن الارتطام بواقع الحياة، او بالأحرى التعرض لواحدة من اصعب قضمات السفرجلة متمثلاً في الزواج والتزاماته، التحول الوحيد الأبرز في حياة ما بعد مثاليات الجامعة. وطنياً ونضالياً جاءت مدريد وأوسلو تعرضان حلاً بائساً، تناسلت بعد القبول بقضمته مرارات وغصات لم تنته.
لكن اوسلو قدمت فرصة هروب إلى الأمام لـ «وجيه» الذي انسدت في وجه جغرافية ما حول الوطن، فهو ابن غزة وحامل وثيقة السفر المصرية التي لم تعد تؤهله حتى لدخول مصر ذاتها. زوجته وطفله في الأردن، وهو هائم على مركز حدود هنا او هناك. يعود «وجيه» مع «عائدي اوسلو»، ويرقب اندفاع الأشجار والجبال والسهول من شباك الباص المتوجه من عمان باتجاه «الجسر» والحدود مع اسرائيل، ليكتشف كيف ان حالها لم يتغير، من يوم ان مر بها في باص بالاتجاه المعاكس يوم كان طفلاً مع شقيقتيه متوجهاً إلى «مخيم البقعة». من تغير هو وجيه لا الأرض والشجر والأشياء، كما يتمتم لنفسه في السطر الأخير من الرواية.
براعة نص حيدر عوض الله تكمن في فداحة ثقته المفرطة بذاته. هي ثقة النص البسيط والعفوي والمُنثال زمنيًا في شكل خطّي لا تقديم فيه ولا تأخير، لا تفلسف ولا تلاعب في الزمن مُقنع او مُفتعل. نبدأ مع الكاتب والأحداث تباعاً من مخيمه حيث ولد وننتقل معه مرحلة مرحلة، إلى الأردن، ثم سورية، ثم بلغاريا، ثم تونس، ثم الأردن وسورية، وانتهاءً إلى عودته مع من عاد وفق توافقات اوسلو. عفوية راسخة لا تنتقص من عمق ما ترويه او قسمات شخوصه. يمرّ في النص بشر كثيرون يتبعون أزماناً وأمكنة متفاوتة، وعلى رغم سرعة عبورهم يتم التقاط ملامحهم ورصدها بدقة.
مردّ ذلك، غالباً، حرارة السرد الذاتي وتعبيره عن تجربة عاشها الكاتب نفسه او عاش اكثر تفاصيلها. لا يحفل النص المسرود خطياً بأي فذلكة او تشاطر او إقحام لـ «أدوات التجريب» في الصنعة الروائية. يكتب عوض الله «السفرجلة» وهي روايته الأولى بثقة من يسند ظهره إلى تاريخ عريق في كتابة الرواية، كأنما يمدّ ساقيه فوق بعضهما بعضاً لتستريحا على جبل رواياته الخمسين السابقة! اين يكمن سرّ هذا النص الواثق الذي ينسال في شكل تقليدي عادي لكنه يتمتّع بسحر داخلي غامض؟
ليس لنا في البحث عن الإجابة إلا العودة ثانية إلى التمهيد «السفرجلي» في اول الرواية والذي يشير إلى أن «الحياة أشد فجوراً من خيالاتها». هي هذه إذن لا غير. ما يتكىء عليه عوض الله هو فجور الحياة التي رافقها ورافقته مخيماً مخيماً، وبؤساً بؤساً، وخيبة خيبة، وفرحة فرحة، ومتعة متعة، وامرأة امرأة، ومدينة مدينة. في كل تلك الأزمنة والأمكنة كانت آمال وأحلام ما تسبق قضمات السفرجلة، والتي ما ان تنقضم الواحدة منها وتنتهي في جوف فمه حتى تتحلل مراراتها غصات اضافية. لا حاجة إذن سوى للغة تلتقط هذه القضمات كما هي، يكون حبر كلماتها عصارة تلك المرارات، وبعدها فليذهب كل التفلسف الروائي إلى الجحيم.
لا ترتجل «السفرجلة» اية بطولة زائفة. تقضم وتعصر بطلها الرئيس «وجيه» او هو الكاتب نفسه فلا ترحمه بل تعريه. لا تترك لـ «وجيه» ستراً مستوراً، بدءاً بنذالات الطفولة غير البرئية في تدمير بيارات البرتقال القريبة من مخيم المغازي وهو لم يتجاوز السابعة من عمره، مروراً بنزوات مراهقته وسفالاتها في مخيم اليرموك، وليس انتهاءً بشهوانياته الخمرية والنسائية في بلغاريا. يظل هذا الخط المُعري مرافقاً وموازياً للخط الحزبي والنضالي المهموم صدقاً وإخلاصًا بتحرير الوطن. ليس هنا اي ادعائية في نثر بعض الشوائب «التجميلية»، بل هي في قلب ما يحدث ولا تنفصل عنه، سواء كان ذلك فعلاً بطولياً أم اعتيادياً.
صحيفة الحياة