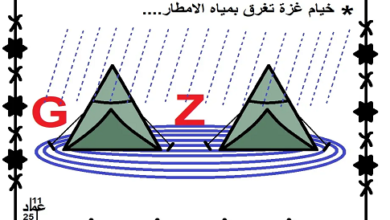رجاء بكريّة: “هوت ماروك”، لياسين عدنان، طوفان الصّخب البشري بامتياز

“.. رواية النّفَسِ القصير الّتي ظلّ عدنان على اعتقاد أنّها أطول ممّا تخيّل تستترُ شيفرتها خلف لهاث تجوبُ جهاتها، وأعني لهاث حيواناتها الموسومة بمهمّاتها واصطداماتها. هي ذاتها الّتي تُحالُ إلى تقنيّة أسلوبيّة بارعة في تعقّب الشّخوص وتحديد مرجعيّاتهم الحيوانيّة، ووفق ذلك يصبح الصّراع لسعا وضربا ودَوسا، جرّاً وعضّا كأنّ الحيثيّات تعيدنا غصبا لِلّغَةِ الغابويّة الّتي اجتهد البشر كي يتركوها فعادوا طَوعا إليها.. “
هل سرّ ما يحدث في رواية “المغرب السّاخن” اللّغة وتشظّياتها، أم أنّه الحرص غير العادي على التّبديل السّريع لمنخفضات مكانها ومناخات شخوصها؟ وأعني مستويات اللّغة المتفاوتة بين العاميّة القحيحة لمرّاكش المدينة، الفصحى البسيطة والعالية فيها؟ أهي السّلاسة أم جاهزيّة الحدث؟ أهي المرأة أم الرّجل؟ أهي الفئران والجرذان أم السّراعيف الّتي تلوي العنق في كلّ زاوية؟ أهو العشق، ولا عِشقَ يُشهَد لهُ هنا، أم أنّهُ الحياد البارد الماسِح للرّغبة بين حسنيّة ورحّال، حليمة وعبد السّلام.
حتّى هيام فتنتها الأرستقراطيّة لا تغريك بالبحث عن الغواية في جسدها. ثمّة قضيّة أخرى هاجمت ورقي وأنا ألتهم مجرياتها سأصطلح على تسميتها *بكاريزما البشاعة. *البشاعة الّتي تقنعك بجاذبيّتها وتستدرج انحسار مستويات الجمال العام لتوقِعَ بِنَفَسِك وصبرِكَ فتُلاحِقُها مسحوبا لكائناتها العجيبة. لقد انكسرت معادلة الفتنة في هذه الرّواية واستُحدِثَ التّشويه الرّوحي لدى البشر كتعويض عن جوعهم للعشق السّاخن، فمكانهُ ينهض مجتمع كامل في حالة غليان وتخبّطات.
بحيث تسير الأمور وفق منطق الرّاوي الإستثنائيّ، فالجزء المشوّه عند حسنيّة هو عماد، ولدى رحّال الشّخوص الّتي ينتحلها، والمخابرات الّتي يرضخ لإملاءاتها، وعجزهِ الجنسيّ في فراش زوجته ولدى حليمة اللّامبالاة والبرود السّافر، ولدى عبد السّلام اليأس والإستسلام، ولدى هيام السّيطرة والدّلال. هي استراتيجيّة ياسين عدنان ربّما الرّابحة وغير المبرمجة لكسبك والتّحالف معك دون مقابل منذ الحرف الأوّل حتّى الغلاف الأخير. فهل تملك البشاعة بحقّ هذه الكاريزما الكاسحة لتجذبك بهذا السّحر إليها؟ ربّما حين تلتغي أسباب الطّموح للجمال بكلّ مُسمّياته.
والمبنى الرّوائي متماسك رغم رحابة المساحة.غير تقليديّ، ويعتمدُ تجزيءَ الفصل الواحد إلى عدّة أجزاء قصيرة، وهو التّكتيك البنيوي لتحديد استراتيجيّة الأسلوب، الّذي اعتمده الكاتب. ثلاثة أجزاء وإثنان وثلاثون فصلا. هذه التقنيّة الأُسلوبيّة ساعدتهُ على تركيز علاقتهِ بشخوصِهِ وقُرّائِهِ معا. وهي تتحرّك على جبهات تحدّدها مستويات اللّغة. فاللّغة العصبيّة المزدحمة جبهتها ساخنة، واللّغة التّقريريّة جبهتها باردة تقدّم تقارير تفصيليّة لكن ترافقها لكنة السّخرية والفكاهة كي تخفّف من حدّة الصّراعات الدّائرة في العلن والخفاء، داخل السيبر، في الشّارع، السّجن مثلا وسائر الجبهات الموزّعة طولا وعرضا. فالكوميديا السّوداء هناك مجنّدة على مقاس الشّخوص تماما ولا ينقصها سوى فنيّة العرض الّتي يقدّمها الرّاوي عبر سيرك العرائس الّذي أشرنا إليه سابقا بدراية مثيرة.
بانوراميّة معبّأة حماسا وكلاما، وحوارا ومناكفة، كأنّ راويها لا ينام أبدا! وإذا نامَ فإنّهُ يستفيق مباشرة كي يمسكَ بورقِهِ ويدخل في الأدوار جميعا دفعة واحدة. كأنّهُ لم يغفُ أبدا، ولم ينقطع عن دائرة السّرد. كأنّ (رحّال العويني) لا يعود لحسنيّة أبدا، ولا ينام مع أحلامهِ الّتي تنفخُهُ في غاباتها طرزانا بطلا يهاجِمُ الذّئاب والخونة، قبل أن يستيقظ فأرا ضئيلا لا يقوى على مهاجمة أحد. هذا التّواصل الاجتماعي الغريب بين قطاعات متنوّعة من النّاس وبهذه المرونة والإنسيابيّة تثير شغف القارئ لسرقة أحد الأدوار كي ينفرد بها وينشئ مملكة ديناميّة تعوم داخل المملكة الأم كي يريح فكر ولسان الرّاوي الّذي لا يكلّ ولا يهدأ.
تخبّطات الواقع المغربي السّياسي على وجه الخصوص يعبّئ حتّى جيوب قمصانِهِ، كأنّهُ يختنقُ بها إذا لم يَفِض بمزيجها الفائر. فالهاجس السّياسي يعوم على سطح الخلافات والتحزّبات ويحيل العلاقات الإنسانيّة لقطع كرتونيّة تهوي وتتكسّر بلا وازع، بمثل ما تلتئمُ بلؤم الطّموحات الهشّة الّتي تطحن الأفراد تحت سنابك جشعها. غير مرّة استحضرتُ قصّة قِدْر المهلّبيّة الّذي نسِيَت البنتُ، بطلة قصّتهُ، كلمة سرّهِ كي يتوقّف عن تصنيعَ تلك الحلوى الغنيّة اللّذيذة، فبقيت تُصنّع الحلوى بسرعة جنونيّة حتّى ملأت بها البيت والشّارع والحيّ ثمّ الحواري والمدينة. وياسين عدنان يواصل تصنيع المهلّبيّة البشريّة الّتي تفيض بالأمكنة ومساحات الحوار، حتّى أنّه لا يفكّر باستدعاء كلمة السّر لأنّه لا يرغب بإيقافها.
يعشقُ راويهما الحكي لدرجة أن يجرفا الواحد الآخر بمتعة حقيقيّة، وتواطؤ ضمني على مواصلة الثّرثرة بكلّ لونٍ ممكن. يحرّض جمهوره على نسيانها لكنّه هو نفسه لا ينساها حدّ إثارة حسد القارىء على الوصفة السّحريّة الّتي تأتي بأفواج البشر والأحداث ويجعلها تمشي في رؤوس القرّاء بإيقاعات عالية لا تنسى. وقِدْر المهلّبيّة في الرّواية تُفوّرُ حتّى أنّها تملأ مصيدة الظّلال الحيوانيّة وتفيضُ إلى الشّوارع المجاورة، القاعات والأرصفة والمدينة الحمراء مرّاكش بكلّ ما فيها ولها من مادّة للحكي، والأهمّ إلى كلّ مكان حدّ استحالتهِ لطوفان يجتاح المدينة، يستولي في طريقهِ على القرّاء المندهشين، الّذين يعتلون جرادل تفذفها عناية الرّواي إليهم. أولئك الكُثُر يزدحمون داخل المصيدة ويبدأونَ التّجذيف والمشاركة، ولو عن بُعد في تشكيل تداعيات الحدث.
هذا النّوع من الكتابة يشبه السّحر. أعلنها بحياديّة تامّة. هذه الثّرثرة الفاعلة والمفعِّلة لعالم كامل حولها، رغم رحابة مساحتها مٌختصَرَة قياسا لمسافات الأماكن والأحداث. وهي تنحسر على غفلة منك وتتركك جائعا لما فاتك منها، لتجدّدهُ في مكان آخر دون سابق إنذار. فالصّور، هنا، لا تكتمل دفعة واحدة، إنّما على مزاج ورغبة وتصدّعات تطال الأبطال الموزّعين على جبهات لدى حسنيّة مرّة، لدى حليمة مرّة، لدى الأرملة مرّة وبعضهم لا يُغامرُ كَي يُعلِنَ دورهُ. فالمساحة الجغرافيّة الّتي يستولي عليها الحدث تستدعي هذا التّثوير التّلقائيّ لوجوه عاديّة وإسباغ صفات استثنائيّة عليها. يُنبتها الرّاوي من تربة تكوينها النّفسي، فهو حين يُدوّرُها ويَصقُلُها ينكشفُ عُمقُ العلاقة الّتي تجمعهُ بها. كلّما تواصل مع اصطداماتها الكثيرة ازداد استيعابا لها حدّ امتلاك أفكارها أحيانا..
“.. وأنت تتساءل بلا توقّف، ومن منطلق كونك روائيّا، كيف أمكن للكاتب السّيطرة على هذا الكمّ الهائل من البشر بهذا التّركيز والمرونة؟..” (رجاء.ب)
تراكميّة الحدث وتوالده من ذاته وأبعادهِ بصور تُدهِشُ راويها وقارئها على حدّ سواء جعلت من القارىء مستقبِلا مُشارِكا تَستكمِل مُخيّلتهُ المَشاهِد الغائبة لحسنيّة ورحّال، حليمة وعبد السّلام، هيام وعماد، حليمة وعيّاد، وشلّة الرّجال، السّراعيف والقنافذ، والبقّ الّذي يختبىء في جحورها. يملأون باحة السيبر الّتي كلّما اتّسعت امتلأت أكثر بكلّ النّوعيّات والألوان والأجناس. المرجعيّات وتاريخها تُستعاد وتُستكمل تلقائيّا من حدس القارىء حين يستوليهِ غياب لحظيّ عن التّفاصيل، وهذه المسألة ربّما تثار للمرّة الأولى بهذه الحدّة والتّركيز، وأعني الحضور الإيجابي للقارىء واستحالتهِ لشريك فاعل في صناعة الحدث. كلّ باسمهِ يُستعاد، مدهشٌ أن تلاحقّ هذا الكمّ الهائل من الوجوه بتسمياتها الكاريكاتوريّة الإنسانيّة والحيوانيّة أيضا، وبمثل هذه اليقظة.
وأنت تتساءل بلا توقّف، ومن منطلق كونك روائيّا، كيف أمكن للكاتب السّيطرة على هذا الكمّ الهائل من البشر بهذا التّركيز والمرونة؟ حتّى إذا غاب أحد الوجوه انتشلهُ من آخر الدّنيا ووضعهُ أمامك مغلولا أو حرّا، هذا يتبع المهمّة الّتي أرسله الرّاوي إليها ونسي أن يعود! كـأنّه لم يغب لحظة واحدة. طاقة رهيبة، لا يعاب عليها مهمّة الرّاوي الكلّي وإلّا كان الكلّ سيغرق في بحر المهلبيّة إلى غير رجعة ومعه الحكاية. وأنت تحسد الكاتب على هذا اللّم الهاوي لكلّ ما يصادفهُ، حتّى الحلزون وجد له متكئا مثيرا للضّجيج والفتنة والجمال أيضا. فاتن ومرعب في ذات الوقت أن تتخيّلهُ يحاورُها جميعا ويحفظ تاريخها بمهنيّة تُيسِّر لهُ رسم أبعادها وفق السّياق، ولكن على هواهُ وهذا الأهمّ. على هواه يعني أنّه يكتب بمتعة، يحسّ الكلمات، ملمسَها وإيقاعها شأن فروات حيواناتهِ. يدجّنُ ما شاء منها عبر مواقف يختارها ويحدّدها وفق مزاجهُ ومِزاجها، لكنّها أحداثٌ وشخوصٌ تظلّ تفيضُ شأن قِدر المهلّبيّة. يوقفُ جريانها ليتابعُ البثّ من شارع آخر، ورصيف وقاعة أخرى ما نسيه وحيدا وبلا عائلة.
ولعلّهُ من المُناسبِ هنا أن نذكر أنّ رواية النّفَسِ القصير الّتي ظلّ عدنان على اعتقاد أنّها أطول ممّا تخيّل تستترُ شيفرتها خلف لهاث تجوبُ جهاتها، وأعني لهاث حيواناتها الموسومة بمهمّاتها واصطداماتها. هي ذاتها الّتي تُحالُ إلى تقنيّة أسلوبيّة بارعة في تعقّب الشّخوص وتحديد مرجعيّاتهم الحيوانيّة، ووفق ذلك يصبح الصّراع لسعا وضربا ودَوسا، جرّاً وعضّا كأنّ الحيثيّات تعيدنا غصبا لِلّغَةِ الغابويّة الّتي اجتهد البشر كي يتركوها فعادوا طَوعا إليها..
عبر تقنيّة المدّ والجزر يلاعبنا الرّاوي ويختارُ ما سيتعلّقُ بِدماغِنا مثل علّاقة لمفاتيحَ سيّارة، تخشُّ حينَ يلكُزُ موتورها ويبدأ دورانه في المدينة. الفيض، (المُنحسِر) هو ما أُطلقُ عليهِ (السّرد ضيّق العُنُق) أو الرّواية قصيرة النّفَس، لسرعةِ كلماتها، وتَلاحُقِ حواراتها وغرَقِها في العام الكثيف المزدحم الّذي يمكنُ قصّهُ في كلّ مناسبة لوجود مشاهد في الخضمّ المنفعل تعوِّضُهُ، وأحيانا بلا مناسبة ودون خَربَطَة الحدث، واستدراج القارىء لِياقةِ مكان آخر. تقنيّة ليست بسيطة، غير أنّها هنا مرِنة سلسة، زخِمة وماتعة.
إذا كنتُ تجنّيتُ على الكاتب بداية تعارفي بروايتهِ، فقد استطاع بذات المرونة اللّاوية للكَتِف أن يحيلني لبعض مناصريهِ الأشاوس. فالمرأة السّالبة الرّخوة الّتي تفاجرت مع جميع الرّجال في فترة الجامعة وظهرت تحت التّسمية بقرة وحلوبة أيضا، والأخرى الّتي لكز اليزيد ردفها فثارت وصرخت، وأدارت قفاها للعالم غاضبة ولم تواجه تعريض اليزيد بها، ولم تحاسبهُ أو تؤنّبُهُ عوّضَتْها امرأة الشّارع الأرملة الّتي افترشت حصّتها أمام مدخل السيبر بعنفوان وأنفة. فبينما ظهرت تستدرّ عطف الجموع بِصدقَةٍ عابرة استحالت على غير انتظار إلى لبؤة. وحين خُيِّل للرّجال أنّها كسابقاتها، سيلوى اليزيد يديها ويدوس أنفها انتفضت فجأة أمام تعريضاتِهِ السّافرة شأن حريق، شبّ فأتى على غرورهِ وألقاهُ أرضا أمام الجموع. كانت تهدّدهُ وهي تدعس على رقبته. هذا النّموذج السّاحر الكاسر لا يمكن استحداثَهُ من درجة فالتة أمام دكّان بهذه السّرعة والوثبة لولا أنّ الرّواية كلّها، وبمجملها تسيرُ ضدَّ التيّار، ووفق الإيقاع السّريع الثّائر. هي تحاول نثر غضبها ونقدها واستياءها بالسخريّة ثمّ بالغضب والإدانة. هذا ما انتهت إليه الرّواية، الإدانات غير التّقليديّة لغة وممارسة.
وأضيف أنّ النّماذج الإستثنائيّة لنساء مستهدفات في المجتمعات التّقليديّة دليلة، ورغم ذلك سنعثر عليها في كلّ مجتمع منتهَك، وشرقيٍّ تحديدا لكنّ الفنيّة والحذق والحيلة الّتي لجأ اليها الكاتب قلبت معايير الجائز والممكن ورفَعَتْهُ لمرتبةِ المُلزِم حين جنّدت الأرملة بحركتِها البركانيّة المُدهشِة الشّارعَ بطولهِ وعرضهِ ومحيط السّيبر، تحت طائلة السِّحر، بقّوة ودقّة وإحاطة، ص 449
“..لم يصدق أحدا عينيه. ذاك أن الأرملة الحسناء لم ترفع في وجهه عينيها فقط، بل انتفضت مثل بركان وارتمت بكامل جسدها القويّ على اليزيد. هزّتهُ هزّا ثمّ طرحتهُ أرضا ولوت عنقه. وجد اليزيد نفسه مثل فريسة سهلة بين يديها. أمسكت بخناقهِ، ثمّ ضغطت على رقبتهِ حتّى جحظت عيناهُ وقالت له:
– إيه، هذا الأبيض ما غا نحيّدوش، هاذو حوايج الخدمة، بحال البلوزة البيضا ديال صاحبك رابح، وإيلا ما فرقتنيش عليك، بربّي حتّى نصبغ هذا الأبيض اللّي ما عجبكش بدمّك يا ولد الكلبة، سمعت؟”
وإذا كنتُ أفرغتُ انفعالا لا يرجوهُ النّقد المتمهّن فإننّي أجيز لنفسي أن أكتب كروائيّة ذوّاقة، هاوية نقد هوائيّ يسافر.
أن أنتمي لفئة الكتّاب الإنفعاليّين الذوّاقة ممّن يتأرجحون على حبال النّقد الهاوي الهوائيّ، ومن الّذي يسافر وهو يكتب على مشاغَباتِ الرّيح والهواء يُعتبر تجاوزا للتمهّن الّذي يشعط غالبا متعة التحليق الّذي تضفيهِ الرّوح الحرّة المتحلّلة من رسميّتها على النّقد. وبالمناسبة كي نصل لهذه المرتبة نحتاج أشواطا من التّجربة والممارسة لننقلَ عدوى المتعة لقارئ يعيش في كلّ جهات العالم. فمتعة الكتابة يجب أن تضاهي متعة ما نرشِفهُ من رحيق الرّواية الّتي نتناولها، و”هوت ماروك”، المَوقِعِ الّذي لمَّ آراء البعيد والقريب في حياة منظومة اجتماعيّة كثيفة رحبة مزدحمة صاخبة.
ظلّت النّهايات، وأعني نهايات الأعمال الأدبيّة والرّوائيّة على وجه الخصوص امتحانا حقيقيّا للرّاوي والكاتب على حدّ سواء، والنّهايات المفتوحة الّتي تبقي فكّك موزّعا بين عالمين لا يجيدها كُثُرٌ من الكتّاب، ولو خيّل إليهم أحيانا أنّهم فعلوا. وإغلاق الرّواية تشي بعمق العلاقة بين شخوصها، أبطالها ومهمّشيها، وصراعها المركزيّ وخباياها براويها. لكن أن يختار الرّاوي صدمة أخرى تُضافُ لصدمات كثيرة لفّت بكَ الدّنيا وأعادتك واقفا ليس من الكياسة بشيء. هو يختارُ أن يضرب رأسكَ مباشرة بفكاهة عارضة، لك أن تصدّقها أو ترفضها. يلخمك بحمل مفاجىء لامرأة لا يتوحّد بها زوجها منذ ارتبط بها إلاّ في حلمه، وأعني رحّال لعوينة وحسنيّة. يسردُ المعلومة كأنّهُ يمرّر لك حديثا عاديّا عن وضع عاديّ بينما تقلبُ حسنيّة ظهرها وتذهب إلى النّوم، وهو إلى بطولاته الوهميّة. هذا النّوع من المفاجآت يخرجكَ من عالم الرّواية وأنت تحمل هواجسكَ وفكّك، وجُرحِكِ معا، وإلى تأمّلك قبل أن تسجّل بحنق على كفّ يدكِ، ” أيّها السّرعوف الجبان، لماذا لا تصرخ الآن؟” والشّخصيّة البطلة بمثل ما تستجمع قوّتها من مفارقات الرّواية الكثيرة على طولِ تشابكات الحدث تنفصلُ عن مركزيّتها بصمت. تعتزل دورها وتنكمش.
حجر الزّاوية:
يعترف ياسين عدنان في حوار مصوّر أنّ أحد شخوصهِ الكاريكاتوريّة القصصيّة قد شكّلت مادّة خاما استغلّها لكتابة روايتهِ “هوت ماروك”، وعليه ننتظر أن يعود لنبشِ سائر قصصهِ الكاريكاتوريّة القصيرة كي يكتشف المنجم الخام الّذي فوّت طراوة فحمهِ الرّطب، ربّما تخرج من هناك حجرَة بحجم كتاب من هذا الوزن..
صحيفة رأي اليوم الالكترونية