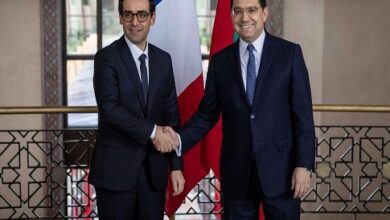فــي كــوالــيس الشــرق الأدنـى إمبراطوريـة إريـك رولـو (ترجمة: ربى الحسيني)
الان غريش*
ترجمة: ربى الحسيني
بدأ الترامواي بالتحرك من هليوبوليس (مصر الجديدة)، «مدينة الشمس»، إحدى ضواحي القاهرة الجديدة. ومثل كل صباح، جلس الشاب مرتاحا ليلتحق بكلية الحقوق المرموقة في جامعة القاهرة في الجيزة. وبينما يمر الترامواي سريعاً بالقرب من واجهات المحال الكبيرة والجديدة، يلفت انتباهه لصوص يكسرون واجهة أحد المحال، فما كان منه إلا أن قفز من مكانه، ورأى المجرمين يهربون في سيارة. نادى على سيارة أجرة في محاولة للحاق بهم. نسي محاضراته، وتوجه مسرعاً إلى مقر الصحيفة اليومية الناطقة بالإنكليزية «الجريدة المصرية» («إيجيبشيان غازيت») حيث يعمل في المساء. يعجب مدير التحرير، كما أنه يفرح، بمقال الشاب. يوقف الطباعة ويغير عنوان الصفحة الأولى: «سرقة في مصر الجديدة» بقلم «صحافي الجريدة اللامع». وفي هذا اليوم من العام 1943، ولد نجم في القاهرة.
لم يكن اسم هذا النجم قد أصبح إريك رولو، ولكن إيلي رفول. لا يبلغ من العمر سوى 17 عاماً، وهو عمر، بالنسبة للبعض، يبقى الأجمل. وقبل عدة أسابيع من هذه الحادثة وبالرغم من نصائح والده، رفض عملاً بأجر أعلى وخلف مكتب أنيق في مؤسسة تأمين، مفضلاً الانضمام إلى «الجريدة المصرية»، فيما يواصل حضور محاضراته في الحقوق في الفترة الصباحية. العناد والفطنة والقليل من الحظ – الحضور في المكان المناسب في الوقت المناسب – ستميزّ حياته المهنية.
يهاجر إلى فرنسا في العام 1952، حيث سيعمل في وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، ومن ثم سيلتحق بصحيفة «لو موند». وخلال عدة عقود، بين العامين 1950 و1980، سيفتح تلك الصحيفة اليومية على العالم العربي، ولكن أيضاً على إسرائيل واليونان وتركيا وإيران وأفريقيا المقبلة على إنهاء الاستعمار، وإثيوبيا، وحتى باكستان البعيدة. وسيغدو الصحافي الشهير في الصحيفة الفرنسية اليومية الأشهر. زميله وصديقه الدائم جان غيراس يشير إلى أن في «امبراطورية إريك رولو، الشمس لا تغرب أبداً»، كما في الامبراطورية البريطانية أو في امبراطورية شارل كنت، الذي أطلق الشعار.
ولـــكن كيـــف لامـــس شارع «الإيطـــاليين» (Rue des Italiens) في باريس، وهو الذي ولـــد في احدى ضـــواحي القاهــرة؟ كيف انتقــــل من «الجريدة المصـــرية» إلى «لو موند»؟ هل هي فجــوة من الصعب تجاوزها؟ أقل مما نتخيل.
كان إيلي فرونكوفونياً، كالعديد من المصريين في ذلك الوقت، أكانوا مسيحيين أم يهوداً أم مسلمين، ومثل العديد من أفراد المجتمعات المتعايشة في مصر من يونانيين وايطاليين فرنسيين أو سريان لبنانيين. الأدب المصري الفرنكوفوني، الذي تم تناسيه بطريقة غير عادلة، لمع بآلاف الأمجاد من إدموند جابس، إلى آلبرت كوسري، مروراً بجورج حنين، وتحول إلى نوع من السريالية، حيث لامس بول إلوار وماكس جاكوب، من خلال فرنسية استثنائية، وغريبة أحياناً، ولهجات تغير لفظ الراء، وعبارات مترجمة مباشرة من العربية.
يصعب علينا أن نتخيل عشقه لفرنسا، وطنه الثاني، الذي استضاف العديد من المصريين. ففي العاشر من حزيران العام 1940، لم يصدق إيلي عينيه ولا أذنيه، فأثناء جلوسهم الى طاولة العائلة للمرة الأولى في حياته، وكان يستمع عبر المذياع إلى نبـــأ استسلام فرنسا، راح والده يجهش بالبكاء. بالنسبة إلى هذا الرجل، المولود في حلـــب، والمتربي في المدارس الفرنكوفونية التابعة لمنظمة «التحالف الإسرائيلي العـــالمي»، كانت فرنسا هي بلد الحرية والعدالة. «القضية الأكبر في حياته، يتذكر إريك رولو، هي قضية درايفوس، فهو يعرف بالتفصيل كل تطوراتها وتقلباتها، كما أنه كان يتحدث عنها تكراراً وبغــــزارة، ويصف بكــــبرياء الاجتماعات العامة والتظاهرات التي شارك فيها للدفاع عن النقيب اليهـــودي الذي اتـــهم بالخيانة لمصلحة ألمانيا. ويقرأ بأسلوب خطابي نصوص إميل زولا وفيكـــتور هوغو، الذي يوقره. كما أنـــه يُغني اقتباساته المأخوذة من خرافات لافونتين». وبعد عدة عقود، تسلم إريك رولو وسام الشرف.
«شعوري وصل إلى أوجه، يتذكر رولو، لأن الرئيس الفرنسي ميتران بنفسه كافأ خدماتي التي قدمتها إلى فرنسا. خُيل لي وكأني رأيت والدي واقفاً في الصف الأمامي حيث الشخصيات التي شاركت في الاحتفال قي قصر الإليزيه».
هذا الشغف بفرنسا كان منتشراً بكثافة. ففي الفترة ذاتها، ذهب هنري كورييل وأخوه راوول، وهما أيضاً مصريان فرانكوفونيان من اليهود، إلى القنصلية الفرنسية للتطوع لمحاربة ألمانيا النازية، وهو ما رفضه القائم بالأعمال بازدراء. وفي القاهرة، كان الاستماع إلى إذاعة لندن تنقل صوت الجنرال ديغول يرتج لفرنسا الحرة، وليس للماريشال بيتان. وفي تشرين الأول من العام 1943، أسس فرنسيون ومصريون من كل المعتقدات، مجموعة «أصدقاء فرنسا» «ليجسدوا تعلقهم بالبلد الذي لم يتوقفوا عن الإيمان بروحه ومصيره».
إيلي رفول لم يكن فقط مصرياً، فرنكوفونياً ومحباً لفرنسا، كان أيضاً «يهودياً». ولكن كيف نُعرف «اليهودي»؟ حاول المعادون للسامية ذلك ولكن من دون جدوى، واخترعوا «عرقاً»، ولكنهم غالباً ما اكتفوا باقتصارهم على ديانتهم. دولة إسرائيل أيضاً لم تستطع ذلك، لأنه ببساطة، كيف يمكن جمع المؤمنين وغير المؤمنين تحت مصطلح واحد، إلى جانب الذين يطالبون بثقافة يهودية أقل أو أكثر غموضاً، وآخرون يرفضونها تماماً؟ هل من الممكن أن يكون الشخص يهودياً باختياره، أو أنه كما كتبها جان بول سارتر، بعيون المعادي للسامية؟
ومثل العديد من الشباب، عاش إيلي أزمة مراهقة وقرر أن يصبح حاخاماً، قبل أن يتراجع ويفقد إيمانه! إذا كانت الدراسات التلمودية قد خسرت الكثير بالتأكيد، فإن مهنة الصحافة ربحت الكثير.
برغم إلحاده، لم ينبذ إيلي أصوله اليهودية، بل بحث من أجل فهم معناها. وفي ذلك الوقت، كان من الصعب الايمان بها، خصوصاً أن الصهاينة كانوا يستفيدون من حرية كاملة للحركة في مصر. كان لدى الوكالة اليهودية سمعة جيدة في شوارع القاهرة، كما أن «كيرين كاييميث لو إسرائيل»، أي «الصندوق القومي اليهودي» الذي أنشئ في العام1901، والهادف إلى تطوير المستعمرات في فلسطين، قد حصل على الكثير من المساهمات في المعابد اليهودية (الكنس). «لم يكن لدى غالبية الممولين دوافع سياسية، بل كانوا يعتقدون أنهم يشاركون في أعمال خيرية»، يتذكر إريك رولو.
اتجه رولو إلى حركة «هاشومير هاتزائير»، أي حرفياً «الحرس الشاب»، وهي حركة صهيونية من اليسار المتشدد. «المئات من المراهقين الذين توافدوا إلى النادي، شاركوا في مسابقات رياضية، وتابعوا محاضرات عن تاريخ اليهود، وشاركوا في حوارات فلسفية برز فيها العديد من منظري الحركة العمالية».
التزم بالفكر الماركسي، لكنه ترك المنظمة بعد عام واحد، مصطدماً بقوميته الضيقة وبعدم اكتراثه بالنضالات في مصر حتى ضد القوى الاستعمارية. «كان لدي صعوبة في الاعتقاد بأن المصريين، بجماهيرهم، معادون للسامية، ولم يكن لدي أي رغبة بمغادرة البلاد»، يختصر رولو.
كان يهود مصر يشعرون أنهم مصريون، ولم تكن صفارات إنذار الصهيونية تسحرهم ولو قليلاً. «الأقلية الصهيونية مستثناة، كتب بشكل جميل جيل بيرو في كتابه «رجل فريد»، الذي كرسه لهنري كورييل. لم يشعر أحد بضرورة وجود دولة يهودية، ولم نشعر بالحاجة إلى نشيد، «العام المقبل في القدس»، في وقت كان يكفي أخذ قطار الساعة التاسعة إلا ربعا للذهاب إلى هناك». وحينما جعل الصراع العربي الإسرائيلي حياتهم مستحيلة، وهم ضحايا في الوقت ذاته لموجات رهاب اليهودية في العالم العربي، ومحاولات الحكومة الإسرائيلية لاستخدامهم وكأنهم الجيل الخامس من المستوطنين، أصبحوا مجبورين على الهجرة إلى فرنسا، الأرض الموعودة الحقيقية.
غالباً ما ترتبط اليوم انتقادات الصهيونية بفكرة معاداة السامية المموهة. أما في القسم الأول من القرن العشرين، فقد نظرت الغالبية الكبرى من اليهود في كل أنحاء العالم إلى المشروع الصهيوني بلا مبالاة، إن لم يكن بعدائية. إيلي فكر أولاً كمصري، متضامن مع مواطنيه، متحد معهم بعيداً عن انتماءاتهم الدينية.
وفي العام 1943، الذي بدأ فيه دراساته في الحقوق وسعيه لأن يصبح صحافياً، تحركت الجامعة المصرية ضد العدو المكروه من الجميع، المملكة المتحدة، القوة الاستعمارية التي تحتل البلاد منذ العام 1882، وتتحكم بالمطر وبالطقس الجميل. وكان شعور الإهانة لا يزال مشتعلاً منذ الرابع من شباط العام 1942، عندما حاصرت دبابات الملكة قصر الملك فاروق، وأجبرته على عزل رئيس الحكومة، وعلى إنشاء حكومة موالية للتحالف مع لندن.
وذات زمن، التفت القوميون المصريون لألمانيا، حتى أنهم انتظروا بفارغ الصبر وصول دبابات إدوين رومل المتجهة بسرعة نحو الاسكندرية، وذلك تحت عنوان مبدأ قديم بقدم العالم: أعداء أعدائي هم أصدقائي. ولكن، منذ خسارة الجنرال الألماني في معركة العلمين في خريف العام 1942، وخصوصاً بعد فوز السوفيات في ستالينغراد، كانت الرياح تجري في مصلحة اليسار: «شاركت، يروي إريك رولو، في اجتماعات عامة وفي تظاهرات حصلت في الكلية. واكتشفت وقتها الماركسيين الذين يمكن تمييزهم عن الآخرين عبر ربط الاستقلال الوطني بالثورة الاشتراكية، والعدالة الاجتماعية، ومحاربة العنصرية. انضم إلى صفوفهم أقباط ويهود ومسلمون تحت عنوان واحد. وفي إحدى الليالي، انضممت إليهم في قاعة نادٍ يديره بطريقة سرية الحركة الديموقراطية للتحرر الوطني، التي أنشأها هنري كورييل، وهي منتدى عام يشارك فيه محاورون يأتون لمناقشة قضايا الساعة العالمية، وكان المنظمون يرفضون نقاش المشاكل الداخلية خوفاً من أن يساهم ذلك في استفزاز الشرطة السياسية. وبالرغم من أنهم كانوا يعتبرون خارجين عن القانون، إلا أن الشيوعيين كانوا يعاملون بتسامح نسبي».
تميز هذا الحراك في شباط العام 1946، بإنشاء اللجنة الوطنية للعمال والطلبة، وبالتظاهرات الضخمة ضد الوجود البريطاني، كان حراكاً سياساً واجتماعياً مشابهاً لذلك التي أشعل مصر في كانون الثاني – شباط العام 2011. شارك إيلي بحماسة، وفي إحدى الاحتجاجات، رأى واحداً من زملائه الشباب يصاب بالرصاص.
إنشاء دولة إسرائيل في أيار العام 1948، فتح الباب خلال عدة سنوات، لمغادرة اليهود من مصر والشرق الأدنى. لم يجد إيلي رفول نفسه، وهو المتهم من قبل حكومة الملك فاروق بعلاقاته من اليسار المتشدد من جهة وهذا حقيقة، وبالصهيونية من جهة ثانية وهذا مجرد خيال، إلا أمام خيارين، السجن أو المنفى، وما يرافقه من التخلي عن الجنسية. مكرهاً، اختار الحل الثاني، ولكن مثل العديد من المنفيين، ظلت مصر في قلبه كل حياته.
في الرابعة والعشرين من العمر، مزوداً بحمل خفيف وبتجربة ثقيلة، وصل إلى فرنسا. لم تحبطه البطالة، وانتهى بأن وجد مكاناً في قسم الاستماع العربي في وكالة الأنباء الفرنسية (آ ف ب): في ذلك الوقت، لم يكن للصحف سوى عدد صغير من المراسلين في الخارج، فضلاً عن وسائل قليلة لمعرفة ما يحصل. فما كان من وسيلة سوى التعلق بالإذاعات المحلية من أجل الحصول على المعلومات.
وفي تشرين الأول من العام 1954، حصل على أول سبق صحافي: «الرئيس المصري جمال عبد الناصر نجا من محاولة اغتيال نُسبت إلى جماعة «الإخوان المسلمين». وفي العام 1955، بدأ بالتعاون مع صحيفة «لو موند»، ومرة أخرى أعطته مصر والأزمة بين ناصر والغرب، فرصة جديدة لتوقيع مقاله الأول على الصفحة الأولى: «سد أسوان سيبنى بالرغم من كل شيء، يؤكدون في القاهرة» (لو موند في 22 – 23 تموز العام 1956). وبعد عدة أيام، مساء 27 تموز، يستمع لمصلحة «أ ف ب« إلى خطاب ناصر، الذي يعلن فيه، بضحكة مجلجلة، متفاجئاً ربما بجرأته، عن تأميم قناة السويس، من أجل تمويل بناء السد العالي، لأن الممولين الغربيين تراجعوا عن ذلك. ولكن إدارة الـ«أ ف ب»، المذهولة بالخبر الجديد، تحافظ لفترة على المعلومة ولا تقرر أن تنشرها إلا عندما تبدأ المنافسة معتقدة أن عبد الناصر لا يجرؤ على هذا القرار.
تلك هي سنوات التعلم. ومنذ ذلك الوقت بدأ الشخص الذي يوقع مقالاته باسم إريك رولو بعبور العالم المليء بالاضطرابات. أرسل سلسلة مقالاته الكبرى والأولى، التي نشرت على مدة ثلاثة أيام بعنوان «إسرائيل، دولة غربية؟». التقى مصطفى برزاني، القائد التاريخي لأكراد العراق، ونمّى معه علاقات استثنائية، كما أن برزاني جعله يعي أهمية المطالب الكردية في الشرق الأدنى. وذهب إلى إيران حيث تحدث عن «الوجه الواحد للعملة»، أي النظام الديكتاتوري والمصاب بجنون العظمة، ما أثار استياء بعض زملائه «المتسامحين» مع نظام الشاه كونه حليف الغرب. ومن ثم يقوم بتغطية الانقلاب في تركيا في 12 أيلول العام 1960، والذي سيسفر لاحقاً عن إعدام رئيس الحكومة. ويصل إلى الكونغو، البلجيكية سابقاً، وهي في طريقها إلى الاستقلال، وحيث مناورات القوى الاستعمارية السابقة والولايات المتحدة أدت إلى اغتيال باتريس لومومبا، بطل الاستقلال، في 17 كانون الثاني العام 1961. وقد لفت نظره حينها، التمرد الذي لحق الإعلان عن وفاة لومومبا. ومن ليوبولدفيل أرسل مقالاً نُشر في الصفحة الأولى بعنوان «قوات لومومبا تطلق هجوماً ضد الإقليم الإستوائي وإقليم كاساي» (26 – 27 شباط العام 1961). كان يواجه كل يوم صعوبات ومخاطر عديدة. عليه سلوك الطريق إلى روديسيا الشمالي (زامبيا الحالية) لإرسال مقالاته إلى فرنسا، التي كانت تنقل وقتها عبر الهاتف.
في المقابل، كان العالم العربي يشهد بدوره أحداثاً تاريخية: إعلان الجمهورية العربية المتحدة، نتيجة وحدة مصر وسوريا في شباط العام 1958، الانقلاب الجمهوري في العراق في تموز العام 1958، ظهور الجمهورية اليمنية في الشمال وبداية الحرب الأهلية في العام 1962، الخ. ولكن كيف سيكون بإمكانه الكتابة عن الدول العربية، وهو الذي لا يزال ممنوعاً من دخولها بسبب أصوله اليهودية؟
في وقت من الأوقات، بدأ بالتفكير بالتخلي عن زاوية «الشرق الأوسط»، في «لوموند» وحصل ما لم يكن متوقعاً (الحظ مرة أخرى؟): دعوة من ناصر شخصياً لزيارة القاهرة في بداية صيف العام 1963. يُفصل إريك رولو تسلسل أحداث عودته إلى البلد الذي ولد فيه في الجزء الأول من هذا الكتاب. وبالتالي بعد حصوله على الشرعية من الممثل الأكثر شعبية للقومية العربية، يجد فجأة كل أبواب الشرق الأدنى مفتوحة أمامه. وخلال العقود المقبلة، سيقابل كل قادة المنطقة، من الملك حسين إلى ياسر عرفات، من صدام حسين إلى معمر القذافي، مروراً بآية الله الخميني وحافظ الأسد. إذا كانت هذه الرواية مركزة فقط على مصر، إسرائيل وفلسطين، فإن مهنة إريك رولو أخذته إلى آفاق جديدة، فقد غطى تحديداً سقوط الكولونيلات اليونانيين، الانقلابات في تركيا، فضلاً عن الخطوات الأولى للثورة الإسلامية الإيرانية.
كما أنه، في ما يعكس فطنة الصحافي الجيد، كان في كل الأوقات في المكان المناسب وكأنه على موعد مع التاريخ: في القاهرة في حزيران العام 1967 خلال الضربة الإسرائيلية، في عمان في العام 1970 أثناء المجازر التي ارتكبها الجيش الأردني ضد الفلسطينيين، في القاهرة مرة أخرى في 28 أيلول العام 1970، اليوم الذي توفي فيه، وبطريقة غير متوقعة أبداً، الرئيس ناصر، في نيقوسيا في العام 1974، خلال محاولة الانقلاب على الرئيس مكاريوس (القبرص واليونان شكلا لفترة طويلة جزءاً من «امبرياطوريته» في «لو مونـــد»، في ما يعــــكس رؤية بريطــانية جداً لـ«الشرق الأوسط» الذي ضم اليونان وقبرص وتركيا في مجموعة واحــدة).
غالباً ما استُقبل إريك رولو بتشـــريفات استثنائية، فأقام في الفنادق الكبرى حيث يكرس المسؤولون غرفة جلوس للقائه، للاعـــتراف، وللكــشف له عن الحقيقة، الأمر الذي لم يخل من إشعال غيرة البعض من زملائه.
دولة واحدة بقيت خارج تلك القاعدة: إسرائيل. بالطبع، استطاع، كما يذكر هو في الكتاب، إجراء مقابلات مع دايفيد بن غوريون، وغولدا مئير، وموشيه دايان، واسحق رابين، وشيمون بيريز. ولكن مناحيم بيغين، زعيم اليمين، رفض مقابلته على اعتبار أنه «عميل مصري». وفي باريس، يتذكر جان غيراس، «لقد كان ملاحقاً من السفارة الإسرائيلية عن طريق رسائل يومية من «قراء غاضبين» موجهة إلى مدير لو موند». فبالنسبة لقادة «الدولة اليهودية»، في السبعينيات من القرن الماضي، كان إريك يعتبر أكثر من عدو، بل خائناً، يعيش فيه «الكره للذات».
لم يكونوا قادرين على فهم أنه عكس ذلك، فهو رجل يحمل التقليد اليهودي الذي هم يسعون إلى دفنه، التقليد الرافض للقومية المغلقة، والمتضامن مع جميع المضطهدين. واحد من أصدقائه، شحاته هارون، وهو محامي يهودي مصري رفض مغادرة مصر حتى مماته، كتب على ضريحه المرثية التالية:
أنا أسود عندما يضطهد السود
أنا يهودي عندما يضطهد اليهود
أنا فلسطيني عندما يضطهد الفلسطينيون
يحب إريك أن يروي «عودته» إلى المنـزل الذي ولد فيه، في مصر الجديدة. في أواخر الستينيات. يقرع جرس المنزل، برفقــــة زوجته روزي، ويلقى استقـــبالاً لطيفاً من السكان الجدد، ويروي لهم قصته. مذهولاً، يراهم ينفـجرون بالضحك: إن من يسكن منزله فلـسطينيون، وسخرية اللحظة تقفز أمام أعينهم جميعاً. فتربطه بهؤلاء المقتلعين من جذورهم، من دون مأوى ومن دون وطن، صداقة، ويــشعر وكأنه جارهم.
هو الذي قاسى خلال الوقت خيبات الصراع العربي الإسرائيلي على دول المنطقة، وعلى التعايش بين المجتمعات، وعلى روح التسامح، يتمنى أكثر من أي أحد السلام العادل، وبناء الدولة الفلسطينية وهو مقتنع بأنها ستحقق الأمن لكل المنطقة. وفي عدة مناسبات، وكما يفصل في هذا الكتاب، قام بدور الوسيط بين إسرائيل والدول العربية، مستبدلاً ثياب الصحافي بثياب الديبلوماسي. وسعى خاصة في العام 1970 إلى تنظيم زيارة لناحوم غولدمان، وهو رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، إلى القاهرة. ولكن المبادرة فشلت بسبب الرفض القاطع لقادة حزب العمل، وكان على إريك أن يستنتج، خصوصاً بعد اتفاقيات أوسلو التي رحب بها، أن كل مبادرة سلام خرّبها المسؤولون الإسرائيليون.
تأثير إريك، وتألقه يعودان بدرجة أولى إلى موهبته، ومعرفته باللغة العربية، وقدرته على التواصل والاستماع. ولكنهما أيضاً يعودان إلى هذه الصحيفة التي لا مثيل لها «لو موند»، والتي كان تداولها لا يزال محدوداً، 140 ألف نسخة في العام 1946، و475 ألف نسخة في العام 1969. خلال تلك العقود، كانت هي صحيفة شارع «الايطاليين» الذي يعطي المثال لكل التحليلات السياسية العالمية، وكانت كل البعثات الديبلوماسية تفك رموز «نشرتها إلى الخارج» بدقة متناهية. فالصحافة المكتوبة وُجدت قبل التلفزيون «بنقله المباشر»، قبل ظهور القنوات الفضائية، وقبل المعلومة الاستعراضية حيث الحدث الوحيد ذو قيمة هو الذي نستطيع عرضه على الشاشة. وبالتالي فإن الصحافة المكتوبة كانت تحدد هرمية الواقع، وهي لم تكن بحاجة للقيام بذلك إلى نشر صور مثيرة.
في ثمانينيات القرن الماضي، تغير المشهد الإعلامي. أصبح بالإمكان المشاركة «مباشرة» في الحروب وفي الألعاب الأولمبية. دخلت الصحافة المكتوبة في أزمة، و«لو موند» اهتزت بدورها نتيجة الصراعات على الخلافة. وفي العام 1985، اختار إريك، وبطلب من الرئيس ميتران، مهنة الديبلوماسية. وتم تعيينه سفيراً في عدة دول، بدءاً من تونس، حيث مقر الجامعة العربية (وخصوصاً منظمة التحرير الفلسطينية التي لجأت إلى تونس منذ إخراجها من بيروت في العام 1982)، ثم أنقرة في تركيا. ومن وقتها لم يستفد من ثقافته الواسعة، وتحليلاته، وعلاقاته التي لا تحصى، سوى الديبلوماسيين. وقد لاحظ هو نفـــسه وبروح الفكــاهة أنه انتقل فجأة من مئات آلاف القراء إلى اثنين، وأحياناً واحد فقط هو رئيس الجمهورية.
خلال الاجتماع الأول لسفراء فرنسا في باريس بعد تعيينه، حيث يتعين على كل ديبلوماسي أن يُعرف عن نفسه ويعلن عن اسم الدولة التي أحيل إليها ـ اسم الشخص، أبيدجان، اسم الشخص، الأردن، اسم الشخص، الأرجنتين، إلخ ـ وحين وصل الدور إليه وقف وقال «إريك رولو»، وقال: «العالم». سكوت، لحقته ابتسامة كبيرة انتشرت في القاعة. رأى فرويد في الهفوات التعبير عن رغبة غير واعية. هل يرى إريك نفسه وكأنه سفير صحيفة «لو موند»؟ وكأنه سفير العالم الذي طافه من الشمال إلى الجنوب؟ أو أنه ببساطة سفيرنا، على ضفاف الكوكب، حيث يعلمنا على الطريقة الأفضل فك شيفرة الاضطرابات؟
ـ *مدير تحرير «لو موند» ديبلوماتيك
صحيفة السفير اللبنانية