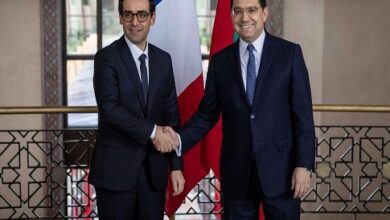فــي كوالــيـس الشـــرق الأدنــى (8) الحرب والديبلوماسية وشارون بينهما هل كـان أشـرف مـروان بطـلاً أم خـائـناً؟ (اريك رولو)
اريك رولو
ترجمة د. داليا سعودي
أفضت حرب أكتوبر (تشرين أول) 1973ـ التي يسميها العرب «حرب العاشر من رمضان»، ويسميها الإسرائيليون «حرب يوم الغفران» ـ إلى تغيير ثوابت النزاع على نحو ظاهر، وافتتاح عهد جديد في الشرق الأوسط. وإذ حظِيَتْ بتغطية إعلامية موسّعة، كان الظنُ السائد أن كل شيء بات معروفاً عن تلك الحرب التي شنتها مصر وسوريا معاً لاسترجاع أراضيهما المحتلة في 1967. لكن يبقى أن قلةً من العارفين بخفايا الأمور كانوا وحدهم على علمٍ بأمر الدور الحاسم الذي لعبه جاسوس بالغ الأهمية في عناصر النزاع. ولم تتم إزاحة الستار عن تلك القصة المتشابكة السرية إلا بعد أربع وثلاثين سنة. ففي الحادي والعشرين من يونيو (حزيران) 2007، عُثر على أشرف مروان ميتاً أسفل بناية أنيقة في أحد الأحياء السكنية الفاخرة في لندن. ولم تلبث شرطة سكوتلاند يارد أن اكتشفت أنه قد تم إلقاؤه من نافذة الطابق الرابع، حيث كان يقطن. وقد أثار حادث الاغتيال وقعاً كبيراً في وسائل الإعلام: فمروان هو صهر الرئيس عبد الناصر، ورجل أعمال ملياردير، اعتاد مخالطة الطبقة الراقية في المجتمع البريطاني، والحكام العرب والمسؤولين السياسيين الغربيين.
وتفجَّرت الفضيحة حين أكدت الصحافة الإسرائيلية أنه كان أكثر جاسوس أفادت منه الدولة اليهودية بين جميع من جندتهم على مر تاريخها. وقبل ذلك بشهر واحد، كان اسمه ومدى موثوقيته قد أثيرا في سجال قام بين مسؤوليْن في الاستخبارات الإسرائيلية، من دون أن يلفت ذلك نظر الرأي العام. ولدى وفاته، تسابق مسؤولون إسرائيليون قدامى في جهاز مكافحة التجسس على مدحه. فقيل عنه بين ما قيل: «كان هبة من السماء»، «كان يزودنا بوثائق في غاية القيمة»، «كان يطلب مائة ألف دولار لقاء كل خدمة يسديها لنا، لكنه كان يستحق أكثر بكثير». هكذا تبيَّن أنه ظل ينقل طوال أعوام تقارير نصية لمحادثات القادة المصريين والسوڤيات، ومعلومات عسكرية لا غبار على مصداقيتها في أعين أجهزة استخبارات القدس.
في الخــامس من أكتوبر 1973، قابل أشرف مـــروان في لندن، بناء على طلبه، زڤي زامير (Zvi Zamir)، رئيس جهاز الاستخبارات ومكافـــحة التجسس الإسرائيلي، «الموساد»، ليعلن له أن مصر وسوريا ستشنــان هجمتهما في اليوم التالي في تمام الساعة السادسة مساءً. وقد نقل زڤي النــبأ على وجــه السـرعة، لكن لم يكن أيٌّ من كبار المسؤولين في موقعه عشية عيد الغفران ذاك، وهــو اليوم المقــدس المخصص للغفران الأعظم في الشريعة اليهودية. وقد وصل الخبر إلى رئيس الاستخــبارات الحربية، إيلي زعيرا (Eli Zeïra)، في صباح اليوم التالي، لكنه تأخــر في نقله إلى غولدا مائير ووزيـر دفاعها الجنرال موشـي ديان. فقــد تشكــك إيلي زعيرا في صحة الخبر، وهو الذي كان دائم الشك في أشرف مروان، لأنه كان يرتاب في كـونه عميلاً مزدوجاً يعمل لصالح مصر.
وإذ خامر ديان شكٌ، قرر ألا يأمر بالتعبئة العامة. وبالاتفاق مع غولدا مائير، اكتفى باستدعاء بعض فئات الاحتياط في تكتم. وفيما كانت تلك العملية في بداياتها بعد، بدأت الجيوش العربية هجومها في الثانية بعد الظهر لا في السادسة مساءً كما حدد مروان.
وحين مات هذا الأخير، طرأ تطورٌ جديد، فقد أسدت له وسائل الإعلام المصرية تكريماً عظيماً، مؤكدةً أنه قد خدع كبار أعضاء الطبقة الحاكمة في دولة إسرائيل طوال سنين عديدة. وكان ذلك حدثٌ غير مسبوق، أن يتم الإعتراف والاحتفاء بجاسوس في بلدين متعاديين في الوقت نفسه. وبشيءٍ من الحذر، أشاد الرئيس حسني مبارك به قائلاً إنه كان «وطنياً مخلصاً أدى لوطنه خدمات جليلة لم يحن الوقت للكشف عنها». وكان سلفه، أنور السادات، قد وصف مروان بأنه «بطل قومي»، وذلك حين قلَّده أرفع وسام في الجمهورية بمناسبة تقاعده. وقد حظي مروان بجنازة وطنية، حضرها جمال مبارك، نجل الرئيس، وكافة أعضاء الحكومة ورؤساء أجهزة الاستخبارات.
وفيما امتنعت السلطات في القاهرة عن الخوض بدقة في تاريخه المهني كجاسوس، اضطلع متحدثون شبه رسميون بمهمة رسم ملامح صورته. كان أشرف مروان، ومنى، الإبنة الثالثة بين أبناء الرئيس جمال عبد الناصر قد تعارفا في الجامعة، وجمعهما الحب وتزوجا في احتفال كبير عام 1966. كنتُ في مصر حين نُشرت صور حفل زفاف العروسين السعيدين. بديا آية في الجمال والشباب.. أشرف في الحادية والعشرين من عمره .. ومنى صبية في السابعة عشرة. ومؤسس الجمهورية في سعادة ظاهرة وحبور بتزويج ابنته لابن لواء في حرسه الخاص…
وقد أتيح لي، في الشهور التالية، الالتقاء عرضاً بصهر الرئيس، لكنني لم أفلح في الدخول معه في حديث فعلي. كان متحفظاً، يرتدي نظارات سوداء، ويتحدث بصوت خفيض لا يكاد يُسمع، حسبتُه في البداية مفرط الخجل. ولم أعلم باشتغاله في مكتب الرئيس إلا بعد رحيل عبد الناصر، إذ كان مروان مكلفا بشؤون العلاقات مع أجهزة الاستخبارات. وقد عُين بعد ذلك مستشاراً للرئيس السادات، حيث أوكلت إليه نفس المهام على الأرجح، بما في ذلك حفظ العلاقات مع مختلف أجهزة مكافحة التجسس الأجنبية، سواء العربية منها أو الغربية.
أجمع الإسرائيليون والمصريون على التأكيد على أن مروان قد قدم خدماته للموساد العام 1966. غير أن ما من شيء قد يفسر ذلك المسلك المحيِّر الذي سلكه زوج شاب، لم يكد يتم الرابعة والعشرين من عمره، ويحظى بترحيب أسرة الرئيس واحتضانها. أكدت مصر، على لسان المتحدث شبه الرسمي أيضاً، أن مروان كان ينقل بانتظام وثائق مؤكدة تورد محادثات بين القادة المصريين والسوڤيات. ووفقاً للقاهرة، كان الهدف من وراء ذلك هو تضليل الإسرائيليين. هكذا علمت حكومة غولدا مائير بأن السادات يشكو من عدم حيازة الأسلحة اللازمة لاسترداد سيناء، وأن الكرملين مازال يصم أذنيه عن مطالبه وينصحه بعدم الانجراف في «مغامرة» مآلها الفشل. وقد أشارت وثائق أخرى إلى أن القيادة العليا للجيش المصري ترى عدم إمكانية شن أي هجوم قبل حلول عام 1979. غير أن حكومة السيدة مائير لم يبدر إلى علمها أن تلك المعلومات قد تقادمت منذ تصالحت القاهرة مع موسكو، وهو ما أدى إلى تدفق كميات ضخمة من الأسلحة السوڤياتية إلى وادي النيل.
وفقاً للرواية المصرية كذلك، كان المقصود من تنبيه أشرف مروان للموساد في الخامس من أكتوبر، أي قبل 24 ساعة من بدء الحرب، هو تيسير هزيمة الدولة اليهودية عسكرياً. فبتحديد ساعة الصفر في اليوم التالي في تمام الساعة السادسة مساءً بدلاً من الثانية ظهراً، أعطى مروان الجيش المصري الوقت الكافي لتدمير التحصينات القائمة بطول قناة السويس، والمضي في اجتياح سيناء.
ووفقاً للقاهرة أيضاً، كان مروان قد أقدم على حيلة أقل ما توصف به أنها حيلة شيطانية. إذ كان قد أرسل إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بإنذار كاذب حول قيام الحرب في أبريل (نيسان) من العام نفسه، بهدف إثارة الشك في موثوقية أي إنذار مقبل، سيكون عندئذ إنذاراً صادقاً. وهي حسابات ثبتت صحتها في صباح السادس من أكتوبر حين تردد القادة الإسرائيليون (أكثر من اللازم) في اتخاذ قرار التعبئة العامة، خشيةَ أن تكون المعلومة غير صحيحة للمرة الثانية.
فأيُّ العاصمتين تكذب، ولماذا؟ كان من الممكن الاستغناء عن ذلك السؤال لو أن أشرف مروان قد نجح في نشر مذكراته التي كان قد انتهى من كتابتها قبيل أيام من وفاته. فوفقاً للمقربين منه، كان قد قرر أن يروي الحقيقة كاملة بشأن دوره في حرب أكتوبر. لكن بعد وفاته، سجلت الشرطة البريطانية اختفاء المخطوط والقرص الصلب الخاص بحاسبه. وهو ما يعني إذن أنه قد قُتل لمنع كتابه من الظهور إلى النور.
وقد اتهمت القاهرة الإسرائيليين بأنهم اغتالوه لكي يخفوا عن أعين الرأي العام مدى السذاجة المهينة التي وصمت أجهزتهم الاستخباراتية التي نجح «عربي» في خداعها لأعوام طويلة. وعلى العكس، أكدت القدس أن السلطات المصرية هي التي قتلته حفظاً لماء وجه أسرة جمال عبد الناصر وصيانةً لسمعتها.
لدى وصولي إلى إسرائيل بعد بضعة أسابيع من الحرب، تكررت إشارة المسؤولين ووسائل الإعلام إلى التحذير الذي وجهه عشية الحرب عميل غامض، قيل أحياناً بانتمائه إلى المخابرات المركزية الأميركية (C.I.A)، فيما كان الأمر يتعلق في الواقع بأشرف مروان. غير أن المسألة بدت ثانوية في ذلك الوقت، لما اعترى البلد من اضطرابٍ جم. فقد كان الشعبُ والنُخَبُ نهباً للصدمة التي أحدثتها هزيمة غير مسبوقة، حتى وإن خفف من وطأتها النصر المحرز في المرحلة النهائية من المعارك.
وبعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد اشتهر بأنه لا يُقهر، خاصةً بعد انتصاره في حرب الأيام الستة، زالت عنه تلك الحظوة وفقد سمعته، وأهين شرفه. فقد انهار خط بارليف، تلك التحصينات المشيدة بكلفة باهظة على طول قناة السويس، إنهار كأنه قصر من ورق في غضون أربعٍ وعشرين ساعة. وطوال عدة أيام، توغل داخل سيناء تسعون ألف جندي مصري، وأحد عشر ألف مركبة، وألف دبابة، وتقدموا على جبهة مضغوطة تبلغ مائتي كيلومتر من دون أن يصطدموا بمقاومة تُذكر.
كانت الخسائر كبيرة للغاية. فحتى قبل شن الهجوم المضاد في 14 أكتوبر، كان قد قُتل 3000 مقاتل إسرائيلي، وجُرح 15000 آخرون، بينما وقع الآلاف في الأسر. في وقت قصير، تقدم الجيش المصري داخل سيناء فيما احتلت القوات السورية مرتفعات الجولان، التي كثر الحديث في ما قبل عن «منعتها»، وهو ما أثار دهشة عامة.
حرب الجنرالات
أثناء إقامتي في إسرائيل، شهدتُ، ذاهلاً، ما كان لي أن أسميه في مقالاتي بـ«حرب الجنرالات». إذ انخرط الضباط من ذوي الرتب العليا في حروبٍ كلامية في الصحافة، لم يٌرَ في عنفها من قبل، ليتقاذفوا في ما بينهم مسؤولية ما اصطُلح على تسميته عامةً بـ«الزلزال». وقد كان من بواعث رضاي المهني ما كان من بعض كبار الضباط، ممن كانوا في الخدمة أو خارجها، وممن لم التقهم قبل ذلك قَط، الذين قبِلوا دعوتي للمجيء سراً إلى فندقي، للدفاع عن أنفسهم أو لاتهام زملاء لهم بانعدام الكفاءة. هكذا تسنى لى جمع معلومات ثمينة على الرغم من إسرار محدثيَّ إليَّ بها من دون التصريح بهويتهم.
كان ضغط الرأي العام على قادة البلاد الذين اعتُبروا جميعاً مذنبين قد وصل إلى حد لا يٌحتمل؛ حتى أن وزير الدفاع، موشي ديان، الذي كان يُعد في ما مضى بطل حرب 1967، قد وُصف بالقاتل أثناء مظاهرات عاصفة، فيما سرت العرائض المطالبة بإقالته.
أما السيدة غولدا مائير، التي كانت تُزكَّى حتى عهد قريب بوصفها «الرجل الوحيد المتصف بصفات الرجولة في الحكومة»، فقد حقرتها الجماهير وهتفت ضدها. وكان ثمة مسرح في تل أبيب تمتلئ قاعته عن آخرها بالمتفرجين كل ليلة، وذلك لتقديمه مسرحية تهزأ من طبقة السياسيين بأسرها.
كما وجدت وسائل الإعلام لذةً خبيثةً في التذكير بالتصريحات العنترية التي رددها رجال السياسة عشية الحرب. (ومن ذلك تصريح ديّان بأن «الجيش الإسرائيلي قادر على دحر جميع الجيوش العربية مجتمعة»، وقول شارون إن بلاده هي «البلد الأشد بأسأً في العالم بعد القوتين العظميين»، وادعاء عزرا وايزمان إن إسرائيل قادرة على «مواجهة القوات السوڤياتية وإنزال الهزيمة بها»).
عَزَت وسائل الإعلام تلك التصريحات المتفاخرة المتعالية إلى ما عُرف بـ«التصور» (concept)، وهو المصطلح الذي سكه الإعلام للإشارة إلى مجموعة أساطير استُخدمت للتعبير عن العقلية شبه العنصرية المسيطرة، والمتلخصة في احتقار العرب الذين يُعدون في نظر القادة محض جبناء. «تكفي طلقة نار واحدة كي يفروا كالأرانب»، هكذا خطب أحد الجنرالات بعجرفة في جنوده الذين أقلقتهم رؤية تمركز القوات المصرية على الحدود. وأضيفتْ إلى ذلك الاحتقار الغطرسةٌ الموروثة من حرب الأيام الستة، والإفراطُ في تقديرِ القوة العسكرية التي يتمتع بها الجيشُ الإسرائيلي. وهو ما يفسر العمى الذي أصيب به كبار المسؤولين إزاء مختلف الإشارات المنذرة بدنو الهجمة العربية.
مع ذلك، كان إيلي زعيرا، رئيس المخابرات العسكرية، يمتلك في ملفاته مخططات تفصيلية للمشروعات الحربية الخاصة بمصر وسوريا، التي لم تكن تثير اهتمامه قط. كما كانت بحوزته أيضاً صور فوتوغرافية ملتقطة من الجو لتكتلات القوات المصرية على الحدود والتي لم يكن يرى فيها سوى «مناورات روتينية».
قبل الحرب بيومين، فُسر طرد أسر الخبراء السوفيات من البلدين العربيين، البالغ عددهم حوالي سبعة آلاف من النساء والأطفال، على أنه ثمرة أزمة في العلاقات بين روسيا وحلفائها. وتمت إساءة التقدير مرة ثانية، بشأن رحيل جميع السفن السوفياتية الراسية في الموانئ المصرية والسورية في اليوم نفسه. وفي الخامس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، أي قبل الحرب بأسبوعين، ذهب الملك حسين ورئيس وزرائه إلى إسرائيل لتحذير غولدا مائير من أن الهجوم المصري السوري بات وشيكاً. وكانت بحوزتهما معلومات موثوقة قدمها عملاؤهما في القاهرة ودمشق. لكن إيلي زعيرا وديفيد إلعازر، رئيس أركان الجيش، رأيا أنها معلومات «غير صحيحة». إذ تصورا أن العاهل الأردني يحاول كسب ود إسرائيل أملاً في استرجاع الضفة الغربية المحتلة في 1967.
كما تَغذى «التصور» الخداع من جهة أخرى على الحيل وعمليات التضليل التي احتال بها الخصمان العربيان. وقد كنتُ شاهداً على ذلك خلال زياراتي لمصر قبل الحرب وأثناءها.
تمويه ما قبل الحرب
ففي الأيام التي سبقت اندلاع الحرب، أعلنت الصحف أن جميع الضباط الذين يرغبون في أداء مناسك العمرة سيصرح لهم بالسفر إلى مكة، وأن الرئيس سيجري عما قريب جولةً في الريف. وروجت أجهزة الشؤون المعنوية في مصر وفي سوريا إشاعة مفادها تدهور العلاقات بشدة مع الاتحاد السوفياتي، لأنه مازال يرفض تزويدهما بالأسلحة المطلوبة. كما استهدفت عمليات التعبئة والتسريح المتكررة منذ صيف 1973 تعزيز الطرح القائل بأن الأمر لا يعدو أكثر من مناورات.
وقد كان لـ«حرب الجنرالات» الفضل في إتاحة الفرصة كي ألتقي بأشهرهم للمرة الأولى، ألا وهو الجنرال «أريك» شارون. كانت إسرائيل بأسرها تحتفي به بوصفه «البطل» الأوحد في حرب أكتوبر، وقد حظي في الواقع بالاهتمام الأكبر في الإعلام. ففي هجوم مضاد خاطف، كانت فرقته قد نجحت في إحداث ثغرة في خطوط العدو، وعبور قناة السويس، لتشرع في تطويق أحد الجيشين المصريين المتواجدين في ميدان المعركة. كما كان هو أيضاً من خرق وقف إطلاق النار، ليوقع الهزيمة بقوات الرئيس السادات. وقد بادرني، منتشياً، بقوله: «يعود الفضل إليَّ في تغيير مسار المواجهة لصالحنا على نحو حاسم. فعمليتي هي الأروع والأبدع على مستوى الحرب كلها». غير أنه نسي أن يذكر أن رؤساءَه هم الذين خططوا بدقة لتلك العملية، وأنه قد خالف تعاليمهم، معرضاً بذلك رجاله إلى خسائر في الأرواح فادحة وغير مبررة. كما تناسى أيضاً أنه هو نفسه كان أحد مناصري الوضع الراهن، والمدافع عن الأساطير التي تسببت في وقوع «الزلزال».
ولن يمنعه ذلك عن الإلقاء بتبعة الهزيمة على الجيش، الذي وقع ضحية «تسييس مفرط»، على حد قوله، وعن السخرية من كل ضابط من الضباط غير الأكفاء، مؤكداً أن تعيينهم قد تم بناءً على ولائهم لحزب العمال الحاكم. كان في ذلك يتحدث ضمناً بلسان حزب حيروت اليميني القومي.
وإذ لم يلتزم بواجب الحديث بتحفظ، وقَّعت عليه هيئة أركان الجيش عقوبة «التأنيب»، مما حدا به إلى قطع علاقته بصديقه ومرشده الجنرال ديان، وتقديم استقالته من الجيش، فيـما كانت شعبيــته قد بلغت أوجها، وأشــاد معجــبوه الكُثر بما يتمتع به من «عبقرية»، ولقبته حشود المتظاهرين بـ«ملك إسرائيل».
كان عصيان شارون دوماً مضرباً للأمثال. فعندما كُلِّف في 1953 بشن غارة انتقامية على أثر اعتداء قام به انتحاري فلسطيني، قام هو بنسف جميع المنازل في بلدة «قبية» بالضفة الغربية الواقعة آنذاك تحت الحكم الأردني. هكذا قتل بدم بارد 69 من أهل القرية المذعورين، بينهم نساء وأطفال، ممن لجأوا للاحتماء بأحد المنازل. فقد كان «يعاقبهم» على عجزهم عن منع تسلل المخرب الفلسطيني إلى إسرائيل. ولما كان قد تصرف من دون تلقي تعليمات، فقد صَدم حتى أكثر القادة تعنتاً مثل بن غوريون وموشي ديان بما أقترفه في تلك المذبحة، وإن لم يتخذوا أي إجراءٍ تأديبِي ضده. وقد استنكر ذلك موشي شاريت Moshe Sharett، القيادي بحزب العمال ورئيس الوزراء المقبل. أما الرأي العام، فلم يؤاخذه على فعلته.
مرة أخرى، من تلقاء نفسه، في بداية السبعينيات، اقترف شارون فظائع في غزة. إذ هجمت دباباته على مخيمات اللاجئين، وفي غضون بضعة أشهر، أحالت نحو عشرين ألف منزل إلى رماد. وبلا محاكمات، قام بإعدام العديد من الفلسطينيين المشتبه في موالاتهم للمقاومة. وقد أكسبته تلك «المأثرة» لقب «البلدوزر»، الذي لقبه به مؤيدوه الذين يماثلونه في اعتبار جميع السكان الأصليين، بما في ذلك المدنيون، بمثابة أعداء أبديين.
وهو ما حدا بالجنرال ديان إلى أن يقول ـ ولا نعلم إن كان قوله هذا مدحاً أم قدحاً – : «أريك لا ينهي أبداً عملية قبل أن يُسقط عشرات الضحايا بين أعدائنا». وكان شارون يؤكد ذلك الحكم لا إرادياً بقوله وقد امتلأ عُجباً وخُيلاء: «ما قتلتُ أسرى حرب قط، لأنني أبداً ما قبضتُ على أيٍّ منهم». أما الجنرال بار ليڤ (Bar Lev)، ذلك الرجل العسكري المتميز، رئيس أركان الحرب الأسبق، الذي يحظى باحترام الجميع، فقد أدانه بمنتهى الوضوح، فقال فيه: «شارون رجلٌ بلا ضمير أو مبادئ». وأما الجنرال عزرا وايزمان (Ezer Weizmann)، وهو صنديد آخر من صناديد حرب 1967، فقد كان أكثر قسوة بشأنه فقال فيه: «شارون أشبه بحمض الكبريتيك الذي يبدأ أولاً بإحراق الإناء الذي يحتويه قبل أن يذيبه وينسكب».
كان الضباط المهنيون المُنَشَّأون وفقاً للقواعد البريطانية يزدرونه. وكان شارون يعلم ذلك. وقد ترك الجيش في نهاية أكتوبر 1973، عالماً بأنه يتخلى بذلك عن الوصول إلى المنصب الذي طالما صبا إليه، وهو منصب رئيس أركان الحرب. لكنه سينجح بصورة أمثل بكثير في مساره المهني السياسي، إذ شغل عدة مناصب وزارية، لاسيما منصب وزير الدفاع، قبل أن يصل عام 2001 إلى رئاسة مجلس الوزراء.
شارون ملك اسرئيل
حين حاورتُه غداة حرب أكتوبر، كان شارون يقدم نفسَه على أنه «المحارب»، وهي الصفة التي سيختارها كعنوان لسيرته الذاتية بعد ذلك بعقود. كانت بنية جسمه، وتصرفاته، ولغته تتوافق كلها مع شخصية «العُصبجي» التي عُرف بها. كان طويل القامة، ضخم الجثة، بارز البطن، مشعث الشعر، ذكوري الحركات، جهوري الصوت. وكانت كلماته خشنةً، فظةً، تطفح جرأةً وفُحشاً، وتسعفه دوماً للحطِّ من زملائه في العمل العسكري.
فرض شارون نفسه تدريجياً كزعيم لليمين القومي المتطرف. وحرص طوال حياته السياسية، أيَّما كان المنصب الذي يشغله، على تكثيف الاستيطان داخل الأراضي المحتلة، نظراً لإيمانه بمذهب موشي ديان المعروف بمذهب «الأمر الواقع». وقد صار المدافع الأول عن فكرة «إسرائيل الكبرى». ومع نهاية عام 1973، بعد استقالته من الجيش بفترة قصيرة، علمتُ من الصحف أنه قد اشترى مزرعة عملاقة لقاء مبلغ ضخم من المال يقدر بنحو 1,5 مليون دولار. ولما كانت مكافأة نهاية خدمته كضابط متواضعة، وكانت أسرته القريبة أو البعيدة لا تمتلك أي ثروة، راحت الصحافة تتباحث طويلاً حول مصدر ذلك المال، دون أن تنجح في كشف غموض هذا اللغز. وبعد بضعة أشهر، في لحظة كان يسعى لتبرير موقفه لدى وسائل الإعلام، حظيتُ بلقائه في ملكيته الجديدة والتي سماها «مزرعة الجميز».
كانت المزرعة الواقعة على أطراف صحراء النقب، والمبنية على أطلال قرية عربية صغيرة، تبدو وكأنها حصنٌ منيع. وفي ما وراء السورين اللذين يحميانها، تقوم بعض الأنقاض مقام البلدة الفلسطينية التي دمرها الجيش الإسرائيلي. وتمتد تلك المزرعة، التي تعد بحسب وسائل الإعلام «الأكبر في إسرائيل»، على مساحة أربع مائة هكتار. هناك، ثمة مبانٍ ثلاثة وحمامات سباحة، تحوطها مزارع متنوعة، وهو ما يعد حالة استثنائية في تلك المنطقة الصحراوية القاحلة. بدا شارون مرتاحاً تماماً وهو يمثِّل دوره الجديد كسيد مزارع رفيع الخلق، منبسط المزاج، فصيح اللسان، منساب في حديث عن جمال الطبيعة وعن مشاريعه الزراعية.
على عكس معظم الآباء المؤسسين للدولة، المعروفين ببساطة معيشتهم ونزاهتهم، اعتاد شارون العيش في بذخ صارخ، يثير الشبهات، والاتهامات، والملاحقات القضائية. وقد توصلت بعض التحقيقات إلى تحديد هوية بعض المليارديرات الأجانب الذين يعبِّرون عن إعجابهم البالغ به من خلال تبرعات سخية، يبلغ مجملها بضع عشرات من ملايين الدولارات. فبعد انتخابه في 2001 لرئاسة مجلس الوزراء، وصفته الصحافة بأنه «أكثر رؤساء الوزراء ثراءً في تاريخ إسرائيل»، فيما ندد به اليسار الموالي لحزب العمل بوصفه «السياسي الأكثر فساداً». لكنه أفلت من العدالة، بفضل حصانته البرلمانية، لكن أمكن التوصل إلى إدانة أحد ابنيه، عمري شارون، بتهمة الاشتراك في الجرم، وحُكم عليه بعقوبة بالسجن.
بعد استقالة شارون من الجيش في 1973، اتسم مساره المهني السياسي بدموية أكبر من تلك التي وصمت مشواره العسكري. فحين كان وزيراً للدفاع، شن في يونيو (حزيران) 1982 هجوماً صاعقاً على لبنان، مخلفاً آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين، سواء من مواطني بلد الأرز أو اللاجئين الفلسطينيين، الذين أُغرقت مخيماتهم بسيول من القنابل والصواريخ الحارقة. كما هجمت مدرعاته على بيروت، واحتلت بذلك العاصمة العربية الأولى (والأخيرة) التي لم تكن قد حاصرها جيش الدولة اليهودية قبل ذلك قط. وقد شارفت أهدافه على الاتصاف بجنون العظمة: فهو عازم، على حد قوله، على محق منظمة التحرير الفلسطينية، وقتل زعيمها ياسر عرفات، وإحداث تهجير جماعي للفلسطينيين باتجاه الأردن، التي ستكون دولتهم بعد الإطاحة بالملكية الهاشمية.
وقد أقر في الحكم في بيروت حزباً مسيحياً ينتمي لليمين المتطرف ويدين له بالولاء، بهدف إعادة النظر في الدولة متعددة الأديان التي تأسست غداة الحرب العالمية الثانية.
أما جرمه الأخير فهو سماحه للميليشيات المسيحية باجتياح مخيمين للاجئين الفلسطينيين، هما مخيما صبرا وشاتيلا، حيث اقتُرفت مجازر وحشية، قُتِّل فيها بلا تمييز الرجالُ، والنساءُ، والأطفالُ، والشيوخُ. وقد تم ذبح معظم الضحايا بالسلاح الأبيض بينما كانت صرخاتهم تترامى إلى مسامع جنود الجنرال شارون المتمركزين على قمة بناية مطلة على المخيمين، وواقعة على مرمى حجر.
وقتها، وصل الاستنكار بين الشعب الإسرائيلي إلى أوجه. وندد مئات الآلاف من المتظاهرين في تل أبيب بجرائم «جزار بيروت». وتضررت سمعة الدولة اليهودية في العالم على نحو بالغ. وإذ اتهمت لجنة تقصي الحقائق شارون بأنه «مسؤول بصورة غير مباشرة» عن حمام الدم، تم عزله من منصبه، مما حدا برئيس الوزراء مناحم بيغن، الذي لحقت به مهانة كبرى وانكسار عظيم، إلى اعتزال الحياة السياسية بصورة نهائية، ليموت وحيداً على نحو يثير الشفقة.
فبواسطة خرائط مزورة، خدعه وزير دفاعه طوال فترة الهجوم، بإخفاء أحلامه المصابة بجنون العظمة، التي لم يتحقق أيُّ منها. كما سيذكر التاريخ أيضاً أن شارون هو المتسبب في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لإقدامه على انتهاك المقدسات الإسلامية على نحو أصاب العالم الإسلامي بالصدمة.
فقد أتى بصحبة عشرات من رجال الشرطة المدججين بالسلاح، ليستعرض قوته في ساحة المسجد الأقصى بالقدس لكي يؤكد أن ثالث الحرمين الشريفين في الإسلام يعد جزءاً لا يتجزأ من الوطن اليهودي. فما كان من الإسرائيليين، الذين أرهبهم عنف الانتفاضة إلا أن انتخبوا «المحارب» على رأس الحكومة.
فما كان من الرجل المُخلِّص إلا أن زاد من اشتعال الحريق، بدلاً من أن يخمده، بسبب وحشية القمع وتزايد عمليات الاغتيال التي استهدفت القياديين الفلسطينيين. كما وصل عدد القتلى والجرحى إلى الآلاف بين السكان الأصليين والمئات بين الإسرائيليين.
صحيفة السفير اللبنانية