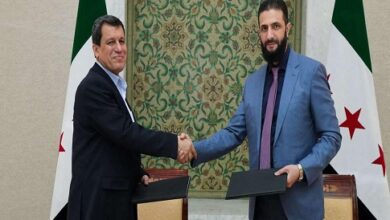نوافذ للحوار| شوقي بزيع: الشعر ليس الاستسلام للغة (حاوره: اسكندر حبش)
حاوره: اسكندر حبش
«فراشة لابتسامة بوذا»، (دار الآداب) عنوان المجموعة الشعرية الأخيرة للشاعر اللبناني شوقي بزيع. وكما استخدم الشاعر في مجموعاته السابقة بعض الرموز المتعددة، يستعمل هنا رمز بوذا «كقناع» يستتر وراءه ليخاطب من خلاله الأشياء والموجودات وربما نفسه في بعض الأحيان. حول الكتاب وبعض الأمور الشعرية، هذا الحوار..
÷ بعد 22 كتاباً، توزعت بين الشعر والنثر (القليل منها)، هل تبدو اليوم الكتابة أصعب عمّا كانت عليه من قبل؟ أم أصبحت أسهل بالنسبة إليك؟
} هي الأمران معاً، هي أسهل بالمعنى الذي يتصل بالحرفة والممارسة الدائمة وشبه اليومية للكتابة، وهي ممارسة لا تتصل بالتمرين على الشعر وحده بل تتصل بالنثر الأدبي الذي أزاوله منذ 3 عقود عبر أعمدة وزوايا ومقالات كثيرة قد تتسع لثلاثين كتاباً فيما لو أردت نشرها. وأنا من القائلين إن على الشعر أن لا يكف عن تنشيط لغته وصقلها ومعالجتها ومرواغتها لئلا تتعرض للصدأ والتأسن والتلبد. النثر بهذا المعنى هو الباب الخلفي للشعر كما ذكرت في مقدمة كتابي النثري «أبواب خلفية».
أما الصعوبة فهي تتصل بالتقدم في السن حيث تبدأ آليات الجسد بالانكفاء وتبدأ الذاكرة بالتراجع وفوران الدم بالذبول. لهذا السبب يسير الشعر عكسياً مع الرواية، فالأول يتطلب هيجاناً في العروق وغلياناً في الأوردة وصهيلا في الروح، في حين أن الرواية تحتمل بنسبة كبيرة على التذكر والاسترجاع والحياة المنطقية. واللغة في رأيي هي عمل جنسي بامتياز. وإذا كان الشعر لغة في اللغة فهو في جوهره روح الجنس وعصبه وتوتره المتعاظم. لذلك ترى الكثير من الشعراء يخلدون إلى الصمت بعد الخمسين من أعمارهم والكثير الآخر يكررون ما سبق لهم أن قالوه والقلة القليلة وحدها هي التي تنقلب على نفسها باستمرار. لكن شرط ذلك أن نحتفظ بكامل حريتنا وكامل طفولتنا وكامل اختلائنا بالشهوة والرغبة في العيش، على أن يقترن ذلك بالكدح وتعميق المعرفة والإصغاء إلى الخفيّ وغير المرئي من وجودنا. لكن الاستمرار في الكتابة ليس ضربا من ضروب المكابرة ولا هو غاية بذاته بقدر ما هو حاجة إلى الانقلاب على النفس وتأثيثها بما هو مغاير ومباغت.
÷ لو أحببت أن أطرح عليك سؤالا حول هذا التأثيث: أي انقلابات تجد أنك قمت بها خلال هذه المسيرة التي تجاوزت اليوم الأربعين عاما؟ أعرف أنه سؤال يخص الناقد أكثر من الشاعر نفسه، لكن هل يعي الشاعر انقلابات تغيراته الكتابية أولا؟
} لم أكن يوماً مطمئناً إلى ما كتبت، قد تكون الأيام الأولى التي تعقب كتابة قصيدة من القصائد هي فسحة الطمأنينة الوحيدة التي تشبه احتفالا بإنزال الحمل الثقيل الذي حملته عن كتفي، إذا لم أتحدث عن فكرة الولادة التي تجعل من الشعراء أمهات بشكل أو بآخر. لكن بعد ذلك يبدأ القلق على القصيدة اللاحقة من جهة والقلق على القصيدة المنجزة التي أتيقن من كونها قد شكلت إضافة ما إلى شعري أو إلى شعر سواي. وهذا القلق هو الذي دفعني إلى الصمت خمس سنوات كاملة ما بين 85 ـ 90 من القرن الماضي. أي بعد أن شعرت بأنني أتحرك في أرض شبه محروثة وبأنني أحتاج إلى فضاءات أخرى لقصيدتي تتجاوز موضوعات المقاومة والمرأة والحنين إلى مسقط الرأس، وهو ما بدا جلياً من خلال مجموعتي الخامسة «مرثية الغبار». أنا أرى بأن هناك مجموعات تأسيسية عند كل شاعر أو مجموعات تشكل انعطافة واضحة في لغته وأسلوبه ومقاربته للعالم. فالشعر في تقديري لا يكمن في الاستسلام للغة وتركها لكي تجرفنا إلى حيثما تشاء، بل يكمن أحياناً في مقاومة إغواء اللغة ومنعها من التدفق العشوائي. وبعد كل مجموعة من هذا النوع تأتي مجموعات لاحقة تقيم في ظلها ثم تبدأ مرحلة ثانية وثالثة وهكذا دواليك.
يمكن لي بهذا المعنى أن أرى انعطافات مماثلة في «قمصان يوسف» و«سراب المثنى» و«صراخ الأشجار» والمجموعة الأخيرة «فراشات لابتسامة بوذا».
قصيدة النثر
÷ قبل أن تتابع عن المجموعة الأخيرة، إسمح لي أن أسأل التالي: ألا تجد أيضاً أن تذوقك، ربما المتأخر، لقصيدة النثر سمحت لك بهذه الإطلالة؟ ما أريد قوله كنت في البداية معارضاً لهذا النوع الكتابي، لكن نجد في السنين الأخيرة أنك من أكثر الذين كتبوا عن مجموعات شعر النثر. هل سمح لك ذلك بتحولات فعلية؟
} إذا كان الفن الحديث قد انتصر للعين على السمع ـ وهذا أمر إيجابي ـ إذا اعتبرنا أن المقصود بالسمع عربياً هو الاحتفاء بالصوت العالي والصراخ الفارغ، فإن جانباً من السمع أمرٌ لا بدّ منه حين يتعلق بالإصاخة والإصغاء إلى الآخرين وبخاصة أولئك الذين لا يشبهوننا أو نشبههم، فالشبيه يعيد الأنا إلى نفسها من دون إضافة كما تفعل المرآة. الآخر وحده هو الذي يثير فضولنا ويأخذنا إلى مناطق الرغبة والدهشة. وموقفي من قصيدة النثر كان وليد تمرين قاس على الانتباه إلى ما يقوله أصحابها بعيداً عن التصنيفات المرتجلة التي كانت تربط هذه القصيدة بسقوط عرش البحور العربية أو بالفوضى والارتجال اللذين يحكمان الكثير من نصوصها.
لقد رأيت في «قصيدة النثر» اقتراحاً جديداً وشديد الأهمية على لغة الشعر لأنها بتخففها من المسبقات الوزنية وغيرها تستطيع أن تقارب الحياة في أكثر جحورها حميمية وألفة وسرية. إنها تبحث عن الصورة الخالصة والمعنى الخالص لأنها محكومة بالكثافة والإيجاز وبالمباغتة الدائمة للقارئ وإلا سقطت في النثر العادي. وأنا أعترف بأن هذه القصيدة قد دفعتني إلى مساءلة نفسي غير مرة عن الحقيقة الشعرية وعن البعد الجمالي الذي لا ينبع من الزخرف أو من فائض الصوت بل من اليومي والمهموس والأكثر التصاقاً بمعنى الشعر.
وهذا ما دفعني للتخفف من القوافي في الكثير من قصائدي والبحث فيما لا يقطع الحالة الشعرية ويبترها بل يشكل عبر القصيدة المدورة الفضاء المناسب للتقصي وحبس الأنفاس.
لكن التصادي بين قصيدتي النثر والتفعيلة كان متبادلا في رأيي وليس على خط واحد، لأن شعراء نثر عديدين أفادوا من إيقاعات القصيدة الخليلية كما من الأبعاد التناظرية للشطور، بحيث يبدو في قصائدهم ملمح إيقاعي واضح ومختلف عمّا يسمى بالإيقاع الداخلي.
عندما أقرأ نصوصاً نثرية لأدونيس في «مفرد بصيغة الجمع» وأنسي الحاج في «الرسولة..» والماغوط من الجيل السابق، وعندما أقرأ لاحقاً لوديع سعادة وقاسم حداد وعباس بيضون، وبخاصة في «صور».. وبول شاوول في «كشهر طويل من العشق»، وعقل العويط وعبده وازن واسكندر حبش (وهذه ليست رشوة بشكل أو بآخر) وزاهي وهبي الذي يكتب قصيدة النثر بروحية الوزن، من الجيل الثالث على سبيل المثال لا الحصر، أشعر بتوتر العبارة وبالشحنة الإيقاعية التي تولد كهرباءها من تجاور الحروف والمفردات من دون أن يتبع ما يكتبونه نظام القصيدة العمودية التقليدي.
لكن لا بد لي من التنويه بأن البعض قد رأى في قصيدة النثر المطية الأسهل لركوب الشعر وللتخفف من كل القيود النحوية والوزنية، في حين أن الشعر الحقيقي هو رقص مع القيود وفق نيتشه. وقد تكون القيود غير الظاهرة في قصيدة النثر هي أكثر وطأة وصعوبة من قيود القصيدة الوزنية.
الإيقاع
÷ أشرت في الحديث عن «سراب المثنى» إلى أن الشكل الإيقاعي يكون مضموناً لذاته أحياناً. وبأن اختياره ليس مجانياً بل هو جزء من البنية النفسية والجمالية للقصيدة؟
} تبين لي من خلال القراءة المعمقة لمعظم ما كتبه العرب من شعر بأن اختيار الشعراء لأوزانهم وإيقاعاتهم لم يكن من قبيل الصدفة المحضة بل جاء نتيجة لطبيعة التجربة نفسها ولعوالمهم النفسية الباطنية التي تفرض اختيار هذا البحر أو ذاك. فليس صدفة على سبيل المثال أن يكون تسعون في المئة من ديوان الحب العذري مكتوباً على البحر الطويل، ذلك أن هذا التنقل المتكرر بين «واو» فعولن التي تؤشر إلى الحرقة والأنين والشعور بالبدد في غياب الحبيب، رغم حرارة الرمال، ليس بالأمر المجاني. وليس أمراً مجانياً أيضاً أن تهبط «ياء» مفاعيلن إلى البئر العميقة لإحساسه بأن العالم يشبه القبر في غياب الحبيبة. ولهذا لم يلجأ شاعر عذري واحد إلى استخدام تفعيلة المتدارك التي تصلح للرقص على سبيل المثال ولحركات سريعة لا تتناسب مع ثقل الزمن العذري المحض. ليس صدفة أن يختار مالك بن الريب قافية الياء المفتوحة في قصيدته الشهيرة التي جاء في أحد أبياتها: «خذاني فجراني ببردي اليكما/ فقد كنت قبل اليوم صعباً قياديا». لأن هذه الياء كانت تحمل وظيفة أخرى متعلقة بنداء المجهول أو الاستغاثة بخشبة خلاص قد لا تأتي أبداً. وهو نفس ما فعله المتنبي في قصيدته اليائية في مديحه القسري لكافور (كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا)..
وحتى في الأدب الشعبي هنالك من وعى ببراعة كيف يزاوج بين البعد الوجداني للتأليف المحكي وبين الوظيفة المباشرة للشعر.
÷ لنعد إلى الكتاب الأخير، لمَ بوذا بالذات؟
} منذ فترة طويلة، وربما منذ ديوان «كأني غريبك بين النساء»، وجدت أن بعض الرموز التاريخية والأسطورية العربية والعالمية يمكن أن تشكل فرصة لإعادة طرح الأسئلة الوجودية المتعلقة بالحب أو الغيرة أو الجمال أو الزمن والموت بشكل مغاير للمألوف ومضيء للكثير من جوانب النفس الإنسانية التي لا تتغير مكابداتها وأسئلتها بتغير الزمن. والكثير من هذه الرموز استخدمته كقناع استتر وراءه لأخاطب من خلاله الأشياء والموجودات وربما نفسي في بعض الأحيان. لقد كنت ديكاً للجن مع «ديك الجن» ومريماً مع مريم ويوسف مع يوسف وبوذا مع بوذا وكنت شجرة مع الشجرة وحجراً مع البيوت المتداعية. وحين تراجع القصائد المستندة إلى الرموز ترى بأنني ألجأ دائماً إلى صيغة المتكلم في الخطاب الشعري لأنني أتماهى مع كل الشخصيات التي قاربتها كما مع عناصر الطبيعة المختلفة. والشعر في جوهره هو تأكيد لوحدة الوجود وهو المدخل المناسب للولوج إلى شخصية بوذا فقد أسرتني هذه الشخصية في تخليها عن المظاهر الخادعة للعيش وهو أمير يافع وثري، وفي بحثه عن الحقيقة خارج المظاهر الخادعة للأشياء. بوذا هو أنا بشكل أو بآخر كما هو أنت ونحن أو أي شخص كان. فهو لم يركن إلى خيار التنسك وقتل الجسد الذي لجأ إليه بحثاً عن المعنى ورأى أن مجانبتنا للشهوات توقعنا في شركها وتجعلنا أسرى لها من دون أن نعلم. وهو لم يشف من شهوات العيش إلا بعد أن استنفدها بالكامل. وحين تحرر من تطلبات الجسد الثقيلة أمكنه أن يصبح خفيفاً وأن يتحدّ مع حركة النهر، أعني به نهر الخليقة العظيم وصولا إلى تلك الابتسامة التصالحية مع الحياة والموت التي قد تكون الابتسامة الأشهر في التاريخ، بالإضافة إلى ابتسامة الموناليزا الملغزة. وبالمناسبة ابتسامة بوذا ليست أقل غموضاً من الابتسامة الأخرى لأنها لا تحمل معنى الطمأنينة فقط بل فيها شيء من الحزن الخفي والسخرية من الحياة.
÷ ثمة مقاربات جديدة في شعرك لموضوعات لم تتطرق إليها من قبل، مثل الفن التشكيلي عن اللون عند حسن جوني، عن ثياب الموتى في «الحياة الافتراضية» الخ..
} في المجموعة الأخيرة حاولت أن أعيد اللغة إلى شفافيتها وتلقائيتها من دون أن أتنازل عن شروط القصيدة الأخرى كالتأمل والتساؤل الوجودي والتقصي المعرفي.. انفتحت منذ أعوام على الفن التشكيلي ورأيت فيه ظهيراً للشعر في خطوطه وموسيقى ألوانه ومدلولاته البصرية وهو ما جعلني أقارب تجربة الصديق الفنان حسن جوني في مواءمتها الناضجة بين الخط واللون بين عوالم الداخل وعوالم الخارج وبين الإنسان وصرخته ضد الألم والفقدان ونقص الهواء والجمال على الأرض.
في قصيدة «تأليف» مثلا انتصرت للغات غير المقروءة التي تنطق بها الأشياء والكائنات الحية ورأيت في وجودها نفسه علامات على الشعر تفوق ما يمكن للغة في تعثرها الشكلاني أن تقدمه أو تفصح عنه.
وفي «ثياب الموتى» لامست ذلك الوجود المسكوت عنه لثياب البشر الذين نفقدهم حيث تتداخل العاطفة مع الخوف والتوجس من ملامسة الحضور الواقعي للموت الذي تمثله الثياب. وكذلك الأمر في «ألزهايمر» و«حياة افتراضية» وغيرها.
÷ غالباً ما تشتكي من غياب النقد الجاد المتابع للتجربة الشعرية عندنا. هل تعتقد أنك أنصفت نقديا؟
} لم يقيض لجيل السبعينيات المواكبة النقدية العميقة والجادة التي واكبت جيل الرواد على سبيل المثال وهو أمر يصعب تلخيص أسبابه في هذه العجالة والتي يعود البعض منها إلى تراجع الأسئلة الكبرى للنهضة العربية وإلى غياب الأسئلة النقدية المتصلة بكل جوانب السياسة والاجتماع والفكر لا بالشعر وحده، ومع ذلك أستطيع ـ على المستوى الشخصي ـ أن ألاحظ اهتماماً بشعري في العقد المنصرم تتمثل بمجموعة من المؤلفات التي صدرت حديثا لكل من المصري كامل الصاوي والجزائري سعيد موفقي واللبناني سعد كمونه والتونسي أحمد الجوه، فضلا عن قراءات نقدية متميزة لصلاح فضل وزهيدة درويش وآخرين. كما ألاحظ أن هناك أطروحات جامعية عدة أنجزت أو هي قيد الإنجاز حول تجربتي الشعرية في جوانبها المختلفة.
÷ لا أعرف إن كانت قراءتي صحيحة ومع ذلك سأسأل: من خلال متابعتي للإصدارات الشعرية الجديدة، أجد أن هناك العديد من الأسماء الشابة، التي تكتب التفعيلة، تقع أسيرة لسطوة شعرك عليهم. هل تجد ذلك صحيحا؟ وإلى ما ترد ذلك؟
} في علم النحو ثمة نوعان من الأفعال، هناك لازمة تحتاج إلى مفعول به وهناك أفعال متعدية تأخذ مفعولا به وأكثر وإذا سحبنا هذا الشيء على التجارب الشعرية نرى بأن هناك تجارب تكتفي بذاتها ولا تنقل عدواها إلى الآخرين، في حين أن تجارب أخرى تستثير شهية الأجيال اللاحقة لمحاذاتها جمالياً أو التناص معها.
لا أعرف إذا كانت موافقتي على ملاحظتك مجانبة للتواضع ولكنني أراها صحيحة بشكل أو بآخر وأنا أتابع بشكل كامل تقريباً ما ينشره الشعراء التفعيليون الشباب، وقد يكون مرد التأثر عائداً إلى حرصي الدائم على المواءمة بين الصدق التعبيري وبين الاشتغال المضني على العناصر الفنية والجمالية والإيقاعية للقصيدة.
وبمعزل عن هذه الإشارة كما عن الهجوم الكاسح لقصيدة النثر على الكتابة الشعرية الحديثة فإن شعراء شباناً عديدين يعملون على منع هذه القصيدة من الأفول وعلى خلق مساحات جديدة لقصيدة الوزن ويمكن أن أسمي من بينهم ربيع شلهوب ومهدي منصور وفاروق شويخ وداوود مهنا.