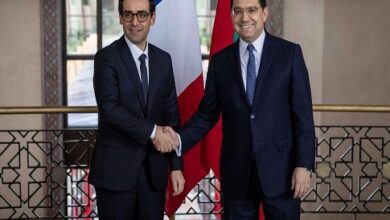هل هي نهاية ‘عملية السلام’؟ (تال بيكر)
تال بيكر
في كانون الثاني/ يناير وأوائل شباط/ فبراير 2012 جرت محادثات "تحضيرية" مؤقتة في الأردن بين ممثلين عن إسرائيل والفلسطينيين بعد أكثر من عام من الجمود. وبما يشبه كثيراً سنوات الدبلوماسية الثلاث التي سبقتها تبدو المحادثات في الأردن وقد أصبحت لها علاقة أكبر مع كون كل طرف يحاول تجنب إلقاء لائمة الفشل عليه بدلاً من التركيز على خلق الظروف المواتية للنجاح.
وإذا لم تكن "عملية السلام" ميتة بالفعل، فإنها إنما تعيش حينئذ في مسرح دبلوماسي زائف يتم فيه تمثيل الخلافات بين الطرفين ولا تمثل إطاراً لحسم هذه الخلافات.
وبالطبع إن الظروف الراهنة، المتمثلة بالانتفاضات العربية في 2011 والمبادرة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة والمفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود وجهود "المصالحة" المتقطعة بين «فتح» و«حماس» والسياسات الداخلية الإسرائيلية والفلسطينية وتمكين المتطرفين والمواجهة مع إيران ومواضيع أخرى كثيرة، لا تخفى على أحد. إن كل هذا معروف بين الغالبية في الدائرة المعروفة باسم "صناعة السلام" بل وهو واضح حتى للمراقبين غير المتعمقين في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.
ويستحث هذا الوضع ثلاثة ردود فعل رئيسية بين مناصري اتفاق إنهاء الصراع. الأول اليأس، وهو الإحساس بأنه من المنتظر بعد هذا الكم الكبير من الجهود والفرص الضائعة أن يُقدر للصراع أن يتدهور وأن يفرض المتطرفون أجندتهم في النهاية، وربما تضيع رؤية إقامة الدولتين.
الاستجابة الثانية هي اللوم. مما لا شك فيه أن التحليل الشامل لنقاط الخلل الهيكلية والسياسات الخاطئة التي ربما تكون مسؤولة عن الجمود المطول هو تحليل له ما يسوغه. لكن للأسف تهبط تلك الجهود باستمرار إلى حوار الطرشان.
والاستجابة الثالثة هي التخيل. إن الفكرة أنه لو كانت قد توفرت فقط بعض العناصر المفقودة (خطاب رئاسي أو خريطة أو قرار من الأمم المتحدة أو اجتماع بين القادة أو مؤتمر سلام) لكان الأمر قد تكلل بالنجاح هي فكرة تمثل نهجاً لا يفعل أكثر من مجرد إظهار تفاؤل مفرط حول ما يمكن إنجازه في ظل الظروف الراهنة. ويسيء هذا النهج فهم تعقد الصراع بشكل جوهري وحجم التوافق الضروري في الأوضاع لإحراز تقدم حقيقي.
ولا شيء من ردود الأفعال الثلاثة هذه – اليأس أو اللوم أو التخيل – يقدم انفراجة كبيرة لأي شخص جاد في تعزيز فرص السلام الإسرائيلي الفلسطيني.
وإذا كان الشرق الأوسط يشهد تغيراً جذرياً فالعقل يقضي هنا بأن التفكير التقليدي عن عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية ربما يحتاج هو الآخر للخضوع إلى تغيير. وللقيام بذلك فليس من الضروري أن نشرد بعيداً عن نموذج حل الدولتين سيما وهو ما يزال الإطار التنظيمي الأكثر حيوية لاتفاقٍ إسرائيلي فلسطيني. لكن من المهم إعادة فحص البنية التحتية للمفاهيم – اللغة والافتراضات – التي توجه عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية، ورؤية ما إذا كانت قد تحملت اختبار الزمن أم لا.
الوضع الحالي
يتم سحب القيادة الفلسطينية في اتجاهات عديدة ومتصارعة. فرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يُقدم رِجلاً ويؤخر أخرى باستقالته ويتأرجح بشكل غير مقنع بين المفاوضات مع إسرائيل وتسريع مبادرة قبول فلسطين في نظام الأمم المتحدة والمصالحة بين «فتح» و«حماس» وصفقة الانتخابات. وحتى لو كانت ضغوط الانتفاضات العربية ومطالب السياسة الفلسطينية ترجح أن اللاحسم من جانبه أمر غير حكيم فإن تبني أي خيار من هذه الخيارات حتى نهايته الطبيعية يتطلب قرارات وتضحيات تبدو بالنسبة له بالذات غير مستحبة.
ومثل كل زملائه في «فتح» لا يثق عباس في خيار التوصل إلى اتفاق سلام ملائم مع الحكومة الإسرائيلية الحالية. لكن ربما الأهم من ذلك أن الوضع الإقليمي والديناميات المميتة للمشهد الفلسطيني الداخلي يجعل هذا بالتأكيد بديلاً غير مستساغ. وفي عصر الانتفاضات الشعبية فإنه ليس بوسعه تحمل التسويات غير الشعبية مع إسرائيل أو الاتهامات ذات المصداقية من قبل «حماس» – التي تجرأت في أعقاب المد الإسلامي في المنطقة وصفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مع الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط – بأنه غير ملتزم بالمصالحة الفلسطينية. وقد تعقد موقفه أكثر بشعور يُعتبر شائعاً في الشارع الفلسطيني وهو أن مشروع بناء الدولة إنما قد وصل إلى نقطة حساسة، بمعنى أن السلطة الفلسطينية تجعل الاحتلال أكثر سهولة بالنسبة لإسرائيل بدلاً من أن تمهد الطريق أمام السيادة الفلسطينية.
غير أن عباس ما يزال يمانع في تحمل عاقبة تجاهله بشكل قاطع لخيار المفاوضات ورؤيته [كسياسي] يعتنق كلية طريق «حماس» أو طريق الأمم المتحدة. إلا أن هذا يتعلق بشكل أقل بتفضيله المبدئي لتسوية تفاوضية أكثر من ارتباطه بعواقب مثل هذا التحرك فيما يخص الثأر الإسرائيلي والأمريكي المحتمل (وخاصة من الناحية الاقتصادية) وكذلك التحديات التي ربما يفرضها هذا الثأر على إرثه وقدرته على الخروج المشرف من السلطة.
وبالنسبة لإسرائيل فقد انحرفت القضية الفلسطينية بشكل كبير عن طورها الرئيسي. كما ينصب الكثير من اهتمام الدولة على الموقف الحاد بشكل متزايد مع إيران والجدل حول الخيارات [المتاحة] لمواجهتها.
وبالنسبة للكثيرين في المؤسسة السياسية الإسرائيلية وفي الشارع نجد أن الضبابية التي خلفتها الانتفاضات العربية (وخاصة مع صعود القوى الإسلامية) ونقص الثقة في الجانب الفلسطيني قد جعلت المفاوضات قضية ذات أهمية ثانوية.
وبالنسبة للولايات المتحدة والعناصر الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة فإن الأوضاع في سوريا وإيران ناهيك عن مصر تمثل مصدر قلق كبير أكثر إلحاحاً.
وفي هذه البيئة وحيث ما يزال مبعوثو اللجنة الرباعية ملتزمين خطابياً باتفاقية السلام إلا أنهم يركزون أكثر على المساهمة بأفضل ما بوسعهم في الحد من الضرر وتثبيت استقرار الوضع.
إن جميع هذه الاتجاهات، مضافاً إليها الاعتبارات الديموغرافية والسياسية، تعزز بعضها البعض كما قد أفرزت ما يبدو على الأقل في الوقت الحالي بأنه جموداً لا سبيل لتجاوزه. وقد أفرز المشهد الحالي جواً خصباً للتصريحات التي تصف "عملية السلام" بأنها ميتة وكذلك الفرصة لإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تصورها.
مراجعة الفرضيات
من المدهش أنه في حين يكثر الحديث عن التغيير في الشرق الأوسط، نجد هناك تغيراً محدوداً في الخطاب والأفكار – في النسق التصوري – التي تصاحب جهود السلام الإسرائيلي الفلسطيني. وتتخذ معظم أجزاء صناعة القرار المحيطة بـ "عملية السلام" مكانها ضمن حدود بالية من النطاق الثابت لتراكيب المفاهيم.
وفيما يلي عدة فرضيات ومواقف تُسمع غالباً من قبل الأطراف أو العناصر الأخرى المنخرطة وتستحق الاهتمام والمراجعة.
"لقد كنا نتفاوض لمدة عشرين عاماً." تُستحضر هذه الفرضية بشكل عام مع إحساس باليأس كدليل على أن الصراع ربما لا يكون مصيره الحسم، نظراً لأن الجهود المستمرة لم تثمر عن اتفاق سلام.
إلا أن هذا خطأ لأن الحقيقة هي أنه في معظم السنوات العشرين الماضية لم تكن الأطراف منخرطة في مفاوضات سلام – قائمة على نوايا حسنة لإنهاء الصراع بل في تقديم حجج تتعلق بالسبب في عدم إجرائهم مفاوضات. ولفترات طويلة كانوا مشغولين إما بالمواجهة المسلحة بكثافات متفاوتة أو بالتأقلم مع تبعات هذه المواجهة.
حتى عندما كانت المفاوضات جارية بكثافة كانت الأطراف تتعامل في الغالب مع الترتيبات المؤقتة والتحديات اليومية وليس مع مشاكل المرحلة النهائية للتفاوض.
وجوهرياً كانت هناك جولتان رسميتان حقيقيتان من مفاوضات الوضع النهائي: في سياق قمة كامب ديفيد عام 2000 وخلال محادثات طابا في أوائل عام 2001 وفي عملية أنابوليس من كانون الأول/ ديسمبر 2007 حتى قرب اندلاع حرب غزة في أواخر 2008. ومنذ 2009 فإن الجهود لبدء مفاوضات بين نتنياهو وعباس قد فشلت في تحقيق بدء محادثات حقيقية عالية المستوى باستثناء اجتماعات قصيرة الأجل في أيلول/ سبتمبر 2010 (والتي كانت في أغلبها شكلية).
وحتى عندما كانت تجري مفاوضات الوضع النهائي فإن بعض القضايا – أبرزها الأراضي والأمن – قد نالت اهتماماً كبيراً بينما هناك الكثير من القضايا الحساسة بالنسبة للاتفاقية (الترتيبات في القدس وإدارة نظام الحدود والعلاقات التجارية وتعويض اللاجئين وأكثر من ذلك بكثير) قد بقيت إلى حد كبير دون أن يمسها النقاش بين المفاوضين الرسميين إلى ما هو أبعد من المبدأ العام. وإجمالاً فإن الوقت الفعلي المكرس للحوار العميق حول مجموعة كاملة من القضايا الخلافية – خلافاً للمراحل التمهيدية والمناورات – كان محدوداً نسبياً، وعند الشروع فيها فإنها قد أنتجت بالفعل على الأقل بعض قفزات التقدم.
وبطبيعة الحال ليس هناك ما يضمن أن المفاوضات الإضافية سوف تثمر عن اتفاق وبالتأكيد ليس في ظل الظروف الراهنة. لكن الفكرة بأن هذا الخيار قد استُنفد هي فكرة مضللة. كما أن التصور بأن الطرفين كانا على وشك الوصول مرتين إلى اتفاق كامل، إلا أن جولة المحادثات قد انهارت، هو أيضاً فكرة تبسيطية.
فالصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو من بين أعقد الصراعات على كوكب الأرض وأشدها مرارة رغم أنه بعيد كل البعد عن أن يكون الأشد فتكاً. بيد، إنه يتطلب انخراطاً مستمراً وكثيفاً وخالياً من توقع الحل السريع. فالصراعات الأقل تعقيداً منه بكثير والتي لا يوجد فيها مثل هذا التلغيم أو المزيج المتفرد من الدين والسياسة والأمن والتاريخ والهوية قد استغرقت أكثر من عشرين عاماً من المفاوضات الجادة للوصول إلى حل. ومثالاً واحداً على ذلك هو الصراع القبرصي الذي شهد العديد من مبادرات السلام المختلفة دون الوصول إلى حل.
"لا شيء تم إنجازه."
هذا التصريح هو نتيجة مباشرة شائعة للفكرة بأن الطرفين كانا منخرطان في مفاوضات عقيمة على مدى عقود. وفكرة أننا لم نقترب اليوم من نموذج حل الدولتين بأكثر مما كنا منذ عقدين من الزمن هي محاولة لوصم عملية السلام ككل بأنها مجرد فشل.
ولا نحتاج أن ننكر العوائق الكبيرة التي تقف حائلاً دون التوصل إلى اتفاق دائم من أجل الإقرار بالتقدم في مجالات مهمة. وفي الوقت التي توجد فيه مثل هذه السلبية تجاه فرص السلام الإسرائيلي الفلسطيني ثمة أمثلة على مثل هذا التقدم: كلا المجتمعين، وبدرجات متفاوتة، قد وصل إلى قبول منطق وضرورة اتفاق حل الدولتين.
وفي هذا الصدد فإن مسافة كبيرة قد قُطعت عندما ينظر المرء إلى أنه قبل بدء العملية كانت الدولة الفلسطينية محل اعتراض من قبل الجميع، باستثناء اليسار المتطرف في إسرائيل، وأن منظمة التحرير الفلسطينية قد رفضت حتى الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. وفي الحقيقة فإن الرئيسين رونالد ريغان وجورج إتش دبليو بوش قد عارضا صراحة قيام دولة فلسطينية بل أن اتفاقيات أوسلو لم تؤكد أن هذا كان هو هدف المفاوضات.
واليوم في الوقت الذي يتعيّن على كل مجتمع أن يناضل لمعارضة هذه المحصلة إلا أن القادة على كلا الجانبين ملتزمون بها على الأقل من حيث المبدأ كما هو الحال مع أغلبيات ثابتة على كلا الجانبين. وقد أصبحت رؤية دولتين تعيشان بسلام وأمن جنباً إلى جنب هي المبدأ الذي ينظم ويشكل الخطاب الإسرائيلي والفلسطيني والدولي حول هذا الصراع. فلم يختار أي من الطرفين أن يتجاهل رسمياً إطار أوسلو واتفاقاته اللاحقة رغم توافر الكثير من الفرص أو الذرائع لفعل ذلك.
ويظل نموذج الدولتين، بغض النظر عن أوجه القصور فيه، هو المعيار المقبول الذي من المتوقع أن يفسر القادة الإسرائيليون والفلسطينيون أو يبررون سياساتهم من خلاله.
ومن خلال وضع ترتيبات الحكم الذاتي وجهود بناء الدولة لاحقاً تحت رعاية رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض (بدعم دولي) بدأت تظهر المؤسسات والبنية التحتية لدولة فلسطينية فاعلة في المستقبل، على الأقل في الضفة الغربية. وثمة تقارير في السنوات الأخيرة من هيئات مثل الأمم المتحدة و"صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" بلغت حد التأكيد على أن السلطة الفلسطينية جاهزة في المجالات الرئيسية للاضطلاع بمسؤوليات إنشاء الدولة. ولا تزال هناك مشاكل حول قضايا مثل حرية الحركة والتنقل وسيادة القانون والتعليم وبسط نفوذ السلطة الفلسطينية في أجزاء من المنطقة "ج" (أي الأجزاء التي تديرها إسرائيل في الضفة الغربية). لكن كانت هناك تحسينات بعيدة المدى في مجالات مثل الصحة والأمن والحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي والبنية التحتية وشؤون الحكم بشكل عام. ورغم هشاشية هذا التقدم والقابلية بأن يُعكس إلا أنه جعل فكرة قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل فكرة ذات إمكانية ملموسة.
وأما الأفكار المتعلقة بالتسوية بعيدة المدى للأراضي أو التنازلات في القدس، والتي كانت ذات مرة غير واردة في إسرائيل، فقد أصبحت الآن جزءاً مشتركاً من النقاش، وإن لم تُقبل كمكونات حتمية للتوصل الى اتفاق. ورغم أن مثل هذا التحرك لم ينل حقه من الذكر والملاحظة بين الفلسطينيين، فمع ذلك كانت هناك تحولات مهمة في موقفهم أيضاً (على الأقل لهؤلاء الفلسطينيين المنخرطين في المفاوضات). وتشمل تلك التحولات على سبيل المثال قبول مفهوم "تبادلات الأراضي" للسماح بضم بعض المستوطنات إلى إسرائيل والاعتراف المتزايد بالحاجة إلى دولة فلسطينية مستقبلية منزوعة السلاح ترافقها قيود أمنية، ومرونة أكبر وهذا قابل للنقاش، حول قضية اللاجئين أيضاً.
وبالطبع فإن هذه الخطوات غير كافية من منظور كل طرف فيما يخص معالجة ما أشار إليه المفاوضون بأنه "منطقة الاتفاق المشترك." لكنها مع ذلك مهمة وساعدت على خلق موقف أصبح فيه الكثير من الإسرائيليين والفلسطينيين معتادين على الخطوط العريضة لاتفاق الدولتين.
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى