«أثقل من رضوى».. الروائية والمصابة
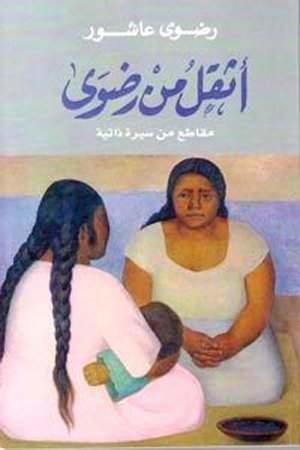
تنهي رضوى عاشور كتابها «أثقل من رضوى» بالدعوة إلى الحياة. لستُ أعرف ما بين هذه الدعوة وبين وفاتها من مقدار، لكني أعرف أن رضوى في كتابها ذاك لم تكن البتة قريبة من الموت، ولم تكن بأي حال ماثلة له. لقد أصيبت بالسرطان وانتقلت إلى الولايات المتحدة حيث أجرت العملية بعد العملية ولم تشعر بأن الموت بات قريباً منها هذا القرب، وأنها تعانيه. فقط العنوان يمكننا أن نستخلص منه ضيقها بالتجربة واستثقالها لها، فرضوى كما نعلم في الأصل اسم جبل وأثقل من رضوى تعني ببساطة أثقل من جبل، وقد ظلت رضوى تحمل هذا الجبل من مصر إلى أميركا إلى ميدان التحرير إلى المستشفى إلى الجراحة إلى البيت بدون أن تئن وبدون أن تشكو وبدون أن تلوم قدرها.
«أثقل من رضوى» هو أيضاً أثقل من سيرة، الكتاب يبدأ ويبدأ معه السرطان والانتفاضة المصرية. ورضوى الأستاذة الجامعية والروائية والناقدة. لا تلبث توازن بين الحالين. لا يصرفها المرض عن الانتفاضة ولا يجعلها تنصرف لها. الكتاب إذاً موازنة بين السرطان وبين الانتفاضة. حين تعود رضوى مع عائلتها من أميركا يكون أول ما تفعله هو الذهاب إلى ميدان التحرير، وحين تكون في أميركا تعيش على أخبار الانتفاضة المصرية، التلفونات التي تتلقاها عنها والأنباء التي تتابعها، عنها.
رضوى الروائية تعرف كيف تروي. لسنا في كتابها أمام مذكرات أو يوميات، نحن أمام رواية، تُحسن رضوى الاختفاء خلف رضوى، تحسن الروائية أن تخفي المصاب، تحسن أن تروي عن نفسها وكأنها ليست هي، لا نجد في كتاب بلغ تقريباً أربعمئة صفحة أي وجدانية مفرطة، أي نحيب وأي رثاء للذات وأي خوف. إن رضوى هي شخصية رضوى، هي بطلتها في عمل روائي. لا نشعر هنا بالوحشة ولا بالرعب ولا بالألم، حتى الألم لا يتألم في كتاب رضوى، حتى الألم لا يستأهل من رضوى سطوراً لوصفه، لذا لا نخرج من قراءة الرواية متشنجين أو مرعوبين. هذا ما كانت رضوى متنبّهة له طوال الوقت فهي لا تلبث تخاطب قارئها، وهي لا تلبث تعتذر له عن تكبيده السماع لشكواها. حين تعود إلى المستشفى بعد أن تكون صرفت صفحات كثيرة للانتفاضة تعتذر للقارئ. على أنها نقلته إلى أجواء المستشفى، الروائية هنا تطغى على المصابة والمصابة توازن بين الروائية والمريضة. ثم أن القارئ حاضر من البداية في نصها.
نحن أمام كاتبة تعتني بقرائها كما تعتني بتلاميذها. الكتاب إذن خطاب للآخر وكتب على هذا الأساس، لم يكتب ليكون نشيداً وجدانياً أو نحيباً خاصاً. لقد كتب من دون تفكير في الموت ومن دون حساب له مع أن كل شيء يدل على أنه وارد، وثمة لحظات من اليأس نفهم منها أنه قريب ومحتمل، تصرّ رضوى على أن تُنهي كتابها بالكلام عن الحياة، وكأنها تعتذر لفرط ما تكلمت عن المرض، ولفرط ما تكلمت عن المستشفى.
عالمان متوازنان، المستشفى بضيقه والمرض الذي ينخر الرأس والخارج الذي يضجّ بالحياة والتمرد والانتفاض. نحن مع رضوى لسنا نزلاء المستشفى فقط، نحن مشاة التظاهرات والصائحون بشعاراتها وهتافاتها. عالمان متوازيان، عالم الرأس المصاب تحت السكين الكهربائية، وعالم الأصحاب والأخوة والتلامذة، بل نحن معها في البيت العائلي، نحن معها لكن أيضاً مع مريد (زوجها) وتميم (ابنها). هكذا نطمئن ونأنس فهذا المناخ البيتي دافئ ومريح، وهذا المناخ البيتي عامر بالحب والرعاية، هذا المناخ يطرد من أمامنا السكين الكهربائية، بل يجعلنا نشعر بالعائلة والبيت والسفر والمعارض والمسارح، كأننا في النزهة وفي السياحة، حتى نكاد نأنس للجو الذي تصفه رضوى وتعيشه، حتى لنكاد برغم ما بها، نحسدها عليه.
تكتب رضوى للقارئ. إنها كاتبة حتى جذورها وخلاياها. إنها كاتبة قبل كل شيء، ولأنها كذلك فهي تكتب حتى هذه السيرة كروائية وكأديبة. إننا هكذا لا نخاف من الكتابة ولا تصيبنا هذه بالكمد والكآبة. الأدب يرفع الأشياء فوق حضيض الهم وفوق الوساوس. الأدب يُرينا الجمال في المعاناة وفي العذابات وفي الكوارث والمصائب. ولأن روضة كاتبة مقتدرة فقد استطاعت، حتى في هذه اللحظات المرة، أن تبقى ممسكة بزمام الأسلوب، واللغة واستطاعت مع كل هذا الخِرْق في رأسها، أن تكون جميلة، وأن تجعل هذا الجمال يمسّنا من قريب. كان أمامنا الأدب، الأدب السلس البديع واللغة المنسقة. بحيث إننا كدنا ننصرف عن موضوع الكتاب المؤلم، إلى رصف جمله وإيقاعاتها وأصدائها. لقد قرأنا أدباً جميلاً، وأجمل ما فيه هو هذه الصلة، التي تكاد تكون التصاقاً، بالخارج، بالأسرة والتلامذة. ما كنا نقدر أن لا نحس ما في ذلك كله من حياة وفرح وصخب حي، ما كنا نستطيع أن ننسى أن الحياة تجري في هذه الجذور والشرايين، وأن رضوى لم تنه عبثاً كتابها بهذه الدعوة إلى الحياة، لم تنه عبثاً كتابها بدون أن تذكر الموت أو تستدعيه وحتى تشير إليه. هذا النص علامة حياة وسيبقى حياً.
صحيفة السفير اللبنانية




