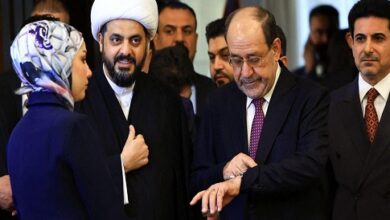“أميركا أولاً” بين ترامب وبايدن

ترامب وبايدن:
التشابه بين الرجُلين لم يأتِ وليد الصدفة، بل تحكمه الظروف الموضوعية العديدة التي تمرّ بها الإمبراطورية الأميركية في حقبة تراجعها.
توقَع كثيرون – أو استبشروا كلٌّ بحسب تموضعه – أنَّ وصول جو بايدن إلى سدة الحكم كان سيفتح مرحلة مغايرة جذرياً لحقبة دونالد ترامب في التعاطي الأميركي مع القضايا الدولية. بُني هذا التصوّر على الفروقات في خلفية الرجُلين وخبرتيهما السياسية، إضافةً إلى لغة خطابيهما المستخدمة، لكن مع الإقرار بوجود تمايز بين طريقة إدارتهما، ولكن غاب عن البعض وجه الشبه بينهما، إذ إنَّ كليهما بنى حملته الانتخابية على فكرة استعادة أميركا مكانَتَها حول العالم بصفتها قائدة “العالم الحر”، وتبعاً سيدة سائر دول العالم، وفي هذا، أولاً، إقرار ضمني بتراجع مكانتها في الساحة الدولية، وأنها لم تَعد كما كانت، وثانياً أن هذا النهج يقتضي بالضرورة بناء صانع القرار سياساته على أساس “أميركا أولاً“.
هذا التشابه بين الرجُلين لم يأتِ وليد الصدفة، بل تحكمه الظروف الموضوعية العديدة التي تمرّ بها الإمبراطورية الأميركية في حقبة تراجعها، ناهيك بـ”الميكافيلية” المتجذرة في العقيدة الأميركية في تعاطيها مع سائر شعوب الأرض.
وقد كان أوَّل امتحان لنهج جو بايدن الذي يفترض أنه مغاير لنهج سلفه في قراره الانسحاب من أفغانستان؛ هذا القرار الذي جاء من دون تنسيق مع حلفاء أميركا في حلف شمال الأطلسي، ومن دون الاكتراث بأبسط موجبات الشراكة التي تقتضي مشاورة الشريك بالحد الأدنى، ما أثار امتعاضاً واسعاً في دوائر قرار دول حلف شمال الأطلسي، وطرح تساؤلات عما إذا كان خطاب جو بايدن في العلن عن “عودة أميركا”، لتكون قائداً وشريكاً موثقاً لدول “العالم الحر”، يطابق الواقع.
على سبيل المثال، خلال ندوة مغلقة أقامتها مجلة “ذي إكونميست” في العاشر من هذا الشهر بعنوان “هل أميركا إلى تراجع؟”، قالت سوفي بيدير (Sophie Pedder)، مديرة مكتب “ذي إكونميست” في العاصمة الفرنسية باريس، إنَّ السؤال المطروح اليوم في العواصم الأوروبية، ولا سيما في فرنسا، ولدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لا يدور حول تراجع أميركا بقدر ما يركّز على إذا ما كانت ما زالت شريكاً موثوقاً، وإذا ما كانت أوروبا في الحقيقة تستطيع بعد اليوم الاعتماد عليها.
وللمفارقة، كان الامتحان الثاني لنهج جو بايدن في طريقة التعامل مع أوروبا والحلفاء عموماً، عندما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية في الخامس عشر من هذا الشهر تأسيس تحالف “أوكوس” الأمني مع كلٍّ من أستراليا وبريطانيا، والذي كان أحد تبعاته إلغاء كانبيرا عقد شراء غواصات قتالية تعمل بمحركات دفع “ديزل” من فرنسا بقيمة تفوق 65 مليار دولار، واستبدال عقد آخر به لشراء غواصات قتالية ذات دفع بالطاقة النووية من الولايات المتحدة الأميركية، ما أغضب الفرنسيين، إلى درجة أن وزير خارجية فرنسا لو دريان “Le Drian” وصف هذه الخطوة بأنها “طعنة في الظهر” من جانب كانبيرا، وأنَّها “ضغط على علاقات الصداقة مع الأميركي”، قبل أن تستدعي فرنسا سفيريها من أميركا وأستراليا.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد أبدى استهجانه لعدم مشاورته في هذا التحالف الجديد. وجاء على لسان جوسيب بوريل (Josep Borrell)، الممثّل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أنَّ الاتحاد عَلِم بإنشاء هذا التحالف عبر وسائل الإعلام فقط، رغم دعوته بعد ذلك إلى تفادي “الدراما” في التعاطي مع هذا الحدث، محاولاً التخفيف من تداعياته على الشراكة الأوروبية الأميركية، ولا سيما بخصوص “استراتيجية الإندو باسيفيك” الأوروبية.
لا شكَّ في أنَّ الخروج الأميركي من أفغانستان يعدّ تحولاً نوعياً في السياسة الأميركية. ومن المؤكّد أنَّ إنشاء الحلف الثلاثي الأمني “أوكوس” يعدّ تبدلاً “جيوسياسياً” رئيسياً على مستوى العالم، حتى إنَّ ستيفن وولت (Stephen Walt) وصفه في مجلّة “فورين بولسي” بأنه سياسة توازن قوى أو توازن تهديد بشكل عمليّ.
ويعدّ هذا الحلف الثلاثيّ نقطة تحوّل في الاستراتيجية الأميركية الطامحة إلى مواجهة الصين، ما يستحقّ بحثاً تفصيلياً مستقلاً، إلا أنَّ ما يهمنا هنا هو تلك المؤشرات الدالة على مدى الاستخفاف الّذي أظهرته إدارة جو بايدن في تعاطيها مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي، والذي لم يشذّ في جوهره عن أسلوب إدارة دونالد ترامب في تعاطيه مع الحلفاء نفسهم. وفي هذا مؤشر على تراجع أهميّة حلف شمال الأطلسي لدى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بما تقتضيه استراتيجيتها لهذه الحقبة الزمنية، التي يبدو أنَّ التصدي لصعود الصين بات أخيراً عمودها الفقري، بعد إخفاق الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في جعله كذلك عبر سياسته الشهيرة “الاستدارة إلى آسيا” التي دشّنها في العام 2012.
وكانت بعض الشخصيات الأميركية الوازنة قد جادلت في صواب ردّ الفعل الفرنسي والأوروبي على استبعادهم عن حلف “أوكوس“، فجادل مثلاً عضو مؤسَّسة “كارنيجي” دانيال باير (Daniel Baer) والسفير الأميركي الأسبق في مجلة “فورين بولسي”، بالقول إنَّ فرنسا محقّة في غضبها بسبب خسارة العائدات المالية من صفقة الغواصات القتالية، لكنها ليست محقّة في غضبها من الاستراتيجية الأميركية، ورأى أنَّ من الخطأ قراءة حلف “أوكوس” على أنّه إعادة تموضع استراتيجي أميركي، لكون تركيز الحلف الاستراتيجي يبقى على “الإندو باسيفيك”، ورأى باير كذلك في الحلف فرصة لتوسيع التعاون في المجالات التقنية والأمن السيبراني ليشمل “مجموعة السبعة” في المستقبل.
رغم هذه النظرة المتفائلة، تبقى الحقيقة أنَّ الولايات المتحدة الأميركية استثنت شركاءها في حلف شمال الأطلسي حتى من مباحثات إقامة حلف “أوكوس”. ويعدّ حصول هذه الخطوة بعد الانسحاب غير المنسق مع الحلفاء من أفغانستان مؤشراً على تبدل النظرة الأميركية لحلف شمال الأطلسي، لا مجرّد هفوة.
وفي هذا الإطار، لا يمكن تجاهل أنَّ بريطانيا كانت الدولة الوحيدة التي انضمَّت إلى التحالف الثلاثي “أوكوس” من بين دول حلف شمال الأطلسي، وهي الَّتي خرجت حديثاً من الاتحاد الأوروبي، ولطالما عدّت نفسها أقرب إلى “أولاد عمومتها على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي”، والتي تتحضّر اليوم لأداء أدوار في العالم بمعزل عن أوروبا.
تطرح كلّ هذه الوقائع أسئلةً عن مستقبل حلف شمال الأطلسي وحقيقة موقعه في الاستراتيجيات الأميركية القادمة. وقد حَدَت هذه التطورات بالفرنسيين إلى إعادة الحديث عن ضرورة اتخاذ أوروبا مساراً “استراتيجياً مستقلاً” أقلّ اعتماداً على التقنيات الأميركية وقدراتها العسكرية، علماً أنَّ مسؤولين أوروبيين آخرين توقَّعوا أن لا تذهب باقي الدول الأوروبية بعيداً مع فرنسا في هذه المواقف.
وفي المحصّلة، بناءً على تطورات شهر أيلول/سبتمبر الحافلة، يبدو أنَّ سياسة “أميركا أولاً” هي التي ستكون حاكمة في المراحل القادمة، وأنَّها لم تكن نزوة “ترامبية”، كما اعتقد البعض، بل هي سياسة مدفوعة بطبيعة الأزمات المتعددة التي تعيشها الولايات المتحدة الأميركية في هذه المرحلة، وبطبيعة الحقبة الأميركية التي يشوبها التراجع الواضح، وبدايات دخول العالم في زمن “الأقطاب المتعددة”. وفي خضمّ هذه التحولات “الجيوسياسية” الكبرى، علينا أن نترقَّب مستقبل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي عموماً ومصيرهما.