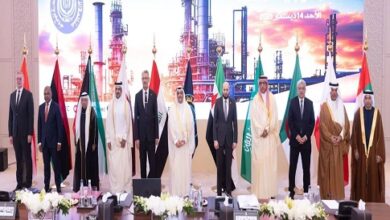أوبرا وعتابا

“تتحسن سمعة الفحم إذا كان الأمر يتعلق بالبخور”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أريد أن أتذكر أول مرة حضرت فيها “أوبرا” في برلين قبل 39 سنة، لم أعد أتذكر اسمها. ولكنني ، بصرياً، ما زلت مندهشاً من فخامة وضخامة المكان، كدهشتي من تلك الأصوات العليا التي كأنها، لفرط قوتها وعلوها، آتية من سماء قصوى غامضة، ولا حدود لعمق رهبتها وجمالها.
في تاريخ دار الأوبرا تلك…أن عشرات القنابل دكتها أثناء الحرب العالمية الثانية، وأن أرشيف صور المكان، المخبأة في مكان آمن، توقعاً للدمار، قد ساعد مهندسي البلد على إعادة إعمار هذه الدار كما كانت. تماماً كما كانت.
كانت دار الأوبرا تلك، والطريق إليها، والقطارات ومحطاتها، والنظافة، والحدائق، وهدوء سلام الحياة… كل ذلك يشبه المستوى الجمالي دائم الجريان والتجدد ،في مدينة لاتوحي عظمتها الراهنه بانحطاط فاشستيتها السابقه. لم يكن هناك حواجز ، ولا تفتيش جيوب، وخاصرات وحقائب نساء. فأنت آمن وسواك آمن، وأنت ذاهب إلى الموسيقى بروح من يعتنق تلك الجملة الذهبية:
“لولا الموسيقى كانت الحياة مجرد…غلطة”.
هناك، بعد أن تستريح في مقعدك، تشمّ رائحة العصور، نكهة الدراما الغابرة، فيما الأصوات تحيط بك لترفعك إلى نشوة الاستماع، بجلال، إلى قصة حب صوتية، تريد إفهامك أن ما تسمعه، في الحقيقة، هو فائض صمت طويل، للعذوبة بكافة أدواتها.
…………………………………………………
قبل الحرب في سورية كنا نذهب إلى دار الأوبرا في دمشق برشاقة البريء، وغير المرشح لتهمة الشبهات الافتراضية، وحتى الذين يتطفلون فيأتون بمزاج سينما “هوّيلو” ـ ذات المقاعد الملوثة بالعادة السرية ـ كانوا يتصرفون بذوق رهبة المكان وانضباط شروط الاستماع فيه. كانت الحياة في سورية، توحّد الناس الذاهبين إلى نشاط ثقافي، تؤنّق سلوكهم، والطريق إلى دار الأوبرا آمن، بلا حواجز، ولا اسمنت، ولا شكوك بنوايا الذاهبين إلى الأوبرا.
اليوم، تذهب إلى هناك بمزاج أنشودة المديح المرتجلة والصاخبة للجيش، وفي طريق لا تستطيع تقدير وقت وصولك إلى الحفلة، فموعدك لن يكون دقيقاً…إن ساعتك معيّرة على الانتظار على حاجز، ومرهونة بألا يكون هناك قنبلة، أو اشتباك. وقد تكون اللهفة القديمة ناقصة ومتوجسة.
في داخل دار الأوبرا…عالم آخر، أنيق ومرتب ونظيف، ولا يشبه عالم الخارج أو ينتمي إليه. ولكن، ثمة شيء مختلف، وغير محسوس في بداية الجلوس والانتظار. كأن يتأخر العرض، ثم يبدأ مبتدئون موسيقيون في عزف غير متقن لمقطوعات مكررة من تراث موسيقي مألوف…وبعد قليل، ربما تتوقع، أن يأتي عازف ربابة، وتحت أكمام ثوبه، الأشبه بنوطة موسيقية، مغني عتابا.
كان السوريون يذهبون إلى قصر الأمويين، أيضاً، على طريق مطار دمشق، ليحضروا حفلاً موسيقياً للفرقة الوطنية السيمفوني، والقاعة تغص، على ضخامتها، بالناس. كان صلحي الوادي، يرفع عصاه لكي “ترن الإبرة” على الأرض صمتاً. وكانت الموسيقى الكلاسيك هي البرنامج دائماً… الموسيقى الاتية من بلاد الفرنجة، ومن العصور الوسطى، كانت تدربنا على الاستماع، والتمتع بغموض هذه الشلالات من الصوت الضوئي. أما الآن فالطريق مقطوع بالقذائف والحواجز، ولا معنى لأي شيء.
فالموسيقى ليست رغيفاً، والحاجز ليس مدخلاً مناسباً إلى قاعة حسنة الإضاءة. وثمة خبز ناقص، وحياة ناقصة.
ذات مرة…خرجنا من دار الأوبرا…
تذكرت، ونحن نعلق على الحفلة، التي مكانها مطعم وليس دار أوبرا، أن أحدهم علق على أداء العازف الأول :
ـ إنه يعزف كما كان شكسبير يعزف.
ـ ولكن شكسبير لا يعرف العزف.
ـ ولا هذا أيضاً.