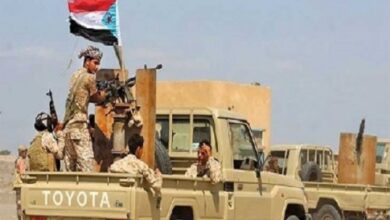أوهام إردوغان في سوريا: واشنطن انتبهت.. أنقرة لم تفعل

سار الميدان السوري طوال السنوات التسع الماضية على وَقْع مشاريع الدول التي رسمت لنفسها مصالح في المنطقة انطلاقاً من الدم السوري، ورأت في فتح الحرب السورية مجالاً لتغيير مشهد الشرق الأوسط برمَّته، ضمن صراع أكبر على توازُنات القوى العالمية ومصادر الطاقة وخطوط نقلها.
فشلت مشاريع القوى الخارجيّة المُعادية للدولة السورية بمُجملها في إخضاعها وفرض تغيير وجهتها الاستراتيجية في المنطقة، وفشلت أيضاً لعبة الإرهاب في السيطرة على البلاد وفرض أمر واقع يؤدِّي إلى سَحْب الأرض من أيدي الحكومة، وثم مُحاربتها وتركيب نظام مُتَّسق مع المطالب الغربية والعربية التي اجتيحت سوريا على أساسها، على الرغم من وصول هذا المشروع إلى مستوى كبير من التحقّق مع سيطرة تنظيم “داعش” بمفرده على نحو 50% من الأرض السوريّة.
إذاً، فشلت الولايات المتحدة في سوريا، وفشلت معها دول الخليج العربية، لكنَّ الفشل الأكثر تذكيراً بنفسه حتى اليوم هو ذلك التركي، الذي انخرط طوال السنوات التسع في تغذية الجبهات السورية بالجهاديين، تحت ذريعة دعم الشعب السوري، وانتهى به المشهد وكيلاً لآخر مجاميع الإرهاب في إدلب.
واشنطن انتبهت.. أنقرة لم تفعل
أظهرت المسألة الكردية في الشمال السوري من بين مسائل أخرى، حجم التضارُب في المصالح بين الأميركيين والأتراك في الأزمة السورية. رسم الأتراك خطوطهم الحمر على ألّا يكون للكرد أيّ وضع خاص شرق الفرات، وألا يتمكَّنوا من مقادير القوَّة إلى الدرجة التي يستطيعون من خلالها تكوين نواة حُكم قادِر على إدارة نفسه، وبالتالي الانتقال لاحقاً إلى الإضرار بالأمن القومي التركي عندما تمتدّ هذه القوّة إلى كرد تركيا.
لكنَّ الأميركيين رأوا خلاف ذلك لفترةٍ طويلة. كانوا يُراهِنون على الكرد ككتلةٍ بشرية وعسكرية مُتمايزة عن المكوِّنات السورية الأخرى، وكصاحبة مشروعٍ مُتجذِّر وهوية قومية، يمكن من خلال تغذيتها تقسيم الجغرافيا السورية، تمهيداً إلى تقسيم البلاد أو استخدامها على طاولة المفاوضات عندما تضع الدول أوراقها لتثمينها وقبض أثمانها.
في السنتين الأخيرتين، لم يتبقَّ في مواجهة الجيش السّوري وحلفائه سوى قوَّتين، بل يمكن تسميتهما تكتلين من القوَّة؛ الكرد من جهة، والتنظيمات الإرهابية في إدلب من جهةٍ ثانية. تخلّى الأميركيون عن الكرد، فانسحبوا من مناطقهم بصورةٍ مُفاجئة. على الأقل، كانت المُفاجأة واضحة على وجوه المواطنين السوريين الكرد عند انسحاب الآليات الأميركية، لكن تبريرات ترامب كانت واقعية بالنسبة إلى كثيرين، فهو لا يريد الانخراط في صراعٍ تركي- كردي غائِر في الزمن.
ولا يعود ذلك إلى استفاقة رؤيوية مُفاجئة في البيت الأبيض، إنما إلى انسداد الأفق أمام استغلال الورقة الكردية، وثبوت جدوى المفاوضات على شيء من النفط، أو على الأقل توفير الجهود للمصارعة من أجله، لكنّ إردوغان لم يفعل ما فعله ترامب، ولم ينسحب من الساحة السورية في الوقت المناسب، بل راهن على أفق مستمرّ لحربه على دمشق.
تقوم رؤيته اليوم على اقتناص مساحة مُعيَّنة من الشمال السوري، وتثبيتها كأمرٍ واقع في الحلّ السياسيّ في ما بعد، على قاعدة أنها المنطقة المُرشَّحة لاستقبال “المُعارضين” العائدين إلى سوريا بعد اكتمال الحل السياسي، وهو يريده حلاً غير مُستدام، أي أن يحمل بذور تفجّره في ذاته “غبّ الطلب”.
لذلك، استمرَّ في دعم التنظيمات الإرهابية في إدلب لمواجهة تقدّم الجيش السوري فيها، وصولاً إلى الاصطدام المباشر معه والتضحية بأرواح الجنود الأتراك، بعد انقلابه في بداية الأحداث على نظرية “الصفر مشكلات”، التي نظّر لها وزير الخارجية السابق أحمد داوود أوغلو؛ الرجل الذي حُمِّل وِزر الفشل التركي في سوريا وأُبعِد، ليكمل إردوغان مشروع الحرب حتى اليوم.
تصوّرات إدلب وما بعدها
يصعب على المُتابعين الواقعيين فَهْم إصرار إردوغان على إكمال معركة إدلب، على الرغم من انسداد الأفق الاستراتيجي لأيِّ انتصار يمكن أن يتحقَّق فيها، فضلاً عن استحالة تأثير أيّة نتيجة لمعركة إدلب في حال النظام السوري والدولة بصورةٍ عامّة في حاضرها ومستقبلها.
يدفع الرئيس التركي اليوم بجنوده في أتون معركةٍ تبدو في كليّتها مبينةً على أوهامٍ قديمة. كيف يمكن للجنود الأتراك تغيير مسار الحرب السورية؟ وخصوصاً أنهم في هذه المعركة يقفون إلى جانب خلاصة الإرهابيين الذين رفضهم العالم ونفض أيديه منهم، في معركة تبدو ساقطةً أخلاقياً وقانونياً، وهي في الحسابات الواقعية أيضاً، تبدو مهزوزةً وغير قادرة على الصمود.
لا منطق متماسكاً في معركة إردوغان في إدلب اليوم. في بداية الحرب، سيقت ذرائع كثيرة أثبتت الوقائع خطأ الكثير منها، لكن بعضها كان مُركّباً على طموحات الناس بالحرية، وتطوير النظام السياسي، ورفض الظلم، والحقوق المعيشية وغيرها.
هذه المُطالبات، وعلى الرغم من ثبوت استخدامها كغطاءٍ ناعمٍ لمشروعات خارجية شرسِة ضد سوريا، فإنها كانت في مرحلةٍ ما مُتماسِكة منطقياً، وجرفت معها شريحة من المواطنين السوريين الذين عادوا منها خائبين، ليجدوا أن لعبة الأمم لعبت بهم وبأحلامهم، وأرادت سَلْب بلادهم خيراتها، لا تمكينهم من هذه الخيرات.
لكن اللافت في خطاب إردوغان والمسؤولين الأتراك الموجّه إلى معركة إدلب هو مُناداته “بحقّ” الجنود الأتراك في الدفاع عن النفس! أين؟ على الأرض السورية!
هو دفاعٌ عن النفس على الأرض السورية، لجيشٍ أجنبي مُحتل ضدّ جيش الدولة السورية نفسها، واستناداً إلى القانون الدولي! الأمر هنا ليس خارجاً عن أبسط ضرورات المنطق، بل إنَّه الوقاحة بعينها. والوقاحة، إن وجدت مَن يُصدّق مقالتها في تركيا، فإنها ستكون مُضحِكةً بالنسبة إلى بقيّة العالم.
كيف ترى الأمم المتّحدة تذرّع محتلٍ بالقانون الدولي للدفاع عن نفسه أثناء ممارسته الاحتلال العسكري؟ وأبعد من ذلك، فهو ليس احتلالاً مستقرّاً رسَّخ مواقعه وبات يُدافع عنها (وهو وإن كان كذلك، فإنه يبقى احتلالاً مرفوضاً وعملاً عدائياً مستمراً)، بل إنه أيضاً احتلالٌ حربيٌ يقود حرباً طازجة وحيّة ومستمرة على الشعب السوري وجيشه.
لكنّ هذه المزحة وجدت في واشنطن مَن يدعمها، فقد أعلنت الخارجية الأميركية أنها تقف إلى جانب تركيا، وأنها “تدعم حقّها المشروع في الردّ على اعتداء النظام السوري على القوات التركية في محافظة إدلب”. ولم يغفل الموقف الأميركي عبارة “السورية” عند ذِكره إدلب! إذاً، هو دعمٌ لجيش تركي مُحتل، ليردّ على محاولة الجيش السوري تحرير أرضه!
هذه المُفارقات الجرمية تثبت مرةً جديدة تعرّض القانون الدولي لفتراتٍ من التجميد القسريّ عندما تتطلَّب مصلحة القوى العالمية المُسيطرة ذلك. هو سارٍ في مفعوله فقط على الضعفاء، وعلى غيرهم في أوقات الرخاء والهدوء. أما في أوقات الحروب واحتدام الصراعات الجيوسياسية وسرقة الموارد، فإن القانون الدولي يدخل في سباتٍ شتوي طويل.
سبات “الربيع العربي“
في العقد الأخير، لم يكن سباتاً شتوياً، بل كان سبات “الربيع العربي”، حيث نام القانون الدولي ليسمح لمشروعات الدول الكبرى بتجاوز سيادات الدول العربية، الواحدة تلو الأخرى. وبصرف النظر عن تفاصيل ما كان من أمور الحُكم السابق، وما حصل في مخاض التغيير، فإن النتيجة اليوم، دول تسودها الفوضى، ودول أخرى مُقسَّمة، ودول نجحت ثورتها في نقلها من العداء لـ”إسرائيل” إلى الركض بلهفةٍ نحو أحضان بنيامين نتنياهو، كما هي حال السودان اليوم.
لكنَّ الحقيقة تقول إنَّ مقاومة التدخّل التركي في الشمال السوري تبقى حقاً سيادياً للدولة السورية، لا يمكن تبديله أو التغاضي عنه، وهو ما يُحقّقه الجيش السوري وحلفاؤه كل يوم، ويحتفل به المواطنون السوريون الذين يُهلّلون لفتح طريق حلب دمشق ودخول البلاد في مسارها النهائي لتحرير إدلب. إنها مرحلة جديدة بكلّ المقاييس، على الرغم من كلّ تهويل إردوغان وجيشه وأميركا من خلفه.
إنَّ الانتصار في إدلب يختزن معاني كثيرة تمتدّ من موسكو إلى طهران، وبينهما دمشق، ومعهما بيروت وبكين وبغداد، في مسارات مُتشابِكة بصمغ الانتفاضة على الوقاحة الأميركية على المستوى العالمي، وعلى وكلاء الوقاحة الإقليميين في كلِّ مكان.
واليوم، يستمر إردوغان المُختال دائماً في مسرحيات يتمظهر فيها كداعمٍ للقضية الفلسطينية في التكامُل مع الضربات الإسرائيلية المستمرة على سوريا. هو يضرب في الشمال، وهم يضربون في الجنوب وفي القلب، ضمن أوركسترا موحَّدة النتائج ومختلفة الأهداف، لتخدم كل أطراف هذا التكامُل الإجرامي.
الخطوة التالية.. ليبيا
لكنَّ أنظار إردوغان، ومعه وكلاء الحرب الآخرون، تتَّجه اليوم إلى الساحة الليبية كمحطةٍ جديدة لتجربة السرقة المتواصلة للمنطقة العربية وخيراتها، فبعد فشل مشروع ضرب سوريا، يريد إردوغان تثبيت أقدامه في إدلب، ليس من أجل محاولة اقتناصها فحسب، وإبقاء تركيا خنجراً في خاصرة دمشق في المرحلة المقبلة، وصولاً إلى ثبيت وضعها بدعمٍ أميركي، على صورة محاولة سرقة الجولان واعتراف أميركا بهذه السرقة الموصوفة، بل أيضاً من أجل استخدام الوجود العسكري التركي في إدلب في تعزيز الدّور التركي المُهروِل إلى ليبيا، حيث تشدّ رائحة النفط أنف إردوغان، ومعه ترامب “عاشِق النفط” المُتباهي بعشقه.
لقد اعتقد الرئيس التركي أنّ الحرب في إدلب ستنتهي خلال أيام معدودة، تماماً كما اعتقد في بداية الحرب على سوريا قبل 9 سنوات. إنّ القوَّة العسكرية التركية وتنازع موسكو وواشنطن على استمالة أنقرة في الصراع الجيوسياسي الكبير، أوهما الرئيس التركي بما لا يستوي مع المنطق، فهو يريد تحقيق انتصارٍ تكتيكي في ختام آخر معارك الميدان، وحَصْر النتيجة الكاملة منها بصورةٍ تتناقض مع مسار طويل من الهزائم التي مُنيَت بها القوات المدعومة منه في سوريا طوال الحرب، وهذا محض هذيان في أحسن الأحوال.
وقد أحسن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وصف المسألة وحال إردوغان فيها، خلال مقابلة له قبل أيام على قناة الميادين، حين قال: “لا يوجد نظام في العالم أغبى من النظام التركي. إنّه لا يحترم سوتشي ولا ما تمّ التوصل إليه في اللقاء الأمني السوري التركي في موسكو”، و”هو يكذب كما يتنفّس. إنه متورِّط في خوض الحرب ضد سوريا، وها هو قد ذهب للقتال في ليبيا”.
وكما في السنوات السابقة، إنّ الحقيقة تثبت نفسها فوق كلّ محاولات التجاوز والتوهّم، وهي قاعدة في العلاقات الدولية المعاصِرة أثبتتها الحرب السورية تحديداً، في نموذجٍ اختلف بصورةٍ صارِخة عن الانتفاضات العربية الأخرى، لتقول نتائج هذه الحرب إنّ كلّ انهيارات الأنظمة الأخرى وتدحرجها، الواحد تلو الآخر، ليست سوى ركون إلى الوَهْم وانخطاف غير مبرَّر كان يمكن تجاوزه لو صمدت تلك الدول وتعاملت على أساس مصالحها بثقةٍ وثبات، وهي قاعدة تتأكَّد من خلال بقاء أنظمة الدول الخليجية الحليفة لواشنطن بعيدةً عن الثورات، آمِنةً من مطالب الشعوب، لأنها حليفة للمُحرِّك فقط.
هذا يعني أمرين: أولاً أنَّ إرادة الشعوب لا بدّ من أن تتحقّق بمُعزلٍ عن الرياح الخارجية. ثانياً، وبناءً على النقطة الأولى، فإن الشعب السوري سيُحرِّر كامل التراب الوطني، وإدلب في أول الأمر.
الميادين نت