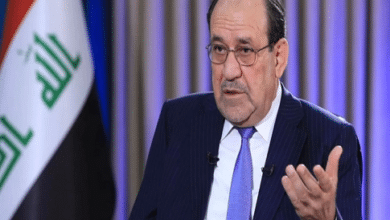إحياء «خريطة إردوغان»: السوريون ضحيّة لـ«البازار» التركي

قبل نحو ثلاثة أعوام، وقف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في الاجتماع الرابع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حاملاً بين يديه خريطة لسوريا رسم عليها خطّاً أفقياً طويلاً محاذياً للشريط الحدودي مع تركيا، يمتدّ على نحو 430 كلم وبعمق 30 كلم في الأراضي السورية، من إدلب في الشمال الغربي وصولاً إلى أقصى الشمال الشرقي من سوريا، في محافظة الحسكة. وذكر إردوغان، حينها، أن هذه المساحة ترغب تركيا في تحويلها إلى «منطقة آمنة»، وهي التسمية غير المباشرة لنيّة أنقرة قضم تلك المناطق واحتلالها بموافقة دولية، بحجّة استيعاب أزمة اللاجئين السوريين. المشروع التركي الذي اصطدم بمقاومة سورية ورفض روسي قاطع، تمكّنت موسكو من تجميده، توازياً مع فرضها خطوط تماس مراقَبة، بالإضافة إلى ضمانات أمنية وتعهّدات متبادلة، تفرض على أنقرة حلحلة ملفّ إدلب، وعزل «الإرهابيين» في المحافظة التي تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة)، الفصيل المقرّب جدّاً في الوقت الحالي من تركيا، مقابل ضمان روسيا إبعاد الأكراد (الفصائل المسلّحة منهم) عن الشريط الحدودي.
وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، دخلت الأطراف المنخرطة في الحرب السورية مرحلة مراوحة، قبل أن تتغيّر الظروف مع دخول العام الماضي نصفه الثاني، وبدء العام الحالي، حيث ظهرت في الأفق متغيّرات إقليمية مهمّة، سواءً ببروز دور الإمارات على الساحة، أو اتّضاح موقف الولايات المتحدة، وانحياز دول المنطقة إلى إعادة وصل العلاقات الاقتصادية والسياسية وخفض التوتّر في ما بينها (مصر والسعودية وإيران وتركيا وفق مسارات متوازية). تحرّكت أنقرة على جبهات عدّة للاستفادة من هذه المتغيّرات، ومن ضمنها الجبهة السورية، حيث بدأت عملية إعادة هيكلة للفصائل الموجودة في مناطق سيطرتها، وسعت إلى إحداث تغيير واضح يعزل موقفها عن موقف قطر، ويقدّم تطمينات للإمارات والسعودية ومصر، عن طريق التضييق على «إخوان مصر»، وإغلاق ملفّ جريمة اغتيال جمال خاشقجي، وليس انتهاءً بتحجيم دور «إخوان سوريا» في «الائتلاف» المعارض، والتخلّص من المعارضين المرتبطين بأجندات غير تركية.
التغيّرات الدولية والإقليمية تزامنت مع ارتفاع وتيرة الحراك السياسي الداخلي في تركيا، تحضيراً للانتخابات الرئاسية المقرَّرة في 23 حزيران 2023، والتي تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي من تبعات الحروب السياسية والعسكرية السابقة، وأزمة «كورونا»، بالإضافة إلى أزمات مالية ونقدية أخرى، ترافقت مع ازدياد العنصرية تجاه السوريين، وارتفاع الأصوات المطالِبة بترحيلهم، الأمر الذي وضع اللاجئين على طاولة البازار السياسي، وعلى شاخصات الدعاية الانتخابية.
وعلى عكس المرّات السابقة، التي دافعت خلالها حكومة «العدالة والتنمية» عن وجود هؤلاء، لأهداف اقتصادية وسياسية أخرى (ابتزاز أوروبا، أو تجنيسهم واستعمال أصواتهم وفق اتّهامات المعارضة للحزب الحاكم)، ظهر موقف أنقرة هذه المرّة مختلفاً، عن طريق تقييد حركتهم، وتسريع عمليات ترحيلهم، بالإضافة إلى تسريب أنباء عن لقاءات أمنية مع مسؤولين سوريين، الأمر الذي نفته دمشق واعتبرته جزءاً من الدعاية الانتخابية في تركيا.
آخر فصول التضييق على السوريين يتجسّد خلال هذه الأيام، عن طريق منعهم من الدخول إلى بلادهم لقضاء إجازة العيد – وهو إجراء كان يتمّ بشكل دوري طيلة الأعوام الماضية -، حيث أُغلق معبرا باب السلامة وجرابلس الحدوديان، بعد أقلّ من يومين على تصريحات أطلقها مسؤولون أتراك، من بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي أعلن فرض قيود على حركة السوريين، وزعيم حزب «الحركة القومية» دولت بهتشالي، حليف «العدالة والتنمية»، الذي اعتبر أن «السوريين الذين ذهبوا إلى بلادهم خلال العطلات ليسوا بحاجة إلى العودة»، بالإضافة إلى إعلان شخصيات معارضة عدّة سعيها لإعادة اللاجئين، ومن بينها زعيم المعارضة كمال كليشدار أوغلو، الذي وجّه أسئلة إلى دائرة الهجرة تتعلّق بأعداد السوريين الذين يملكون وثائق لجوء، وعدد المجنّسين منهم، وهي أسئلة يبدو أن الإجابة عليها ستكون محرجة بالنسبة إلى الحكومة التركية.
وبينما استثمرت أنقرة، خلال العامين الماضيين، خطاب الكراهية الذي ارتفع بشكل غير مسبوق تجاه السوريين، لدفع مَن يمكن دفعه منهم للعودة إلى مناطق في سوريا قرب حدودها، حيث تقيم مشروعات سكنية وتجارية واقتصادية، معظمها بتمويل غير تركي (بعضها قطري، وبعضها بدعم أوروبي أو عبر منظّمات دولية مختلفة)، يبدو أنها، وفي ظلّ الظروف الخارجية والداخلية، وجدت أنه من الأفضل الإمعان في استثمار هذا الخطاب، وتشديد القيود على اللاجئين، بالتوازي مع تحرّكات سياسية وميدانية في الساحة السورية، حيث بدأت حفر خندق يفصل مواقع سيطرة الفصائل التابعة لها عن مواقع سيطرة الحكومة السورية في ريف حلب، قرب تادف، على أن يمتدّ الخندق ليشمل مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، وصولاً إلى ريف عفرين شمال حلب. كذلك، كثّفت تركيا عمليات استهداف مقاتلي «قسد» عن طريق القصف بالصواريخ والمدفعية، والطائرات المسيّرة، في وقت أعلى فيه الرئيس التركي من حدّة خطابه ضدّ الأكراد، حيث توعّد في كلمة أمام اجتماع نواب حزبه في البرلمان، بـ«سحق رؤوس القوات الكردية في سوريا».
وتحاول تركيا، خلال هذه الفترة، تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحرب الروسية في أوكرانيا، في ظلّ سعي واشنطن للتحشيد ضدّ موسكو. ومن المقرّر أن يجتمع وزيرا الخارجية، التركي مولود جاويش أوغلو، والأميركي أنتوني بلينكن، الشهر المقبل، في العاصمة الأميركية، لمناقشة القضايا العالقة، ومن بينها ملفّ «قسد»، الأمر الذي تستعدّ له واشنطن عبر مشروع توحيد الأكراد، وتقديم تسهيلات اقتصادية تنعش مناطق «قسد» ومناطق السيطرة التركية عبر استثنائها من قانون العقوبات «قيصر». ويبدو، أيضاً، أن أنقرة تعدّ خطّة أخرى تتعلق بالحصول على ضوء أخضر أميركي لشنّ عملية عسكرية تقضم من خلالها مناطق جديدة قرب الشريط الحدودي، الأمر الذي يعيد إحياء «خريطة إردوغان»، ويضمن له قفزة كبيرة في السباق الانتخابي عن طريق التخلص من ملف اللاجئين، ومكاسب إضافية تتعلّق بتوسيع المنطقة التي تحتلّها قواته، وإقامة مشاريع اقتصادية، وتحصين شريطه الحدودي بشبكة علاقات يتمّ تأسيسها لتستمرّ، حتى لو خرجت القوات التركية وفق تفاهم سياسي ما مستقبلاً.
صحيفة الاخبار اللبنانية