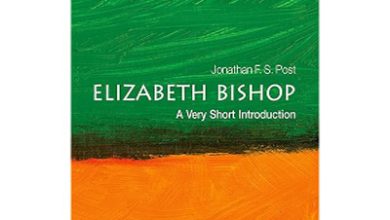الإسلام السياسي: ثلاثة أجيال (علي بولاتش)
علي بولاتش*
لم يكن ثمة وجود للحركة الإسلامية (بمعنى الإسلام السياسي) قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكان عدم وجودها أمرًا طبيعيًا. ذلك لأن الدولة العثمانية كانت دولة الإسلام في إطار أيديولوجيتها المؤسسة ومشروعيتها السلبية والإيجابية، وكانت كذلك دار الإسلام على الرغم من ضعفها، والقاعدة أنه لا يُطلب ما هو موجود بالفعل. ومع تعرض الدولة العثمانية لهزائم عسكرية واقتصادية وسياسية أمام الغرب، واندفاع نخبتها السياسية نحو البحث عن حلول لأزمات الدولة، ظهرت الحاجة إلى تنظيم وتشريع جديد بالعودة إلى المصادر الرئيسة في الإسلام على نحو يتوازى مع حركة التغريب. وظهر المسار الذي تدفقت منه الحركة الإسلامية في ذلك الظرف التاريخي والاجتماعي.
يمكننا القول: إن الحركة الإسلامية خلال تلك الفترات الثلاث الرئيسة قد تعاقبت أجيالها الثلاثة الجيل تلو الجيل. فالجيل الأول عاش في الفترة من 1850 حتى 1924، والجيل الثاني من 1950 حتى 2000، بينما الجيل الثالث فقد ظهر مع بدايات الألفية الثالثة ولا يزال على مسرح التاريخ إلى الآن. وثمة منطق وراء هذا التصنيف الزمني.
ونحن بحاجة إلى توضيح بعض المعايير حتى يتسنى لنا إبراز علاقة كل جيل بالآخر، ووضعيته الفكرية والسياسية. ويمكننا أن نحدد هذه المعايير في: "إطار المرجعية، والتوجه السياسي، وشكل الزعامة". وبناء عليه:
كان إطار المرجعية لإسلاميي الجيل الأول الذين كان لهم دور بارز في الحركة الإسلامية بين عامي 1850-1924، هو "العودة إلى القرآن والسنة"؛ ومن ثم كانوا يعلون من قيمة "فتح باب الاجتهاد"، و"إيقاظ روح الجهاد". ومن خلال وجهة نظرهم هذه، كانوا يرون أن السبيل إلى خلاص الدولة العثمانية من الضعف الذي اعتراها يتمثل في وجوب أن تقوم حركة الإصلاح على عودة العلماء إلى القرآن والسنة وضرورة الاجتهاد. حيث إنه في حال عدم فتح باب الاجتهاد، فإن الإصلاحات الوافدة من الغرب سيتم قبولها كما هي، وهو ما سيمهد الأجواء للسماح بالأفكار والقوانين العلمانية. وهو ما حدث بالفعل. وكان ما فهموه من "إيقاظ روح الجهاد" أنها حركة معنوية من أجل حرب حقيقية ونهضة اجتماعية-اقتصادية ضد الاستعمار.
تبلورت التوجهات السياسية لأبناء الجيل الأول من الإسلاميين في إنقاذ الدولة العثمانية. وكانت الدولة بالنسبة لهم هي الدولة العثمانية التي تمثل دولة الإسلام من خلال أيديولوجيتها المؤسسة وإطارها الشرعي، ووجود خليفة للمسلمين على رأسها. وكانت الدولة قد تعرضت للضعف، ولم يكن من الممكن إنقاذها من خلال تقليد الغرب كما هو من دون اجتهاد. وكانت عملية الإنقاذ تكمن في العودة إلى مصادر الإسلام الأصلية.
وكانت النخبة المثقفة لدى ذلك الجيل الأول وقاداتهم المفكرون وخطباؤهم السياسيون يجمعهم "نمط عالم الدين- المثقف". فقد كان جميعهم في الغالب أشخاصاً متميزين في العلوم الإسلامية والفكر والتاريخ الإسلامي. وفضلا عن ذلك فقد تلقوا تعليمًا غربيًا. فهؤلاء الأشخاص كانوا يعرفون الكثير عن كلا العالمين، وكانوا يناضلون في الحياة العامة مثل العلماء الأمويين والعباسيين، وكانوا كذلك قادرين على حماية شخصيتهم المدنية، وهم مختلفون في ذلك عن العلماء الرسميين في الدولة العثمانية. لذلك لم يكن رجال الدولة العثمانيون وعلماؤها الرسميون يستسيغون رواد ذلك الجيل الأول من الإسلاميين.
راح أبناء ذلك الجيل الأول من الإسلاميين ضحايا حرب "تشاناق قلعة" عام 1915. حيث قُتل في تلك الحرب نحو خمسين ألفاً من رجال الفكر والطلاب. لدرجة أن تلك الحرب عُرفت باسم "حرب طلاب العلوم الشرعية". وتأسست الجمهورية التركية عام 1923. وتمت تصفية ذلك الجيل من خلال قانون "إقرار السكون" عام 1925، وتحت وطأة وسطوة حكم الحزب الواحد فيما بين عامي 1923-1950. وبعد هذه التصفية الراديكالية التي جرت عقب قيام الجمهورية التركية خلدت الحركة الإسلامية لنوم عميق حتى عام 1950.
ومع الجيل الثاني الذي ظهر على مسرح التاريخ في الفترة من 1950-2000، أصبحت مرجعية الإسلاميين "الدولة القومية- الحديثة". وأولوا اهتمامًا كبيرًا لأسلمة البنى الاجتماعية- السياسية الغربية بغية تجاوز أزمة المشروعية. وتشكل الطور الذهني للإسلاميين في تلك الفترة في "النمط الغربي" عبر المعرفة والتعلم والمؤسسات الاجتماعية، واتخاذ الأجندة السياسية والاقتصادية أساسًا لهم. إلا أن ذلك قد "طُلي بلون إسلامي"، أو أضيفت له "مجالات أخلاقية- معنوية، وإيمانية- ميتافيزيقية مبتكرة".
كانت "الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي" هي التوجه السياسي الرئيس لأبناء الجيل الثاني من الإسلاميين. وفي تلك الفترة أدارت الأنظمة القمعية السلطوية في تركيا وإيران وأفغانستان سياسات تصفية ضد الإسلام. أما الدول العربية والإسلامية الأخرى فقد كانت مشغولة بنضال حقيقي ضد الاستعمار. وبعد التحرر من الاستعمار لم يكن ثمة شيء سوى "الدولة القومية الحديثة".
وفي ظل ذلك المناخ دخل المسلمون الذين كانوا يتألمون من إلغاء الخلافة من ناحية، ومن القمع والاستعمار من ناحية أخرى، في عملية تستهدف أسلمة الدولة القومية الحديثة، واضعين أمام أعينهم نموذج دولة الفاتيكان الدينية. وكان نمط الزعماء والقادة لدى ذلك الجيل الثاني لا دراية لهم بالعلوم الإسلامية أو الفكر والتاريخ الإسلامي؛ فقد كانوا "مثقفين وأكاديميين وسياسيين يستهدفون السلطة" تلقوا تعليمًا غربيًا، ويعملون في المجالات العلمية؛ فكان منهم الأطباء والمهندسون ورجال القانون والصحافة.
ثم بدأ الجيل الثالث من أبناء الحركة الإسلامية في تركيا وإيران في الأعوام الأولى من الألفية الجديدة.
كان عام 1997 هو نقطة البداية، عندما وقع في تركيا انقلاب 28 فبراير الذي عُرف بـ"الانقلاب ما بعد الحداثي"، كما تولى في العام ذاته محمد خاتمي رئاسة الجمهورية في إيران. وكان ظهور الجيل الثالث في مصر في ميدان التحرير. ويمكن القول: إن التعرجات الرئيسة التي وقعت في كل من تركيا وإيران ومصر، تكاد تكون قد حدثت بشكل متزامن، يفصلها عن بعضها سنوات قليلة.
ويمكننا القول: إن نقاط الضعف التالية قد انتقلت من أبناء الجيل الثاني إلى الجيل الثالث:
كان إسلاميو الجيل الثاني قد استلموا من الجيل الأول "عداء التقاليد" بوصفه ميراثًا سيئًا. ولم يقوموا بالتفرقة اللازمة بين "أعراف الأمة وتقاليدها الصحيحة" التي أفرزتهم على مدار التاريخ وبين "التقاليدية والتعصب". وهو ما جعلهم يُعرفون بـ"حركة المبتدعين"، ويندفعون بمرور الوقت نحو "الراديكالية". فالحداثة الغربية تمضي عبر "عداء التقاليد"، وهو ما كان يُنتظر من الإسلاميين فهمه مبكرًا.
قاموا بتسييس الإسلام بشكل مفرط؛ حيث عجزوا عن تقديم أنشطة تبرز التوازن بين "الإسلام الرسمي والإسلام المدني" الذي شهده التاريخ الإسلامي بمحاسنه ومساوئه.
قامت الحركة الإسلامية بتسييس خطابها وأدبياتها بشكل مفرط، وأضحت غريبة عن التصوف، وأبعاد الدين المعنوية والمعرفية والأخلاقية. لذلك عجزت عن تقديم أجوبة ثقافية وفلسفية وفكرية بالمستوى الكافي على فلسفة التنوير. فقد قدمت السياسة على ما عداها، ومن ثم أفرزت هذه الضحالة والسطحية أنماطًا سياسية وسياسيين منقطعي الصلة بالثقافة.
ظل تأثير الخطاب الإسلامي في مرحلة التنظيمات والتحديث التركي منحصرًا بشكل عام في الشعراء والقصاصين والأدباء. في حين لا نجد تأثيرًا للفن والأدب والشعر في النموذج العباسي في التعاطي والتلاقح الذي تحقق مع عوالم الفلسفة والمعرفة والحكمة. وتتمثل أكبر عوائق ونقاط ضعف الحركة الإسلامية في تركيا اليوم في وقوعها تحت أسر الشعراء والقصاصين والأدباء حتى الآن، وكونها محرومة من المثقفين والعلماء الحقيقيين.
ووجد الإسلاميون أنفسهم فجأة أمام فرصة للحكم والسلطة دونما استعداد أو تأهل لها. وبسبب حرصهم المفرط على الوصول إلى الحكم قبلوا بتولي السلطة. وبهذه الكيفية:
لم تتمكن الحركة الإسلامية من تقديم إجابات صحيحة للحداثة، وقبلت بمعايير "الفرد، والعلمانية، والدولة القومية"، واكتفت بصبغها بـ"المحافظية". ومع وصول الإسلاميين إلى السلطة تبنوا قيم الدولتية، والقومية، والسياسة الواقعية، والتحالفات العالمية، وكان يدفعهم نحو ذلك ما تعانيه الحركة الإسلامية من ضعف فكري ذهني.
وبالتالي، سقط من حسابات الإسلاميين "نموذج" العودة إلى القرآن والسنة؛ حيث انتهجوا خارطة طريق الاتحاد الأوروبي والسياسات الليبرالية دونما الاقتراب من باب الاجتهاد. وتناسوا "الجهاد" بسبب نماذجه السيئة والزائفة، وعدوه "إرهابًا".
لم تخضع علاقات الإنسان/ الأسرة، والجماعة/ المجتمع، والمؤسسات الاجتماعية- السياسية لتعريفات جديدة في إطار إسلامي.
إن خلاصة تجربة الجيلين الأول والثاني والنقطة التي وصل إليها الجيل الثالث من الإسلاميين تكشف لنا أن الحركة الإسلامية ينبغي عليها القيام بمواجهة أولا مع منظورها المعرفي، ومعارفها المؤسِسة، وأفكارها.
*خلاصة بحث علي بولاتش 'الحركة الإسلامية في تركيا مقابلتها بمصر وإيران' (فبراير 2014) 'تركيا الإخوانية حضار ومستقبل حزب العدادلة' الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث.
ميدل ايست أونلاين