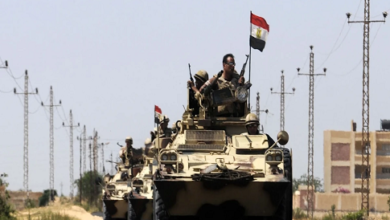التشظي في رواية “الحب في زمن العولمة”

وأنت تقرأ رواية “الحب في زمن العولمة”، للروائي المتميز صبحي فحماوي، ينتابك القلق من زمن وقطار العولمة الذي يدهس الفقراء في طريقه لترقية الأغنياء والخونة والانتهازيين. ويتشظى فكرك بين الواقع والخيال، الحقيقة والزيف، المعقول واللامعقول، الجد والهزل، الجد والسخرية، الحب والخيانة، القوة المادية والضعف الجسدي، الغرور والندم، الأصالة والعولمة.
تحاول القبض على مفاتيح الواقع فيها، وعلى من يتحدث، فتخونك الأمكنة والأزمنة والوقائع والأحداث، المتكلم والمخاطب، الرؤية مع، من خلف، أو من خارج. أين ومتى ومن ولماذا؟ العلاقات والدواعي والأهداف. تضيع بين هذا البين بين، رغم جماليته، لأن المؤلف / السارد يختار لحظة أن يترك مسافة بينه وبين المحكي، ثم يعود ليغوص مع الشخصيات في جزئيات وتفاصيل حياتها الخارجية والخاصة، وما يشغل بالها من هواجس وأحلام وطموحات.
تنطلق من مؤشر العنوان باعتباره من أهم العتبات التي تهيئ القارئ وتوجه علاقته بالنص، ولكونه أحد مكونات النص الموازي، وإن كان هذا الأخير “لا يملأ دائما وظيفة مساعدة على تبين هوية النص”، وهذا ما يحدث لقارئ هذه الرواية؛ حيث يخيب العنوان أفق توقعه، وهو ما يعكس جمالية العمل الأدبي حسب هانس روبرت ياوس. تنطلق بحثا وطمعا في القبض على مفاصلها في علاقة مع عتبة العنوان، لكن دون جدوى. وهكذا تضطر إلى الانفتاح على باقي مكونات النص، لاكتشاف الدلالات والأبعاد الرمزية للشخصيات والأماكن والوقائع، في دروب الرواية الممتعة في زمن العولمة.
تنفتح الرواية على وجه من وجوه العولمة التي تعكس الفوارق الصارخة في المجتمع؛ حيث سائد الشواوي، الموظف البسيط في البلدية، يضع آخر اللمسات والتجهيزات النهائية لدخول قصره الفخم في الرابية الغربية لمدينة العولمة. إن القصر هو نتاج يد من أيادي العولمة التي لا تعرف إلا الهيمنة والسطو، وهو حال الشواوي.
هل نحن أمام سيرة ذاتية .. بحكم حضور ضمير المتكلم المرتبط أساسا بالمؤلف/ السارد، وحيث إن عملية الاسترجاع في السيرة الذاتية، تتم غالبا عن طريق ضمير الأنا المتكلم الذي يتطابق مع السارد؟
تبدو مدينة العولمة هذه، سرابا في الوطن العربي، فهي “ليست في مصر أو سوريا، أو الأردن أو فلسطين، أو العراق أو المغرب العربي، أو بلاد الجزيرة العربية، ولا حتى في الصومال أو جيبوتي، بل هي واقعة داخل الحدود المشتركة لهذه الدول، في مساحة مستباحة”. إنها مدينة هلامية، تنعكس صورتها المادية في كل مكان تمتد إليه أذناب العولمة/ الأخطبوط. لقد تخلت عن أصالتها وبداوتها وبساطتها، وفتحت ذراعيها للرأسمالية المتوحشة. “ومن ثم تغير اسمها، بفعل غزارة المرور التجاري، والسياحي، والاجتماعي والديني والثقافي العابر للدول”.
يصعب إذن، تحديد جغرافية مدينة العولمة وهويتها الممسوخة، وثقافتها المهجنة وغير المندمجة. “إن الانشطار إنما يعكس وضعية ثقافية لم تتم بعد إعادة بنائها، ثقافة يتزامن فيها القديم والجديد، والأصيل والوافد، في غير ما تفاعل ولا اندماج”.
كما يصعب القبض على مكان رئيس في الرواية؛ حيث يسافر بنا السارد عبر مناطق شتى من الكرة الأرضية، تماشيا مع مفهوم العولمة التي تلغي الحدود الجغرافية والسياسية، ومقولة “العالم قرية صغيرة”، “إن الدنيا قد تغيرت، وإن العالم قد صار قرية صغيرة، أي إن الدنيا قد صارت شبكة صغيرة”؛ فمن “البطين” التي لا توجد لها إحداثيات على خارطة العولمة، تنطلق رحلة الشخصيات، وخاصة الرئيسة، في اتجاه الفلبين والهند وأدغال إفريقيا، وجزر الكاريبي ونيويورك، وسويسرا وفلسطين.
يأخذ المكان كواقع ملموس ومحدد بالتعيين والجغرافيا، بعدا رمزيا في الرواية، كونه يند عن التحديد ولا يرتبط بالواقع إلا من خلال أسماء المدن والدول والمراكز والمقرات، “هذا النادي يقع في شقة بعيدة عن هذا الشارع…”. فالمتجول مع السارد في أرجاء المعمور وداخل مدينة العولمة لا يجد فرقا بين الأماكن التي يدخلها مع الشخصيات والأحياء التي تمر بها، وبين التي ينتمي إليها أو زارها، أو يسمع عنها أو يشاهدها كل يوم من خلال وسائل الإعلام المتنوعة.
إن تماهي الواقع الافتراضي غالبا “مدينة العولمة”، مع واقع المتلقي بمظاهره المتناقضة، وآثار العولمة عليه، تجعل من الصعب تركيز الأحداث والوقائع في حيز مكاني بعينه، “وإذا أردت أن تُعرف أحدا على عنوان بيتكم، تقول له إنه يقع في شارع المتآكل بن المتهالك، بعد المطبين الكبيرين، تجد بركة لمياه المجاري… ثم تدخل في شارع فرعي، على بابه، أو في منتصفه، تقبع حاوية نفايات كبيرة مندلقة، ومقابل الحاوية تجد بيتنا”.
إنه اللاواقع برمزيته الساحرة والساخرة، لذلك يرد المؤلف على القارئ المفترض أبو جلهوم” نحن أنا والسارد سعد الدين، المتمرس فوق دماغي، والذي يراقب كل حرف من حروف الرواية، لا نسمح لك باستغلال الحرية الممنوحة، لكتابة أشياء غير واقعية في هذه الرواية…!”.
يزداد واقع العولمة كآبة وغربة، وانحلالا ومسوخا يوما بعد يوم؛ لقد تحولت مدينة العولمة/ البطين، من منطقة عبارة عن بيوت طينية وأخرى حجرية، نسي الشريكان، “سايكس” و”بيكو” تثبيتها على أرض الواقع “وهكذا تركت تلك الأرض منسية، فسماها التجار والمارون، والعابرون وأبناء السبيل، والقراصنة وعصابات المافيا… أرض البطين”، فتحولت إلى مدينة مفترسِة ومفترسَة بلا قلب ولا هوية “إن الدنيا قد صارت شبكة واحدة… وإنهم قد اختاروا مدينتنا المحايدة، لتكون نموذجا للعولمة”.
أي واقع متشظي ومتغول هذا الذي تعيشه الشخصيات؟! انعدم الأمان، وضاقت سبل العيش، وضاق الفضاء بزوجة الشواوي “أسمهان” فألزمته بتغيير الإقامة بعد إغراء “سميرة” زوجة مدير البنك المركزي لها: “الحياة يا أسمهان يا أختي صارت معقدة! والأغنياء بصراحة صاروا يواجهون حقد المجتمع عليهم”.
ولكن رهاب العولمة امتد إليها رغم أن الإقامة بمدينة البلوط كلفتها أكثر من مليون دولار؛ “هذه ليست حياة!… حارة البلوط هذه لا تعدو كونها جيتو يهودي في بلد أوروبي متعصب… نحن نعيش هنا يا سميرة في رعب وخوف دائمين”. من هنا جاءت فكرة بناء القصر الذي تم وانتهى، وتاهت العائلة داخله وانشغلت بفقدان رب الأسرة للمناعة، فاشتد هذيانه بعد أن نشب في شرايينه فيروس الإيدز أظافره، والذي ناله مكافأة من حرية العولمة الإباحية، وأصبحت كل مكونات القصر أشباحا متحركة تريد النيل منه، يشاهدها في الليل البهيم “متحركة طويلة سوداء، بأذرع عديدة تتماوج في الهواء…”. لقد تغيرت حياة الشواوي وعائلته مثلما تغيرت معالم مدينة العولمة “وصارت فيها عمارات يسمونها أبراجا! وصارت فيها حركة تجارية متشابكة، ونوع من الحضارة التي لا ترحم”.
لقد عاش الشواوي في حيز الخصوصية عندما غادر المدرسة واشتغل مراسلا في قسم المساحة بالبلدية “فرح أبوك وقال: مراسل، مراسل! المهم أن لا يدور الولد في الشارع ويهمل..!”. لكنه سرعان ما تعولم وسكنه هوس العقار، وانساق مع القرش “رجل لا يعرف إلا القرش”، في مدينة العولمة وأصبح يخضع لإملاءات مستشاريه؛ سامارو من الهند، رالف وود من نيويورك، سندجار من الفلبين، محمد منارات من كوالالمبور.. فتضخم الطمع في نفسه، وضاعت هويته وأحكم قبضته على العقارات بفضل سماسرة الأراضي وشبكة من العملاء “سأدفع لك ما تريد، اتصل بي لدى سماعك عن أية قطعة أرض واقعة، صاحبها مريض ومحتاج،… يريد أن يموت ومحتاج…” وامتلك قصرا لا ينعم بفخامته “أبو سفيان ينام في غرفته الجديدة في القصر، كانوا قد فرشوها له بأثاث فخم.. وكان ينام قليلا، ثم يصحو، ويهدي كثيرا”.
لا يقتصر الواقع الزئبقي على الفضاءات المترامية داخل الرواية، بل يمتد إلى ما هو رمزي معنوي؛ الأخلاق والمبادئ والمعاملات والعواطف.. كلها فقدت أصالتها في مدينة العولمة، وصار النفاق والانتهازية والسطو وسائل للوصول “القرش يكبر في ناظريه، فيغطي المساحة الفاصلة بينه وبين الآخر… فهو لا يشاهد البشر، ولا يرى غير القرش”.
تتملص الذات الكاتبة من فعل السرد من أول إضاءة في الرواية، “أشعر الآن، أن أحد أولاد سعدالدين قد ركب رأسي، وانسل إلى داخل مخيلتي… واستحكم هناك، وبدأ يسرد من فمي حكايات، ويختلق شخصيات كثيرة، لرواية لا أفهم عنها شيئا! قال لي: اكتب اسمها (الحب في زمن العولمة)”. وعلى طول الرواية تتشظى الذات بين الأنا الكاتبة، “وهكذا بدأ يأمرني، وأنا أطيع بالكتابة”، والآخر الفضولي “كنت أتمنى أن أدخل في دماغ المؤلف،… فأوجهه ليأخذ (كاميرا فيديو) ويصور لنا بقلمه بعض معالم مدينة العولمة”، والسارد المتسلط “أحتج على دكتاتورية وفوضوية سعدالدين، هذا الذي لا يحل عن دماغي، والذي يسيرني على هواه”، بين ضمير المتكلم المفرد “أنا العبد لله كاتب هذه الرواية”، والمتكلم المثنى “ونحن أنا والسارد سعد الدين”، وضمير الغائب المفرد المتنوع؛ “كان الشواوي يحاول أن يطرد تلك الشرور”، “كانت ثريا فتاة لطيفة”.
هل نحن إذن، أمام سيرة ذاتية؟، بحكم حضور ضمير المتكلم المرتبط أساسا بالمؤلف/ السارد، وحيث إن عملية الاسترجاع في السيرة الذاتية، تتم غالبا عن طريق ضمير الأنا المتكلم الذي يتطابق مع السارد، والذي يتطابق هو الآخر مع الشخصية الرئيسة. وحيث إن السيرة “حكي استعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص” أم نحن أمام سيرة غيرية؟ بحكم أن السيرة “ليست تاريخ حياة فحسب، لكنها ـ إلى جانب ذلك ـ تاريخ لمختلف العلوم والمعارف المتصلة بالأشخاص المترجم لهم”، واعتبارا للحضور المكثف لضمير الغائب؛ حيث يطلعنا الكاتب على ترجمة لسائد الشواوي، فالترجمة حسب البستاني هي “ذكر سيرة شخص وأخلاقه ونسبه…”.
وتضيع هذه الاحتمالات والتأويلات حول من يتحدث، حينما تتداخل ترجمة شخصيات بعيدة عن عالم الكاتب، كما عن عالم الشواوي “قال الطفل عبدالسميع لأبيه سرحان الذي كان يعمل زبالا”، كما أن الرواية لا تنتهي على حياة المؤلف أو الشخصية الرئيسة، وإنما على مأساة شخصية ظهرت فجأة وترقت سلم الحياة والمال بسرعة “جلست رهام متقاعدة في البيت، وهي محسورة على الأيام الممتعة التي قضتها في ربوع إدارة أموال دار الأيتام… وقال لها رتشارد: يا رهام (تايم إز موني)..
فخلال شهر من هذا العمل معنا، ستستطيعين شراء فيلا”، ولكنها ـ وبسرعة أيضا ـ آلت إلى الفشل والسقوط المروع، كنتيجة مباشرة للطمع وللرأسمالية المتوحشة التي تنفثها العولمة “يبدو أن إغراء المال، شجع رهام وديفد على المضي قدما بتلك المغامرة… قفزت رهام من حضن ديفد، وهي تشاهد النيران المجنونة تقترب منهما… لقد وجدت الجثتان هامدتين على أرض الشركة، وهما متفحمتين!”.
يحكي السارد عن الشخصية بضمير الغائب “كان الشواوي…” ، أو يخولها الحديث عن نفسها بالهذيان “بقي سائد الشواوي وحده في غرفة نومه، ولكنه استمر يهذي ويكلم نفسه: أريد أن يكون فنيو الدهان…”، أو ينمي الصراع بينها وبين شخصيات أخرى، من خلال الحوار، فتكشف وتبوح بحقائقها؛ ” قال لي المساح أبو خنفر: احمل أجهزة المساحة يا سائد! قلت له: حاضر سيدي! …
ـ رئيس البلدية: الآن تستطيع أن تقول إنك مساح مرخص… فقال له سائد: البركة فيك يا سيدي الرئيس… ونظرا للمشادة غير القابلة للحل… والتي دخل الشواوي بين ثناياها، يشعل النار هنا، ويطفئها هناك.. وبعد حوار طويل مع الأخوين، اشترى سائد الشواوي الأرض”، أو يقدمها على لسان متحاورين آخرين: “أف! هذا الشواوي يفكر بالمؤامرات ويخاف منها، كأنه الزعيم الأوحد! فقال عضو آخر: ـ يا ليته يخاف! المصيبة انه لا يخاف!… حجم القرش عنده كبير جدا، بحجم الرحى! فلا يرى خلفه أحدا”.
أو يقدم أفراد عائلتها، ليبوح كل واحد بطريقته، ووفقا لقرابته وطبيعة علاقته بها؛ وهكذا تبرز البنت “ثريا” المصدومة بمرض الأب سائد. قال لها الطبيب: “ـ هل ستصيرين مديرة بنك في المستقبل؟ ـ أي مستقبل هذا يا دكتور! مستقبلي هو صحة أبي”. ولكنها سرعان ما استفاقت وحاولت الثورة على واقع الأب “كان مهران (الأستاذ) يقول لها مستغربا: أنت تعيشين حياة غنى مفرط، وتنطقين باسم الجياع والمحرومين..! فتقول له مؤكدة: أنا لا أحب الظلم، ولا نهب حقوق الآخرين، سواء بالتحايل أو بالقوة”.
أما إحساسها اتجاه أستاذها مهران، والذي تكبله التقاليد والفوارق الطبقية والثقافية، فقد اصطدم بواقع الحب في زمن العولمة؛ “كانت تريد رجلا يحترم عقلها أولا، ثم جسدها ثانيا… كانت ترفض هذا الحب في زمن العولمة”.
تضيع الذات الكاتبة إذن، بين هذه الضمائر، وتطل علينا بين الفينة والأخرى لتذكرنا بأنها مازالت تؤدي دورا، وتتحكم في سير الأحداث، بل وتدخل مع المتلقي في جدال يصل أحيانا حد الغضب “يا أخي أهلكتموني بالأسئلة! بصراحة العجوز قد بلغ السبعين من العمر، ولم يرغب بالاستسلام للتقاعد الجنسي”، بل يصل إلى درجة التهديد بتوقيف السرد وإنهاء الرواية: “قلت لكم لا تسألوني كثيرا، وإلا توقفت عن السرد! وأنهيت الرواية!”. أي نوع من الرؤية السردية إذن، يعتمدها المؤلف؟
ميدل إيست أون لاين