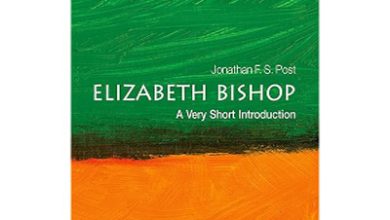الحركة المسرحية في أراضي 1948 (راضي شحادة)
راضي شحادة*
بما أنّنا فلسطينيون بقينا على أرضنا نعيش كمواطنين في دولة «إسرائيل؟!» منذ عام 1948، وبما أنّ قضيتنا الوطنية لم تُحلّ بعد، وبما أنّ المسرح هو فرع من فروع الثقافة الفاعلة والقوية، واحدى مهماته الرئيسة المساهمة في تجذير الهوية والوعي الوطني لدى المتلقين من مبدعين يمتهنون مجالا يتطلب مستوى وعي ثقافي وجمالي وإبداعي ووطني راقٍ، فإنّ ذلك كله يؤكد أنّ موضوعنا الذي نطرقه هنا مرتبط كل الارتباط بقضيتنا الوطنية، حتى وإنْ لم يكن العمل الإبداعي الذي يقدمه مسرحيّونا لا يتطرق إلى القضية السياسية والوطنية بشكل مباشر، فإن له حتما علاقة بحقيقة أننا موجودون في هذا القسم من هذه الجغرافيا والتاريخ… والهوية الوطنية.
ما فائدة الاستطراد في الوطنية والسياسة، بينما الموضوع المطلوب طرقه هو هويةُ المسرح الفلسطيني لدى فلسطينيي 1948 الذين حشروا مرغمين بين خيارين مُرّين: إمّا بقبول بطاقة الهوية الإسرائيلية الزرقاء، أو مغادرة وطنهم، لكي يصبحوا لاجئين خارج الوطن مع سائر إخوتهم المشردين في المخيمات والشتات وعلى أطراف الوطن؟ ولأنّ المسرح ليس سلعة تجارية استهلاكية عادية بل هو مجال ثقافي من الدرجة الأولى ويحتاج إلى مضمون وشكل يرفعان العمل المسرحي إلى أرقى درجة ممكنة، فإنّ كونه مسرحا فلسطينيا خاضعا لسلطة الدولة التي يعيش فيها وهي «إسرائيل»، فلمجرد وجود قضيتين متناحرتين متصارعتين، وهما الاحتلال الإسرائيلي والقضية الفلسطينية العادلة، فإنّ ذلك يحتِّم علينا أنْ نعكسه على ما نريد التعبير عنه مسرحيا، إذا كان ذلك مؤلَّفا أو مُعدّاً كي يصبح مسرحا أو عرضا فلسطينيا له هويته وشكله وكيانه وحضارته الخاصة وارتباطه الوثيق بفلسطينيته وبجذوره وبعروبته، والمشترك بينها جميعا أنهّ مسرح إنساني من الدرجة الأولى.
من العزلة إلى الصحوة الإبداعية
بقينا تحت الحكم العسكري الإسرائيلي حتى سنة 1964 وكان الاحتلال يمارس ضدنا إجراءات عسكرية قمعية صارمة، ثم تحوَّل الوضع بعدها إلى حكم مدني. ولم تكن لدينا تقاليد مسرحية ملحوظة. وبما أنّ المسرح فنٌّ جماهيري وجمعيّ وتظاهريّ، فقد انعدمَ وجود حركة مسرحية في هذه الأثناء، بل حدث نوع من انقطاع شبه كلِّي عن أبينا العالم العربي الذي كنا على قناعة تامّة بأنّه سيكون سَنَداً لنا ومنقذنا بجيش الانقاذ، وأنّنا انتظرنا منه طويلا كي يساعدنا بالفعل وليس بالشعارات حتى نعود إلى حضنه بعد أنْ عزلنا الاحتلال الجديد عنه.
منذ نهاية ستينيات القرن الماضي، وبالتحديد في منتصف السبعينيات، حدثت صحوة إبداعية فلسطينية وعربية في كثير من المجالات الثقافية والوطنية، ومنها المسرح، فبرز لدينا بعض الفرق المسرحية والفنانون الذين يعملون بشكل فرديّ، ولكن الأمر بقي في حدود التطوّع والهواية أكثر من الاحتراف. فالمسرح لم يكن مجالا كافيا للكسب المادي، الأمر الذي يجعل طارقي بابه يعتاشون من وظيفة تضمن لهم الرزق ويضحّون بما لديهم من المزيد من الوقت في مجال المسرح، ولم تكن هنالك مؤسسات أو مدارس تدرِّس هذا المجال. في هذه الفترة كان لا بد أنْ تكون الانطلاقة من المدينة لأنّ المسرح مجال مَدَنِّي ومدينيّ، مع أنه ظهرت فرقٌ مسرحية في القرى إلى جانب «المسرح الناهض» في مدينة حيفا و«المسرح الحديث» في مدينة الناصرة، وفي مدينة القدس (العربية) منذ السبعينيات حتى مرحلة تأسيس «مسرح الحكواتي الفلسطيني».
كانت للفنون الأخرى حصة أقوى بالبقاء والانتشار كما هي الحال في الشعر الذي يمثل امتدادا لتقاليد عربية عريقة عبر تاريخنا العربي؛ فالشعر والرواية والرسم فنون يبدعها فرد، بينما المسرح فن صعب لأنّه يجمع جميع الفنون، ويحتاج إلى تجميع وجمهرة خلال العرض، وبالتالي فهو فن جماهيري جَمْعي، وهو ما يجعل ذلك صعبا في ظل ظروف سياسية صعبة. ولأنّه كذلك، فقد كانت السلطات تجد فيه فنّاً توعويا تحريضيا بشكل جماعي. إنّ وعي السلطات الإسرائيلية لمصالحها أدّى إلى برمجة قوانينها بناء على مصالحها، وإلى إرغام الفلسطينيين على عدم تجاوزها، ما حدا بها لوضع خطة ممنهجة وذكية، بحيث وضعت يدها على مناهج التعليم، وكانت انتقائية في كيفية تنفيذ هذا المنهاج عن طريق مديرين ومعلمين يخضعون للمنهاج ومستعدون لتنفيذه بحزم وتحت رقابة المفتشين وأجهزة المخابرات. وضمن خطّة غسيل دماغيّ خطير وممنهج، وُجِدت أكبر شريحة عُمْرية من أبناء شعبنا منذ الطفولة إلى نهاية المرحلة الثانوية خاضعة لمنهاج تضليلي يزيف التاريخ ويجذّر الوعي نحو أسْرَلَتِنا وتَبَعِيّتنا لـ«إسرائيل»، لكي تنقلنا إلى مرحلة التنازل عن هويتنا الفلسطينية والاكتفاء بهويتنا الطائفية والدينية والعائلية.
تحت هذا الضغط، ومحاولة الحفاظ على كياننا وعدم المواجهة المباشرة مع نظام قوي جديد أثبت أنّه قادر على أنْ يُلحق الهزيمة بالجيوش العربية، وَجَدنا أنفسنا نحن المتلهّفين للعمل في المسرح نبحث عن فن اجتماعي، ونعدّ مسرحيات غربية ونُبَنْدِقُها لكي تلائم طبيعة مجتمعنا، متوخِّين الحذر بمراقبة ذاتية ورقابة، بحيث لا نَتدّخل في مجال السياسة والتحريض والوطنية، لأنّ ما نفعله ليس سِرّيا بل هو مسرح مكشوف لكل من يريد الحضور والمشاهدة. ندرت النصوص المحلية، وأحيانا كنا نستعين بنصوص من العالم العربي الذي هو أيضا بدأ يفطن إلى تأسيس الوعي الثقافي، ومنه المسرح، خاصة في مصر وسوريا وتونس والمغرب، وما كان يصدر من نصوص مسرحية مترجمة وعربية وبغزارة في الكويت. لكننا بقينا إلى الآن نفتقر إلى العمود الفقري الذي يشكّل نقطة الانطلاق للعرض المسرحي، وهو النص المسرحي الْمُخَصَّص للعرض المسرحي، وبخاصة النصوص التي توازن بين كياننا الوطني والسياسي الاجتماعي. ولا ننكر أنّنا حظينا في المدة الأخيرة ببعض النصوص الفلسطينية القوية التي تحوّلت إلى عروض مسرحية، ولكنها لم تُلبِّ حاجتنا بشكل وافر على أتمّ وجه، ونعتزّ بأنّ بعض الأقلام الملمّة بأسرار اللعبة المسرحية تجتهد حاليا في تعبئة هذا الفراغ.
التبطين والترميز
ولأنّ المسرح في تلك الفترة من سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته كان لا يزال يخضع للرقابة السلطوية الإسرائيلية أُسوةً بالسينما، فقد كانت الفِرق المسرحية أحيانا تلجأ في مواضيعها الوطنية إلى التبطين والترميز، بينما تعرَّضتْ بعض المسرحيات السياسية الوطنية المباشرة إلى المنع من قبل جهاز الأمن ولجنة الرقابة والمحكمة العليا الإسرائيلية. إنّ بداية اللجوء إلى المسرح كوسيلة تعبير عندنا تميز معظمها بانتقاءَ مواضيع اجتماعية بعيدة عن طَرْقِ باب الموضوعات الوطنية والسياسية التي قد تؤدّي إلى التحدي المباشر مع الرقابة ومراقبة السلطات التي كانت تحذّر من التدخل في «السياسة» من دون أنْ تضيف أنّها تقصد «السياسة الوطنية» التي اعتبرتها السلطات جزءا من التدخل في الأمور المتعلقة بأمن الدولة، وليس «السياسة» التي تخدم «إسرائيل».
هذا لا يعني، بالطبع، أننا نريد الاستنتاج القاطع بأنّ المسرح يقاس فقط بمدى انحصار مواضيعه في شكل واحد من المعالجة، لأنّ المسرح يختلف عن الخطاب السياسي المباشر بأنّه فن إنساني ذوقي جمالي مؤثر في جميع القضايا الأخرى، ولكنّ حدّة الصدام بين متطلبات السلطة ومتطلبات القضية السياسية في فترة البحث عن التحرر الوطني التي لم تكتمل، كما هو الحال لدى سائر الشعوب التي تحررت وحصلت على حرية تقرير مصيرها، جعلتنا نؤكّد على حاجة استغلال المسرح كمجال يخدم الهوية والقضايا الوطنية.
ومثال ذلك، خلال وجود لجنة إسرائيلية للرقابة على المسرحيات والسينما حتى نهاية سنوات السبعين، كانت الشرطة الإسرائيلية تحضر إلى مكان عرض مسرحيتنا «السلام المفقود» التي تتطرق إلى موضوع السجناء الأمنيين، وتبلغنا بأنّنا يجب إيقاف العروض إلى حين الحصول على إذن مسبق من لجنة الرقابة.لم يكن هذا متّبعا بشكل منهجي وصارم مع جميع العروض الموجودة على الساحة، وإنما كان التعرض يجري للمسرحيات التي يُبلّغ عنها بأنها تحريضية أو سياسية. وعندما تابعنا العروض حتى العرض الثالث، تسلّمنا أمراً رسميا بالمثول للتحقيق في مركز الشرطة مع الممثلين وكل طاقم المشاركين في العمل، ما شكَّل ضغطا على الأهالي، وقد كان بين المشاركين أطفال وصبايا، ما حدا ببعض الأهل لأن يطلب منا السعي للحصول على تصريح من لجنة الرقابة. كانت لجنة الرقابة مكونة من 21 عضوا، 19 منهم عارضوا عرض المسرحية، وواحد، وكان عربيا، وقف على الحياد، وواحد كان صهيوينا يمينيا متعصبا وافق على أنْ نتابع العروض بحجة أنّه من خلال السماح لنا بمتابعة العروض فإنّها ستكون فرصة سانحة وسهلة لجهاز الأمن لكي يتابع ردود فعل الجمهور على مسرحيتنا، بحيث يشكّل العرض شكلا من أشكال ردّ الفعل الشعبي على الأمور الوطنية أو التحريضية أو الحماسية، وهكذا يستطيعون رؤية ردود الفعل بشكل مكشوف، وهذا أفضل من أنْ يبقى الأمر مخبّأ وسريا بين صدور الجمهور العربي المعادي للدولة، وعندها يسهل عليهم مراقبة واعتقال أو محاكمة أو معاقبة المحرّضين والخطرين على «الأمن»، وعلى هذا النوع من التعبير المسرحي الوطني والتحريضي!
بعدها استأنفنا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وكان القضاة الثلاثة على قلب رجل واحد بأن رفضوا إعطاء تصريح لعرض المسرحية، لأنّها تحرِّض ضد «إسرائيل» وتشكِّل خَطراً على أمنها. وعندما واجههم محامينا بأنّ كلمة «إسرائيل» لا تذكر بالمرة في المسرحية، كان ردّهم بأنّ رد فعل الجمهور يدلّ على أنّ المقصود بالشخصيات الشرّيرة والقامعة والظالمة هو دولة «إسرائيل»، بينما ردود فعلهم الإيجابية بالتصفيق والتشجيع كانت للشخصيات العادلة والخيّرة والتي ترمز إلى العرب والفلسطينيين أو للشخصيات الواقع عليها الظلم. وعندها فَقَدْنا الأمل بمتابعة العروض، فأَصدرتُ المسرحية في كتاب، ولم يكن الأمر ممنوعا لأنّ الكتاب هو علاقة فردية بين القاريء والكتاب وبشكل منعزل، بينما المسرح هو علاقة بين مجموعات بشرية متجمّعة بشكل جماعي وتَكَاتُفِي وتظاهريّ، أمام مجموعة من المبدعين الذين يوصلِون إلى تلك المجموعات شحنات تفاعلية إبداعية لها مغزى بشكل قريب من حالة التظاهر.
كان بعض النقاد الإسرائيليين الذين كتبوا عن مشاهداتهم بعض مسرحياتنا يستنتجون أنّ الترميز أو التلميح عن شرٍّ ما في مشهد ما من المسرحية يُقصد به الإسرائيليون، وخاصة أنّهم يعلمون أنّ من يقدّمون العرض هم فلسطينيون ولديهم فكر مسبق بأنّهم يسعون للوعظ ضد الاحتلال والشر والظلم.
مراقبة الأعمال المسرحية
توسّعت «إسرائيل» وقويت وانتصرت تقريبا في جميع حروبها ضد العرب، واعتَبَرت القدس مدينةً موحَّدة تابعة لها ولقوانينها المدنية وليست لقوانينها الاحتلالية، ولاحقا فعلت الأمر ذاته مع هضبة الجولان فضمّتـها إلى حدودها رسميا وبقرار حكومي وبرلماني. ألغت السلطات الاسرائيلية الرقابة على المسرح في أراضي 1948، وكانت مدركة لحقيقة أنّ الإقبال الجماهيري على المسرح خارج المدارس هو جمهور محدود جدا، ولا توجد لديه تقاليد راسخة للإقبال على العروض المسرحية، ولا يشكل ظاهرة خطيرة. فضلاً عن أنّ الفرق كانت تتوخّى الحذر في طروحاتها لمواضيعها بحيث أنّها راحت تمارس رقابة ذاتية، وخاصة أن الإرهاب السلطوي كان يؤكد على خطورة التدخل في السياسة والشعارت الوطنية، ما قد يؤدّي إلى العقاب والقمع، أو خسارة المردود المادي والمعنوي المفترض أن يجنيه العاملون في المسرح لكي يستطيعوا المتابعة في «مهنتهم»، والأفضل القول «مهمّتهم» أو «همّهم» الإبداعي.
لكن السلطات الاسرائيلية كانت على قناعة تامّة بأنّ المدارس فيها تجمُّع ضخم لآلاف البشر عبارة عن جمهور جاهز وبِكْر ومادّة خام للتغيير، ما جعل السلطات تتشبّث بخطتها طويلة المدى في المنهاج التعليمي في المدارس، حيث استعملت قبضتها الحديدية لتنفيذ المنهاج بحذافيره، ومن يريد تقديم نشاط لا منهجي، كالمسرح مثلا، عليه أنْ يحصل على تصريح خاص من قبل وزارة المعارف الإسرئيلية بحيث يتطلب الأمر مشاهدة المسرحية التي يَطلب أصحابُها عرضَها في نطاق المدارس. كانوا على قناعة بأنّ تجذير المنهاج لدى أجيال تكبر تحت سلطتها ومنهاجها يشكل محوا ممنهجا للهوية الفلسطينية وتجذير الانتماء إلى الدولة الفتية القائمة والرضوخ لقوانينها. إنّه مشروع «أسْرَلَة» الفلسطينيين دماغيا وفكريا وتربويا منذ نعومة أظفارهم إلى نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، ومن ثم جعلهم يخدمونها في جميع مؤسساتها، وبضمنها الجيش والشرطة وجهاز المخابرات، وهو نوع من الأسرلة بمواطنة منقوصة أو مجزّأة ومجزِّئة، فهي تسعى لتحويلنا إلى مجموعات مهجّنة منقوصة المواطنة، بدلا من توحّدها تحت هويتها الفلسطينية، وتبقيهم تحت سلطتها تائهين بين إسرائيليتهم وفلسطينيتهم، واعتبارهم مجرد مجموعات من الضيوف المسلمين والدروز والمسيحيين والشركس والبدو والعائلات والطوائف والمذاهب وما هبّ ودبّ مما يساعد على تجزيء المجزّأ وتشتيت المشتّت وتنفيذ سياسة فرّق تسد على أرقى مستوى ممكن.
مسرح في الهواء الطلق.
استمرت السلطات الإسرائيلية في مراقبة الأعمال المسرحية من خلال سلطة المعارف وجهاز التربية والتعليم والضغط الممنهج للعمل في نطاق المنهاج المقرر، وهو مبرمج لإلغاء الهوية وتزييف التاريخ. أعطت الحرية للعمل خارج المدارس بدون تصريح بعد أنْ ألغوا جهاز الرقابة، ولكنها شدّدت على تقييد الحركة داخل المدارس، فهي تشكل أداة للتأثير المباشر على عقول مجموعات بشرية كبيرة منذ الطفولة، وغسل الأدمغة بمنهاج وقوانين صارمة لا تسمح لقوة أخرى التأثير عليها، إلا بتصريح خاص ومصادقة ضمن حدود شروطها.
إنّ الغاء الرقابة عن المسرح والسينما في أراضي 1948 وَازاهُ فتح الرقابة وتكرار التجربة في الأراضي المحتلة سنة 1967، حيث كان الحكم العسكري يشدد الخناق على كل شيء بما في ذلك الحركة الثقافية، وعندما كان مسموحا لسكان أراضي 48 بالتجوال في أراضي 67 كان يُطلب من الفرق التي تودّ عرض مسرحياتها في «المناطق» كما تسميها «إسرائيل»- تقديم طلب تصريح لأعمالها المسرحية من الحاكم العسكري. حتى منطقة القدس المحتلة التي أعلنت «إسرائيل» أنّها تتمتّع بحكم مدني لأنها بنظرهم «موحّدة» وليست محتلة، فقد تعرَّضت للكثير من الخناق، وشهد «مسرح الحكواتي» عشرات الإغلاقات بأمر من الحاكم العسكري، وبناء على قانون الطوارئ، بحجة أنّ بعض نشاطات هذا المسرح تحريضية وضد أمن «إسرائيل».
التخصص والاحتراف
منذ النصف الثاني من الثمانينيات حتى الآن، حدثت هبَّة ملحوظة لدى المهتمين في مجال المسرح ومجالات الفنون الأخرى، فقد تحمس المحبّون للتخصص في هذا المجال، والتحقوا بمعاهد عُليا وحصلوا على شهادات، ما جعلهم يمتهنون العمل المسرحي، ليس بالاعتماد على الهواية فحسب، بل عن دراسة ودراية وعمق، فظهرت أفواج جديدة من العاملين في هذا المجال من ممثلين ومخرجين، ومصمِّمي ومنفذي ديكور، ومهندسي وتقنيّي إضاءة وصوت، وسينوغرافيين، ومصممي أزياء، وملحنين ومغنين وموسيقيين وراقصين، وصانعي ومستعملي أقنعة ودمى، وممثلي مونودراما (مسرحيات الممثل الواحد) وممثّلي «ستاند-أب» كوميديا، وممثّلي «بانتومايم» (التمثيل الإيمائي الصامت)، والقليل القليل جدا من المؤلفين للنصوص المسرحية القريبة من المنصة وليست المكتوبة منها والقريبة جدا من الأدب المقروء. طبعا ظهرت في المجالات ذاتها هَبَّة كبيرة لدى الفتيات اللواتي تخرّجن في مجالات الفنون المختلفة وشاركن، ما أحدث توازناً ملحوظا في العملية المسرحية بين الذكور والإناث. بل إنّ هنالك مجموعة من الممثلين والممثلات الفلسطينيين طُلبوا للعمل في مسارح عبرية يهودية كبيرة لحرفيتهم ومهنيتهم التي تفوقوا من خلالها على الممثلين اليهود، وباللغة العبرية، وعندما نهض المسرح نهضته الكثيفة في الوسط الفلسطيني في الداخل عادوا وقدّموا خبراتهم الكبيرة لأبناء شعبهم على أحسن وجه وبحرفية عالية وبخبرة لا تُضاهى.
في هذه الفترة، أصبحت الحاجة ملحّة إلى الانتقال من حالة التطوّع واللجوء إلى المسرح كمجال ثانوي لا أمل في احترافه كليا لأنّه «لا يطعم خبزا»، إذ لجأ الطامحون لاحتراف المهنة إلى تأسيس فِرَق مسرحية متجولة ومسارح مع قاعات ثابتة، واعتمدوا عند تحويله إلى مصدر رزق على تأسيس جمعيات غير ربحية تعتمد على جلب الأموال من أجل التمكن من إنتاج أعمالهم المسرحية وإدارة شؤونهم، حيث أنّه كان هنالك شبه قناعة بأنّ المسرح مجال مكلف جدا ولن يكون الاعتماد على مدخول التذاكر كافيا لإعالة العاملين فيه وتخصيص جزء من المدخول من أجل العملية الإنتاجية.
إشكالية التمويل
هكذا تأسست على هذا الأساس العديد من الفِرَق المسرحية والمسارح التي توقّف بعضها عن العمل وظهر غيرها، واليوم يوجد لدينا عشرون فرقة ومسرح تعمل معظمها كجمعيات، وهي تحصل على ميزانية دعم من وزارة الثقافة الإسرائيلية، بالإضافة إلى الفنانين الذين يعملون بشكل فردي ومستقل وليسوا ملتزمين بفرقة أو بمسرح معيّن. هنالك مسارح لها مقرّات وقاعات وأصبحت تعمل على شكل مؤسسات رسمية، وأخرى متجولة، وتكاد تخلو الساحة من المسارح التي تعمل بشكل مستقل وتمتنع عن الحصول على موازنات دعم من مؤسسات الدولة، اللَّهم باستثناء مسرح أو اثنين رفضا التعامل مع هذه المؤسسات لأنّها تقدم الدّعم وتعلن مع بداية كل موسم أسماء الفرق التي تأخذ دعما منها وكأنّها تابعة لهذه الوزارة، أو كأنها تقدّم للفرق منحة تشجيعية، بينما يدّعي الحاصلون على هذه الموازنات أنهم مواطنون في الدولة يقومون بواجبات ويدفعون الضرائب وهذه الموازنات ليست منّة عليهم من قبل الدولة بل حقّ يستردّونه.
مع ذلك، فإنّ الإجحاف في توزيع الموازنات للفرق والمسارح الفلسطينية أدّى إلى فضح التفرقة بين مواطنين وآخرين بناء على هويتهم السياسية، إذ تذهب 97% من هذه الموازنات إلى المسارح والفرق العبرية، وفقط 3% من الموازنة تخصص للعرب، مع أنها موازنة مَجْبِيَّة في الأصل من جيوبنا عبر الضرائب والمؤسسات الرسمية الإسرائيلية. فإذا كنا اليوم نشكل 20% من عدد السكان، فالمنطق يقول بأنّ الدولة يجب أن تعيد إلينا 20% من الموازنة المخصصة للمسرح.
على الرغم من كل هذه التبريرات والقناعات، فقد بقيتُ متشكّكا في مسألة أن تحصل الفرق على دعم مادي بدون مقابل، فالسلطات تظنّ أنّها مقابل إعطاء بعض الفتات من مجمل الموازنة للفرق العربية إنمّا هي تضمن بأنّ هذه المسارح والفرق سوف تبقى ضمن شروطها المؤسساتية وتحت سيطرتها، أو على الأقل فهي تضمن بأنّه عند الإعلان جهارا في وسائل الأعلام عن حصول هذه المسارح والفرق على الدعم فإنّها تنوّه إلى أنّها مرتبطة بالمؤسسة، بينما العرب الحاصلون على هذا الفتات من الموازنات هم بدورهم أيضا يقولون إننا على استعداد على اللعب مع السلطة لعبتها، فهي لديها أهدافها ونحن لدينا أهدافنا، فنحن على الأقل نريد أن نحصل على أكثر من ذلك كحقوق لكوننا مواطنين هنا وجزء من مؤسسات الدولة، وبالتالي نستطيع أن نعبّر عن إبداعاتنا ضمن المتاح، ونستطيع على الأقل أن نجعل إنتاجاتنا الإبداعية أكثر غنىً وتكاملا بسبب وجود هذه الامكانية المادية المتواضعة. ولكن ما يميز هذه الفرق المسرحية والمسارح أنّها حاولت أحيانا إيجاد بعض الأعمال من تأليف وإخراج وصناعة محلية تخُصُّنا، بينما الكثير منها بقيت مستورِدة لمواضيع من خارج بيئتنا التي تخصنا، وبقيت تفتقر إلى أسلوب أو مذهب يميز أعمالها بحيث تستطيع إصدار «بيان مسرحي» تشرح من خلاله طريقة توجّهها من ناحية الشكل والمضمون أو المدرسة أو المذهب الذي تسعى لخلقه أو إبداعه والذي يميزها عن غيرها من المدارس أو المذاهب المعروفة، ويسهم بقفزة جديدة تضيف شيئا خاصا لعالم المسرح، اللهم إلا ما ندر منها، وقد تميزت «فرقة الحكواتي المقدسية» و«مسرح السيرة الفلسطيني» بعملهما على أسلوب يخصهما شكلا ومضمونا وعبّرا عن ذلك من خلال بياناتهما.
في هذه المرحلة أصبح مجال المسرح بعيدا عن التطوع وأصبح مصدرا حِرَفيا يُعتاش منه. وبما أنّ معظم الجمهور الجاهز بكثافة وبأعداد كبيرة موجود داخل جدران المدارس، فَقَدْ كثّفت الفرقُ مجهودَها للوصول إلى المدارس لكي تعرض فيها بكثافة، حيث إنه خارج نطاقها لا يمكن الحصول على جمهور كافٍ وجاهز بأقل ما يمكن من دعاية وتكاليف وتحضيرات كبيرة مسبقة، وبخاصة أننا لم نصل بعد إلى الحد المطلوب من الجمهور الذي يشعر بأنه بحاجة إلى المسرح كتقليد «إدماني» لكي يخرج من البيت من أجل حضور عرض مسرحي، ما قد كان يُعَرِّض العُروض المسرحية المخصَّصة للجمهور العام إلى التوقّف بعد عشرة أو عشرين عرضا، بينما عملية الإنتاج لهذا العمل تكون قد استغرقت وقتا ومجهودا كبيرين وتكلفة عالية.
* كاتب ومسرحي من قرية المغار في الجليل. أَسس مسرح البلد عام 1973، وهو أحد مؤسسي «مسرح الحكواتي» في القدس المحتلة، ومؤسس «مسرح السيرة».
صحيفة السفير اللبنانية (ملحق فلسطين)