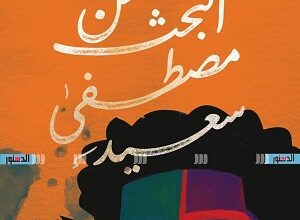الحيوان كاستعارة كبيرة عن الإنسان (كاظم جهاد)
كاظم جهاد
بالأبيض والأسود وحدهما صنع يوسف، كما هو معروف، عالماً كاملاً. فتح عالم الحفر والغرافيك واللوحة الزيتية والتخطيط بالحبر على هذين اللونين وأثبت قدرته لا بل براعته في أن يصنع منهما مروحة لونيّة عريضة. راح يتلاعب بالمساحات ودرجات الإضاءة والتعتيم فصرت ترى نفسك أمام عائلة من الألوان. ولقد كان اللّون الأسود كبير الفائدة له إذ هو يساعده في تشخيص عالم شديد القتامة وجد يوسف أحد عناصر رسالته الفنيّة متمثّلاً في أن يمعن فيه حفراً وإضاءة. مستعيناً به ومتلاعباً به راح يرصد ويفجّر قدرات المقاومة والتعبير لدى كائن ألفى نفسه حبيس ظلامٍ متكاثف. «ما الذي يقدر عليه جسدٌ ما؟»، أو، بتعبير آخر، «إلى أين يقدر أن يذهب هذا الجسد أو ذاك؟» سؤال لسبينوزا جعل منه جيل دولوز في دراساته الفلسفية للرسم والأدب منطلق فلسفة هامّة. الطاقة، بما هي قدرة احتمال ومكابرة وفعل مقاوِم، حتّى في المظاهر الأكثر جموداً، وإلى حدّ التخشّب، التي يمكن أن يهبها جسدٌ عن نفسه ذات لحظة. بفضل تواشج لونين صارا هما اللّون كلّه، أو أصبحا هما الألوان بكاملها، جابه يوسف عبدلكي جمود العالم بحياة تلقى في الجمود، وعلى نحو شديد المفارقة وكبير الحذق، سبيلاً للإعراب عن حيوية فائقة وعنفوان دائم. ركّز على الحيوانات بخاصّة، بادئاً مسيرته بسلسلة من الخيول، ثمّ انعطف إلى سلسلة عن الأسماك وأخرى عن جماجم الخراف، وأقــام فيهـــما طـــويلاً.
سمكة حيّة، أو ميتة، أو هي على قاب قوسين أو أدنى من الموت. سمكة لا تزال تحمل في ارتعاشها الخفيّ الذي يخترق نوابض الجسد كلّه، ويحوّل السطح الجامد إلى هدير أعماقٍ، أقول لا تزال تحمل آثار الذّبح. هي هنا تتطلّع بعينين ساطعتين، سوى أنّ سكّيناً شطرتْها نصفين، أو أنّها يحدّها مسماران نحيلان يقفان علامة على أنّ في هذه «الاستراحة» الجامدة أثرَ عنفٍ باتر. هذه السمكة، كالأشكال الحيوانية الأخرى التي يصوّرها الفنّان في منقلب هو بين الحياة والموت، تشكّل دائماً استعارة كبيرة عن الإنسان. إنّها بدليّة يصفها دولوز وغواتاري في أعمالهما الفلسفية المشتركة بخصوص الآثار الفنية والأدبية التي تصوّر وقفة بعض الكّتاب والفنّانين أمام الحيوان بما هو تعبير عن الكائن بعامّة. تتعلّق المسألة بذلك الجانب الإنسانيّ الذي هو في الحيوان. فالحيوان يعاني، وخلافاً لتصوّر هايدغر في تمركزه الإنسانويّ الذي تصدّى له دريدا من منطلق قريب، يعبرّ الحيوان عن معاناته هذه بفصاحة أو بقوّة كافية: من لم تأسره ذات يوم النظرة الشاكية لهرّ يعصف بدواخله ألمٌ جارفٌ أو توقٌ عصيّ؟ كما أنّ للأمر صلة بذلك الحيوان الذي هو في الإنسان: من منّا، يتساءل دولوز، لم يتضوّر ذات يومٍ ألماً حتّى ليجأر كحيوان جريح؟ هذه البدليّة، هذه الانتقالية بين الإنسان والحيوان تشكّل لفنّ يوسف عبدلكي نابضه الكبير أو نبضه الخاصّ. حفظَها من ارتياده الذكيّ لأعمال كبار الفنّانين، وجعل منها عنوان عمله.
عن إرادة، وبقرار فنيّ أو فكريّ، وبلا حرج، طوّر عبدلكي أعماله هذه في ظلال المدرسة الانطباعية، غير عابئ بصرعات التجريدية، غنائية كانت أم لم تكن. وهل من حرج في أن يُدرج فنّانٌ آثاره في ذلك المسار الواسع الذي اختطّه فان كوخ وسيزان وآخرون؟ مثلما رسم فان كوخ حذاءين فلاّحيّين ينطقان بمسيرة وتاريخ وعناء، رسم عبدلكي حذاءين ملتقطين في فضاء المدينة، ينطقان هما أيضاً بمسيرة وتاريخ وعناء. وعلى النحو ذاته، يشكّل لديه هيكل عظميّ لسمكة لم يبقَ منها سوى الحسك، أو جمجمة خروف عارية، يشكّلان البطانة المكتنزة لوجود عِيش حتّى الثمالة وما زال يحتفظ في هيكله الباقي والأجوف بشيء من توهّجه وامتلائه بحياة كانت ولم تعدْ. في هذه البورتريهات المفارِقة، في «نيجاتيف» الصورة هذا ما ينطق بحياة ترفض أن تساق بكاملها إلى العدم. واقعية تراجيدية ورفض للامّحاء ونظرة دائمة الالتفات من منقلب الموت إلى جهة الأحياء. وخلافاً لتقليدٍ تشكيليّ يحمل عنوان «الطبيعة الجامدة» أو «الحياة الصامتة»، الذي نرى فيه طاولة عليها فواكه جافّة وغليون وما يشبه، نقابل في لوحات عبدلكي حياة حيوانية أو نباتية جامدة بالمعنى الحرْفيّ للكلمة، ولكنّ شيئاً خفيّاً يجعل حالة الجمود هذه حبلى بنقيضها التامّ. نظرة لا تخلو من السطوع، انفعال قام الرسّام بتجميده، أي تثبيته، مرّة وإلى الأبد، نور يعيا على الظلام التهامه أو تطويعه، رقصة ثابتة إذا جاز التعبير، شيء من الرفض والمقاومة حيث لم تعد المقاومة منتظرة، هذا كلّه يجعل هذه «الطبائع الجامدة» بالغة الشبه بالصّور الفوتوغرافية الشهيرة التي تصوّر قتلى الحروب: تصوّرهم في لحظة الانعطاب، حيث لا تزال نظرة القتيل طافحة بوهجها كلّه، وبشعاعها الخاصّ، في اللحظة العصيبة والمشخّصة وشبه غير ممكنة التسجيل التي تنتقل فيها من مسرح الحياة إلى مَطارح الموت. ثبات النظرة في هذا الواقع السديميّ، في هذه المنطقة الوسيطة أو البينيّة، في هذا البرزخ الفاعل الموّار، تلك هي آية يوسف التي تستوقف الموت، بمعنى أنّها تستنطقه وفي الأوان ذاته تبقيه كأنّما على مسافة.
المسمار نفسه، الذي قلت إنّ يوسف يصوّره أحياناً مشكوكاً في صميم سمكة، أو مغروزاً إلى جانبها إشارةً إلى الحدّ أو العائق المقام في وجه كيانية مجبولة على الانسكاب والفيض، هذا المسمار لم يفت يوسف أيضاً أن يجعله يتمخّض بدوره عن سلسلة لوحات. تراه في بضعها منتصباً بكامل ماديّته الأليمة، نحيلاً كخيط باتر، منتصباً كإساءة، وفي بعضها الآخر ترى أغصاناً وسيقان نباتٍ وقد انتصبت في إهابها المسماريّ وكثافتها شبه المتصلّبة. سوى أنّ حركة راقصة وتثنّياً شبه فرح ونوعاً من الوثب، هذا كلّه يؤطّر شاكلتها في سكنى الفضاء. سيقان كأنّها تصلّبت في سيرورة مقاومة، من دون أن تنسى أنّها حوامل حياة، ومن هنا ما يرتسم عليها من انبساط وليونة.
الاغتراب
عاش يوسف عبدلكي في المنفى الفرنسيّ عقوداً عديدة. ونادراً ما عرفتْ أرض الاغتراب هذه، التي تمتدّ معرفتي لها على ما يقرب من أربعين عاماً، فنّانين بمثل سخاء يوسف ورفيقة حياته، المخرجة السينمائية هالة العبد الله. حتّى لا أطنب في الكلام عن كرمهما الشخصيّ، بعدما ركّزت الكلام على فهمي المتواضع لفنّ يوسف، يكفي أن أقول إنّ كثيرين ممّن يعانون من آلام المنفى وعذاب الاغتراب كان يكفيهم أن يعاشروا هذين الفنّانين كي يستردّوا عافية وفرحاً بالكينونة كان يخيّل لهم قبل ذاك أنْ لا عودة ممكنة لهما. يكفي أيضاً أن أضيف أنّني كثيراً ما رأيت يوسف أكثر احتفالاً بمعارض سواه ممّا بعمله نفسه، وكثيراً ما رأيت هالة أكثر كلاماً عن أفلام سواها ممّا عن أفلامها هي. بعد عقود النفي هذه، قرّر يوسف أن يعود إلى أرض ولادته. معروفٌ كم يصعب على شاعر أن يعيش خارج مجالٍ تنثال عليه فيه كلمات لغته الأمّ في انبجاسها الطبيعيّ وحرارتها الأصليّة. هو انتفاء عن اللّغة بما هي شاكلة انخراط في العالَم وحبل سريّ لا وجود للشاعر بدونه. وعلى هذا الانسلاخ يستعين الشاعر بقواميسه وكتب تراثه يحملها معه أنّى حطّ رحاله، وبارتياد عوالم الجالية، أبناء وطنه، على ما تحمله له هذه العوالم أحياناً من متاعب وما يمارسه بعض أقرانه فيها من إعادة إنتاج لأمراض الوطن. الأمر نفسه بالنسبة للفنّان، فهو لا يستعذب الإقامة طويلاً في فضاء لا يرى فيها ألوان عالمه الأصليّ ووجوهه. كالأدب تماماً، يـتأسّس الفنّ على «لغط» حيويّ ووجوه لا بديل لها وعادات يوميّة وطقوس ومناظر أثيرة وذكريات وملامح خاصّة. وعندما أدرك يوسف استحالة إطالة الإقامة بعيداً عن أبجديّة الطفولة وألوانها وأناسها، عاد إلى الوطن، على علمه بما يمكن أن تكلّفه إيّاه هذه العودة من معاناة يوميّة وملابسات ثقيلة ممكنة. اعتقاله اليوم يشكّل ظلماً متطرّفاً من حيث انّه يتنكّر لكلّ ما في فعل العودة، عودة يوسف بالذّات، من نبالة وتضحية، لا بل هو إساءة لكلّ ما في العودة من دلالات إنسانيّة وإبداعيّة. قل لي ما تفعل لعائديك أقلْ لك من أنت.
الحريّة، كلّ الحريّة ليوسف عبدلكي.
(كاتب عراقي ـ باريس)
صحيفة السفير اللبنانية