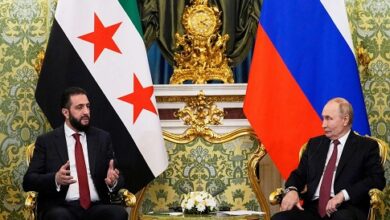الدَّور المُلتبِس للمنظّمات غير الحكوميّة

أظهرت حركات الاحتجاج المختلفة التي انتشرت في المنطقة العربيّة بعد أحداث تونس في ديسمبر(كانون الأوّل) 2010، أنّ جموع الناس التي خرجت إلى الشوارع حينذاك، لم تكن تُحرّكها “نظريّات كبرى” عن التغيير والثورة. وفي هذا الإطار لم يكُن هناك من دَورٍ واضح لكتاباتٍ مؤثِّرة من المثقّفين، من عرب أو من سواهم. كان يقود الجموع في معظم الأحيان نشطاء ميدانيّون يعملون في منظّمات حقوقيّة مختلفة تُطالِب ببعض القضايا الجزئيّة (حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل..إلخ).
فضلاً عن النشطاء الميدانيّين، برز خلال حركات الاحتجاج نشطاء آخرون تُحرّكهم أطر فكرية مُستمدَّة من إيديولوجيّات الحركات الإسلامية السائدة، مثل حركة الإخوان المسلمين تحديداً، التي طوَّرت أيضاً فكراً حركيّاً للتأثير في جموع الناس عن طريق الالتصاق بهم، وتحسُّس همومهم، والمساعدة قدر الإمكان في تخفيف معاناتهم. ما يعني في كلا الحالتَين غياب الرؤية المُلهمة التي تستنهض قوى المجتمع، كما كان الحال مع الناصريّة مثلاً في منتصف الستينيّات من القرن الفائت، أو الماركسيّة في بداية القرن العشرين.
في هذا الإطار بالإمكان التساؤل، هل إنّ الفكر المُستمَدّ من خطابٍ حقوقيّ عامّ من منظّمات العَولمة قادرٌ في حدّ ذاته على تقديم تلك الرؤية الفكرية التحويلية؟ وفي الاتّجاه نفسه، هل بإمكان الحركات الإسلامية المُعاصرة، مهما التصقت بجموع جماهيريّة، والتحمت بها، أن تعمل على تخفيف معاناتها، بإنتاج فكر قادر في حدّ ذاته على تحرير الناس من أوضاع التخلّف والاتّجاه بهم نحو مسار ديمقرطي حقيقي؟
لا شكّ أنّ عملية التغيير الاجتماعي تستدعي تعبئة الشرائح والفئات الاجتماعية التي تسعى إلى التغيير، وهو ما يستدعي بدوره قيام هياكل وأُطر تنظيمية تشمل الساعين للانضمام إليها وتُمكّنهم من ممارسة أدوارهم في سبيل التغيير الاجتماعي المنشود، وذلك من خلال “تمكين المجتمعات المحلّية”، وغيرها من المفاهيم التي ارتبطت بانتشار المنظّمات غير الحكومية منذ أواخر ثمانينيّات القرن المنصرم وتوسّع مفهوم “المجتمع المدني”، مثل “التمكين” و”ممارسة القوّة”، و”القيادة التحويليّة” وغيرها.
من أهداف الألفيّة الى أهداف التنمية المُستدامة
ابتداء من عام 2000 وحتّى عام 2015، سار العالَم على الأهداف الألفيّة للتنمية التي دخلت في خطط الحكومات ومنظّمات المجتمع المدني والمنظّمات الدولية والعالمية، بغية تحقيق إنجازات في مكافحة الفقر والجوع والأمراض والأمّية والتمييز ضدّ المرأة..إلخ. هذا التبشير الإيدولوجي بمقولة المجتمع المدني تبلور في سياسات مُحدَّدة تعمل على تأسيس العديد من المنظّمات غير الحكومية في العالَم، وعلى تشجيعها وتمويلها، إمّا لسدّ فجوات التنمية، التي لم تستطع الدولة في العالَم الثالث القيام بها، أو لتغيير النُّظم التسلّطية ونشْر الديمقراطية.
وتَمحور الدَور التنموي للمنظّمات غير الحكومية، بشكل عامّ، حول توجّهَين: توجّه يرى أنّها تلعب دَوراً مهمّاً في عملية التنمية، بسبب قدرتها على دمج قطاعات واسعة من الناس وإشراكها في عملية التنمية، وهو ما يُطلَق عليه عادةً اسم “التنمية التشارُكية – Participatory Development؛ وتوجّه آخر يُشكِّك في قدرة المنظّمات غير الحكومية على القيام بهذا الدَّور، لكونها تُعيد إنتاج البيئة السياسية والثقافية التي تعمل في ظلّها، ولا تُشكِّل بالضرورة نقيضاً لها؛ ففي معظم الأحيان، تكتفي هذه المنظّمات بتقديم خدمات لمجموعة “مُنتفعين” في المجتمعات المحلّية، من دون أن تتيح الفرصة لـ”المشاركة الفعليّة”، التي تتمثّل في المشاركة في اتّخاذ القرار، وفي تحديد الأولويّات، وفي توزيع الميزانيّات، فضلاً عن تقييم البرامج، وقيادة المنظّمة غير الحكومية نفسها…إلخ، وبما يؤدّي إلى تمكين فردي وجماعي حقيقي، وإلى أن تُصبح المنظّمة غير الحكومية مُساءَلة Accountable من قبل جمهورها ومنتفعيها. غياب هذا النوع من المُشارَكة قد يكون أحد الأسباب المُفسِّرة لعدم قدرة المنظّمات غير الحكومية، بنيويّاً، على خلق قيادات محلّية (كما كانت تفعل الأحزاب السياسية وأطرها الجماهيرية) تتميّز بالتدريب السياسي والتنموي الكافي للقيادة. هذا فضلاً عن قيام عمل العديد من المنظّمات غير الحكوميّة على “مشروعات” أو برامج محصورة بنقطة بداية ونقطة نهاية، أي بفترة زمنيّة معيّنة، ما يحول دون “عملية المُداوَلة” التي تَفترض اتّساع العمل التنموي، اجتماعياً وجغرافياً، بعكس “الإطار الزمني” لمنطق المشروع الذي يركِّز على الإنجاز وليس على المُداوَلة.
المنظّمات غير الحكوميّة والتحوّل الديمقراطي
لا شكّ أنّ المنظّمات غير الحكومية تلعب دَوراً مهمّاً في تعليم الديمقراطية وإثارة قضايا قد تكون ذات اهتمام عامّ في المجتمع، لكن، وعلى الرّغم من ذلك، تُثار شكوك عدّة حول قدرتها على إحداث تغيير ديمقراطي عميق أو تغيير اجتماعي عامّ، إذ يحتاج هذا الأمر إلى قوى سياسية واجتماعية مُنظَّمة ذات قاعدة شعبية عريضة. وفي هذا الصدد انتُقد التوجُّه العالَمي الذي يربط ما بين انتشار المنظّمات غير الحكومية وتطوّر “المجتمع المدني” بشدّة.
فهذه الرؤية بنظرهم تبسيطيّة، وتتجاهل أُسس تشكُّل القوّة السياسيّة القادرة على إحداث تغيير اجتماعي وسياسي حقيقي في المجتمعات. تلك القدرة التي تنمو وتتطوّر من خلال أُطر مُنظِّمة للفعل الجماهيري كالأحزاب السياسية، والحركات الاجتماعية، والنقابات، والاتّحادات، أي الأطر التي تسعى إلى تأطير الجماهير وتنظيمها سواء بهدف معارضة الحُكم، أم العمل على تغييره. وفي هذا الصدد تمَّ النّظر إلى المنظّمات غير الحكومية كعنصر مُشتِّت لدَور التنظيمات السابقة، وكجهة مُنافِسة للأحزاب والحركات الاجتماعية تعمل على الاستحواذ على قياداتها وعلى كوادرها الجماهيريّة الفاعلة. وبحسب هذه الرؤية، لا يُعتبر انتشار المنظّمات غير الحكومية دليلاً على حيويّة المجتمع المدني ونشاطه، بل العكس؛ إذ قد تلعب تلك المنظّمات دَوراً في إعاقة تشكيل قوّة سياسية قادرة فعلاً على التغيير.
كما لاحظ البعض الآخر أنّه قلّما تستطيع المنظّمات غير الحكوميّة مُناهَضة الحُكم الفاسد والمُستبدّ فعلاً، اذ غالباً ما تستقوي الحكومات على تلك المنظّمات، سواء بإغلاق مقارّها وسجن قياداتها أم بمصادرة أموالها، من دون أن تجد هذه القيادات مَن يُدافِع عنها سوى مموّليها من الدُّول الكبرى، ومن دون مُشارَكة حقيقيّة من الجماهير في هذا الدّفاع.
ومن الانتقادات التي انصبَّت على دَور تلك المنظّمات، هو أنّها لا تسعى، وإن سعَت لا تستطيع، إحداث الدمقرطة والتغيير السياسي المنشود؛ إذ إنّها غالباً ما تُعيد إنتاج البنى السياسية والثقافية السائدة، من دون تغيير يذكر سواء في نمط القيادة أم في مضمونها الديمقراطي.
في هذا الصدد يُشار إلى أنّ عملية التحوّل الديمقراطي تَستلزِم شروطاً أساسيّة منها، أوّلاً، أن يكون هناك مساحة مفتوحة لإحداث التغيير الديمقراطي؛ بمعنى أن تكون هناك قوى مَعنيَّة وبحاجة إلى هذا التغيير. ثانياً، أن تُحدَّد طبيعة القوى المَعنيَّة بالتغيير وكيفية تسييس المطالب والمصالح بغية تحقيقها؛ وهو ما يشكِّل جوهر عمليّة التحوّل الديمقراطي. فأين هي هياكل المنظّمات غير الحكوميّة إذاً من استيعاب تلك المجموعات أو مطالبها واهتماماتها؟
ثمّ إنّ كثيراً ما تعتمد المنظّمات غير الحكومية على التعليم والتدريب لنشر الديمقراطية والتبشير بها، استناداً إلى مقولة أنّ ترديد خطابٍ ما يحوي قيَماً ومفاهيم جديدة، والمُبالغة في ترديده، ينتهي بتبنّيه لكي يُصبِح خطاباً مُهيمِناً. غير أنّ هذا الاعتقاد انتُقد بشدّة من قِبل المُنظّرين حول الحركات الاجتماعية؛ إذ رأوا أنّ قوّة خطاب ما وهيمنته لا يأتي عن طريق ترداد لغوٍ ماNew Jargon بشكل مستمرّ ومُنتظِم. وبالتالي، لا يُمكن فصل الخطاب عن المنظّمات التي تحمله ولا عن الفاعلين في توليده. فهذا الخطاب المُسمّى بإطار الفعل الجماعي Collective Action Frame، لا يمكن فصله عن بناء قوّة اجتماعية على الأرض أو بالأحرى عن بناء حركة اجتماعيّة.
*باحثة وأكاديميّة من فلسطين- جامعة بيرزيت
نشرة أفق (تصدر عن مؤسسة الفكر العربي)