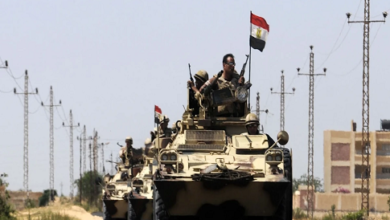الروائيّ الذي كادَ يصمّني عنه مواء القطّة

لم أقرأ الأعمال السرديّة الكاملة للروائيّ التونسيّ محمّد الباردي (1947- 2017) إلاّ بعدما بلغني نعيُه. فقد عرفته خلال الفترة الجامعيّة ناقداً أكاديميّاً عتيداً للرواية العربيّة، تُعدّ بحوثه حول أعمال إلياس خوري، وحنّا مينة، وصنع الله إبراهيم، وجمال الغيطاني، وكُتّاب السيرة الذاتيّة في الأدب الحديث، مراجعَ أساسيّة لا غنى عنها بالنسبة إلى الباحث المختصّ في مجال النقد الروائيّ. وقد شهدتُ بنفسي، عند شبّاك الإعارة في المكتبة الجامعيّة، خصومات تندلعُ بين طلبة الآداب بسبب تعمّد بعضهم احتكار “إنشائيّة الخطاب في الرواية العربيّة” أو “الرواية العربيّة والحداثة” أو “نظريّة الروائيّة”، فقد كانت هذه الكُتب، بصرامتها المنهجيّة وعمق قضاياها وسمعة صاحبها العلميّة في الوسط الجامعيّ، تعرفُ إقبالاً عريضاً وتحظىَ بثقة الدّارسين.
ولمّا كنتُ في تلك الفترة منتميةً، بلا سبب واضح واقعاً، إلى صنف القرّاء المُرتابين من الرواية التي يكتبها الأكاديميّون المختصّون في النقد الأدبيّ، بناءً على موقف مسبقٍ أثبتت لي الأيّامُ ونضجُ القراءات مقدارَ ما فيه من جهلٍ بمدوّنة سرديّة متميّزة، ومن سذاجةٍ في تصوّر الفعل الإبداعيّ، فقد تجنّبتُ أن أقرأ للباردي الرّوائيّ واكتفيتُ بالباردي الناقد. وكنتُ أردّد مع المردّدين إنَّ ناقد الرواية لا يصلحُ لكتابتها، فشتّانَ ما بين الكيميائيِّ العارفِ بتركيبة العسل والقابع خلف مجهره الإلكترونيّ، والنحلة المرفرفة بين الزهور. وكنتُ أسمعُ عن “جمعيّة مركز الرواية العربيّة” التي أسّسها محمّد الباردي مطلعَ التسعينيّات في مسقط رأسه في الجنوب التونسيّ وجَعَلها مركزاً للبحث العلميّ في مجال البحوث السرديّة وقبلةً للروائييّن والنقّاد العرب بفضلِ ندوتها الدوليّة السنويّة، وعن دار النشر الخاصّة التي بعثها (ضحى للنشر) وأصدر فيها أهمّ أعماله، فيزداد يقيني بأنّه لا يُمكن لشخصٍ واحدٍ أن يحتكر الروايةَ نقداً وتأليفاً وبحثاً وتدريساً ونشراً، بالكفاءة نفسها، فلا مناصّ من الوهنِ في موضعٍ ما.
ثم أُهديَت إليّ يوماً، في مناسبة رسميّة، مجموعة كُتبٍ وجدتُ بينها روايتَين للباردي. فما إن أقبلتُ على الأولى وعنوانها “جارتي تسحبُ ستارتها” (1997)، حتّى ألفيتها، منذ صفحتها الأولى، مُرسّخةً يقيني في “تعالم” الرواية التي يكتبها الأكاديميّون وثقلِها على القارئ العاديّ: “ماءت القطّة مرّة أولى، ماءت القطّة مرّة ثانية، في المرّة الثالثة فُتح الباب (…) ماءت القطّة، تمتدّ أصابع بشريّة رقيقة لتمسحَ شعر القطّة (…) يخفتُ مواء القطّة.. “.
تركتُ الروايةَ ولم أعد إليها، وأزهدني ماقرأته منها في أن أُقبل على الرواية الثانية، فظلّت مركونة على رفّ مكتبتي أشهراً طوالاً. ثمّ جاءَ الصيفُ وثقلُه وفترات الظهيرة منه وتمطّيها، فحملني السأمُ على أن أسحبَ الرواية الثانية للباردي “على نار هادئة” (1997) من منفاها علّها تغيّر رأيي بخصوص عوالمه السرديّة. ولا أخبّركَ عن خيبتي حينَ طالعتني في رأس صفحتها الأولى “ماءت القطّة مرّة أولى.. ماءت القطّة مرّة ثانية”. فمن سوء طالعي أن كانت الروايةُ عينها مهداة إليّ في إصدارَين بعنوانَين مختلفَين، أوّلهما عن “دار الآداب” البيروتيّة والثاني عن “دار الجنوب” التونسيّة. ولا أخفيكَ أنّ مواء القطّة في الكتابَين أصمَّ أذنيَّ من بعد ذلك عن روايات الباردي الأخرى، على الرّغم من تتويجها أكثر من مرّة بجوائز أدبيّة مرموقة. فقد كانَت تلك الصفحات القليلة آخر عهدي بالرجل روائيّاً، ولم أفكّر في أن أقرأ له إلّا بُعيد وفاته كما لو أنّني أكفّر بقراءتي المتأخّرة تلك عن ذنب التجاهل من دون اطّلاع.
وكان من البديهيّ أن أبدأ بإحدى النسختَين القديمتَين أقرؤها بعَينٍ جديدة. بيْد أنّ جِدّة النظر، وإدراكَ التلطّف في الصنعة، والتفطّنَ إلى المهارة الفائقة في تطويعِ متن الرواية لاستيعاب أشكال فنيّة متنوّعة وصيغ تعبيريّة شتّى تتفاعل في ما بينها من دون نشاز، لم تكُن كافية لتغيير انطباعي الأوّل، فالمُبالَغة في التجريب ليست من ذوقي، والأذواق لا تناقش.
وكنتُ أعرفُ سماعاً أنّ الباردي بدأَ مساره الإبداعيّ سارداً مُلتزِماً بمبادئ الاتّجاه الواقعيّ في صناعة الرواية. فعُدت إلى بواكيره الروائيّة التي وصفها هو نفسه، في مرحلة متأخّرة من تجربته، بالكتابة العفويّة غير المُحتفية بمسألة الشكل الفنيّ، فلم تلبث أن بانت لي فيها، وخصوصاً في “الملّاح والسفينة” (1981)، ملامحُ واضحة للطيّب صالح في “موسم الهجرة إلى الشمال”، واستشعرتُ في ” قمح أفريقيا” (1986) نفَسَ حنّا مينا في “الياطر”، وبدت لي “مدينة الشموس الدافئة” (1983) مصطخبة بإيقاع جمال الغيطاني في “الزيني بركات”. وعلى الرّغم من تنوّع الخلفيّات المرجعيّة للباردي في هذه الرّوايات الثلاث، فقد اجتمعت على الإفراط في اللّصوق بالواقع، ولم تنجُ من الرتابة الناجمة عن خطيّة الزمان، ولا من الوهن المنجرّ عن سفور تدخّل الكاتِب لتوجيه الشخصيّات وتكييف الأحداث وإنطاق الرواة بما ينسجمُ مع رؤيته الشخصيّة للوجود. ولئن كانَ ثابتاً أنّ الباردي لم يتمكّن في ذلك الثلاثيّ المبكّر من نحتِ شخصيّة أدبيّة مستقلّة، فإنّ نصوصه الافتتاحيّة تلك لم تخلُ، على الرّغم من ذلك، من طابع مميّز لا يُمكن له إلّا أن يشدّ القارئ شدّاً. فهي تعبقُ بخصوصيّات البيئة التونسيّة الجنوبيّة في فترة بناء دولة الاستقلال.. يختلط فيها التراثيّ المُستحكِم في نفوس الجنوبيّين بالحديثِ الوافد عليهم من العاصمة تارّة ومن بلدان الهجرة تارّة أخرى.. صراعٌ خفيّ ومعلنٌ حلبتُه قابس، مسقط رأس الباردي، المدينة التونسيّة الجنوبيّة التي “لا بدّ من فكّ حصارها” (مدينة الشموس الدافئة). وتتشابه الفضاءات في الروايات الثلاث، فلا يكاد القارئ يتذكّر، متى فرغ منها، نسبة الأحداث المرويّة إلى إحداها أو إلى الأخرى، فالواحة بنخيلها الشامخ حاضرة على الدوام، والتلاميذ الذين لا يحملون محافظ جلديّة، بل قفافاً صغيرة من سعف النخيل، يتقافزون من رواية إلى أخرى، كما لو أنّ الروايات نسيج مسترسل واحد.
تتصفّح المجموعة فتُفاجئك الرائحة اللّذيذة للشاي الأخضر أو الأحمر المائل إلى السمرة الداكنة من فرط تركيزه، وتسمعُ تكتكة الفحم في الكانون من تحت البرّاد الكبير، وشقشقة سطل القصدير المعبّأ بالكؤوس “الطرابلسيّة”. ومن مقامات أولياء الله الصالحين تنبعثُ الأزجال الصوفيّة والمدائح والأذكار باللّهجة التونسيّة، وتخبّ النساء في البخانيق الملوّنة، ويرفل الرجال في الجباب البيض من تحت الشواشي الحمر، وتختلط روائح البخور الذكيّة بنكهة الكسكسيّ المقدّم لعابري السبيل.
على أنّ في هذه الروايات الأولى أيضاً عمقاً سياسيّاً جعَلَ منها ذاكرة وثائقيّة حيّة تسجّل على نحو فنيّ سياقات مرحلة مهمّة من تاريخ تونس الحديث. ففي بعضها (الملاّح والسفينة) استعراض تفصيليّ لمراحل تجربة اقتصاديّة كادت تعصف بمكتسبات الدولة، لولا أن أوقفها الزعيم بورقيبة متخليّاً عن وزيره أحمد صالح بعدما تبيّنت له خطورة “التعاضد” على السلم الاجتماعيّ. وفي بعضها الآخر (مدينة الشموس الدافئة) توثيقٌ لأحداثِ كانون الثاني (يناير) 1978 حينَ أدّى تفاقُم الأزمة بين “الاتّحاد العامّ التونسيّ للشغل” وحكومة الهادي نويرة إلى فكّ الارتباط بين “منظّمة الشغّالين” والحزب الاشتراكيّ الدستوريّ الحاكِم وانتهى الأمرُ إلى انفجار الوضع بعد تكرّر الإضرابات العمّاليّة والتلويح بالإضراب العامّ واختيار النظام المواجهة الدمويّة بإطلاق الرصاص الحيّ على المُتظاهرين، واعتقال عدد كبير منهم.
وتتكرّر في هذه الروايات صورة التلميذ الفقير الذي يشدّ المعلّم أذنه فيكاد يدميها، أو يصفعه على خدّه، لأنّه ضحك في القسم وهو يصرخ فيه: ” تضحك يا ابن الكلب؟ أنت لا تدفعُ ملّيماً وتضحك؟” (قمح أفريقيا). فـ”حمدي رجب” بطلُ “قمح أفريقيا” و”عبد الله القناوي” في “مدينة الشموس الدافئة” و”أحمد ابن العمّ الصادق” بطل “الملّاح والسفينة” جميعهم أبناء فلّاحينَ سمحت لهم مدرسة بورقيبة بركوب المصعد الاجتماعيّ منتقلة بهم من حالٍ إلى حالٍ، وجميعهم غادروا مدينتهم الجنوبيّة باتّجاه العاصمة، حيث الجامعة “مصنع العقول”، وهُم شبيهون في ذلك بمحمّد الباردي نفسه الذي يذكر في “حنّة” (2010)، روايته السير ذاتيّة، ملامحَ من طفولة صعبةٍ في مدينته الجنوبيّة كلّلت، على الرّغم من الرسوب في مراحل الطفولة الأولى، بتفوّق دراسيّ أفضى به إلى الجامعة في تونس العاصمة. في الروايات الثلاث حينئذ نزعةٌ إلى الكتابة السير ذاتيّة وإن لم ينسب فيها الكاتِب صراحةً بعض الأحداث لنفسه مُطابقاً بذلك بين أعوان السرد. وستزدادُ هذه النزعة وضوحاً في “حوش خريف” (1997)، حيثُ يستنتجُ القارئ بلا عُسر أنّ ضمير المتكلّم في بعض المَواطن من النصّ محيلٌ على الباردي الكاتِب، فهو يقول مثلاً: “ولكنّني في هذه اللّحظة وأنا أصوغ كتابي هذا وأتخيّل الصورة كما رَسَم ملامحها رُواتي، لا أستطيع أن أحدّد تحديداً دقيقاً في أيّ زاوية كانت تجلس السيّدة”، ولكنّ الميثاق السيرذاتيّ يضحي صريحاً في “الكرنفال” (2003) حيثُ يروي السارد استنكارَ جلسائه في المقهى ما جاء في كتابه “حوش خريف” من تعريضٍ بأعيان المدينة، ويقولُ في خطابٍ يتماهى فيه السارد مع الناقد الروائيّ المنظِّر: ” ها أنت الآن تكتب سيرة سليم النجّار، ولكنّك في حقيقة الأمر تتحدّث عن نفسك: لا يكتب الإنسان سيرة غيره إلّا عندما يجد فيها شيئاً من ذاته أو شيئاً من ذات مثيرة يريد أن يكون له بعضٌ من إشعاعها”.
وقد كدتُ أنهي جولَتي في عَوالِم الباردي السرديّة عند الفقرة الأخيرة من روايته “الكرنفال”. فقد تشوّك لحمي وأنا أقرأ في خاتمتها: ” أصوات النساء تصل إليك، بكاء وعويل ونواح. وتظلّ أنتَ واجماً تريد أن تسألَ عن الجنازة، ثمّ تنحشر بين الرجال، وعندما انحنيت إلى رجل منهم، همس في أذنك: “محمّد بن الصادق بن الطاهر الباردي الدّايم ربّي”. هل فكّر الباردي في وقع هذه الجملة على قارئ غفل مثلي يقرؤها بعد أيّام قليلة من وفاة كاتبها؟ هل قصد أيضاً أن يفتتح “ديوان المواجع” (2014)، رواية العمر كما سمّاها في إحدى محاوراته الصحافيّة، بلازمة تتكرّر ثلاث مرّات بالدارجة التونسيّة: “إنتَ دايم، هو دايم، ولا دايم غير الله..”
كلّ ما كتبه الباردي في كفّة و”ديوان المَواجِع” في كفّة ترجحها. هذا ما وقرَ في نفسي، وأنا أقرأ الصفحات الخمسمئة للرواية المُذهلة. لا يعرفُ عيونَ السرد العربيّ مَن لم يقرأ بعدُ “ديوان المَواجِع”. هي عصارةُ ما جاءَ قبلها من رواياتٍ للباردي، بل هي قادرة على أن تفيء بظلّها على ما كتَبَه من بعدها أيضاً. رواية تكتنز قرناً كاملاً من تاريخ الدولة التونسيّة، منسوجة بإحكامٍ كأنّها زربيّة قيروانيّة نادرة. درسٌ عميق في السرد الفنيّ البديع العميق بلا تكلّف ولا تعالم أو تعالٍ. روايةٌ تأسرك بما فيها من معرفة دقيقة بتفاصيل التاريخ والفلسفة ونوازع النفس البشريّة، تنساب رقراقة كجدولٍ في واحة.. اكتنز فيها الباردي حنكةَ عمرٍ كامل، وفيها صبّ عذاباته الشخصيّة وعذابات الوطن الجريح من فترة الاستعمار إلى ما بعد ثورة 2011. وإذا كانت “الرواية ديوان العرب”، كما يُقال اليوم، فإنّ “ديوان المَواجِع” لمحمّد الباردي، هي عندي، ديوان التونسيّين.
فهل أنصفتك يا باردي؟
نشرة أفق (تصدر عن مؤسسة الفكر العربي)