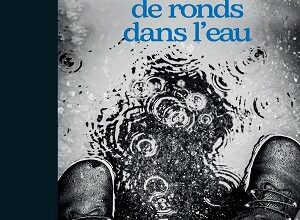الرواية أوجدت من أجل قول الحياة في أبسط تراكيبها(فرجينيا وولف)

تتطرق الروائية الإنجليزية فرجينيا وولف (25 يناير 1882 – 28 مارس 1941) التي تعتبر من أيقونات الأدب الحديث للقرن العشرين ومن أوائل من استخدم تيار الوعي كطريقة للسرد، في مقالاتها التي اختارها وترجمها الأديب إسكندر حمدان إلى مواضيع الشعر والسرد والنقد، كاشفة عن ثراء رؤيتها وأفكارها، حتى لنستغرب حين نقرأ لها ـ وفقا للمترجم ـ نحن القراء العاديون في القرن الحادي والعشرين، مآل الكتابة والسرد، ورجوعهما للامتثال لقواعد من أجل الدخول في تيارات تتطلبها الحقبة، أو الذائقة العامة أو النقاد أو ما شابه، بينما، قبل قرن مضي، كان صوت من أقوى الأصوات، وأحد الأقلام الأكثر عنادا على الإطلاق يحارب بثبات ورصانة كل التثليد، مكسرا كل القيود، حاملا التجريب إلى أسمى تجليات الحرية.
انطلقت المختارات التي حملت عنوان “رسالة إلى شاعر شاب” وصدرت عن دار خطوط وظلال، من رسالة/ مقال للشاعرة د.هناء علي البواب مواجهة إلى وولف تشتبك فيها مع موقفها الذي تعلي فيه من شأن كتابة السرد وتقلل من شأن كتابة الشعر. تقول البواب “أنت التي حين يذكر اسمك في عالم الأدب نراك أسطورة، ونلمحك في تقاسيم الصورة لوحة بملامح مختلفة مميزة، أنت التي حين تذكر الشعر تراه في مخيلتها كما تتحدثين إلى ذلك الشاب المتيم بالحياة: “وها أنت ترى هنا كم من السهل عليّ أن أكتب مجلدين أو ثلاثة في مدح النثر والسخرية من الشعر والقافية، ولأقول كم هو واسع ومفتوح مجال أحدهما، وكم هو ضيق وهزيل مجال الآخر. لكنه سيكون من الأسهل وربما أكثر إنصافا أن نتحقق من هذه النظريات بفتح واحد من الكتيبات الرفيعة في الشعر الحديث الملقاة على طاولتك”.. فالشعر يا فرجينيا ليس نظريات وقوائم حسابية يحتسبها الشاعر بحسب الأوتاد والقوائم لكل ركيزة في كل بيت، الشعر صوت الحرائق حين تلتهم العصافير النائمة، هو الثمل الوحيد الذي يشعر الضعيف أنه الأقوى في هذا العالم الحزين، وهو الذي يشعرك أنك ستزيح الجبل بكلمة واحدة، وهو الذي يوهمك أنك سترفع السماء بنظرة واثقة”.
وتواصل البواب مواجهة وولف “عليك أن تعلمي أن الشاعر الفارس ثائر على الاستعارات المكنونة التي ابتذلها سابقوه، فإما أن يشحنها بطاقة قوية، أو أن يتركها تموت في ظلام الموقف الجديد. فالشاعر طفل يحمل معه كل كلمة تبقى على حافة فنجان قهوة لامرأة جميلة من حمرة شفتيها، ولأن الشاعر ملك الجن، وهو سلطان السحر والطفولة والحب، منه يستحي العقل وترتبك المعرفة، ولكني للحظة ما سأوافقك بأن الشاعر دجال ومجنون، ومعشوقته القصيدة هي لحظة هستيرية تريح العقل من براهينه الخائبة وتطلعاته الخاسرة، فالقصيدة وخزة التخدير الدائمة في عضلة الحياة المرتمية على سرير الحزن والوجع”.
ويشير المترجم في مقدمته إلى أن الأشكال التي تتطرق من خلال وولف إلى مواضيع الشعر والسرد والنقد، بأسلوبها المتفرد، على سخاء كبير ما تسميه الحياة، وفي الوقت نفسه على تطلب كبير لا يترك مجالا للتسامح في أهم جزء من حياتها، الأدب. بين الجميل والبشع، بين الأنيق والفظ، بين سراديب الكلمة والصمت، توصل دائما فكرة لا تنقل المعنى كاملا لروح نشعر بها ترتعش حساسية وحبا، للحياة، للآخر، للشخصية، وفوق كل اعتبار، لحرية السرد وضرورة الخروج من القوالب التي فرضتها أزمنة لم تعد أدواتها تصلح لمعالجة ما يريد الكاتب إيصاله”.
ويضيف “من خلال هذه المقالات المختارة، نتتبع تساؤلات، وأيضا محاولات إجابة من عرفت بتيار الوعي في كتابتها. هي التي أيضا بحثت كثيرا عن صوتها، من خلال عديد الألوان الأدبية. نجدها لا تتردد أبدا في التصريح بما تظنه خاطئا، أو غير ذي صلة، محاولة دائما، وهي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تخاطب ذلك الصامت أبدا، القارئ، فتح آفاق جديدة ومختلفة لا يحدها الالتزام ولا الخضوع لقواعد لم توافق عليها بالأساس. هي لا تخشى إعادة تعريف المفاهيم. وأحيانا تترك الأسئلة للوقت أو المستقبل. فإن كانت تجهل ما الذي كان سيحل بالرواية، وبذلك الكائن الهجين وليد التجريب الذي هو لا شعر ولا رواية، وإن كانت لا تتردد في تأكيد أن كتابة الرواية فن لا يمكن تلقينه في المدارس مهما كانت المناهج، وإن بقيت مترددة أمام عظمة الأدب الروسي سواء في القصة القصيرة أم الرواية، وهي على يقين أنه سيظل مستعصيا على القارئ الغربي، إن كانت مقتنعة من أن الروائي معرض للحياة بشكل رهيب، فهي تبقى متأكدة من شيء وحيد، هو أن الرواية أوجدت من أجل قول الحياة في أبسط تراكيبها، وأكثر مظاهرها بؤسا، وأنه لا وجود لحياة دون شخصية، ولا وجود لشخصية واقعية يحس بها القارئ ويعيش معها دون حرية في السرد وفي اللغة تضمن لها الوجود”.
وفي رسالتها للشاعر الشاب تقول وولف “لكن كيف لك أن تخرج، وتلتحق بعالم الآخرين؟ هذه هي مشكلتك الآن، إذا كنت سأخاطر بتخمين ـ أن تجد العلاقة الصحيحة، الآن وقد أصبحت تعرف نفسك، بين الذات التي تعرف، والعالم الخارجي، إنه مشكل عويص. ولم يجد حسب اعتقادي أي شاعر على قيد الحياة حلا له. هناك آلاف الأصوات المتنبئة باليأس. العلم، يقولون، قد جعل الشعر مستحيلا؛ لا مكان للشعر في زمن السيارات والتلغراف. أصبحنا لا ندين بأي دين. كل شيء هائج، وانتقالي. لذلك، ما يقوله الناس الناس، هو استحالة وجود علاقة بين الشاعر والعصر. هذا هراء بكل تأكيد. تظل الحوادث سطحية؛ فهي لا تتوغل في العمق بما يكفي لتحطم أكثر الغرائز تأصلا وبدائية، غريزة الإيقاع. كل ما عليك فعله الآن هو أن تقف عند نافذتك وأن تدع حسك الإيقاعي ينفتح وينغلق، ينفتح وينغلق بجرأة وحرية، حتى يذوب شيء في شيء آخر، حتى ترقص سيارات الأجرة مع أزهار النرجس، حتى يصنع كل من هذه الشظايا جميعها. ما أقوله هراء، أعلم ذلك، ما أعنيه هو، استجمع كل شجاعتك، واستدع كل ما أوتيت من يقظة، استدع كل المواهب التي منحتك إياه الطبيعة. ثم اترك حسك الإيقاعي ينتشر بداخلك، ووسط الرجال والنساء، الحافلات، العنادب ـ وكل ما صادف مروره في الشارع ـ حتى يربطهم معا في وحدة متناغمة”.
وتتابع وولف “قد تكون هذه مهمتك ـ إيجاد علاقة بين أشياء تبدو غير متوافقة وفي الوقت ذاته لديها انجذاب غامض، أن تتشرب كل تجربة تأتي في طريقك بلا خوف وتشبعها بالكامل بحيث تصبح قصيدتك كلاًّ متكاملا، لا جزءا، لإعادة صياغة التفكير في حياة البشر إلى شعر، وبذلك تمنحنا التراجيديا مرة أخرى والكوميديا من خلال شخصيات لن تكون مفصلة على طريقة الروائي، بل مكثفة ومركبة على طريقة الشاعر ـ فهذا الأمر يخصك أنت وحدك ـ وبما أني لا أفرق بين مختلف القوافي، وأنا لهذا السبب عاجزة عن إخبارك كيف عليك تعديل وتوسيع طقوس واحتفالات فنك القديم الغامض ـ سأنتقل إذن إلى أرض أكثر أمانا، وأرجع إلى هذه الدواوين الشعرية الصغيرة في حد ذاتها”.
وفي مقال “أهذا شعر؟” ترى وولف أن هنالك أشخاصا يكتبون ما يريدون كتابته، حتى لو نقص من نصهم ألف كلمة، أو تجاوز طوله الطول المعتاد بخمسمائة وخمسين ألف كلمة. وعندما يكتبون يفكرون بجمهور لا يتعدى أبدا خمسة أفراد، أو ربما ثلاثة، أو ربما شخصا واحدا فقط، لكن الجمهور الخفي هو الأكثر تطلبا. والكتيبات الصغيرة التي تنشرها دار “هوفارث بريس”، لو حكمنا عليها وفقا للأمثلة التي أمامنا، هي من تلك الطبيعة المتطلبة، والتي ليست موجهة لترضي أيا كان بالخصوص، ولا تتوجه لأي جمهور سوى الذي توجد بين حضوره أشباح أفلاطون، والسير توماس براون، إضافة إلى كاتب أو اثنين لا يزالان على قيد الحياة، واللذين لا يملكان بالتأكيد أدنى فكرة عن مدى الامتياز الذي يحظيان به. وهكذا شاءت الصدف أن السيد موري والسيد إليوت واللذان يجمع بينهما صدق شغفهما فقط لا غير، تنشر أعمالهما عند الناشر نفسه، وأن ينقد كتابهما في اليوم نفسه. عندما نقول كلمة نقد نحن لا نفكر في الأمر فعلا. سواء كان هذا يعزي إلى استحقاق المؤلفين أم لا، لا بد وأن ناقد هذين الكتابين يحس نفسه أكثر عرضة للخطأ على غير العادة. لربما يكون كل نص محرر بنوايا صادقة هو بهذا الشكل في آن محفز ومدمر. أو ربما لا يمتلك الشعر الاحترام السطحي نفسه للقواعد كما يفعل النثر”.
وفي مقال آخر تقول وولف “لأن الشعر بالطبع لطالما انحاز إلى جانب الجمال؛ وأصر على حقوق معينة مثل الإيقاع، والوزن، والإلقاء الشعر. ولم يهدف أبدا لأن يستعمل في استخدامات الحياة العادية. وقد أخذ النثر على عاتقه كل الأعمال المضنية؛ أجاب على الرسائل، دفع الفواتير، حرر المقالات وألقى الخطب، لبى احتياجات رجال الأعمال، والبقالة ورجال القانون والجنود والعساكر والفلاحة. أما الشعر فقد بقي بعيدا في منأى، بين أيادي كهنته. وربما قد دفع ثمن هذا الانعزال بفقدانه القليل من المرونة. يؤثر فينا حضوره وحضور كل أبهته بجميع عناصرها ـ حجاباته، أكاليله، ذكرياته، روابطه ـ يحركنا عندما يخاطبنا. وعندما نطلب من الشعر أن يعبر عن هذا التنافر وانعدام التناسق، عن هذا التباين وهذه السخرية، عن هذا الفضول، والمشاعر الحية والغريبة التي تتطور في غرفنا الصغيرة المعزولة، عن الأفكار العظيمة العامة التي تعلمنا إياها الحضارة والتي حافظت على استقلاليتها، فلا يمكنه التحرك بالسرعة الكافية، وبالبساطة الكافية، وبما يكفي من مجال يسع لتحقيق ذلك. نبرته شديدة التأثر، وتصرفه شديد التعاطف. بحركة يد مهيبة، يدعونا إلى اللجوء إلى الماضي، لكنه لا يتبع إيقاع الروح، ويلقي بنفسه ببراعة وسرعة وشغف في أفراحه وآلامه على اختلافها. وقد بين بايرون الطريق في دون جوان. أظهر كيف للشعر أن يكون أداة مرنة، لكن لم يحذ أيّ كان حذوه ليصنع استخدامات أخرى بهذه الأداة. فنحن لازلنا لغاية الآن لا نملك شعرا دراميا”.
وتتساءل وولف فيما إذا كان الشعر قادرا على القيام بالمهمة التي نسندها إليه الآن. وتقول “من الممكن أن تكون العواطف المرسومة هنا بهذه الطريقة المشوشة والمنسوبة للفكر الحديث أكثر استعدادا للخضوع للنثر من خضوعها للشعر. ومن الممكن أن يتولى النثر في نهاية المطاف المهمة ـ وقد تولى في الواقع المهمة بالفعل ـ بعض الواجبات المعينة التي كانت في السابق من مهام الشعر. في هذه الحالة لو تجرأنا على تجاوز السخيف في الأمر وحاولنا أن نعرف في أي اتجاه نسير، فنحن الذين يبدو أننا نتطور بسرعة مذهلة، فسنقول إننا نتجه نحو النثر، وأن النثر سيكون في غضون عشرة أو خمسة عشر عاما هو العرف في مجالات لم يستعمل فيها من قبل. ستكون الرواية آكلة لحوم البشر هذه التي التهمت عديد الأشكال الفنية، قد التهمت بعد ذلك شكلا فنيا آخر. وسنضطر حينها إلى اختلاق أسماء جديدة للكتب المختلفة التي تختبئ تحت هذا الاسم الوحيد”.