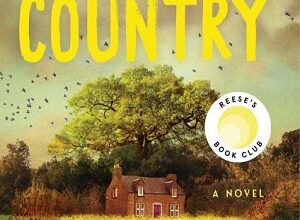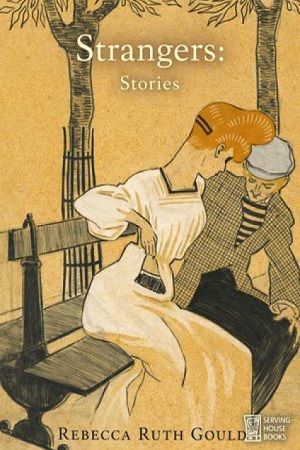
الطبعة الثانية من مجموعة ريبيكا غولد تستعرض صراع الهوية بين الشرق والغرب عبر قصص تدمج بين العلاقات المهنية العابرة والمعالم السياحية، محملةً بنظرة استشراقية متعاطفة لكنها لا تخلو من الأحكام المسبقة.
صدرت الطبعة الثانية من “عشاق غرباء”* لريبيكا روث غولد بعنوان مختصر وهو “الغرباء”، مع إضافات محسوسة على النص السابق. وإذا لاحظنا أن الطبعة الأولى تعبر عن هم حضاري، فهي أيضا تتابع مشاكل الشرق والغرب، ولكن ضمن إطار الحياة المهنية (أو علاقات العمل – وغالبا ما يكون في مجال الفن والتعليم والثقافة)، وأحيانا يتطور إلى حب قصير الأجل، لينتهي بدوره إلى اكتشاف نقاط الاختلاف. ومن حسن الحظ أن الطبعة الثانية تهتم ببندين إضافيين.
الأول هو التوسع بالمعالم السياحية للمدن المتعددة التي تمر بها الشخصيات. وتأتي بشكل محطات موزعة بين غرب أوروبا – بشكل أساسي مدن إنكليزية باردة يغطيها الثلج، ومدن شرقية ماطرة مثل تبليسي في جورجيا ودمشق في سوريا، وحتى دبي التي لا تغيب عنها الشمس. وبين هذين الحدين تغتنم غولد الفرصة لتقديم كل ما بلغ لعلمها عن تلك الأماكن بالقراءة والمشاهدة. وتنوع المصادر يغني قصصها بجانب موضوعي وآخر ذاتي. ولكن هذا لا يعني أنها قصص تسجيلية، فهي لا تذكر مصادرها بدقة، وتعتمد كثيرا على إحساسها بما تشاهد وتسمع. ويتحول ذلك في كثير من الأحيان إلى رأي سياسي يدل على مواقف مسبقة، كما هو الحال في “الأيدي”، أول قصص المجموعة. وتصور فيها طهران بشكل مدينة بطريركية تفرض على سكانها أشد أنواع الرقابة. ولم يبق إلا أن تتهمها بصفة الأخ الأكبر – بالمعنى الذي ورد في كتاب جورج أورويل الشهير “1984”، وبنفس الاتجاه الذي تبناه الروسي المعارض زامياتين في روايته المعروفة “نحن”. وكذلك هو حال قصتها “حينما تكونين مسنة”. وفيها تتغزل بمدينة تبليسي، وتهجو استغلال الروس لها سواء في القرن السابع عشر في عهد الملك إراكلي الثاني، أو في الوقت الراهن. وترى المدينة بصورة ضحية لأطماع جيرانها الروس بالإضافة لجيرانها القاجاريين – وهم صنف شديد البأس (مزيج من الفرس والتركمان)، وقد عاشوا على الغزو وسلب الآخرين، وعرفوا بالتهور وإراقة الدم. وأثناء فتح خزانة المعلومات – تمرر بعض الأفكار عن الطبيعة والطقس والبيئة.
غير أنها لا تتخلى تماما عن العلاقات الغرامية، وتضعها وراء السياحة والتجوال، ثم تحكم عليها بالفراق، انسجاما مع الاتجاه الاستشراقي المعاصر – كما في “رباعية الإسكندرية” للورنس داريل، أو “البدوية” لروبرت هيتشنز. وغني عن الذكر أن إعادة تكوين العالم وفق مفاهيم جاهزة – في الاستشراق الكلاسيكي – تحول إلى نوع من الاستكبار أو شفقة وإحسان الإنسان الغربي المتحضر مع شيء غير قليل من الترهيب والتخويف (وهذا ينسحب على البلدان المسلمة وروسيا ومن يدور في فلكها). ولكن كل هذه الشوائب – قديمها وحديثها – لا تعكر جو قصص غولد، وإذا وردت فهي على سبيل التعاطف، ولإلغاء أثر بعض الرواسب التاريخية. ومع أن المفاضلة بحد ذاتها (وهي صفة لا يخلو منها نص استعماري) دليل على شعور باطن وموروث، جعل الشرق في الجزء الأسفل من سلم التطور، تنتهي جميع قصص غولد، نهايات مترددة. أحيانا تختار نداء قلبها المكسور، وأحيانا تتبع صوت العقل، وتلبي مقولة معروفة تعزى لكبلنغ، ومفادها أن قدر الشرق أن لا يهادن الغرب. بعكس رواد القصة العربية. فقد اختاروا الحسم والقطيعة بعد فصل غرامي ملتهب. وتصبح المحبوبة في خاتمة المطاف بمثابة مشروع تنويري يستحيل تنفيذه (وتتضمن هذه الأفكار مواقف تلوم المرأة الغربية التي تفتح وتغلق باب مخدعها لمن ترغب به، وكأنها تشترط أن تكون العصمة بيدها. وهو إجراء يستهدف الرجل الشرقي المسلح بسيف الأخلاق وحب الوطن. وأنوه هنا بسلسلة روايات شكيب الجابري، وأخص بالذكر “قوس قزح”، ناهيك عن نوفيلا لفاضل السباعي بعنوان “الظمأ والينبوع”). وأعتقد أنها نهايات مزدوجة ومقلوبة وبالاتجاهين. فهي لا تهدد الشرقي بالحرمان فقط، والمرأة في هذا السياق ليست مغامرة بيولوجية فقط – ولكنها رمزيا مصدر للمعرفة والوفرة أيضا – وإنما تتركه كذلك وسط الطريق بوضعية سريالية ميؤوس منها. وتلطف غولد هذا الجو بتبنيها لغلاف سياحي تعلب – بالأحرى تؤطر به عناصر قصصها وهي – الحب والسياسة والثقافة. ولكن لا يتطور ذلك إلى خيال تسجيلي، ويراوح على محيط مشروع صنع الله إبراهيم – ولا سيما فيما يخص حقن الذكريات والسيرة بالأرشيف والمعلومات.
البند الثاني هو الناحية التعليمية. وتبدو لي وكأنها لتمرير درس في التاريخ والسياسة، إنما بقالب قصصي. وهذا يعني أنها تلتزم بجانب الحياد أو الموضوعية مع إضافات يمليها الواجب الإنساني. بتعبير آخر الشخصيات وطنية فقط، بدون وعي سياسي (أو محرومة من عقد الإيديولوجيا والأحزاب)، ولا تلتزم إلا بإملاءات الضمير والواجب العام. وأفسر، على هذا الأساس، اهتمامها بالمطبخ والمائدة وأنواع المأكولات.
ومطابخ غولد لا تختلف كثيرا عن حقول وبوادي لورنس مؤلف “أعمدة الحكمة السبعة”. وهذا تحصيل حاصل، فالواجبات المنزلية أقرب لطبيعة المرأة – وهو إبدال وكناية لواجبها الآخر في حضانة أطفالها، بينما الحروب والمهام الصعبة من واجبات الرجل. ومع ذلك تبدو غولد امرأة حقيقية وغير مزيفة – وينحصر غرامها بالطهي والمعلومات – وكأنها نسخة متأخرة من جين أوستن – بعكس نساء مسترجلات من أمثال أجاثا كريستي ومسز بيل. بتعبير آخر عالم غولد في البيت والمكتبة والجامعة، ولكن عالم كريستي وبيل غامض ومبهم وبدون حدود، وهو أقرب للخطط الاستعمارية التي تؤمن بسياسة الغزو والفتوحات وترويض الشعوب. ومع ذلك لم تكن غايتها استعراض خبرتها الواسعة بالمطابخ، وإنما أرادت أن تنحاز لثقافة الحياة، وبالطريقة الغربية. فالتسوق وإعداد الطعام، وبينهما استراحة الظهيرة في المطعم، تستهلك نصف وقت المواطن الأوروبي، بينما تشكل أعباء الحياة كل وقت سكان العالم الثالث. ومقارعة الضرورة جزء من السردية الشرقية، ويأتي بعدها حكما التفكير بالموت والتهيؤ له. وأعتقد أن وعي غولد بهذا الجانب مؤجل إن لم يكن غائبا تماما. وهو دليل آخر على أن مقاربتها للشرق تدل على الشك بسياساته في الوقت الراهن، وهو موقف استراتيجي يتبناه الاستشراق المعاصر بشكل عام. وهذا لا يعني أنها تنتمي لهذه الفصيلة بالمعنى الحرفي للكلمة، لكنها أقرب ما تكون لمشاهد متعاطف مع الضعفاء ومع برامج تطويرهم، حتى أنها اختصرت علاقتها مع الكنيسة الشرقية (في قصة: حين تكونين مسنة) بمشوار تحت المطر – الجارف، وكانت ترمز به لحالة من القهر والغضب. وبتبادل حزمة من الرسائل، وعدد من المخطوطات المكتوبة بلغة نائمة. ولا أجرؤ أن أقول لغة ميتة. فاللغات تتحول ويطرأ عليها تعديلات، ولكنها لا تندثر. وهي مثل الطاقة، لا شيء يأتي من العدم ولا شيء يفنى.
ميدل إيست أونلاين