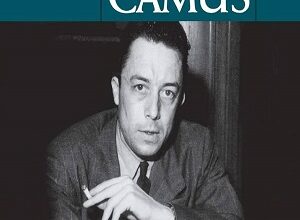السياسة البريطانيّة في الشرق الأوسط: تاريخ من العنف والغطرسة
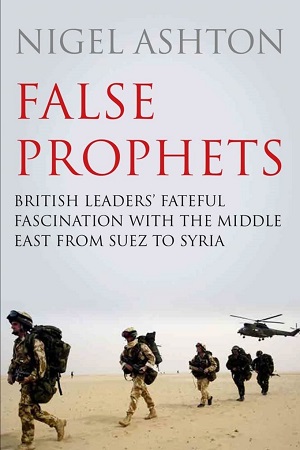
السياسة البريطانيّة في الشرق الأوسط: تاريخ من العنف والغطرسة… في النصف الأول من القرن العشرين، كانت بريطانيا القوة المهيمنة في منطقة شاسعة تمتد من مصر إلى إيران. وكانت هذه مصلحة إستراتيجية حيوية، إذ ضمنت سيطرة لندن على الطريق البحري إلى الهند، وعلى المصدر الرئيس للنفط في العالم. بعد الحرب العالمية الثانية، تراجع النفوذ البريطاني لصالح القوة الأميركية. ولكن مشاكل هذا التحول، والاضطراب الأمني الدائم في المنطقة، أبقيا الشرق الأوسط على رأس قائمة الساسة البريطانيين.
يرصد كتاب «الأنبياء الكذبة» False Prophets: British Leaders’ Fateful Fascination with the Middle East from Suez to Syria (أتلانتيك بوكس ـــــ 2022) لأستاذ التاريخ الدولي نايجل أشتون، سياسة رؤساء وزراء بريطانيا المتعاقبين، ودور بريطانيا في منطقة الشرق الأوسط المضطربة على الرغم من الضغوط الاقتصادية في الداخل والمعارضة الشعبية.
تعامل كل رئيس وزراء بريطاني مع مشاكل المنطقة بمزيج من العنف والغطرسة، بداية مِن عام 1956 مِن خلال العدوان على مصر في ما عُرف بـ «حرب السويس» وانخرط في تلك الحرب ثلاثة رؤساء وزراء بريطانيون هم: أنتوني إيدن وهارولد ماكميلان وأليك دوغلاس هوم.
كان إيدن يرى في تأميم الرئيس المصري جمال عبد الناصر لقناة السويس تهديداً وجودياً للمملكة المتحدة، إذ يُمكن للرئيس المصري وقف إمدادات النفط وقطع الطريق البحرية المؤدية إلى الهند أمام البريطانيين. لذا اندفع لشنّ عملية عسكرية بريطانية – فرنسية بالتواطؤ مع إسرائيل. لم يستمع إيدن لأي معارضة لخطته، وفشل في الاستجابة لتحذيرات أيزنهاور بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع حربه.
انتهت حرب السويس بإذلال إيدن، لكن هذا لم يُعط درساً لمَن سيخلفه عام 1957، فقد استمر رئيس الوزراء الجديد هارولد ماكميلان في استخدام القوة للدفاع عن المصالح البريطانية في الشرق الأوسط، وبقيت مخاوفه محصورة بتنامي القومية العربية التي تُهدد السيطرة البريطانية على النفط، خصوصاً في منطقة الخليج. أطلق ماكميلان العنان لرؤيته الإمبريالية/ الرومانسية لدور بريطانيا في الشرق الأوسط من خلال الضغط على أيزنهاور للقيام بعمل عسكري مشترك بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في لبنان لمواجهة ما أسماه مؤامرة جمال عبد الناصر ضد «الحكومة المسيحية» هناك. بعد فشله في إشعال تلك الحرب، نشر قوات المظليين البريطانيين في الأردن عام 1957 لإحباط انقلاب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية علي أبو نوار ضد الملك حسين. في العام ذاته، انخرط الرئيس الأميركي أيزنهاور وماكميلان في وضع خطة لإسقاط الحكم في سوريا لتزايد ميلها نحو الاتحاد السوفياتي. لكن الخطة فشلت لعدم القدرة على إقناع الدول العربية (العراق والأردن) المجاورة بالقيام بالغزو خوفاً آنذاك من ثورة شعوبها المتأثرة بالمد العروبي الناصري. وفي عام 1961، أعلن ماكميلان الإبقاء على القوات البريطانية ووحدات الأسطول، التي كانت تتأهب للرحيل عن الكويت، عقب إلغاء اتفاقية الحماية، بعدما أعلن الرئيس العراقي آنذاك عبد الكريم قاسم نيته في ضم الكويت.
أما رئيس الوزراء دوغلاس هوم، فقد استمر على نهج أسلافه المناهض للقومية العربية، والمعادي لجمال عبد الناصر. لذا قرر دوغلاس الانخراط في حرب اليمن، ووجّه باستخدام القوة العسكرية لمساعدة الملكيين ضد الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة مِن القاهرة، لكن تم إقناعه بالقبول بضربة جوية محدودة وحملة لتسليح معارضي الجبهة الوطنية، واقترن ذلك بحملة إعلامية من الدعاية السوداء تهدف إلى تقويض معنويات النظام الجمهوري.
ومع صعود هارولد ويلسون إلى كرسي رئاسة الوزراء عام 1964، استمر الشعور بأن بريطانيا تلعب دوراً كبيراً في المنطقة على الرغم من الضغوط الاقتصادية في الداخل، وكان ويلسون شديد التأييد للاحتلال الإسرائيلي. لعب وزير خارجيته، جورج براون دوراً حاسماً في صياغة قرار مجلس الأمن الرقم 242 لوقف إطلاق النار في حرب 1967 بين إسرائيل والبلدان العربية.
على عكس صهيونية ويلسون، كان رئيس الوزراء إدوارد هيث حريصاً على إصلاح العلاقات مع الدول العربية. تحت قيادة هيث، لعب ضابط مخابرات متمركز في الأردن يدعى بيل سبيرز أهم دور بريطاني سري. فقد قام سبيرز بتثبيت وتشغيل وسيلة الاتصالات الآمنة الوحيدة للملك الأردني الحسين بن طلال مع العالم الخارجي أثناء أزمة «أيلول الأسود» عام 1970، ومنحت وصلة الاتصالات اللاسلكية التي أقامها سبيرز حكومة هيث امتياز الوصول إلى المعلومات حول خطط الملك عندما أطلق العنان لجيشه ضد المقاتلين الفلسطينيين المتمركزين في الأردن وضد القوات السورية التي غزت شمال البلاد.
وفي عام 1973، اندلعت حرب عربية إسرائيلية أخرى. وكان الملك حسين حذراً من التورط فيها، لكنه تعرض لضغوط متزايدة للقيام بذلك. طلبت سوريا منه إرسال قوات لتغطية جناحها في مرتفعات الجولان، لكن الملك كان قلقاً من رد فعل إسرائيل المحتمل. ولم تكن لديه نية لمهاجمة إسرائيل من الجولان وأراد أن يعرف الإسرائيليون ذلك. حلّ الضابط سبيرز المشكلة من خلال صياغة رسالة من الملك ليتم نقلها إلى إسرائيل عبر القنوات البريطانية، لتضمن لندن أن حركة القوات الأردنية ما هي إلا مناورة مِن الملك لمنع أي تهديد سوري مُحتمل للأردن (كما كانت الحال في عام 1970)، وفي هذه الحالة، تفهّم الإسرائيليون تحرك الملك وتجنبوا استهداف قواته في الجولان.
على أي حال، حقّقت الجيوش العربية (مصر وسوريا) انتصارات أولية قبل تدخل واشنطن وإرسال شحنات أسلحة ضخمة إلى إسرائيل. وفي إشارة واضحة إلى أن هيمنة بريطانيا في المنطقة قد انتهت، فقد تولى وزير الخارجية الأميركي -في ما بعد – هنري كيسنجر دوراً كوسيط لوقف إطلاق النار. وأدى الغضب العربي إلى قيام منتجي النفط بخفض الإنتاج وفرض ارتفاع كبير في الأسعار. وتسببت هذه الأزمة الاقتصادية في خسارة هيث الانتخابات عام 1974.
أما رئاسة الوزراء من جيم كالاهان، ومارغريت تاتشر وجون ميجور، فقد حصل جميعهم على نصيبهم من الأعمال الدرامية في الشرق الأوسط، خصوصاً الصعود والهبوط في مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، ثم غزو صدام حسين للكويت عام 1990 وحرب الخليج.
لعبت تاتشر دوراً رائداً في مواجهة صدام حسين، لكنها انتهت فجأة بسقوطها من منصبها في العام نفسه. وكان موقف تاتشر المتصلب امتد حتى إلى الدعوة لاستخدام الأسلحة الكيميائية الانتقامية ضد القوات العراقية التي تحتل الكويت. ضغطت تاتشر بشكل متكرر على الإدارة الأميركية للرئيس جورج بوش الأب، لتكون مستعدة للرد بالأسلحة الكيميائية رداً على أي استخدام عراقي.
كان القائم الرئيسي على برامج أسلحة صدام الكيميائية والبيولوجية هو صهره، الجنرال حسين كامل المجيد، وثالث أقوى رجل في العراق بعد صدام وابنه عدي. بعد خلاف مع الأخير في آب (أغسطس) 1995، ترك البلاد خائفاً على حياته، ذاهباً إلى الأردن حيث وفّر له الملك حسين ملاذاً آمناً. شرع المجيد في الكشف عن برامج أسلحة الدمار الشامل لصدام. ولكنّ الرسالة التي حملها كانت غير متوقّعة: لقد دمّر صدام كل مخزونه من أسلحة الدمار الشامل بعد حرب الخليج وكان يرفض عمليات التفتيش الدولية فقط للحفاظ على وهم القوة.
كانت مزاعم المجيد غير مرحّب بها عند المخابرات البريطانية والأميركية، التي استاءت أيضاً من محاولته تنصيب نفسه كرئيس صوري للمعارضة العراقية. في الواقع، كان رد فعل كل من MI6 (جهاز المخابرات الخارجية البريطاني) ووكالة المخابرات الأميركية المركزية سلبياً للغاية. لكن بعد الغزو الأميركي للعراق، الذي حدث بذريعة تفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل، اتضح أن مزاعم المجيد دقيقة.
يعقد نايجل أشتون مقارنة بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وإقدامه على حرب العراق، وبين سابقه إيدن وحرب السويس. وإذا لم يكن السياق واحداً، فإنّ كليهما كانا مهووسيْن بالقوة والغطرسة ومهدديْن مجتمعهما بالخطر الذي يشكله «ديكتاتور عربي» (صدام وناصر). هدّد إيدن بأنّ ناصر قد يطلب دفع فدية من بريطانيا من خلال سيطرته على النفط، بينما هدّد بلير بأنّ أسلحة صدام الكيميائية والبيولوجية، تشكّل خطراً إرهابياً غير مقبول.
ينتهي كتاب أشتون بدراسة فترة رئاسة وزراء جوردون براون وديفيد كاميرون، وخصوصاً قرار الأخير شنّ حملة جوية ضد ليبيا عام 2011، ما يظهر ميل رؤساء الوزراء الدائم إلى استخدام الأداة العسكرية. تأخر رفع السرية عن الوثائق التي تغطي علاقات بريطانيا مع ليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط، مثل العراق وسوريا ومصر، ما دفع أشتون للجوء إلى القضاء لمدة 5 سنوات حتى حصل على حكم عام 2018 يمكّنه مِن الاطّلاع على الوثائق التي أظهرت له أن غالبية العمليات العسكرية البريطانية شكّلتها الاعتبارات الاقتصادية، والعلاقة المعقّدة بين لندن وواشنطن حول الشرق الأوسط، وخلل التوازن بين علاقات المملكة المتحدة مع إسرائيل (جلب العديد من رؤساء الوزراء قناعاتهم الشخصية إلى الوظيفة) ومع الدول العربية. لكنّ الثابت الأكيد أن الحرب ولّدتها غطرسة بريطانيا لشعورها بأنها عرفت الشرق الأوسط بشكل أفضل من الأميركيين أو الدول الغربية الأخرى.