«الشمندورة»… رواية «متجاهلة» أسَّست الأدب النوبي
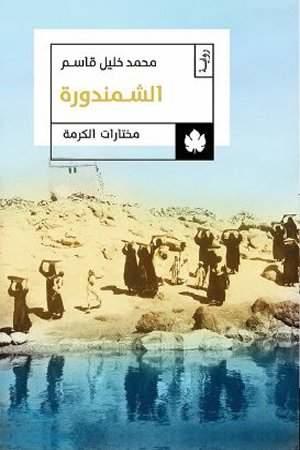
فَتحتْ الطبعة الثانية من رواية «الشمندورة» (دار الكرمة) للكاتب محمد خليل قاسم (1922 – 1968) جراحاً نوبيةً ووطنية عدَّة، لكون دار نشر خاصة وليس مشروع «مكتبة الأسرة» التابع لوزارة الثقافة، هي التي تذكَّرت تلك الرواية المؤسِّسة للأدب النوبي. وكانت الطبعة الأولى من العمل نفسه قد صدرت عن دار «الثقافة الجديدة»، الخاصة أيضاً. ومن بين أسوأ المفارقات، أن الجميع – نقاداً ومثقفين وقراءً – يعترفون لهذه الرواية، بوصفها العمل الأدبي المؤسس، في الرواية المصرية الحديثة، عموماً، والعمل المؤسس للرواية النوبية، على وجه الخصوص، تماماً مثلما يشهدون أيضاً وبالحماسة ذاتها، على أن «الشمندورة» – ويا للغرابة – تعتبر واحدة من أهم الروايات العربية، التي تعرَّضت للظلم والاستبعاد من مؤسسات النشر الرسمية، والتجاهل النقدي والأكاديمي في الجامعات، لأسبابٍ تتعلق بأحداثها بالذات، وبالقضية العادلة جداً لهؤلاء الذين تحكي عنهم الرواية. تجاهلُ أول رواية نوبية، وصل إلى حد أن مشروعاً للنشر بحجم «مكتبة الأسرة»، تقوم عليه وزارة الثقافة المصرية منذ أكثر من عشرين عاماً، ويطبع العشرات من الروايات سنوياً، للأحياء والأموات، لم يتذكر القائمون عليه أبداً، إصدار طبعة من رواية «الشمندورة»، ولو على سبيل «التعويض» المتأخر للكاتب، الذي فضح كثيراً من «مهازل تعويضات» الحكومة. جزء كبير من الصيت الذي حصلت عليه الرواية، يأتي من شخصية صاحبها، نوبي الأصل، الذي انتمى إلى اليسار المصري، وعمَّر طويلاً في سجون الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، خلال عقدي الخمسينات والستينات، من القرن الماضي، وربما لأن روايته – الوحيدة – ذاتها كُتبت خلف أسوار السجن، حيث دوَّنها بقلم «كوبيا»، على ورق «بفرة»؛ مُخصَّص للسجائر. وهُرِّبت الأوراق إلى خارج «سجن الواحات»، لتنشر في ما بعد مُسلسلةً، في مجلة «صباح الخير» القاهرية، وتصبح درّة الأدب النوبي.
كلمة «الشمندورة»؛ تعني الجسم الذي يطفو على سطح الماء ويستخدم في ملاحة السفن، والرواية تنتمي جمالياً إلى تيار الرواية الاجتماعية الواقعية، إلا أن الكاتب منح هذا الشكل التقليدي للرواية، قيمة إضافية بتجسيده روح هذا العالم، الذي لم يعد موجوداً، في محاولة أدبية لاستعادتِهِ، تأخذ القارئ إلى رحلة الآلام بين دروب قرية غارقة. هي أول رواية، تتناول طرفاً من هموم «مئة ألف مصري»، اضطروا لترك ديارهم، نزولاً على رغبة حكومات ما قبل 23 تموز (يوليو) 1952، في تحويل مناطق نوبية خصبة، إلى جزء من «خزان أسوان»، بُغية توسيع الرقعة الزراعية في المحافظات المصرية. ومنذ «التنويه»؛ يلفتنا الكاتب إلى أن «الأسماء في هذه الرواية شائعة بين النوبيين، فإذا ما حدث تشابه بينها وبين أسماء أشخاص حقيقيين، فليسوا مقصودين بالمرة»، فيبدو التداخل واضحاً، بين حياة الكاتب وسيرته الذاتية من ناحية، وأحداث الرواية من ناحية أخرى. الذي لا شك فيه، هو أن محمد خليل قاسم، المولود في قرية «قته»، عاش مأساة تعرض قرية نوبية بكاملها إلى الغرق، بسبب توسعة «خزان أسوان الثانية»، وهذا ما ترويه أحداث الرواية بالضبط، باستخدام الاسم الحقيقي للقرية، «قته»، الواقعة في نطاق محافظة أسوان، في جنوب مصر.
من «بر عيد ولحظ»، و«بكر» إلى «صالح جلق»، ومن خلال المواجهة بين الفقراء؛ نساءً ورجالاً، والأفنديات والطرابيش الحمر والوجوه المستديرة، يعيش العالم الصغير لقرية على ضفاف النيل، غنياً بالعلاقات العاطفية. فأكثر الشخصيات تميزاً هن النساء، بدءاً من الأم المصابة دائماً بالإعياء، والتي كثيراً ما تسقط فاقدة الوعي، إلى «داريا سكينة» المرأة التي أجهدها الفقر وأتعبها رحيل ابنها إلى أحضان نساء القاهرة البيضاوات، إلى زوجة «جمال»، القاهرية المرفوضة، إلى «حسن المصري» الصعيدي، الذي هبط مجتمعاً مغلقاً، ليختبئ فيه من جريمة ارتكبها بذبح زوج عشيقته، لكنه يشعر في هذه القرية أنه وحيد، ويقول من أول الرواية إلى آخرها: «مصير الغريب «يردع» – يرجع – لبلده»، إلى أن يتم تهجير القرية كلها، ولا يعود الغريب إلى بلده أبداً.
لقد سجّل خليل قاسم على لسان الطفل «حامد»، الذي لم يبلغ العاشرة بعد، وصفاً مُستفيضاً للحجرات والبيوت والعادات والتقاليد والأصوات والحقول والبشر، ولمجمل الحياة اليومية لقرية نوبية تنام في حضن النهر، وكيف دخلت ضمن «توسعة الخزان الثانية» العام 1933، فأصبحت أحلام سكانها البسطاء غارقة تحت «بحر النيل»، حيث رأى المياه تزحف من بعيد لتغمرَ البيوت والأراضي الخصبة، التي عاش فيها أهالي القرية سنوات طويلة، ليقبلوا في نهاية الأمر تعويضات حكومية هزيلة ومُجحِفة، نقلتهم للإقامة في مناطق صحراوية قاحلة، اعتبرت أسوأ ما يُمكن، أن يحصل عليه مزارعون بسطاء من تعويضات. الراوي الطفل، هو ابن «الشيخ أمين»، التاجر، الذي يتعرف إلى نمط «المقايضة» الاقتصادي، المتبع في «بقالة» والده، الذي كان لايزال سائداً هناك، خلال عقد الثلاثينات من القرن العشرين.
فالأهالي غير المتعلمين – والذين لا يملكون سوى بلح النخيل وما يرسله أبناؤهم من قروش قليلة من الخارج – يسحبون ما يريدونه طوال العام، من أطعمة واحتياجات منزلية، من دكان «البقال»، ليقوم هو بتسجيل كل شيء، ويحصل على ثمنها بَلَحاً، يقوم ببيعه في ما بعد، نظير جنيهات قليلة، يشتري بها بضاعته، من جديد.
على رغم أن خليل قاسم لم يصدر سوى مجموعة قصصية واحدة بعنوان «الخالة عيشة»، إلى جوار روايته تلك، إلا أنه سرعان ما أصبح «الأب الروحي» لجيل من الأدباء النوبيين، منهم حجاج أدول الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية العام 1990 عن مجموعته القصصية المتميزة، «ليالي المسك العتيقة»، ويحيى مختار، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية العام 1992، عن مجموعته القصصية «عروس النيل»، والراحلان إدريس علي، صاحب رواية «دنقلة»، وإبراهيم فهمي، صاحب مجموعتي «القمر بوبا» و«بحر النيل».
صحيفة الحياة اللندنية




