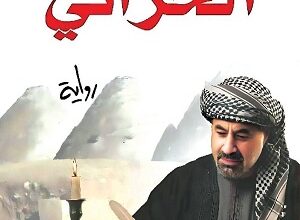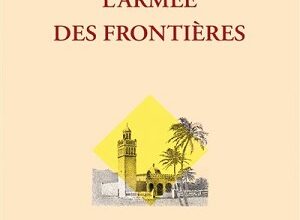«الصاد شين» لحمدي أبو جليل … تنقل القصص العربي إلى منطقة جديدة

اختار الروائي المصري حمدي أبو جليل لروايته عنوان «قيام وانهيار الصاد شين»، (دار ميرت- القاهرة) وهو ما يحيل القارئ مباشرة إلى مجموعة محمد مستجاب «قيام وانهيار آل مستجاب». كما يحيل إلى الكتابات المرتبطة بقيام وانهيار الحضارات.
والصاد شين اختصار لبدو الصحراء الشرقية بالنسبة لليبيا. بدو الصحراء الغربية بالنسبة لمصر. وهم أقرب إلى بدو ليبيا لأن أهل مصر –تاريخيّاً- مزارعون، استقروا حول النيل وأنتجوا حضارتهم على ضفتيه.
الحدود بين الدولتين
وهم يتنقلون عبر الحدود بين الدولتين، وبعضهم استوطن في قرى شمال الصعيد. في بني سويف والفيوم، وهم الذين ينتسب إليهم حمدي أبو جليل نفسه الطبيعة الصحراوية الجافة الشحيحة،
والتحايل عليها وعلى الناس للحصول على شروط حياتية أسهل. هي التي خلقت طبيعة هؤلاء البدو. وهذا ما يبدو واضحاً في الرواية، حيث ينتقلون جماعات جماعات إلى ليبيا،
التي شهدت طفرة مالية بسبب اكتشاف البترول. يدَّعون أنهم «صاد شين»
ليحصلوا على بطاقة يتعاملون بها باعتبارهم ليبيين. بل وليبيين مميزين لأنهم أنساب الزعيم –معمر القذافي- الذي تقول الروايات إنه «صاد شين» أصلاً. ويقول الواقع إن أهله مميزون عمن سواهم من الليبيين. بحكم سيطرته على الأرض والناس.
الفصل الأول من الرواية
الفصل الأول من الرواية، إن شئت تسمية أجزائها فصولاً، بعنوان «اتضح أن الزعيم نفسه صاد شين»، ويحاول أسطرة هذا الزعيم الذي كان فارقاً في سيرة بدو الصحراء الشرقية. والذي حوَّل نفسه بالفعل إلى أسطورة، بدأت بالصعود الكبير وانتهت بمأساة عظيمة.
يقسم حمدي أبو جليل روايته إلى فصول قصيرة، يعطي اسماً لافتاً لكل منها:
»واغش أفريقيا»، «التعريف الأصلي للصيد في بلاد الودن الطالعة من تحت الطقم»، «مزرعة الأرانب»، «الزوديك»، «مطعم الأومليت والبطاطس باللحمة»، «لمبادوزا»، «شيشيليا»، «المقطر»، «مجرودة التهريب»، «بلبل الصحراء»… إلخ، وهي ليست أجزاء من حكاية كبيرة فقط، بل ليست حكايات كلها،
فقد تخللتها فصول هي مقالات بحثية خالصة، سبق نشرها في الصحف، مثل فصل «مصدر الصاد شين»، الذي يقول في بدايته ص101: «بدو مصر مصدر الصاد شين، بل القبائل الليبية كلها، وهم على المستوى العرقي نوعان، بدو الشرق وبدو الغرب، وهم يختلفون في اللهجة والزي والتقاليد والأغاني والموطن الأصلي…».
وهناك فصل عبارة عن أغنية، أو أهزوجة تراثية بدوية. عنوانه «أهزوجة التهريب». يقول في بدايته ص80: «هذه مجرودة التهريب من مصر إلى ليبيا قبل الزعيم أو في عهده. لا أذكر بالضبط، المهم: إذا كان لكل رواية أغنية فهذه أغنية الصاد شين».
ثم يكمل الفصل بالأغنية فقط، وينتقل إلى فصل آخر بعدها، والأغنية يقول مطلعها: «يا مرحب يا بو دور خصيب اسمع مني قول بترتيب/ نقوله عن شغل التهريب= اللي ثلثينهم غلبانين»، وما يستوقفني هنا أنه يقول بوعي الكاتب الخارج عن النص: «إذا كان لكل رواية أغنية فهذه أغنية الصاد شين».
الصاد شيِن
هذا الوعي يقودنا إلى واحدة من أهم سمات رواية «الصاد شين». وهي أنها لا تنفصل عن كاتبها.
فالكاتب هو الراوي وهو البطل الذي يحمل اسمه نفسه. وهو نفسه صاحب الرؤية التي تقف بوعي خلف النص.
تحرك الأمور حسب فكرته عن الكتابة نفسها. ورسالتها، وعن الرواية وبنائها وعلاقتها بتراث الرواية العربية خصوصاً. والعالمي عموماً.
وحسب قناعات اجتماعية وسياسية ودينية لا تتردد في التعبير عن نفسها بشكل علني، وتكسر –في شكل علني أيضاً- المقولات التاريخية عن أن الفكر والفلسفة والسياسة والمعارف الأخرى تفسد الأدب، فنحن أمام روائي يكتب بوعيه الكامل الطاغي، ويريد أن تصل كتابته كما أرادها على الأقل.
والمكان في الرواية ينتقل بين جغرافيا المنطقة كلها. من قرية في الفيوم إلى القاهرة فالصحراء الغربية، ثم بنغازي وطرابلس وسِرت وسَبها في ليبيا، ومنها إلى إيطاليا ومدنها المشهورة. تبعاً لحركة البطل الذي سافر من قريته في الفيوم إلى ليبيا ليجد عملاً يدر عليه مالاً مثله مثل معظم المحيطين به في الثمانينات من القرن العشرين، ومنها قرر أن يسلك الطريق نفسه الذي سلكه بعض من سبقوه بالإبحار إلى إيطاليا في شكل غير شرعي، خَطِر. عن طريق مهربين يحصلون على مقابل مادي مرتفع، ويعرضون حياة الشباب للخطر بسبب نقص الضمانات.
وهو في كل مدينة يحكي عن حاله وحال من معه، فيعطي صورة غير مباشرة عن أحوال المدن وناسها.
فعن مدينة سبها –مثلاً- يقول ص13 و14: «قعدت السنة في سبها. أقصى الجنوب الغربي. وهي العاصمة الثورية المقدسة للزعيم الثائر ونظامه الأثور، وفيها عاش ودرس وبدأ الشرارة الأولى لثورة الفاتح التي سلمته ليبيا اثنين وأربعين سنة. وأسس فيها أول مؤتمر شعبي عام وأطلق منها نظريته العالمية الثالثة في تحرير الإنسان.
والحقيقة أنه حاول أن يجعل منها مدينة أوروبية بحدائق متسعة ومتنوعة. لكن السبهاويين. السكان الأصليين، والتبو والطوارق.
فهموا أو لم يجدوا أنفع من فهم أن الحدائق ما هي إلا مراعي حكومية مسوَّرة. وتقاسموها بالأغنام والإبل. وعندما ضجت السلطات من مواشيهم تقاسموا الحدائق في الحشّ.
كل واحد يحش من منطقة معينة. وأنا كان من نزهاتي النادرة في سبها مصاحبة صديقي محمد الطارقي وهو بيحش في العصاري لأغنامه من حديقة المديرية العامة للثقافة والفنون في سبها». وستجد شبيهاً لهذا عن المدن الأخرى في الدول الثلاث.
الرواية
الرواية –إذن- لا تعتمد على الجماليات المستقرة للكتابة السردية:
الحكاية والتصاعد الدرامي وبناء الشخصيات والصراع والعقدة والحل. كما أنها لا تأخذ الطريق الذي يسلكه الروائيون الذين يريدون كسر البناء التقليدي. فيهشمون الزمن مثلاً، بالتقديم والتأخير. ويهملون المتن لمصلحة الهامش، أو يدَّعون هذه الأشياء، لكنها –الرواية- لا تعترف بهذا الموروث أساساً. وتخلق لنفسها نسقها الخاص الذي يعتمد العشوائية.
فالكاتب يقول أي شيء في أي مكان وأية لحظة. كيفما ترد الأشياء على ذهنه. ولا يتماس مع الواقع فقط بل يدخل فيه ويعايشه. لا ليصبح جزءاً من الحكي. بل ليصير هو نفسه الحكي.
كل هذا في إطار وعيه بما يقدم، وبالحدود التي تفصل الأدب عن الكلام العادي. فهو ينفصل عن الأشكال المعروفة وهوامشها ليس ليخرج عن عباءة الفن. ولكن ليقدم لنا فنه هو، الذي لم يسبقه إليه أحد.
في هذا السياق. وحسب هذا الفهم للرواية وللوعي العام بها. تأتي اللغة. فهو يحكي بالكتابة بالضبط كما يحكي شفاهة، هي رواية شفاهية بالأساس، يستخدم فيها لغة البدو الخشنة بصعوبتها على غير العارفين بها. وبوعورتها وخدشها لحياء أبناء الطبقة المتوسطة التي تشكل التربية الدينية التقليدية المحافظة جزءاً مهماً من تكوينهم النفسي والعقائدي والثقافي والاجتماعي، فيسمي الأشياء والأفعال بأسمائها الجارحة من دون أن يشعر بخروج عن المألوف.
الأداء اللغوي يناسب السياق القيمي والاجتماعي والمعرفي
هذا الأداء اللغوي يناسب السياق القيمي والاجتماعي والمعرفي الذي تدور فيه الرواية ويشكل وعي أبطالها، طبقة العمال من بدو الصحراء الذين يمارسون أعمالاً دُنيا.
فالبطل في سبها الليبية كان يصنع الطوب الأسمنتي، وهي وظيفة عضلية بالكامل لا تحتاج إلى عقل، ثم بدأ في تجارة المخدرات، فتحول إلى المخدرات تحت غطاء مصنع الطوب، وحين انتقل إلى إيطاليا لم يكن أمامه غيرها، في بلد يستهلك المخدرات بمعدل مرتفع، وفي كل مكان طوَّع اللغة لتعكس الحياة حوله بقدرة عالية