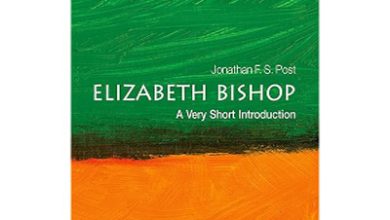الطبقة الوسطى المصرية يتوارى فقرها خلف الأبواب المغلقة

أكد د.أحمد حسين حسن أن الأدبيات والخبرات أثبتت أن أبناء المواقع الوسطى هم دائما الأعلى طموحا، والهادفين دوما لتحقيق “قفزات طبقية”. وقال في كتابه “الطبقة الوسطى والتغير الاجتماعي في مصر” أنهم في الغالب الأكثر عرضة للمعاناة من توترات المكانة الطبقية، ويضرهم بشدة ضياع الحدود بين الطبقات، لا سيما مع العاملة أو الدنيا، ويمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لهم يسعون دائما لتجنبها والإفلات منها. كما يضرهم وبالأساس أي تغيرات أو تحولات بنيوية لا تنحاز تداعياتها لهم. وهذا هو ما حدث بالفعل في خبرة التكوين المصري منذ ان تم الأخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم ثم محاولات التكيف مع الرأسمالية. وهي التحولات والبرامج التي أصابت المواقع الوسطى في مقتل.
وشدّد في كتابه إن هذه التحولات لم تنجم إلا عن خسائر متتالية تواجهها الأسر الوسطى باستمرار منذ منتصف السبعينيات وحتى الآن. لقد أصبحت الآن عاجزة عن الوصول إلى كثير من السلع والخدمات التي كان لديها قدرة عالية في الماضي على الوصول اليسير إليها.. إلخ. لقد ترك هذا الموقف آثارا سلبية على القسم الأكبر من الشرائح الوسطى، التي اضطرت للتخلي عن جزء غير صغير من بنودها واحتياجاتها الضرورية. واضطرت إلى التعامل مع الخدمات الخاصة التي استنزفت قسما كبيرا من دخولها المحدودة.
لقد كشفت هذه التحولات البنيوية التي جرت في التكوين المصري خلال الثلاثين سنة الأخيرة للمواقع الوسطى أنها ليست آمنة تماما من كل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولعل هذا ما دفع عدد غير قليل من الباحثين لإدخال شرائح عديدة من المواقع الوسطى في نطاق ما أسموه بـ”الفقراء الجدد” الذين قد يختلفون في خصائصهم الاجتماعية والديموغرافية “تعليم ـ مهارات ـ وضع مهني ووظيفي ـ مقومات متنوعة لرأس المال الثقافي.. إلخ” عن الفقراء فقرا بنيويا أو مزمنا. لكنهم من ناحية أخرى، هم فقراء فقرا خاصا يتوارى فقرهم خلف الأبواب المغلقة على حد تعبير أحد الباحثين. إن هؤلاء هم الذين نحسبهم أو نظنهم أغنياء من التعفف. إن على أبناء المواقع الوسطى الآن أن يستمروا في صراعهم العنيف، ليس ليشبعوا طموحا أو يحققوا تطلعا بل لمجرد الحفاظ على الذات من شبح الهبوط، وما قد تبقى من مقومات مكانة أو وضع طبقي مميز. ويؤدي هذا الموقف بإضطراد إلى نتائج سلبية تمس المصلحة الاجتماعية، في اتجاهات الانحراف والفساد والتقاعس وضعف الكفاءة، وبالطبع حركات الاحتجاج الديني والسياسي على السواء.
وطرح أحمد حسين في كتابه الدراسة تساؤلا عاما مفاده: ما اتجاهات التغير في بنية المواقع الوسطى الحضرية وأدوارها خلال الربع الأخير من القرن المنصرم؟ وفكك إلى ثلة من التساؤلات النوعية كالتالي: أولا ما أهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي خبرها التكوين الاجتماعي المصري خلال الربع الأخير من القرن السابق (1975 – 2000)؟
ثانيا ما أهم السياسات الاجتماعية التي انتهجتها الدولة خلال تلك الفترة، وما تأثيرتها في أوضاع المواقع الوسطى وفرص حراكها في الحضر؟ ثالثا ما اتجاهات التغير في تكوين أو تركيب المواقع الوسطى الحضرية والأحجام النسبية لشرائحها البينية؟ رابعا ما اتجاهات التغير في خصائص عمل وتعليم ومحتوى مهارة المواقع الوسطى الحضرية، وكذا في آليات حراكها الاجتماعي المتاحة؟ خامسا ما اتجاهات التغير في أدوار وفاعلية – حالة الوعى الطبقي والحركة والتنظيم السياسي – المواقع الوسطى الحضرية خلال الفترة الزمنية محل الدراسه؟ سادسا كيف استجابت المواقع الوسطى الحضرية المختلفة للتحولات الحادثة التي أفرزتها سياسات الدولة وبرامجها؟ أي ما أهم الآليات التكيفية التي أوجدتها المواقع الحضرية لمواجهة المشكلات وميكانزمات إعادة وجودها الاجتماعي؟
وأكد أحمد حسين بشأن التساؤلين الأول والثاني على زمرة من التحولات الجذرية في السياسات والبرامج: شكل الانفتاح الاقتصادي، ثم بعد ذلك ما عرف بسياسات التكيف الهيكلي مع الرأسمالية، والتحول الأهم الذي مثل نكوصا شديدا عما شهدته الستينيات من سياسات انحازت اجتماعيا وطبقيا إلي المواقع الوسطى والعاملة؛ فدعمت كثيرا من مواقعها الطبقية.
وقد انطوى الانفتاح والتكيف علي برامج وإجراءات كثيرة؛ اقتصادية واجتماعية وتشريعية وسياسية، من قبيل تفكيك القطاع العام وإهماله ثم بيعه وتسريح الغالبية العظمى من عماله وموظفيه “الخصخصة”، ثم التخلي عن سياسة تشغيل الخريجين، وما ارتبط بها من تراجع شديد في مستوى التأهيل والتدريب. كما مثل السماح بالهجرة الخارجية إلى النفط تحولا اجتماعيا مهما والذي ـ رغم إفادته بشكل نسبي بعض الشرائح بعض الشرائح الوسطى والعمالية في تحسين أوضاعها ومواقعها الطبقية ـ أسهم في حدوث تغيرات ملحوظة في بنية المواقع الوسطى وتفكيكها وتراجع أدوارها الاجتماعية وفاعليتها السياسية بوجه خاص.
وفيما يتعلق بالتساؤل الثالث قال أحمد حسين “يضاف إلى ما سبق ويدعمه السياسات التشريعية التي نفذتها الدولة عبر الثلاثين عاما الأخيرة في المجالات المختلفة، مثل قوانين الاستثمار الأجنبي، وإلغاء الحراسات، وإنشاء المنابر ثم الأحزاب، وقانون تحديد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الأرض الزراعية وفي الوحدات السكنية.. إلخ. وقد تزامن مع هذا كله استمرار عجز القطاع الخاص عن الوفاء بأدواره التنموية في التشغيل والنمو. لقد أفضت هذه التغيرات الجذرية إلى تغيرات موازية في تكوين وحجم المواقع الوسطى الحضرية ـ وأنساق قيمها ومفردات وعيها وفاعلية أدوارها المجتمعية. فمن حيث اتجاهات التغير في الحجم النسبي وفي التكوين خبرت المواقع الوسطى تغيرات ملحوظة وجلية في الأحجام النسبية لشرائحها البينية عند مستوى القمة والقاعدة على السواء. فعند القمة التي تمثلها الشرائح المهنية؛ الفنية والعلمية والإدارية “مديرون وإداريون معا” زادت أحجامها بشكل كبير منذ منتصف السبعينيات وحتى السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. في حين انخفضت عند القاعدة، وبشكل ملحوظ أيضا، والأحجام النسبية لأصحاب الأعمال الكتابية والعاملين في مجال الخدمات. وهو ما يدعم القول بحدوث عمليات فرز وإحلال داخل التكوين الطبقي للمواقع الوسطى على حساب الشرائح الدنيا ذوو التعليم المتوسط ودون المتوسط والعمالة المكتبية من صغار الموظفين في أجهزة الدولة. وهي الشرائح التي يتواضع مستوى تعليمهم ولم يحققوا مهارات أو خبرات تلحقهم بفرص عمل أفضل، ومن ثم تتراجع إمكانية حراكهم لصالح الشرائح ذات التعليم العالي والمهارة والخبرات الفنية والإدارية الأفضل التي يحتاجها فعليا سوق العمل لاسيما مع التوسع النسبي للمشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة.
ويشير إلى أنه من بين التغيرات المهمة أيضا التراجع الواضح في حجم شريحة أصحاب الأعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص وليس لدى الغير. وهو التراجع الذي صب في خانة الزيادة في الحجم النسبي للعاملين بأجر في مؤسسات الدولة أو في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم على السواء. وكأن هذا السحب كان من نصيب الذين يعملون بشكل مستقل، وأصحاب المشروعات الإنتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة، ليضافوا إلى نصيب العاملين الأجراء من أبناء المواقع الوسطى، وهي الشريحة التي زادت من 10.5 % في منتصف السبعينيات لتبلغ 33.1 % في السنوات الأولى من القرن الحالي. وهو موقف له دلالات جمة، فهو يعني من ناحية عدم جرأة أبناء المواقع الوسطى؛ موظفون، وتجار، ومهنيون، وتكنوقراط، وغيرهم، على العمل المستقل خوفا من ضراوة منافسة المشروعات الاحتكارية. كما يعني من ناحية ثانية أنه مع غلبة العاملين بأجر نقدي لدى الغير من المواقع الوسطى يدلل هذا على ما يزيد من الترجع في مفردات وعيهم الطبقي. فأصحاب الرواتب من المواقع الوسطى يقتربون بشكل أكبر من العمالة الأجيرة في موقعهم في علاقات إنتاجهم وملكيتهم من علاقات السوق، وكذا من حيث حيازة السلطة وممارستها، وحيازة الاستقلال في العمل، ودرجة الخضوع للاستغلال. وهذه كلها معايير من المفترض أنها محددات أصيلة للموقع الطبقي المتوسط خاصة.
ويلفت أحمد حسين إلى أنه بالإضافة للتغيرات الحادثة في الأحجام النسبية لبعض الشرائح الوسطى البينية، بالزيادة في جانب، والتراجع في جانب آخر، شهدنا على المستوى الإجمالي لكل المواقع الوسطى على مدار السنوات العشر الفاصلة بين عامي “1996 – 2006 ” تراجعا شديدا في الحجم الكلي للمواقع الوسطى وفي حجمها النسبي الإجمالي لقوة العمل مقارنة بالموقع العمالي. فرغم تضاعف الحجم الإجمالي للمواقع الوسطى خلال عشرين عاما “من 31 % إلى 61 % فيما بين 1976 إلى 1996” تراجع بمقدار 20 % خلال السنوات العشر الأخيرة. وبالطبع كان الانكماش لصالح زيادة حجم المواقع العمالية خلال السنوات نفسها بمقدار 22 % تقريبا. ويضاف إلى عمليات الفرز والإحلال المشار إليها، أن حدثت تغيرات في تكوين بعض الشرائح الداخلية؛ إذ انكمشت أحجام الشريحة البيروقراطية التي كانت متمركزة في قطاعات الدولة وأجهزتها ـ وكذا الشريحة البرجوازية الصغيرة التقليدية ـ في حين بزغت شرائح حديثة بفعل التطورات الخارجية والداخلية الجارية. وهي الشريحة البرجوازية الحديثة المعولمة، والتي رغم انتمائها إلى صلب المواقع الوسطى، تتباين عنها في كل من علاقات العمل والسوق والموقع في بناء السلطة وحيازة الاستقلال في العمل. بالإضافة إلى تباين مفردات وعيها الاجتماعي.
أما من حيث الإجابة عن التساؤل الرابع الخاص باتجاهات التغير في خصائص العمل والتعليم والمهارة فيرى أحمد حسين أن المواقع الوسطى شهدت على تغيرات جذرية مهمة في علاقات عملها ومستوى تعليمها وحيازتها المهارية وفي سوق العمل وقطاعه. حيث كشف عن تحول قسم مهم من عمالة المواقع الوسطى إلى القطاع الخاص بفعل عوامل كثيرة منها ضمور القطاع العام وتدهور قواعده الإنتاجية ثم الشروع في بيعه، واستقطاب القطاع الخاص للعناصر القديمة من كوادر القطاع العام ذات الأصول المهارية والخبرات الإدارية والتنظيمية، مع عناصر أخرى حديثة أكثر تأهيلا ودراية وقدرة على التعامل مع معطيات سوق العمل والإنتاج وإضعاف إمكانات الاتصال والتفاعل بين عناصر المواقع الوسطى؛ أى الظروف المهيئة لبناء قدرات طبقية تنظيمية ملائمة.
وفيما يتعلق بالتساؤل الخامس حول اتجاهات التغير في وعي المواقع الوسطى وأدوارها وفاعليتها الاجتماعية والسياسية، بين أحمد حسين أنه فيما يختص بجزئية الوعي بالسياسات الجارية والمواقف من البرامج المطبقة، رفض الغالبية العظمى من مفردات عينة الدراسة لجوانب كثيرة من السياسات الاقتصادية الليبرالية، سواء كانت مع الانفتاح الاقتصادي أو التكيف الليبرالي. والتي تمثلت جزئيا في سياسة الخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام، وتخلي الدولة عن جزء مهم من أدوارها الاقتصادية والاجتماعية. إذ أكد المبحوثون على التبعات السيئة للسياسات المطبقة بالنسبة لشرائح طبقية واجتماعية عريضة أهمها، العمال والموظفين والشباب والمستهلكين على حد سواء. ففيما بين “70 % إلى 80 %” من غالبية المواقع الطبقية الوسطى أكدوا على رفض الخصخصة على وجه التحديد. يستوي في هذا رؤساء العمال مع كبار ومتوسطي المديرين، العاملين لحسابهم الخاص أو لدى الغير. وفي الوقت نفسه لم يظهر العاملون في القطاعات الخاصة اتجاهات أكثر ليبرالية أو تقدمية مؤيدة للخصخصة أو مدافعة عنها – مقارنة بالعاملين بقطاعات الدولة التي توسم غالبا، في أدبيات كثيرة بالمحافظة والرجعية في مواقفها، لقد اتفق الجميع في كل القطاعات على أضرار الخصخصة ومن ثم عدم تأييدهم لها.
وعن حالة الوعى الاجتماعي والطبقي للمواقع الوسطى الحضرية وأنساق قيمها الاجتماعية كشف أحمد حسين عن عدم وجود تجانس قيمي واضح بين القيم التي تؤمن بها المواقع الوسطى الحضرية. وقال “كشفت البيانات المتاحة عن وجود تضارب وتناقض فيما يتعلق بقيم التعليم، والعمل، والتسامح الديني، وقبول الآخر السياسي، والموقف من المرأة، وحرية المنافسة.. إلخ. وهو التناقض الذي يمكن فهمه في إطار تناقض خصائص المواقع الطبقية الوسطى البينية واختلاطها. وفي ضوء تباين مفردات الوعى بالمصالح والأهداف، علاوة على تشتت الانتماءات السياسية والأيديولوجية.
أما فيما يتعلق بالتساؤل السادس والأخير والذي يتناول اتجاهات التغير في الأدوار المجتمعية والسياسية للمواقع الوسطى الحضرية، فلقد انتهى أحمد حسين إلى تقرير عزوف الغالبية العظمى من مفردات المواقع عن المشاركة السياسية والاجتماعية بوجه عام في غالبية التنظيمات والكيانات القائمة، سياسية كانت أو مدنية أو شعبية أو اجتماعية أو رياضية.. إلخ. أيا كانت مستويات المشاركة أو تجلياتها. بل إنه لم تكن من الأساس فكرة المشاركة السياسية بمعناها الأوسع واضحة في أذهان النسبة الأكبر من المبحوثين، فالمشاركة لم تتجاوز مجرد الاشتراك في الانتخابات المختلفة لإختيار المرشحين.
ميدل إيست أونلاين