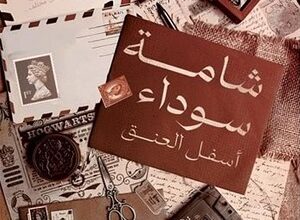العروبة الجامعة بين التسامُح والرفض

مخاطر جمَّة تواجِهُ العرب من جوانب مُختلفة، وعلى شاكلةٍ مُتصاعِدة، تُذكّرُ بحقباتٍ صعبةٍ ماضية، عاش فيها العرب ويلات الاستعمار والوصاية، بما حملتا من قهرٍ وقمعٍ واستبداد، ومحاولاتٍ حثيثة لتغيير الهويّة القومية الجامعة، أو تهشيمها على أقلِّ تقدير. وتشعُر الأغلبية الساحقة من النُخب العربية أنّ هناك استهدافاً غير مسبوق للدول العربية، واستباحةً تصل إلى حدّ الاستهتار بالمشاعر القومية.
يترافق هذا الشعور مع شكوكٍ تربط بين الأهداف الإسرائيلية وطموحات بعض القوى الإقليمية والدولية، من خلال تلاقي المصالح الناتجة عن تغييبِ عامل التأثير العربي في جيوبوليتيك المنطقة وسوسيولوجيّتها، عبر تنفيذ مشاريع تفتيتيّة: أحياناً تأخذُ طابعاً دينياً او مذهبياً، وأحياناً أُخرى تتلطّى خلف شعارات ” المقاومة ” للاحتلال الإسرائيلي، ولكنّ الهدف منها شيءٌ آخر.
لا يمكن فصل الأحداث الكُبرى التي تجري في بلاد ما بين النهرين والشام العربيّتين عن سياق الاستهداف الوجودي للفكرة العربية برُمّتها، ذلك أنّ تشجيع بعض المجموعات غير العربية على الانفصال، أو التمرُّد، غيرُ بريءٍ على الإطلاق، لأنّ هذه المجموعات عاشت في كنفِ العروبة لقرونٍ طويلة بأمانٍ واستقرار، والأغلبية من هذه المجموعات لجأت إلى بلاد العرب هرباً من البطش والاضطهاد والإبادة التي تعرّضت لها في موطنها الأصلي، ومنها على سبيل المِثال أكراد شمال سوريا والأرمن وبعض الأمازيغ في المغرب العربي.
أمَّا الأفكار التفتيتية التي انتشرت على خلفيّات مذهبية أو فقهية مغلوطة، فهي أيضاً دخيلة سياسياً على الذاكرة الثقافية العربية، ولم تحصل إلّا بفعل عامل تشجيع خارجي. ويمكن إدراج حركة ” داعش ” الإرهابية الانفصالية في وسط سوريا والعراق ضمن هذا المنحى، لأنّ الأوهام المغلوطة التي يبني قادة ” داعش ” أفكارهم عليها، تُشكّلُ طعنةً في خاصرة الفكرة العربية، وتبريراً لمشاريع التفتيت والتمزيق التي تتبنّاها قوىً إقليمية ودولٌ خارجية كُبرى. ويأتي الانفلاش والطموح المُتفلِّت عند بعض القيادات اليمنية – ولاسيّما عبد الملك الحوثي – ضمن السياق التفتيتي ذاته. وليس سرّاً أنّ هذه الحالات – التي ذكرناها كمثال على خطورة التدخّلات الخارجية في الشؤون العربية – مرتبطة بدول إقليمية غير عربية، وبمسارات خارجية ليست بعيدة عن التأثيرات الصهيونية.
إنّ محاولات التشكيك بالعروبة كحضارة، ليست جديدة، وقد تعرَّضت هذه المقاربة لمحارباتٍ مُتعدّدة، وللتشكيك. وقد حاول العثمانيون تتريك بعض الدول العربية، ولاسيّما في بلاد الشام، عبر 400 عام من الاحتلال ولم يفلحوا. وحاول الاستعمار – وخصوصاً الفرنسي – تغيير وجهة الشعب العربي في شمال أفريقيا برمّته، من خلال التآمر على اللغة العربية، واستبدالها باللغة الفرنسية، إلّا أنّ ذلك لم ينجح على مدى 150 عاماً، وقد عادت الجزائر إلى كنف العروبة، رغماً عن أنف الاستعمار، ومعها تأصّلت العربية أكثر فأكثر بين أبناء الشعب المغربي والتونسي والموريتاني. وعلى الوتيرة ذاتها، رفضت شعوب وادي النيل تسلُّل الأفكار الدخيلة، وتمسّكت بعروبتها الصافية على الرغم من كلّ التحدّيات.
العروبة ليست لغة فقط؛ إنّها حضارة متوارثة من جيل إلى جيل. والأبجديّة تنمُّ عن ثراثٍ يحمل معاني التقاليد والأعراف والرؤى، بما في ذلك تفسيرات مختلفة لبعض الظواهر الطبيعية وحتّى العلمية ( فالقمر بالعربية مذكّر والشمس مؤنّثة بينما بالفرنسية عكس ذلك) وهذه الخصوصية العربية تنطلق من غنىً حضاريّ وإبداعات فلسفية وعلمية وأدبية، ومن مقارباتٍ سيسيوديموغرافية مُترامية وموحّدة إلى حدٍّ بعيد، تعتمد على الصدق والكرم والتقيّةِ وحسن الضيافة، وعلى اعتبار أنّ الإسلام الحنيف لا يتعارض أبداً مع فكرة العروبة، بل يُغنيها ويكمّلها في آن. وتلك الآراء روّج لها بعض المفكّرين العروبيّين غير المسلمين من أمثال ميشال عفلق وجرجي زيدان وقسطنطين زريق.
صحيح أنّ الدول الوطنية العربية الحديثة أُنشِئت وفقاً لاعتبارات جغرافية أو تقليدية، أو بتأثيرٍ من معاهداتٍ دولية فرضتها الدول الكبرى في النصف الأول من القرن الماضي، ولكنّ التجانُس الديمغرافي لم يكُن مفقوداً إلى الحدود التي يتحدّث عنها بعض المروّجين لفكرة الاستباحة الخارجية اليوم. وقد عاشت المكوّنات الاجتماعية للدول العربية – ولاسيّما المشرقية منها – باستقرارٍ وسلام، عقوداً طويلة، وغلبت على جدلية التبايُنات الداخلية سمةُ التنوّع السياسي ضمن وحدة المرجعية العربية الجامعة، بما في ذلك بعض المكوّنات ممّن لا ينتمون إلى العربية، وكانوا قابلين بالعيش ضمن جغرافيا العروبة الحاضِنة، ولكنّ ممارسات بعض الأنظمة القمعية بحقّ الأقلّيات الإثنية – ولاسيّما الأكراد – أسهمت في قطع حبال التواصل بين هؤلاء والتركيبة السوسيوبوليتيكية المحيطة، وخصوصاً في شمال العراق وشمال سوريا.
إنّ الدعوات لإقامة الوحدة العربية التي انتشرت في النصف الثاني من القرن العشرين، والتي حملها نخبويّو حزب البعث العربي الاشتراكي ومؤيّدو الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لم يُكتب لأيٍّ منها النجاح الكامل، وبعض التجارب استهلكت نفسها على خلفية الصراع على السلطة والنفوذ، وعلى وجه التحديد؛ تجربة الوحدة المصرية – السورية (1958-1961) وكذلك الأمر بالنسبة إلى اتّحاد الميثاق القومي بين سوريا والعراق (1978) ولكن تلك الإخفاقات لا تعني بأيّ حال من الأحوال تشكيكاً بالفكرة العربية الحضارية الجامعة للشعب العربي المتنوّع ولوحدة الأراضي العربية المترامية من المحيط إلى الخليج.
وما يؤكّد تلك الوحدة المتنوّعة في الجِيوسوسياليسْت العربي، عدم قدرة الدول الكبرى المجاورة للجغرافيا العربية على محو الآثار التراثية العربية عن المجموعات التي تعيش ضمن المساحات التي سلختها هذه الدول – وبإرادة المستعمرين – عن واقعها العربي، وأقصد عرب الأحواز – أو عربستان – التي ضُمَّت إلى إيران بموافقةٍ بريطانية، كذلك عرب لواء الإسكندرون الذي تمَّ ضمّه إلى تركيا بموافقةٍ فرنسية.
إنّ نمط تعدّد الدول الوطنية ضمن الإطار العربي، لا يتناقض مع التمسُّك بالتراث الواحد، وبوحدة الانتماء التي يستند اليها العرب أينما كانوا. وصيغة العمل العربي المُشترك في إطار جامعة الدول العربية، تجربةٌ ناجحة إذا ما تمَّ تفعيلها، وتطوير مستوى آداء منظّماتها الرافِدة المُتخصِّصة، في المجالات الأمنية والدفاعية والثقافية والإدارية والاقتصادية، وفي قطاعات الصناعة التكنولوجية والاتصالات. ومثل هذه الصيغة الجامعة مُعتمَدة في أماكن أُخرى من العالم على المستوى القارّي، أو القومي. فالفيدرالية في الولايات المتّحدة الأميركية، صيغة تعاون بين ولايات متعدّدة الإثنيات والقوميات والألوان والأديان ضمن اتّحادٍ، لا يوجد فيه وحدة إلّا في الأمن والخارجية والدفاع. وهو تجربةٌ ناجحة لعملٍ فيدراليٍّ مُشترك. أمّا الاتّحاد الأوروبي، فحو يعمل في صيغة تعاون لدول مُستقلَّة ومتنوّعة، ولا تنتمي إلى قومية واحدة، ولا تتحدَّث لغة واحدة، ولكنّها تتعاون في الاقتصاد والأمن للحفاظ على مصالح أبناء القارّة أجمعين لمواجهة التطوّر الهائل الذي شهده العالم في العقود الأخيرة.
إنّ التضامن العربي، أو العمل العربي المُشترك، ضرورةٌ قومية ووطنية أكثر من أيّ وقتٍ مضى. ومواجهة الأخطار التي تواجه الأُمّة تفرض توحيد الرؤى العربية في حدّها الأدنى، وخصوصاً في مجال الوقوف في وجه الاستباحة التي فرضتها التدخّلات الخارجية في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، وعلى وجه التحديد تدخّلات الدول الإقليمية المجاورة، ومنها مَن يدفع الأموال الطائلة لتفكيك النسيج العربي في عددٍ من الدول – وخصوصاً في العراق وسوريا ولبنان واليمن – وهدف هذه الدول، توسيع نفوذها الإقليمي على حساب المصالح العربية المُشتركة.
إنّ مواقف جامعة الدول العربية الأخيرة تنمُّ عن استفاقة مطلوبة في هذه الظروف العصيبة. والفرصة مُهيّأة لترسيخ التضامن العربي والوقوف في وجه التدخّلات الخارجية الهدّامة في الشؤون العربية.
تمتلك الأمّة العربية عظمة لا يُستهان بها، وعندما يتوافر التعاضد العربي، يمكن أن تتحقَّق المُعجزات. فقبل 756 سنة، وقف العرب مجتمعين في عين جالوت وهزموا هولاكو وجيشه (الماغولي- التتري) الذي لا يُقهر، وقضوا على أعتى إمبراطورية إجرام في التاريخ. فهل يقف العرب اليوم موحّدين لوضع حدٍّ للاستباحة الخارجية للسيادة العربيّة؟
*أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
نشرة أفق الألكترونية (تصدر عن مؤسسة الفكر العربي)