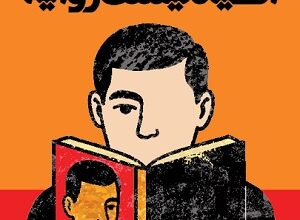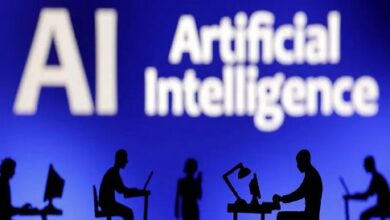«الكيانات» ضرورة.. و«سايكس بيكو» ذريعة

تمضي السنوات قُدما وتزداد اوضاع بلادنا تراجُعاً، لدرجة يبدو وكأننا في عداء مع التقدم وفكرته. نصّر على السير خارج منطق العصر وتحولاته، نهوى الاستقرار في قبور التاريخ وحفرياته. فيتعجب الجمود من جمودنا وعدم مقدرتنا على تجاوزه، ومن شغفنا بالوقوف خلفه ورغبتنا في المزيد من الانحدار والسقوط.
لذلك تمر السنوات، بما تحمله من تقدم وإنجازات وتطورات، في غفلة عنا. نكاد لا نشعر إلا بما تولده من أصداء توقظنا للحظة من سباتنا العميق فنرتعب من هول ما نحن عليه من حروب لا تنتهي، وتشظٍّ يأكلنا كالمنشار، واحتلالات تغدو مطلبا «وطنيا»، وثروات منهوبة بتشريع رسمي، وأوطان مع وقف التنفيذ، ودول لا تمتلك مقومات الحياة، وشعوب تتوزع عشائر وقبائل وطوائف ومذاهب وعائلات، ونوع من السلوك الديني الذي تحول الى وحش يأكل البشر ويدمر الحجر و «يُصادر الله» وينتهك ابسط البديهيات في الاسلام. ضمن هذه الرؤية يمكن القول إن العام الماضي هو تتويج لمسلسل الخيبات والانكسارات، برغم ما قد يحمله هذا التوصيف من انتقادات حادة، قد تصل الى حد الاتهام بتعميم التشاؤم وزرع اليأس وكسر إرادة الأمة في «الصمود والممانعة» والوحدة.
تتعدد العوامل التي قذفتنا الى هذا المصير غير الطبيعي، بالرغم من كل النضالات والتضحيات التي قدمتها الاجيال السابقة. غير أنه قد يكون من أهم الأسباب (أحد الأسباب) التي أوصلتنا الى هذا الدِرك من الانحدار والتراجع يكمن في النظرة المتكلسة تجاه الكيانات السياسية التي جاءت نتيجة موازين القوى التي أفرزتها الحرب العالمية الأولى، وطريقة التعامل معها والتفاعل في إطرها، سواء جاءت هذه الرؤية وسلوكياتها من الاتجاه الوحدوي ـ القومي، او الكياني القطري.
معطيات واضحة
فمنذ مئة عام كانت اتفاقية سايكس بيكو (أيار 1916) قد وزعت مناطق النفوذ في المنطقة على الدول المنتصرة في الحرب الكونية الأولى (فرنسا وبريطانيا). وجاء مؤتمر سان ريمو (نيسان 1920) لتثبيت ما رسمته الاتفاقية وترسيخ التجزئة في المنطقة من خلال إنشاء الكيانات السياسية القائمة في المشرق العربي. غير ان هذه الكيانات، يبدو انها مُهددة اليوم، بالمزيد من التشظي والتفسخ والتحلل، الى مناطق وأقاليم ودويلات صورية تقوم على عصبيات الانتماءات الأولية الحادة في انشراخاتها ورفضها لبعضها، الأمر الذي يجعل الأمة والأوطان ضمنها، أمام تحديات غير مسبوقة، ويجعل النظرة للمستقبل اكثر سوداوية. وهذا ما قد «يُعيد ـ نا» الى ما قبل تشكل الدولة الحديثة ومستلزماتها.
من المؤكد أنه لا يمكن تجاهل ما ولدته اتفاقية سايكس بيكو في جسم الأمة من انشراخات على اكثر من صعيد، حالت دون تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي… او في ما ساهمت به من تهيئة الأجواء لتحقيق وعد بلفور وتمكين الحركة الصهيونية في فلسطين، وفي كشفها مستوى الخداع الذي تعرض له الشعب العربي من الدول الاستعمارية، ومدى انتهاك هذه الدول لحق «تقرير المصير» الذي رفعته حينها. غير أن مسار التجربة السياسية منذ قرن من الزمن، بين بالمقابل، «دور ـ نا» أحزابا ودولا وشعوبا في ترسيخ مفاعيل الاتفاقية، والتأسيس لما قد يحمله المستقبل القريب من «توقعات» قد تكون الأوضاع فيه أخطر مما هي عليه واكثر فتكا. لذلك وبعد هذا العمر المديد، لم يعد مُقنعا إلقاء اللوم على «الاستعمار» وزبائنيته، وتجاهل موقع «الذات» ومسؤوليتها في هذه المسألة، كما في غيرها من القضايا الشائكة في بلادنا.
اتجاهان متقاطعان
لقد تجمدت منطلقات الأحزاب الوحدوية ـ القومية على نظرة نمطية تجاه الاتفاقية ومفاعيلها. وانطلقت في تعاملها مع هذه الكيانات على اعتبارها «غلطة تاريخية» و «كيانات مصطنعة» ومنتوجاً استعمارياً يعمل على خدمة الخارج واللحاق به. لذلك «تجب» إزالتها وتدميرها، لتعود الأمة الى «صفائها» و «جوهرها» وطبيعتها «الخيرة» وشخصيتها «الفذة».
هذا المنطق المغالي في رؤيته ونظرته، جعل الأحزاب الوحدوية سجينة مقولاتها، وغير قادرة على مواكبة التحولات الإقليمية والعالمية من جهة، وعاجزة من جهة اخرى عن تطوير «الكيان المصطنع» وتحديث بنيته وتجديد هياكله وتطوير سلطته، لدرجة عمدت هذه القوى الى إلغاء الحسي الموجود وتجاهله في سبيل «حلم» جميل ومتألق يُفترض أن يكون عليه الوجود. من هنا، فانها ازدادت بُعدا عن أهدافها ومنطلقاتها برغم كل تضحياتها، وأضاعت فرصا عديدة لتقديم «نموذج» يمكن البناء عليه وصولا الى الحلم الموعود.
بالمقابل، فان هذه القوى التي حملت الفكر الوحدوي، على اختلاف مشاربها، تجاهلت دورها في ترسيخ التجزئة وحمايتها، وتغافلت عن تهشيمها فكرة «الوطن ـ الكيان»، وتجنبت تقويم التجربة وما تخللته من «فظائع» وخطايا بحق الكيان والناس…، الأمر الذي حوّل سايكس بيكو الى «حائط مبكى» نُحيل اليه ونُعلق عليه «هزائم ـ نا» و «تخلف ـ نا» واستمرارية «تفكك ـ نا». فاستقرت هذه القوى على أطلال الماضي السحيق، تعيش حالة «ذهنية صوفية» حالمة، تنتظر «بطلها» القومي «المنتظر» لاستعادة «الماضي المجيد». وتجمدت في النصوص واستقالت من دورها التاريخي. وبرغم ان بعضها تحكم بـ «الحديد والنار» باسم الأمة لعشرات السنين، غير أنها لم تستطع أن تحقق أي إنجاز وحدوي، ولم تُقدم على أية خطوة لكسر مفاعيل سايكس بيكو وتجاوزها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا وثقافيا… الاستثناء المحدود وحدة مصر وسوريا 1958 الذي له مقاربة اخرى.
امتد هذا السلوك، وبطريقة معاكسة، الى الأحزاب الكيانية، على اختلاف توجهاتها وان بنسب مختلفة. فقد «حلمت» بعض هذه الأحزاب بالكيانات وعملت على إقامتها. غير انها لم ترتَقِ الى فكرة الحزب السياسي الحديث والدور المناط به في الاجتماع السياسي القائم. فكما غالت الأحزاب الوحدوية في رفض الكيان وتمجيد الوحدة، وقفت الأحزاب الكيانية على المقلب الآخر. فعمدت الى التطرف في معاداتها للوحدة وتعظيمها للكيان. فكانت طريقة تعاملها مع «المولود الجديد» غير طبيعية، سواء في المبالغة في «تخيلها» لطبيعته او لتحديد دوره، او تعيين موقعها كقوى سياسية في أطره، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، او في عــــلاقاتها وتعاملها مع مكوناته المجتمـــعية، او في عدائها للمحيط وتنكرها لفـــكرة الانتــماء والتضـامن معه.
من هنا «صادرت» الكيان الناشئ وعمّقت إنشراخاته لضمان هيمنتها واستمراريتها، وعطلت تفاعل نسيجه الوطني، ولعبت على الهواجس والخوف من الآخر… وتنكَّرت لمقولاتها «الليبرالية»… مما حوّل الكيان الى مزرعة، والدولة الى تجمع طوائفي متصادم، والوطن الى ساحات مباحة تتوزع عليه هذه الفئات المتنافرة، والشعب الواحد الى مذاهب وطوائف متنافرة متقاتلة، مسكونة بالكراهية والرفض المتبادل، تستقوي بالخارج وتستحضره عند كل استحقاق،… لذلك تبعثرت مقومات الكيان وتعطلت مسيرته ونمت في تربته وفضاءاته بذور التفكك والانهيار….
يمكن القول ان الاتجاهين تقاطعاً، وإن اختلافا وتساندا، وإن تناقضا، على الأقل، في تهشيم الكيان وتفريغه من مقوماته الأساسية، وفي منع قيام الوطن وبنائه، وفي الانقضاض على الدولة وضرب أسسها، بكل ما يحمله هذا العمل السياسي من أبعاد تطال الانسان كإنسان، وجودا وحرية وحقوقا… وقد يكون هذا المسار الطويل قد عزز، مع عوامل اخرى متممة ومرافقة له، مسيرة التراجع التي وصلنا الى ما نعيش بعضا من تداعياتها، في اللحظة السياسية الراهنة.
بديهيات منسية
وعليـه، فإن العمل على المحـــافظة على الكيانات القائمة وتدعيم أسسها، وتغيير النظرة اليها، وتــجاوز «خـــطايا ـ نا» تجاهها، قد يكون ضرورة انسانية ووطنية وقومية.
إن عملية المحافظة هذه، كمهمة وطنية وقومية، ليست إجراءات شكلية وخطابات ممجوجة، بل تستند الى العودة الى بديهيات العيش في إطار الاجتماع السياسي الحديث، سواء لجهة بناء الدولة على أسس دستورية، واحترام الدستور والقانون، وإعادة الاعتبار للانتماء على أساس الفكرة الوطنية والمواطنة، و «تحرير» الانسان من هيمنة الطوائف والمذاهب ووصاية رجال الدين، والعمل بمبادئ التنمية المستدامة، ورفض الصنميات الفكرية والتنظيمية…
غير أن هذه الضرورات البديهية تبدو بعيدة جدا في المنظور القريب. كونها تتعارض مع سلوكيات القوى السياسية، ومنظوماتها الفكرية، وتتناقض والبنية المجتمعية التي اخترقها الهريان، وعشش فيها التعصب، واتسعت في أرجائها مساحات الكراهية والرفض المتبادل… فهل سنبقى ندور في الحلقة المفرغة، أو يمكن الفكاك من هذا الأسر؟ وكيف؟
صحيفة السفير اللبنانية