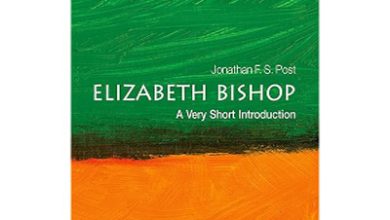الملحمة أمّ الأدب

يُمكن ردّ الأدب بأجمعه إلى الملحمة، فهي “أمّ الأدب” لأنّها أصله وعِماده، وقوامها مادّة سردية صيغت بأسلوبٍ شعري، وظهورها سابق للأجناس الأدبيّة، فهي الأمّ التي غذّت الأدب بعناصره الأولى، فمن أحداثها نشأ السرد بأنواعه، ومن إنشادها نجم الشعر بقوالِبه، ومن حوارها خُلِق المسرح بأشكاله، وبمرور الوقت استقلّت تلك الأنواع بخصائصها، وانفردت بصفاتها، بمنوال متتابع حسب العصور والأزمان، فيصحّ القول إنّ الملحمة كانت خزين الأدب قبل التجنيس، وذخيرته بعد ذلك.
وليس غريباً أن ترتبط الملحمة بالعمى، فلطالما نُظِر إلى كفيف البصر على أنّه قادر على إنشاد الأشعار، ورواية الأخبار، وهو تقليد أخذت به الشعوب القديمة، وآمنت به، ومنها الإغريق، وما لبث أن أصبح العمى من مآثر مُنشدي الشعر القديم. ولعلّ صورة الضرير يترنّم في هذه المناسبة بمآثر قومه، ويتغنّى في تلك بأمجادهم، وهو يطوف ربوع بلاده مُنشداً أقواله بحسن إيقاع، وجودة سبك، وبراعة صنعة، قد أضفت عليه هَيبة دونها هَيبة المُبصرين، ومَنحَتْه مجد الخالدين.
ذلك ما كان عليه حال “هوميروس” صاحب ملحمتَيْ “الإلياذة” و”الأوديسة”، وهما أمّ الأدب اليوناني بأجمعه، وفيهما تمرّس بالإنشاد قبل أن يظفر بالمكانة السامية، وقد صاغ الهيكل الشفوي للملحمتَين خلال تطوافه في أنحاء اليونان. وافترض “هيرودوت” أنّ هوميروس عاش قبل مولده بأربعمائة سنة. ولمّا كان المؤرّخ قد ولد في عام 484 ق.م، فيفترض أنّ الشاعر عاش في القرن التاسع قبل الميلاد، فبه افتُتحت الألفية الأخيرة للحضارة اليونانية. وُضع الشاعر الضرير في اختبار شفوي شاقّ، فقد طُلب إليه إعادة بناء العالَم القديم الذي انحسر عن الأعيان، وقبعت بعض أحداثه في الأذهان، وينبغي تشييده، واستعادته بالتخييل. ليس الشاعر مُنشِداً لأمجادٍ انقرضت، بل صانعاً لها بالتخييل الشعري، فلا يجوز له أن يَصِف الأحداث كما يَصِف المؤرِّخ حدثاً غابراً، بل يدفع جمهوره إلى خوض غمارها، بابتكار وقائع تعمل على بعث المُشارَكة الوجدانية في وسطه، فتتوارى الصفة التوثيقية للشعر وتحلّ مكانها صيغة توهِم بالواقع لكنّها لا تشغل به.
ولكي يتأكّد مقصد الشاعر الملحمي، وتُثبت غايته، ينبغي عليه أن يطمع بضربٍ من التدفّق الشعري الذي ينهل من الذاكرة ما يناسب من الأحداث، والإسهاب في وصفها بما يروي عطش الجمهور للعيش في ماضٍ انحسر وجوده من حياته، كما يجب عليه اختيار العبارة البليغة التي تحمل فكرة واضحة. فما يترقّبه الجمهور، فضلاً عن التماهي مع ذلك العالَم، هو سموّ الألفاظ والموضوعات والقيَم. فلا تجوز الدناءة في أخلاق الأبطال، ويحذّر من السلوك الرذيل، ويُحسن تجنّب اللّؤم، فلا يليق بهم ما يشين أفعالهم، وكلّما ترفّع الأبطال عن الصغائر، واتّصفوا بعزّة النَّفس، كان حظّهم من التقدير كبيراً. والشاعر المجيد مَن يضبط إيقاع مرويّاته مع رغبة جمهور يتطلّع إلى تعظيم مآثر الماضي بأسلوبٍ يأخذ في حسبانه خلق استيهام في نفوس المُستمعين للموضوع، فذلك هو نصيب الملحمة من تمثيل الأحوال، ومن تصوير الأفعال، فلا ترتدّ إلى ما دون وظيفتها، وصنعتها تقتضي ذلك أساساً لها، وتَستوجِبه أصلاً من أصولها.
مَنَحَ العمى هوميروس موقعاً سما به على سائر الشعراء المُبصرين، وقد نقّب باحثون كُثر في دلالة اسمه، فوجدوه يحيل على العمى. فهو المُنشِد الضرير، والشاعر الذي انطفأ بصره. ومجمل الأخبار حوله ذهبت إلى أنّه كان فقير الحال، وقد انتقى بعض الأحداث المهمّة التي وقعت في بلاده، فجعل منها موضوعاً لقصائده، وتكاثرت الأخبار حوله، وتضاربت الأقاويل، ما جعل البحث في هويّته شبه متعسّر إلّا على سبيل الاحتمال، أو الترجيح، إلى درجة شكَّ “ديورانت” في وجوده، فقال “هو إنسان قد لا يكون له وجود”. وسواء انطبق الاسم على مسمّى حقيقي أو على شبح أدبي له، فقد طار ذكره في الأرجاء كلّها، وعدّه أفلاطون شاعراً لا نظير له، فهو مثاله الأرفع بين قدامى الشعراء. وغمره أرسطو بالثّناء الذي لم يحظَ به أحد لا من قبل ولا من بعد، فقال عنه إنّه كان “شاعراً فحلاً من النَّوع العالي في الشعر”، وله “في كلّ شيء المقام الأعلى”، ويُعَدّ “سيّد الشعر غير مُدافع” لأنّه “فاق الشعراء جميعاً في المقولة والفكر”، أي أنّه غلب شعراء الإغريق في التعبير عن الفكرة بالكلمات المُناسِبة لها، وبرع في التصوير بأسلوبٍ لم يُسبَق إليه. وحيثما أثير ذِكر هوميروس في التراث اليوناني، شُنِّفت الأسماع لذلك الهدير الملحميّ الصاخب؛ فاسمه علامة تحيل على حقبة بطولية انحسر أمرها من التاريخ، وانطمر في ثنايا أشعاره، ولا سبيل إلى تعقّب الأمجاد الإغريقية القديمة إلّا بمصاحبة ذلك الضرير الهائم.
هوميروس أو “كفيف البصر”
لعلّ “سليمان البستاني” يكون أوّل مَن عرض باللّغة العربية، في العصر الحديث، لدلالة اسم “هوميروس” حينما باشر في ترجمة “الإلياذة” نَظماً إلى العربية في العقد الأخير من القرن التاسع عشر، وانتهى، في تقديمه المُسهِب لها، إلى أنّ أجدر معاني اسمه بالاعتماد هو “كفيف البصر”؛ إذ فقد الرؤية بسبب الرمد الذي أمحى بصره، وطمس نظره، وهو “لم يكد يتجاوز سنّ الشباب”، فكان يترحّل مُنشداً الأخبار القديمة التي جمع أشتاتها من أفواه الرواة. وما إن ظفر بالشهرة حتّى اختصمت حول نسبته إليها بعض قبائل اليونان ومُدنها. تزاحَم المُبصرون حول ضريرٍ مترحّل، وتقاسموا تركته من الأقوال، وجعلوها منبعاً لمجدهم، ومنهلاً لسموّهم، فكان أن حَظِي بالتعظيم، وأصاب التقدير، في سائر العصور اللّاحقة لعصره.
من المعلوم أنّ كلّ أمّة تبتكر لها شاعراً فحلاً من بين الشعراء المعبّرين عن أمجادها ووجدانها، وتلوذ به، فتُثري أشعاره بكلّ ما يخطر لها من هواجس، وتغذّيه بما يَرد على بالها من أحاسيس وشواغل، وتُنطقه بما تريد وتتمنّى، ثمّ تنزله مقاماً رفيعاً في خيالها وتاريخها. غير أنّ مجد هوميروس فاق أمجاد شعراء الأُمم الأخرى حينما وقع الاتّفاق على أنّه صاغ مكنون الذاكرة الإنسانية في بداياتها الملحميّة الأولى، وقد تعهّده بنو قومه بالرعاية، ولم يفتر اهتمامهم به على الرّغم من تعاقب الدهور، وتقلّب الأحوال، فدفعوا به إلى أرجاء العالَم ليكون مؤسّس القول الملحميّ في التاريخ. فقد انتمى إلى طبقة مُنشدي الشعر الجوّالين، ولم يلبث أن تزعّمهم في التطواف والإنشاد، فجذب الاهتمام إليه، شاعراً مترحّلاً، يترسّم خطى سابقيه من المُنشدين العميان، لكنّه اختلف عنهم في براعة القول، وحذق الصنعة، والتمرّس في صوغ المرويّات الحامِلة لمفاخر القدماء على نحوٍ لفت الأسماع إليه.
حمل هوميروس، في أوّل أمره، اسماً غير الاسم الذي اشتهر به في ما بعد. فالعمى هو الذي منحه الاسم الشعري. فقد اكتسب اسمه “الأعمى”، الذي يرجح أنّه كان نعتاً للكفيف المتكسِّب من شعره، وبه صار مَعْلَماً من معالِم تاريخ الشعر اليوناني. وليس قليلاً على عمى هوميروس أن يفتح الجدل على موضوع العمى والبصيرة. فقد انتهى “مانغويل”إلى إقرار الحقيقة الآتية: “أن تكون أعمى هو أن لا ترى الواقع الخارجي؛ في هذه الملاحظة يكمن الظنّ بأنّ الواقع الداخلي يكون مُدركاً بوضوح أكثر إن لم يكن معوّقاً بأيّ واقع آخر. إذا لم يَعُد عالَم اللّون والشكل مُدركاً، يكون الشاعر، عندئذ، حرّاً في إدارك العالَم بكليّته”؛ فتكون الرؤيا قد دفعت بالرؤية إلى الوراء، ونزعت الشرعية عنها، وحلّت محلّها، وصار موضوعها الاستكشاف الشعري للعالَم الذي ما عاد يُرى بمظاهره المرئية بل أمسى جزءاً من النَّفس والذِّهن والمشاعر.
أن يكتسب الشاعر اعترافاً مُدعَّماً بالثقة الكاملة من شعبه، فينبغي عليه أن ينتسب إلى سلالة الشعراء العميان المترحّلين الذين يتكسّبون بما ينشدون من أشعار، لكن ينبغي عليهم صوغ أمجاد الأُمم التي ينتسبون إليها، وتلك مُقايَضة شائعة شملت كثيراً من الشعراء، وكثيراً من الأُمم. على أنّ ميزة العمى فاقت سواها في تقاليد الآداب الإغريقية، فإنشاد الشعر كان مهنة العميان في البلاد اليونانية.
وعلى الرّغم من اتّهام هوميروس، كما ذكر القفطي، بالبطء في نَظم الشعر، وقلّة ما نُسب له من أشعار سوى الملحمتَين المشهورتَين، فقد عُدّ بتلك الأشعار فاتحاً للشعر الإغريقي، وهو طبقاً لما أكّده “باورا” يتميّز بأنّه “مُنشِد صادق، تمرّس بالنَّغم وسرد الحكايات”. ولأنّه أعمى، فلم يكن “يؤلّف للقرّاء، ولكنّه يَنظم للسامعين”، وغاية ما أراد، نَظم شعرٍ “يُلقى على مَسامِع القوم”. وعلى هذا، فقد شُبّه بـ”الشمس الغارِبة” التي لا يمّحي أثرها بعد زوالها، فتبقى صُور منها في العيون. فتشبيه حالته العمياء، بعد أن كان مُبصراً، بالشمس الغارِبة التي سطعت خلال النهار، تحيل على ما تجلّى لبصره قبل انطفائه. كأنّ الشاعر يرى العالَم بخياله، ويستكمل صنعه بما سمع من أقوالٍ وأوصاف.
*ناقد وباحث من العراق
نشرة أفق (تصدر عن مؤسسة الفكر العربي)