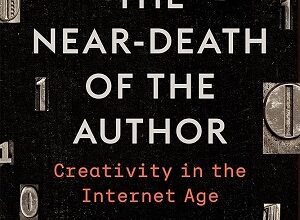الملف 42: كيف غدا العالم الحقيقي رواية؟

انطلاقا من الصفحة الأولى تحاول رواية “الملف42” لعبدالمجيد سباطة أن تؤسس ولادة وتكون وتطور سيرورة بنياتها النصية والتدليلية انطلاقا من وضع مؤلم يائس يعلن استحالة اكتمالها وتحققها كمشروع رواية مغايرة وغريبة، أو تقتحم عتبة الغرابة بتعبير عبدالفتاح كليطو. هذا يعني أنها تريد أن تعيش مخاضها وولادتها خارج الصندوق، وما يمليه، قسرا وتسلطا، من تفاهات تشييئية، لم تستثن الإبداع الروائي من دائرة تعفنها العطن. “أنا عاجز عن إتمام مشروع رواية بدأت كتابتها يوم الاثنين1 أبريل 2019.” إن الذي انسحب وانهار أمام هذه المواجهة الجهنمية بين الكتابة وبؤس التفاهة واجترار المألوف، وبين السرد الروائي والحقيقة التي تقف وراءها صراعات إرادات قوة همجية متغطرسة وجشعة، هو سلطة المؤلف التسلطية ذات الرؤية الأحادية والانغلاقية، ومقصدية المتكلم الخانق لديمقراطية التعبير والرؤى والأفكار في تعددها المختلف.
إنها رواية تؤزم نفسها، بالمعنى الإيجابي للأزمة في الصيرورة والحركة، والجدة والتغيير. فهي رواية تخلق دينامياتها وتوتراتها وغليانها. وترى في نقصها واستحالة اكتمالها أفق تشكلها الفني والجمالي، الذي يبتعد عن المألوف المجتر والمكرور، مقتحمة عتبة الغريب والمهمش المنسي. فهي غير جاهزة، ولا ناجزة أو نهائية. إنها الرواية المستحيلة، التي تطاردها لعنة النقص والألغاز والأحجية، التي تنخر متنها / القصة، ومبناها/ الخطاب. فالروائي وجد نفسه مورطا كمفعول في بنية النص، خاضعا لقواعد النوع المعنوي والقيمي الادبي للكتابة، ولا دخل له في قدر الرواية في أن تكون وتصير. هكذا واجهته بتحد صريح الشخصيات: “نحن نملك الحق في تقرير مصائرنا بأنفسنا”.
والأكثر من هذا فهو يعلن استسلامه، بل موته كضحية، بعد أن تجاوزه منطق الكتابة وآليات اشتغالها التي تبحث عن اكتمالها في تخطي نقصها، أي في الفراغات والمسكوت عنه، قصد إنتاج ذاكرة مضادة للمعتاد الذي عمر طويلا وحال بين انبعاث الحقيقة من رحم السرد، وخلخلة المظاهر البراقة للحقيقة السائدة، التي تطاولت مع الزمن وحالت دون إدراك الحلقات المبتورة، والمغيبة التي تحولت إلى ألغاز تنتظر من يفك طلاسمها، وينزع عنها غبار القهر والنسيان. مع تسليط الضوء على السياقات والمسارات، والكوارث و المآسي التي حاولت أن تميط اللثام عنها سردية “أحجية مغربية”، التي انتهكت باب الحكاية المحظور، وهي تعلن ولادة الحقيقة في صورة رواية مفعمة بعوالم السرد المرعبة والرهيبة، وهي تسرد مأساة شعب مهمش منسي قدر له بتواطؤ مشبوه بين الداخل والخارج أن يدفع الثمن باهظا، وتهدر حياته وصحته، ومستقبله. ويسدل ستار العتمة السياسية والاجتماعية، والفكرية الثقافية، على الجريمة، كأن شيئا لم يكن. ونحن نعلم، من خلال الرواية، الضحايا بالآلاف، بين قتيل ومعاق.
إننا إزاء نسيج من الدلائل والعلامات التي تشكل الرواية، وتجعلها عملا فنيا مستقلا لا علاقة له بتلك الثنائيات النمطية مثل الواقع والخيال. هكذا تتضافر داخل الرواية مجموعة من النصوص المختلفة الطرائق في الصياغة والأسلوب، مما جعل الرواية جديرة بتحقيق جمالية الأسلبة بامتياز كبير. وهذا يعني أن الحضور المكثف للكثير من أشكال الخطاب والأنساق الثقافية داخل الرواية، يتجاوز مستوى المجاورة وتقاطع النصوص ليحقق تفاعلا بنيويا مع منطق الكتابة الروائية. وداعما لآليات اشتغالها التي تسعى الى جعل الحقيقة/الواقع حاضرة في السرد وبه.
إننا أمام التناص الخلاق الذي يجعل المتخيل واقعا، حيث بتعبير نتشه يغدو عالم الحقيقة في النهاية رواية، يمكنها أن توجد وتصير في السرد ومن خلاله. “لست رجل سياسة يكذب على جماهيره لإخفاء الحقيقة، أنا كاتب يكذب ليكشف لقرائه الحقيقة”. لهذا تتكاثف وتتآزر تناصية النص في تعددها اللغوي والخطابي، وعلى مستوى الأصوات والرؤى، لجعل الرواية في غنى عن الاستنجاد بالمرجع/ الواقع المباشر.
هكذا تؤسس الرواية واقعية الخطاب ومتخيل القصة، حيث القارئ مشدود إلى النص غبر عابئ ولا مهتم أو منشغل بمرجعية المتن. همه الوحيد جمع الشظايا الحارقة للتحكم في قدرة إنتاج التدليل، وليس فقط توليد المعنى. لذلك تمتص الرواية وتستثمر الكم الهائل من النصوص الإبداعية والفكرية والصحفية…، حتى تستطيع الاكتفاء بنفسها مورطة القارئ في جنون رغبة ملء فراغاتها، وتجاوز النقص الذي يتهدد ها في سيرورة استحالة اكتمالها. “تناصية النص تفترض على الدوام أن النص غير مكتمل، وأنه يحاول دائما أن يصل الى بعض صور اكتماله تاريخيا عندما يقع بين يدي قارئ فعلي.”
تبعا لهذا الفهم والتأويل، لممكنات واحتمالات الرواية، الذي تبلور خلال تفاعلنا، أثناء القراءة، مع النص الروائي، حاولنا انطلاقا من استراتيجية الكتابة التي انبنت وفقها العوالم السردية للرواية، بالإضافة إلى الكثير من المؤشرات النصية، أن نقترح هذه القراءة للرواية التي تفتح ذراعيها لمختلف القراء مهما كانت خلفياتهم المعرفية والثقافية والأيديولوجية، ودرجة تمكنهم العلمي واقتدارهم الفكري والنقدي. لهذا سنركز على تأويل الدلالات الرمزية لبعض المؤشرات النصية، وما تفترضه أو تتطلبه من إسهام فعلي في سيرورة اكتمالها.
من خلال هذه الشخصية نتعرف على الوجوه الخفية للديمقراطية الأميركية خصوصا (والغربية عموما)، وما يتستر عليه النظام الرأسمالي النيوليبرالي من تحكم قهري مرن يتخطى الاستيلاب والتشييء، إلى هدر المشروع الوجودي للإنسان. ووضعه في نوع من الإقامة الجبرية على مستوى التفكير والتعبير والإبداع…، إلى درجة التحكم في زمام تقرير مساراته ومصيره، ونمط حضوره الوجودي. هكذا وجدت الكاتبة والروائية كريستين ماكميلان نفسها متورطة “قانونيا” في نوع من الوصاية الأبوية للرأسمال المالي والإعلامي، المتمثل في الثقافة السياسية والإعلامية التي تشتغل كموجه إرشادي للرؤى والأفكار وأسلوب الحياة والنمط الوجودي، للفرد والمجتمع والدولة. وهي ثقافة تشتغل بشكل رهيب وخطير بلغة الحرية والقانون في سعيها للسيطرة والهيمنة، لفرض قضايا واهتمامات، وتسويق تطلعات وطموحات، وأحلام وهمية بعيدة عن القيمة الإنسانية للفرد الذي يعيش بكل حرية تحت وقع سطوتها التي تسيطر على وعيه وتتحكم في إدراكه. كما تلجم ممارساته ومختلف أشكال فعله الفكري والابداعي، والسياسي الاجتماعي حين يجد نفسه مسيجا بقوالب ثقافة صندوق نظام التفاهة.
“بل أواجهك بحقيقة تحولك إلى كاتبة على مقاس تفاهات عصر ما بعد الحداثة، نجمة شباك يهتم القراء بحياتها الخاصة وصورها المثيرة على أغلفة مجلات الموضة، أكثر من اهتمامهم بما تكتب، نعم، سيحقق لك النجاح المزيف ثراء فاحشا، بما يمكنك من شراء منزل فاخر بضواحي نيويورك وإقامة شاطئية رائعة تطل على شواطئ ميامي، لكنه لن يضعك في مصاف العظماء، لست بالنسبة إلى ناشرك سوى فقاعة… وسيكون أول من يرميك بعد تراجع الاهتمام باسمك، إلا إذا استعدت زمام الأمور، بما يجعل من روايتك القادمة ميلادا جديدا لقلمك، لا إعلانا رسميا لوفاته.”
وبفضل صديقها براندون وجدت الكاتبة ماكميلان نفسها “خارج الصندوق، وربما خارج الولايات المتحدة الأميركية… المغرب”، لتكتشف الوجه البشع للديمقراطية الغربية، الذي تتستر عليه الحياة السياسية والثقافية والإعلامية داخل المجتمع الغربي، حيث يصعب على مواطنيه التعرف داخليا على همجية قوانين منطق السوق بالمعنى الرأسمالي الجشع للنيوليبيرالية، الذي يصوغ الأفراد في قوالب نمطية منزوعة الوعي والإدراك المعرفي والواقعي والأخلاقي تجاه الوجه الآخر الدموي للتراكم الرأسمالي في البلدان المستعمرة، أو المستقلة حديثا، من خلال النهب والسطو على خيرات وثروات الشعوب الضعيفة.
وفي هذا السياق يمكن اعتبار أب الروائية تمثيلا دقيقا للطبيعة المزدوجة التناقضية للديمقراطية الغربية التي تبدو داخليا مثالية ونموذجية، ومضرب للمثل والتفكير والحلم، وهادئة لا تبعث على الريبة والشك. ومألوفة إلى حد الاجترار الذي يفتقر لروح السؤال والمغامرة. لكنها تخفي حقيقة وجهها الآخر البشع الدموي الذي تعرف عليه براندون حين دفع الثمن غاليا من لحمه الحي لما نجا من موت محقق، حيث فقد ساقه. لهذا كانت تجربته وخبرته في دلالاتها الرمزية معاقة لا تمكنه من الحفر عميقا لرؤية حقيقة الوجه الدموي للنهب الاستعماري والتراكم الرأسمالي الذي تنهض عليه الديمقراطية الغربية. صحيح أن حدسه وامتلاكه للحس النقدي لواقعه الحي يسعفه في أخذ المسافة النقدية تجاه التفاهة السائدة. لكنه يفتقر الى الموهبة والحس الإبداعي الأصيل القادر على البحث، وملء شقوق التاريخ المنسي للقهر والظلم والمآسي، الذي يخفيه الوجه المشع والساحر للديمقراطية الغربية في تلاعبها بالمبادئ والقيم الإنسانية بمعايير مزدوجة داخليا وخارجيا.
هكذا كان الأب بالمعنى السياسي للهيمنة والسيطرة تعبيرا صريحا عن الصورة الإعلامية والسياسية للواقع الغربي المخادعة. لذلك يبدو كأنه لا يجر وراءه تاريخا من البشاعة والقتل والمآسي، المتخفية وراء مظاهر الصورة البراقة للمساعدات والخدمات الإنسانية. “والدي شخص بسيط جدا، حتى لا أقول بأنه ممل، عاد من المغرب وأكمل دراسته الجامعية، تزوج من أمي وحصل على وظيفة عادية في شركة عقارية، حياته أبعد ما تكون عن المغامرات والأسرار، ولا يوجد فيها تفصيل واحد يمكن أن نبني عليه صرحا روائيا متينا.”
وباعتبار براندون الصورة الداخلية للضحية المعاقة (وهنا ينبغي أن ننتبه للمعنى الرمزي للإعاقة بما يتجاوز الجسد) التي أنتجتها قوة وسطوة الديمقراطية الأميركية، فهو يمتلك إلى حد ما البوصلة والرؤية النقدية، لتحفيز النظرة، وإنتاج الأسئلة التي مكنت الكاتبة ما كميلان من الحفر عميقا وراء ما يخفيه مألوف هذا السطح المخادع للحقيقة الزائفة التي تدمر أي شيء مهما كان قيما لإخفاء سردية أسرارها البشعة.” كيف أقدم والدك على تدمير كتاب قيم إرضاء لرغبة نرجسية في إخفاء صور شخصية؟ … أشك هنا في أن الأمر يتعلق بصور سرية فضل والدك الاحتفاظ بها لنفسه وعدم إطلاع زوجته وابنته عليها، لارتباطها بماض بعيد سبق ما سماها حياته الحقيقية معكما على حد تعبيره.”
هذه هي الأرضية التي انطلقت منها الروائية لتحمل عناء ومشقة السفر والبحث وراء حقيقة الصور المثالية للأب الأميركي المخادع (القوة والسيطرة والهيمنة…)، التي تحولت إلى رواية تروى من خلال السرد. وقد رفضت الكاتبة تكريس المألوف الذي يكتفي بما يروجه السطح الزائف والتافه من مظاهر وتمثلات في غاية الوقاحة الأخلاقية والسياسية.” معلومات الصورة الثانية واضحة، منطقة مغربية تعرضت لفيضانات وانهيارات طينية شتاء عام 1958، فتدخلت القوات الأميركية الموجودة هناك للمساعدة، سيكون هذا منطلقا للحديث في روايتك عن بطولات قام بها والدك في إنقاذ الضحايا، تعلمين بأننا نحب تجميل صورة الأميركي الخارق الذي… قطعت نظراتي النارية كلامه.”
إن ما يخفيه الواقع اليومي الأميركي لمنطق السوق الرأسمالي النيوليبرالي، من اختلالات اجتماعية واقتصادية، ومن سيطرة على الوعي وتحكم في الإدراك، إعلاميا وسياسيا وثقافيا، رغم ما تحقق من مكتسبات ديمقراطية، وقيم حداثية، كل هذا يعريه الوجه الدموي لهذه الديمقراطية في الأطراف خارجيا وهو يمارس في حق الشعوب التي تعيش في ظل الاستبداد المحلي. هذا الوجه هو ما حاولت الروائية تعريته وكشف حقيقته، بالتعاون مع الضحايا الذين يدفعون الثمن بشكل أو بآخر. هكذا تتعرف الكاتبة على مثقف مغربي مقهور ومهمش، لكنه مسكون بهم وبؤس وأحاجي بلده. الشيء الذي ورطه عن قناعة معرفية وواقعية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الظروف والملابسات، والسياقات والترابطات المعقدة التي شكلت عوالم سردية “أحاجي مغربية” التي تغري بالرغبة في التعرف على مكوناتها وحلقاتها المبتورة بالقهر والنسيان. إنها ما يستحيل أن يكتمل في الرواية، ويظل سردا ناقصا ما لم يسهم تفاعل القارئ في اكتماله حسب ما تمليه عليه فرضياته التأويلية.
لم يكن الواقع السياسي الاجتماعي، والثقافي الأكاديمي (المشحون بالمصلحة الضيقة والانتهازية والولاء والمحاباة…) في صالح الأفق العلمي والمعرفي والنقدي الذي اختاره رشيد لنفسه مسارا ومصيرا. فإذا كانت الروائية ماكميلان ضحية التحكم المالي والسياسي والإعلامي في صناعة نجوم التفاهة، فإن رشيد محاصر بمختلف أشكال القهر الاجتماعي والسياسي والتربوي، والهدر الفكري والعلمي، التي حالت دون ممارسة شغفه المعرفي والبحثي، المرتبط أساسا بالمهمش والمسكوت عنه في صورة أقرب إلى الطابو والمحظور. فرؤيته الفكرية ونظرته النقدية القائمة على قناعات مبدئية وأخلاقية وواقعية جعلته معنيا بالبحث عن البنيات المضمرة والمنفية في رواية “أحجية مغربية” كسردية مقموعة أسدل عليها ستار التعمية والتعتيم، وأصابتها لوثة فقر الدم التاريخي، كأن المغرب الحديث لم يعرف كارثة الزيوت القاتلة التي دمرت المجتمع وفككت العائلات، وهدرت حياة الكثير من الأبرياء. لكن اللقاء الفكري والبحثي والإبداعي بينهما ساعد كل واحد منهما على تذليل الصعوبات، والتغلب على الاستعصاءات وضروب الصد التي وقفت في طريقهما. وهما يحاولان معا التعرف على الحلقات المفقودة، في “أحجية مغربية” وما ضاع منها من الأجزاء المبتور، والأسرار الإجرامية التي تحالفت فيها مصالح الوجود الكولونيالي مع القهر السياسي والاجتماعي والاقتصادي المحلي، متمثلا في الطبقة السياسية الحاكمة والفئات الاجتماعية المسيطرة (التجار…) وبعض شرائح النخبة المثقفة.
هكذا تم التعاون وتضافرت الجهود لأن الوجه التافه والبشع للديمقراطية الذي سلخ من الروائية قيمتها الإنسانية وجعلها في وضعية الاستيلاب والتشييء وفقدان الاعتبار الوجودي المستقل، إلى حد التحكم في حريتها وزمام مصيرها، لم تكن لتكتشفه وترى عريه المقرف اللاأخلاقي واللاإنساني إلا في المآسي المروعة التي تمارسها هذه الديمقراطية في حق الشعوب الضعيفة تحت غطاءات الخدمات والمساعدات الإنسانية التي جعلت الأب/ بالمعنى الكبير الرجل المنقذ العظيم الذي أدى خدمات إنسانية نبيلة. لكن خلف هذه الحقيقة/ الصورة كانت “أحجية مغربية” تضع الأسئلة المحرقة لسرديتها المأساوية، وتسمي كل من تورط من الأشياء والأشخاص بأسمائها الحقيقية.
وما كان لرشيد أن يتعرف طريقه في المسالك الوعرة التي نصبتها أحجية مغربية. إلا من خلال التآزر الفكري والنقدي والإبداعي الذي قدمته الروائية ماكميلان كوجه آخر نقدي إبداعي، حر ومستقل لهذا الغرب المتعدد. إنها صاحبة إرادة بحثية في الذهاب بعيدا في كشف المستور وراء الصور الخادعة، وقد لاح لغزه الملتبس في رواية “أحجية مغربية”. فوجدت نفسها معنية بإزاحة قناع الصورة، دون خوف من عقدة الذنب والتأثيم في حق الأب (القوات الأميركية ونظامها السياسي) المشبوه القاتل والمتغطرس، الذي كان يخفي وراء حقيقته الصورية سردية مأساة بشرية.
ثالثا/ صوت الضحية المشلول والمغيب
ما جعل رواية “أحجية مغربية” لغزا محيرا، وسردية شائقة هو قدرة الضحية على حفظ الذاكرة من النسيان. وقدرتها أيضا على توثيق الفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والتنافس النخبوي الانتهازي في صراعات هامشية. ففي شخصية خالد رفيقي صاحب رواية “أحجية مغربية” تتكثف معاناة وآلام الناس البسطاء الذين مستهم جريمة الزيوت القاتلة، بالإعاقات النفسية الجسدية المختلفة المشحونة بعذابات الآلام، وبالموت البشع، مع التهميش والتنكر للقيمة الإنسانية للضحايا وعائلاتهم. صوت الضحية مشلول، وموارده الجسدية في غاية الهشاشة والضعف المبين. لكن إرادته كانت قوية، وإصراره كان عنيدا بما فيه الكفاية لتحويل التاريخ الشفوي المكبوت والمنسي في قعر الذاكرة إلى سردية رائعة ساحرة لا تقل قيمة عن أعمال بعض الروائيين الذين، “أبدعوا أنساقا سردية جديدة تستطيع مفاجأة القارئ ومراوغة أفق تطلعه، مستفيدين إلى حد كبير من قدرة جنس الرواية على استيعاب مختلف الأجناس الأدبية، محطمين بذلك الحدود الفاصلة بين الأنواع، فأدرجوا القصة، والقصيدة، والمسرحية، والرسالة، والمقالة الصحفية، والأغنية وغيرها داخل المتن الروائي.”
هكذا كانت تفكر الرواية نفسها، وتتأمل بلغة واصفة منطقها الداخلي ككتابة أدبية، وهي تدرك قوتها في تقنياتها السردية، وآليات اشتغالها.
هذا الصوت المخنوق والمشلول والمغيب بفعل ظروف وصراعات موضوعية وذاتية. ولم يجد أي دعم ولا سند يسلط عليه الضوء، ويخلصه من أسر التهميش والنسيان، ومن كهف القهر والتعتيم والنفي القسري. إلى درجة صارت فيها “أحجية مغربية” طابو ولوثة تصيب عدواها كل من يحاول الاقتراب منها أو لمسها بأي شكل من الأشكال. حيث توقفت الجريدة التي أعلنت صدورها وأغلقت الدار التي نشرتها. “لا وجود لأي قراءة نقدية في العمل، سواء تعلق الأمر بمقال تحليلي أو دراسة جامعية مفصلة، كما أن الحصول على نسخة من الطبعة الوحيدة للرواية لم يكن بالأمر الهين… رغم كل العراقيل المذكورة، قررت الاشتغال في أطروحتى على رواية أحجية مغربية.”
هذا ما حاولت الرواية بحثه وتوثيقه، وجمع شظاياه الحارقة والمؤلمة، من خلال التعاون بين فعل المثقف النقدي المحلي والغربي. وتبعا لهذا الأفق استطاعت الرواية – قدر الإمكان- استثمار جميع المعطيات التاريخية، والأنساق الثقافية والإبداعية لإخراج صوت الضحية من الكهف المظلم إلى رحابة الفضاء العام لمعانقة شمس الاعتبار الإنساني، في سردية حارقة موجعة. قدرها شكلها الروائي الجذاب في عدم اكتمالها، أي في مطاردة فراغاتها التي تنخر بنيات منطق اشتغالها كصيرورة سرد وبحث لا يهدأ. وهذا ما دفع بشخصيات الرواية المعنية بأفق استحالتها إلى العمل على اكتمالها وإخراجها في صورة الرواية المستحيلة.