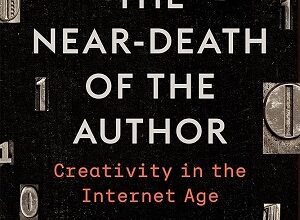الواقع المثقَل بأعباء الحرب في ‘زقاق الجمجم’

يقدم الروائي العراقي بيات مرعي في روايته “زقاق الجمجم” مجموعة من الأحداث التي يسترجعها عبر ذاكرته. وتدور في بيئة شعبية بسيطة تمتاز بواقعية شخصياتها، وبعلاقاتها الإنسانية الدافئة التي لم تعد موجودة في الوقت الحاضر.
وجاءت الرواية الصادرة عن “الآن ناشرون وموزعون” في الأردن في 232 صفحة من القطع المتوسط. واستحضرت كثيرًا من الأحداث التي وقعت خلال الألفية الثالثة في العراق، وما رافق تلك المرحلة من معاناة واحتلال.
وتدور الحكاية حول مشاهدات عسكري عراقي قدم إلى مدينة البصرة من خارجها، فعاد به شعوره بالغربة إلى ذكرياته في “زقاق الجمجم”؛ مسقط رأسه في مدينة الموصل، وهو مكان يمثّل ملامح المدينة وأهلها وتفاصيل الحياة اليومية هناك، فأخذ ينقل ما عايشه عن قرب من تفاعل بين أهل الزقاق، الأمر الذي جعل الرواية مليئة بالحكايات الفرعية التي تجسد هموم الناس هناك وخلجاتهم، ويختلط فيها العام بالشخصي تاركا أثره على أحلام الناس في الزقاق وآمالهم.
يصف بطل الرواية تفاصيل المكان قائلًا: “جدار منزلنا الجنوبيّ يطلّ على الزّقاق بنافذته الواسعة التي طالما كنت أجلس في حوضها منذ الفجر، وأرقب الأحداث نزولاً عند رغبة أمّي التي كانت تمنعني الخروج خارج الدّار قدر ما استطاعت خوفاً عليَّ، لكنّ الفُرَص التي كنت أقتنصها حين تكون أمّي مشغولة بأمور البيت كانت كثيرةً، فكنت أخرج من الدّار إلى زقاق الجمجم وألتحق باللّعب مع أطفال محلّتنا. زقاق ضيّق مبلَّط بالحجارة، تنبعث منه روائح مختلِفة كأنّ أحداً يحرق دهن العود وعرف الصّندل لتهبّ رائحةٌ على جناح طائر تجعل الرّوح تنتشي، ربّما كان ذلك لكثرة ما تتعطّر نساء الزّقاق بشتّى أنواع العطور، كنت أحبّ الخروج من الدّار لأعرف ماذا يحدث”.
ويتخذ المكان بذاكرته وتفاصيله المرئية والمخبوءة واشتباكه مع الإنسان الذي يعيش فيه، دور البطولة عموماً في الرواية، كما نقرأ في هذا المشهد: “كان ألقُ الشّارع ينبعث من أحداثه وأنا أبحر في كلّ ما يجري فيه، أتصوّر أنّ شارعنا (شهر سوق) أوّل طريق شقّها الإنسان على الأرض، وهكذا يضحك مَن يسمع رأيي هذا. وأنّ أوّل عربة خيل رقصت خيولها الأصيلة كانت فيه حتّى إن لم تذكرها الأساطير والملاحم، وأوّل نقطة ضوء سقطت على رصيفه فجعلتْه مضطجَعاً لجميلات محلّتنا، وأوّل لقاء للمطر كان على سطحه، وما قناطر أزقّته سوى بوّابات سحريّة تؤدّي إلى عوالم شتّى متناهية المسافات والأسرار. تلك القناطر التي تبتلع زائريها تحت ظلالها الفضّيّة الشّاحبة، التي تحتوي على ألف خرافة وخرافة من الحكايات والبطولات ترفد الحياة كلّها بالعِبر والنّصائح. تلك الأزقّة التي تمدّ سالكيها بحمّى روائح أطعمة مختلِفة أقرب إلى سيمفونيّة عارمة الضّجيج تلاحق الزّائرين من نافذة إلى أخرى على طول الطّريق وكأنّها تريد أن تُضيّف زائريها قبل أن يدخلوها”.
وتمتلئ الرواية بأحاديث الحرب وانعكاساتها القاسية على شخصيات الرواية التي يصوّرها البطل في أحد المشاهد قائلًا:
“عدد من سيّارات الإسعاف كان يمرّ مسرِعًا في تلك الشّوارع، تتقاطع وجهاتها. كنتُ خائفاً لأنّ المَشاهِد التي تخيَّلتها أو التي أشاهدها لم تعد تستر عيوب الحرب القبيحة التي دسَّت أصابعنا في مواقدها رغماً عنّا ولا يستطيع أيّ عقلٍ أن يتقبَّلَها باستثناءِ عقول المجانين أو الذين دجِّجَتْ عقولهم بأفكار الانتصارات والحروب والقتال. والمتعطِّشِين إلى سفك الدّماء. والذين يلهثون حول حلم المناصب والكراسي التي تخفي عيوبهم الشّخصيّة وانكساراتهم النّفسيّة كم تمنّيت حينها أن أنمو نحو الأصغر. نحو الماضي، فكرة غريبة أن أعود بالزّمن إلى الوراء كي لا أرى كلَّ ما يجري الآن حولي”.
وظهرت المرأة في الرواية بوصفها جزءًا أساسيًّا من نسيج المكان الشعبي الذي وقعت فيه الأحداث. ونقل البطل تفاصيل دقيقة لطبيعة الهموم التي تشغل النساء في الحي والأحاديث التي كانت تجري بينهن. ومن ذلك: “كانت نساء الزقاق يجهلن حساب الوقت بالساعات، فيحسبن معظم أوقاتهن باستدارة الشمس اليومية المتكئة على أسطح بيوتهن. وتحولات الظل التي ترافق هذه الاستدارة اليومية. لا بل إنهن لا يرضين حتى حساب أعمارهن بدقة، ولم يفطن مطلقا إلى أنفسهن إلّا ساعة وقوفهن أمام المرآة”.
وكذلك في المشهد التالي: “أدمنت النّسوة الجلوس على عتبات دورهنَّ كلَّ يوم كان وقت العصر مصحوباً بالضّجر العميق. حينَ أسندت مديحة يدها على ركبتها وهي تحاول الجلوس معلِنةً عن وجعٍ في ساقها اليسرى. وكأنّ ناقةً عرجاء حطّت مكانَها”.
الأحداث داخل الرواية أكدت على دور المرأة وموقفها خلال الحرب
وأكَّدت الأحداث داخل الرواية دور المرأة وموقفها خلال الحرب وبعدها. لا سيما ذاك النموذج الذي فقد الزوج أو المعيل . كانت إحداهن ضحية الحرب لكنها حافظت على نفسها، وصمدت في وجه ما اعترضها من صعوبات أو مغريات كان من الممكن أن تضعف أمامها لولا ما نشأت عليه من عفة ووقار.
تقول “مديحة” في أحد المشاهد: “أنا لم تتعبني السّنين يا مهديّة، إنّما الذّكريات السّيّئة. لقد حطَّ الغراب على شجرة حياتي مرَّتين. المرّة الأولى في عام 1990، عندما رحل الذي لم أتوقّع رحيله بهذه السّرعة نتيجةَ سقوط صاروخ أعمى عليه في غارة طائشة من طائرة حقودة.والمرّة الثّانية أنتنَّ تعرفنَها، تعرفنَ عذاباتي مع أخي (عبّود) الذي جاءوا به إليّ بعد أن أصابته شظيّة تائهة أفقدتْه عقله أيّام الحرب. فكان ذلك جبلاً ثقيلاً من الهمّ لا تحمله أرضكِ هذه التي تجلسين عليها يا مهديّة، فجعلني مجنونة أكثر منه، حتّى تعوّدتُ على تناول هذه الحبوب التي تشبه الحبوب التي يتناولها عبّود ولا تختلف عنها إلّا قليلاً”.
الرواية قدمت قبل نهايتها رؤية تنطق بالألم للواقع
وقدمت الرواية قبل نهايتها رؤية تنطق بالألم للواقع الذي انتهى إليه العراق بسبب الحروب التي أنهكت شعبه واستنزفت إمكانياته: “ساد الاعتقاد عند أغلب النّاس أنّ اللّعنة هنا أسطورة الموت لا تنتهي. ليبقى بلد الحضارات يصارع الحياة في غرفة العناية المركّزة. مضى أكثر من عام ونيّف على وجود بقايا متفرِّقة وقليلة من قوّات العدوّ تاركِينَ تراكماً من خيوط مقطّعة، ليس من السّهل ربطها أو إعادتها إلى وضعها السّابق. فهذا النّسيج المرتبك الذي جاء به المحتلّ عمداً طمس معالِمَ الحياة وثوابِتها ليكونَ البلد حلبة صراع بدأ ولا تُعرَف له نهاية”.
ومن الجدير ذكره أن بيات مرعي ولد في مدينة الموصل في العراق عام 1963، وهو كاتب ومخرج مسرحيّ. تخرج في أكاديميّة الفنون الجميلة بجامعة بغداد عام 1990. وهو عضو في نقابة الفنّانين العراقيّين وعضو الاتّحاد العامّ للأدباء العراقيّين، وصدر له قبل رواية “زقاق الجمجم” مجموعة كبيرة من الأعمال التي تنوعت بين المسرح والقصة والرواية، ونال مجموعة من الجوائز الأدبية العربية.